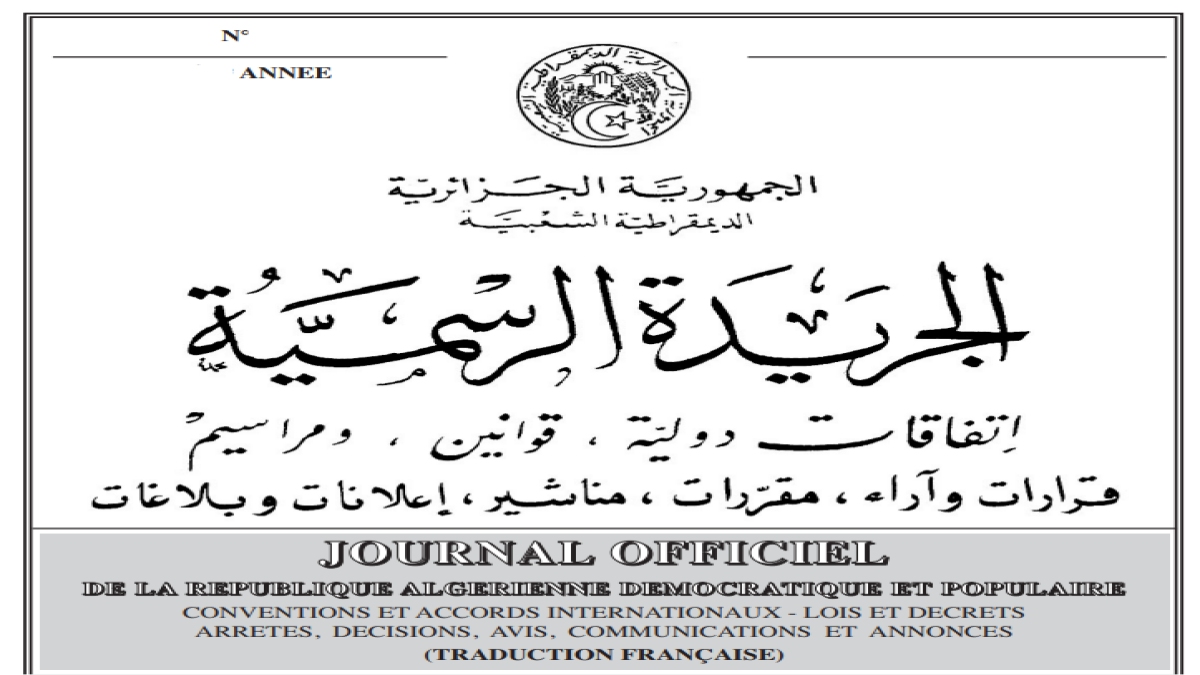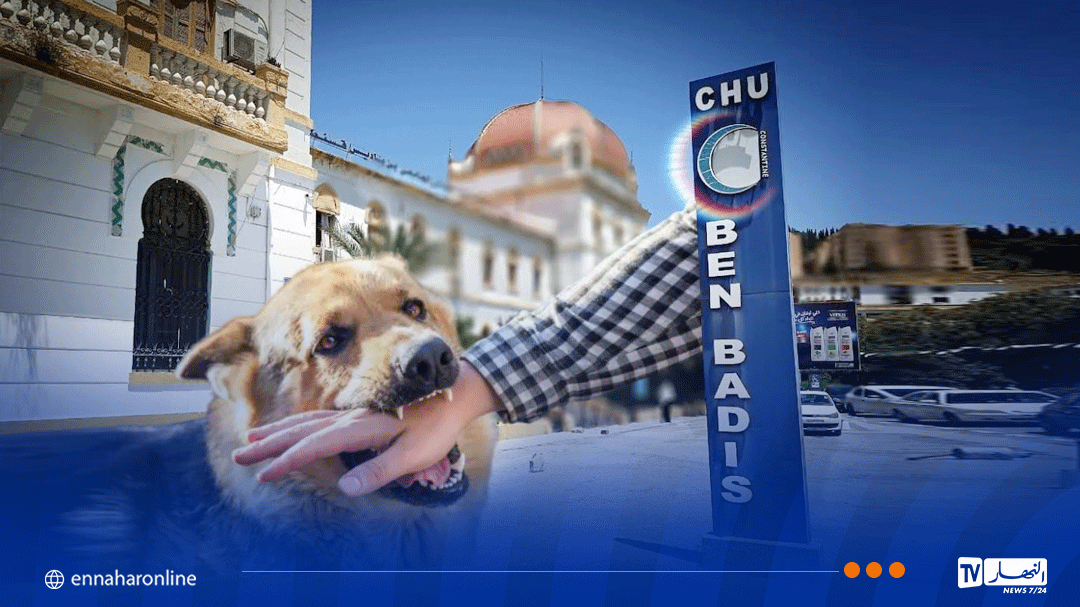لماذا يخون العرب المطبعون أنفسهم؟!
أ. خير الدين هني/ أثر الخيانة على واقع الأمة!! الخيانة فعل شنيع، وعمل فظيع، وشيء عظيم عند الله، وأمر محرم في جميع الأديان والشرائع والثقافات، وهي سلوك مقبوح لدى الأسوياء من البشر، إلا عند من اختل عقله وفسدت فطرته وانتكست طويته، وفقد توازنه العقلي والنفسي والديني والأخلاقي، فهؤلاء شرذمة لا يتورعون (لا يمتنعون)، من …

أ. خير الدين هني/
أثر الخيانة على واقع الأمة!!
الخيانة فعل شنيع، وعمل فظيع، وشيء عظيم عند الله، وأمر محرم في جميع الأديان والشرائع والثقافات، وهي سلوك مقبوح لدى الأسوياء من البشر، إلا عند من اختل عقله وفسدت فطرته وانتكست طويته، وفقد توازنه العقلي والنفسي والديني والأخلاقي، فهؤلاء شرذمة لا يتورعون (لا يمتنعون)، من فعل أي قبيح، مهما كان محرما أو فيه اشتباه أو غير أخلاقي، فالفرد الذي لا يتورع هو من يبيح لنفسه ارتكاب المعاصي والمحظورات دون تردد أو خجل أو حرج أو قلق من العواقب، فيرى هذا الفرد غير السوي الخيانة أمرا طبيعيا مادامت تحقق له المنفعة والكسب.
فالكسب والمنفعة والطموح الزائد، هي المخرجات التي تستهوي الخائن وتجعله يسعى بكل جهد ومكر وخديعة وحيلة لبلوغ أهدافها، لأنه فقد الضمير والإحساس وحسن الاستقامة في الدين والخلق والمروءة، وهو حين يفكر في الخيانة تكون معايير القياس الأخلاقي لديه قد تلاشت واختلت وجاهتها، وأصبحت الإحساسات والمثل الفطرية التي يحتكم البشر إليها في حياتهم، للتفاضل فيما بينهم على أسسها، أو لتمييز الفضيلة عن الرذيلة والخير عن الشر، قد فقدت وجاهتها المعيارية.
فمعايير القياس التي تُقيَّم بها الأشياء، لا تقبل عند الخائن إلا إذا كانت ذات بعد عملي ونفعي، ولا يقبل أي معيار في الممارسة، إذا كان غير عملي وينزع إلى التجريد كما يقرره فلاسفة الأخلاق، فالخيانة بمفهوم الخائن حنكة وحكمة وشطارة ودهاء وبعد نظر وتكيّف إيجابي مع الأوضاع والظروف الجديدة، والتكيف الإيجابي حسب نظرية هؤلاء الرهط، نابع من الغريزة المتوثبة والذكاء المتوقد والقريحة (الملكة أو الموهبة)، الملهمة والمبدعة في عالم الأفكار والإبداع والاختراع، تفرضه الدينامية (الحركة) المتغيرة للحياة.
فالحركة والتطلّع والتجديد في المفهومية الأخلاقية، هي الآليات الميكانيكية والفنية التي يحقق بها الإنسان الخائن المنفعة والطموح واللذة والمتعة والسعادة، وقد استلهم مفاهيمها التبريرية من الفلسفة الذرائعية، التي تتوخى التجربة الحسية والنتائج العملية، ذات البعد العملي والنفعي، حيث تُعَد الذرائعية مذهبا فلسفيا وضع قواعدها وأصولها فلاسفة تجريبيون غير مثاليين، إذ تركز المثالية في فلسفتها على الأفكار المجردة التي لا واقع عملي لها في الحياة، إلا بما يتخيله الذهن وفق شطحات تصورية مجردة من الصور الحسية، لا تخضع للتجربة والنتائج الملموسة في واقع الحياة.
فالأخلاقيون لا اعتبار لهم في تفكير الخونة، لأنهم يعيشون في أوهام الخيال المثالي بعيدين عن الحياة وتعقيداتها الظاهرة والباطنة، وتتغذى المثالية من الأفكار المجرة ذات البعد الأخلاقي، خلافا للذرائعيين الذين يناهضون الفلسفات الطوباوية، التي تتغذى من فلسفة المثل والقيم الرفيعة والأخلاق الفاضلة، لكون الإنسان في تقدير هذه الفلسفة وبعدها الروحي، محكوما بنظم دينية وأخلاقية جامدة، ولا سبيل إلى التحرر من قيودها في عالم السياسة والنشاط والتدبير والحركة، إلا في إطار ثابت وجامد من غير حركة أو إرادة حرة في الانفصال عنها، لأن الانفصال عن قواعد الأخلاق ولوازمه، يعني الخروج من القيود والضوابط والقواعد، ما يؤدي إلى الانغماس في محظورات الدين وموانع الأخلاق، والانفصال الحر عند المجتمعات المحافظة حسب تقدير الخائن، يؤدي به -حتما- إلى عدم الالتزام بالضوابط والقواعد والمبادئ والمثل الرفيعة، وهذا السلوك المثالي المتكلس لا يستسيغه الخائن، لأنه يجمد حريته ويعيق حركته ويعطل نشاطه ويخيب آماله في بلوغ أهدافه.
ولذلك لا يقبل الذرائعيون اللبراليون الفلسفات الطوباوية المجردة، التي تقوم على أفكار الدين والأخلاق، لأنها فلسفات خيالية لا تمت إلى عالمنا المحسوس بأي صلة، وهي لذلك لا تحقق كسبا ولا منفعة مادية، والأفكار عندهم لا تكون صحيحة إلا إذا كانت عملية ومفيدة.
فالذرائعية اللبرالية عند السياسيين، تتوخى تجسيد الفعل السلوكي أو السياسي، في تجارب واقعية بما يخدم المنفعة العامة للدولة أو الحياة الشخصية للصَّفَوات من عليّة الأفراد والنخبة كما يصنفون أنفسهم، ولذلك يعتبرون الخيانة في أوضاع معينة، وبحسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة، أمر تُسوِّغه الضرورة ولا غضاضة فيه (لا حرج أو منقصة أو عيب)، إذ إن الضرورة تستلهم آليات مسوغاتها في كل الأحوال من دينامية الحياة وتطور أفكارها، وقد بنت هذا التصور الفلسفي من إلهام، انبثق ممّا رسمه خطّ الاتجاه نحو ما يحقق لذة الإشباع والمتعة والسعادة، بما يغني النفس من رغباتها واحتياجاتها وطموحها الذي لا يعرف الحدود، وهي الاحتياجات التي تحقق للنفس الطامحة الكينونة والديمومة، العلو والرفعة والاستغراق في النرجسية، ومتعة الشعور بالوجاهة والتألّق، أو ممّا اكتُسِب من الغنى والثراء أو المنافع أو الوجاهة السياسية أو الاجتماعية.
ولهذا نجد الذرائعيين اللبراليين من التشكيلات البشرية، يسوغون لأنفسهم أي فعل غير أخلاقي، في التجارة أو الأعمال أو المعاملات البينية أو في السياسة والتنافس على الحكم، أو البقاء فيه وتوريثه لخلفهم من الأبناء والأحفاد، ويقبلون التضحية بكل قيمة لها بعد مثالي وأخلاقي طالما أنها تحقق لهم المنفعة والكسب، ولذلك -أيضا-اتخذوا من الرذيلة والأخلاق المقبوحة، عملا مشروعا ومباحا في الممارسة والسلوك والعمل والمعاملة، حيث تغيرت بلدان محافظة فقدت عذريتها المطهرة، حين تحولت إلى الغوص في عالم الرذيلة، والتكسر والعري والدعارة والفحش العلني، كل ذلك باسم الإلهام الجسدي الذي يتوق إلى إشباع النهم (الإفراط أو الشراهة في الاستهلاك)، بكل ما يشبع الجسد ويسعده باللذة والمتعة واليسار.
ولهذه الأسباب غير المنسجمة مع لذة الروح، نجد الأخلاقيين والدينيين والمحافظين، يشنّعون بمن ينزعون إلى أسلوب الخيانة والغدر والعمالة للعدو، وينعتونهم بكل وصف قبيح، لأن الخيانة في كل أحوالها وظروفها، لا تخدم وطنا ولا أمة أو قضية وطنية أو قومية، وإنما ينكفئ نفعها على حياة الأفراد الفاقدين للضمير والحس وشعور الانتماء، وكذا على من يلتف حولهم من الانتهازيين والوصوليين ومن لا ضمير أخلاقي لهم، ممن يسوِّغون لهم اقتراف كل فعل فظيع وشنيع، ويزينون لهم قبيح أفعالهم، بتأويل الفتاوى الدينية أو القانونية أو الدستورية أو الأخلاقية، وهؤلاء التيوس المحلِّلون الذين لا يخافون الله، سيتحملون أوزار أوليائهم الخونة، وزيادة من الذنوب والآثام، لأنهم ضلّوا وضلّلوا غيرهم من العوام، الذين لا علم لهم بأصول التأويل ومآلاته الخطيرة.
وعلى هذه القواعد غير السوية، نلفى الخيانة بمساوئها وقبحها وشناعتها، تُمجّد من قبل الأعداء وتُقدس ويُنوّه بأصحابها، كما فعلت فرنسا الغشومة مع الخائن بوعلام صنصال وكمال داود ودعاة الانفصالية، وغيرهم ممن ماتت ضمائرهم وباعوا شرفهم وبلدانهم، وأكبر من ذلك -جرما- أن ينال كل من يتصف بخيانة أوطانهم وشعوبهم، التزكية والترقية وتعليق الرتب والشارات والنياشين، كفعل فرنسا مع رموز الحَرْكة الخونة ممن بقوا أحياء، وينالون الإطراء والتقدير وحسن الثناء من الأعداء، مثلما فعل دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى، مع كبير المطبعين العرب حين اجتمع به، وسمع منه ما لا يخطر على بال أحد، وقد أبدى له المطبِّع ردة خطيرة وتنازلا كبيرا من غير إكراه ولا إلزام، من أنه مستعد للتحلل التام من كل مقدس أو فضيلة أ و قضية من قضايا الأمة المشروعة، وقد ظهر على محيا الدبلوماسي وسحنته، -وهو يتحدث عن خصال المطبِّع- الشعور بالفرح والسرور والغبطة والارتياح والإعجاب الكبير، حين كان المطبِّع يتودد إليه ويتألّفه ويتزلف إليه، بتقديم هذا التنازل الكبير والمجاني، من غير شعور بالحياء والخجل والتذمّم والحرج!!
صرح الدبلوماسي الأمريكي بقوله وهو فرح جذلان: «إن العرب أخطؤا حين وصفوا هذا الرجل العظيم بــ(….)»، والحال أنني وجدته رجلا كفئا حكيما عليما رزينا متفهما لقضايا أمته والعالم، وهو متفتح على الأفكار الجديدة النيرة، المجافية للأفكار الظلامية، يقصد أفكار التحلّل من الإسلام الظلامي، وقَبوله الطوعي بموالاة اليهود والنصارى وتنفيذ المشروع الصهيوغربي كاملا غير منقوص، وقد قبل في كلام ضمني مُبَطّن، بيع كل شيء مقدس طالما أن صفقة البيع مربحة لمشروعه السياسي، لأنها ترضي الصهيونية والغرب وتجعلهم يَحدبون عليه ويترضّون عنه، وتحقق له المنفعة من الوصول إلى الحكم وتوريثه لمن يأتي بعده من أولاده، كل ذلك يكون على حساب المقدس والقضية الفلسطينية المركزية في السياسة العربية، والمشروعة بالإرث التاريخي والقوانين الدولية والأخلاقية المعاصرة، وأن هذه الصفقة تدخل في باب ما يسمى في لغة الاقتصاد (رابح رابح).
أثر الخيانة على سمعة المطبعين!!
ولا ريب أن أثر الخيانة كان سيئا على سمعة المطبعين مع الكيان الصهيوني، وهؤلاء المطبعون من العرب إنما قبلوا مشروع الخيانة، لأنهم اعتبروا الخيانة من لوازم الذرائعية الميكيافيلية (الغاية تبرر الوسيلة)، وهي الفلسفة التبريرية التي تؤمن بالأفكار الوظيفية ذات البعد النفعي، فعلوا ذلك بعدما تملّكهم الرعب من هبَّة ثورات الربيع العربي، وهي الثورة التي قذفت برموز الفساد والطغيان في مزبلة التاريخ، وأصبحت اللعنات تطاردهم بخزيها وعارها إلى يوم الدين، وكانت لهم نهايات مأساوية على أيدي شعوبهم، أبكت الأعداء والخصوم قبل الأصدقاء، وقد لمسوا بأنفسهم كيف كان أصحاب المشروع الإحيائي من خيرة الشباب المتيقظين ونخبة مثقفيهم، هم من كانوا يتزعمون هذه الثورات ويوقدون جذوتها كلما َّخبأت، فلما انتهت بالقضاء على الفساد والمفسدين، انتخبت الشعوب رموز هذه القيادات من الإحيائيين، ليقودوهم عبر المؤسسات الدستورية.
فلما رأت قيادات النظم الوراثية والانقلابيين من المطبعين، هذا التغيير الطارئ والمهدد لعروشهم، انتهجوا سبل الخيانة مع العدو الغاصب، لأنهم قدَّروا أن العدو المحمي من الغرب هو من يضمن لهم البقاء على عروشهم، وقد وجدوه بالقرب منهم، وهم جميعا يتقاطعون في بغض الحركات الإحيائية، ويشتركون في معاداتها والكيد لها بالمكر والخديعة والضغينة، لأنها تحمل مشروعا إحيائيا لا ينسجم مع مشاريعهم الإبراهيمية والتلمودية، وأن هذه الحركات هي من أجج ثورات الربيع العربي، ولعل الذي أزعجهم وأرعبهم جميعا أن هذه الحركات مُتشبّعة بالأفكار الثورية، المناهضة للمعتدين والغاصبين والظالمين والفاسدين والخونة، لذلك تحالفوا في توليفة صهيو غربية عربية، بما شبّهه المحلِّلون في فتاويهم الفاسدة بحلف الفضول، بقياس خاطئ وضال وبعيد عن الحق.
فكان تحالفا دينيا وثقافيا مدمجا، وعسكريا واستخباراتيا بما يخدم مشاريع الصهيونية، مقابل حماية عروش المطبعين من ثورات شعوبهم والتهديد الإيراني المزعوم، وكذلك مقابل حفظ امتيازاتهم وديمومتهم في الحكم أولا، ثم من أجل القضاء على هذه الحركات الثورية ثانيا، ولكي يقطعوا خط الرجعة على الإحيائيين، اتفقوا على استئصال النصوص القرآنية والنبوية التي تشنّع بجرائم اليهود وغدرهم وخيانتهم ونقضهم العهود من المناهج الدراسية، وهي النصوص التي قدّروا أن محتوياتها وأهدافها، تغذي عقول الحركات الثورية بالأفكار المناهضة، للظلم والظالمين والمفسدين المعتدين ممن نشروا الفساد والبغي في الأرض.
وإنه لمن المعلوم أن الكيان والغرب المتصهين، يكنّون في نفوسهم عداء كبيرا للإحيائيين، لأنهم قدّروا أنهم متى وصلوا إلى الحكم واجتمعت كلمتهم على وحدة الصف، انتفضوا على الصهيونية الاستعمارية، واجتثوا جذورها اجتثاثا وتركوها خبرا بعد عين، لأنهم يعلمون أن من تقوده الفكرة العُلْوية، لا يمكن بيعه بالأثمان البخسة، وأن من تقوده الفكرة والأيديولوجيا السامية، ليس من اليسير شراؤه أو التأثير في أفكاره ومشاربه وتوجهاته، وحركة الطالبان وإيران مثال، لذلك اجتمعت مصالح المطبعين والصهيوغربية، على تنظيم الثورات المضادة على الحكومات المنتخبة في بلدان الربيع العربي.
ومنذ ذلك التاريخ أوحت الصهيوغربية إلى النظم الوراثية والانقلابية، أن خلاصهم من خطر السقوط والزوال، لا يكون إلا بالتطبيع الفوري مع الكيان، مقابل حماية عروشهم من ثورات الإحيائيين والثوريين المناهضين لهم.
تلكم هي الخطط المحبكة، التي حيكت بين المتحالفين في الغرف المظلمة، وذلكم هو اللغز المركزي الذي ظل مخفيا على الكثير من الناس، وبعث في نفوسهم الحيرة والقلق على حجم الخيانة العربية لقضاياها العادلة، وجعل المطبعين يخونون أنفسهم ودينهم وأمتهم، ويهرولون -تباعا-إلى تنفيذ خيانة التطبيع والعمالة مع الكيان والغرب المتصهين عدو العرب والمسلمين.
وآية ذلك أن الدول الوراثية الغنية، ليست في حاجة اقتصادية أو علمية أو تكنولوجية إلى الكيان وحلفائه الغربيين، لأن أموالهم الطائلة المكدسة في الخزائن العامة والخاصة وصناديق السيادة، (أكثر من تريليون دولار لكل دولة أو ما يقارب ذلك في صناديق السيادة فقط)، ويمكن أن يشتروا بها ما يشاؤون من الدول المتطورة المعادية للغرب، كالصين وروسيا وغيرهما، ولذلك أصبحت كبيرة الدول المطبعة تعمل في السر والعلن، بكل وسائل الدعاية والتحريض والترهيب والإغراء، لمحاربة الإسلام والمسلمين في الغرب والتضييق عليهم، وقد اشترت لوبيات سياسية وإعلامية ومالية وفنانين نافذين من أجل تحقيق هذه الغاية، وهناك دول أخرى تعمل في الخفاء بالكيد والمكر والخديعة ضد الإسلام والمسلمين، حفاضا على سرية العمل لحساسة موقعها من المسلمين.
أما نظام المخزن، فكان ولاؤه للصهيونية سريا منذ أمد بعيد، ولولا بقية من حياء وتذمّم لتظاهر به في حينه، وأعلن ولاءه وتطبيعه مع الصهيونية منذ زمن التخفي، ولكن الظروف السياسية كانت غير مواتية، إلى أن جاءت لحظة الخروج من السرية، والإعلان عن التطبيع، فاهتبل الجميع هذه الفرصة الملائمة، التي لا يجود بها الزمن إلا قليلا، وأسرع المخزن إلى إعلان التطبيع رغم معارضة الشعب المغربي المقهور، وهدف المخزن ليس المحافظة على العرش فحسب، ولكن غايته الكبرى هي جلب استعطاف الغرب المتصهين معه، وتأييده للاستيلاء على جغرافية الصحراء الغربية، وابتلاع أراضيها وقهر شعبها، والسيطرة على ثرواتها ومواردها.
فالمخزن حين أقدم على مشروع التطبيع، إنما لأنه يعلم -يقينا-بأن التطبيع مع الكيان، هو مفتاح النجاح في جلب هوى الغرب، المؤيد للصهيونية الاستعمارية والمناهض للقضايا العربية، وللشرق المداهن المتواري خلف حجب النفاق، وما إن تم التطبيع الفعلي هرولت دول الغرب الكبرى تباعا، إلى الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية، وبعد ذلك بقليل، تدفقت عليه الاستثمارات الضخمة في الصناعة والفلاحة والسياحة والبنية التحتية.
وأقبلت عليه جحافل من وفود السياح، بالتشجيع والإيعاز السياسي والدعاية الإعلامية المتصهينة، إلى أن ارتفع لديه مستوى النمو إلى درجات عالية وغير مسبوقة في سجله السياحي، فسجل في موسم 2024أكثر من 14 مليار دولار في السياحة فقط، وهو يخطط لبلوغ 30مليون سائح قبل حلول عام 2030، بعوائد مالية بالعملة الصعبة تجاوز 20مليار دولار، ما جعله يخرج من ضائقته المالية التي أثرت على الموازنة العامة، وقد فرضت عليه هذه الضائقة مظاهر من الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وإني أقدّر أنه سينهض من ظاهرة التخلف في غضون عقدين فقط، إذا سار على هذه الوتيرة من تدفق الاستثمارات الكبرى، كما وقع مع كثير من الدول الصديقة للصهيونية والغرب، في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، (البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية وهونكونغ وطايوان والهند، مثال).
على أن الغرب والصهيونية، تخلّقوا بعادات الاستعمار والنهب والسلب وسرقة موارد الشعوب الضعيفة من غير حرج، وأصبح هذا السلوك العدواني المشين يشكّل أساليب تفكيرهم، وعواطفهم وأحاسيسهم وشعورهم، يحيون عليها ويموتون من أجلها، ولذلك تراهم يؤيدون أي حركة استعمارية أو توسّعية أو نهب موارد من أي دولة، طالما أن ذلك يحقق أهدافهم ومشاريعهم، وبما أن المطبعين العرب خانوا أنفسهم وشعوبهم وأمتهم من أجل أهدافهم السياسية، فلا يوجد بعد ذلك ما يمنع الصهيونية والغرب من مجاملاتهم والتعطّف معهم والحَدْب عليهم ظاهريا، طالما أنهم يسيرون في ركابهم ويأتمرن بأمرهم ويخضعون لإرادتهم، رغم أن الصهاينة والغرب يخفون في نفوسهم ،أعمق مشاعر البغض والمقت والكراهية، لكل عربي وإن كان من كبار الخونة المطبعين الموالين لهم، لأن كره العرب والإسلام عقيدة نشأ عليها اليهود والمسيحيون منذ الصغر، وقد تشربوا مشاعر البغض والكراهية في الأديرة والبيع من الرهبان والقسيسين، ممن يبغضون الإسلام بغضا لا نظير له في السلوك الإنساني، لأنهم يعتبرون الإسلام والعرب والمسلمين من بعد، هم من أسقطوا التاج الروماني رمز الحضارة الغربية في اليرموك والقسطنطينية ، ثم في سائر الممالك المسيحية في أوروبا، وأن النبي محمدا والعرب هم من طردوا اليهود من شبه الجزيرة العربية. وهم يعتبرون الإسلام العدو اللدود لمشاريعهم التنصيرية والتلمودية والاستعمارية، ولذلك يوقدون له نار كل حرب، سواء أكانت نفسية أم ثقافية أم دعائية أم باردة أوساخنة.
وللاستدلال على صحة هذا الفرض، أورد ما صرح به الرئيس بوش الابن حين أعلن قبل غزو العراق، أن هذه حرب مقدسة بين الإسلام والمسيحية، وكذلك ما أعلنه نتنياهو مؤخرا من أن لا فرق عنده بين حماس وعباس محمود والسلطة الفلسطينية، رغم ما تبديه السلطة من فروض الطاعة والولاء الأعمى والتذلل المشين للكيان والغرب.
ونختم فنقول: إن الخيانة مهما كان لونها، عواقبها وخيمة على الخائنين وإن طال زمنهم أحياء أو أمواتا، وعلى الأمة ومشاريعها السياسية والحضارية، فهل من متعظ؟