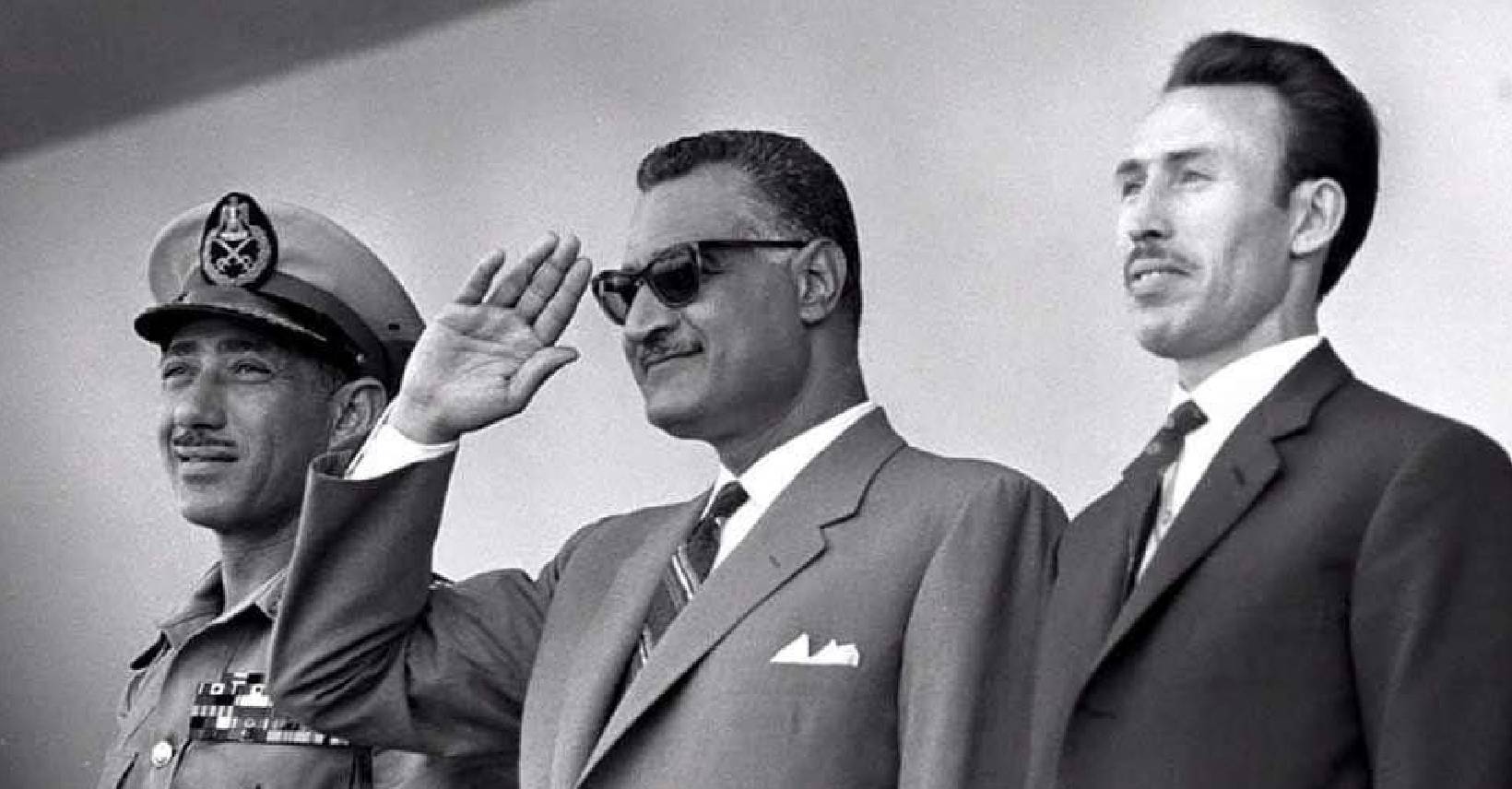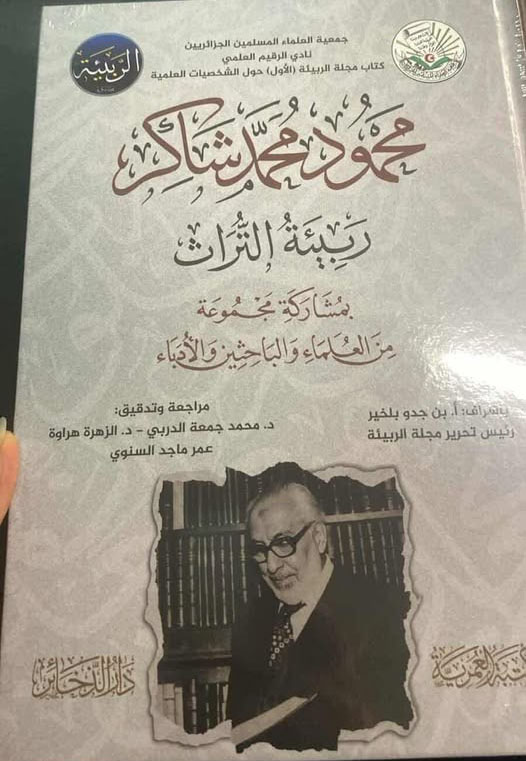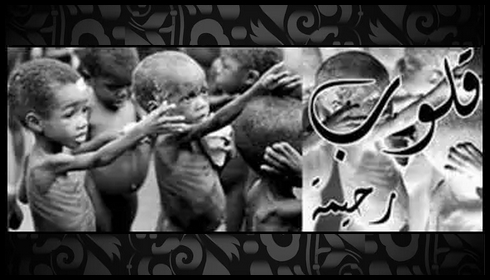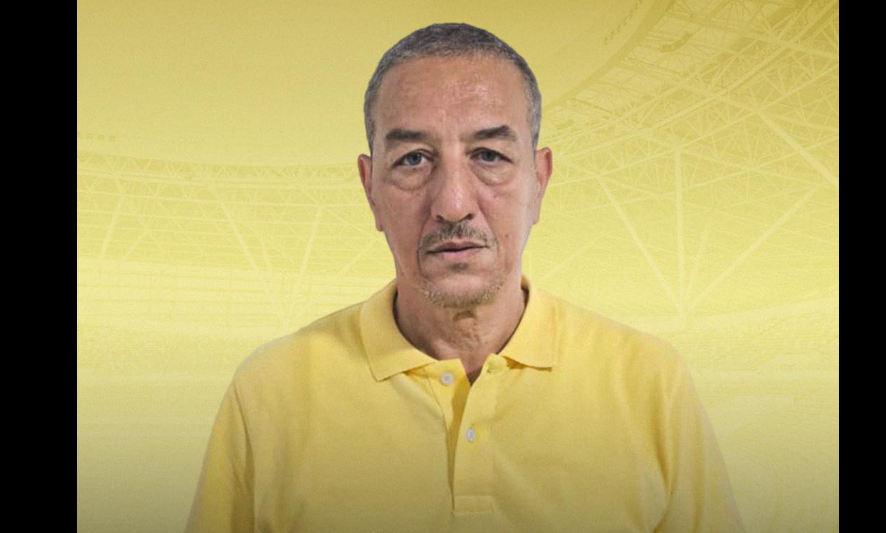ورقة طريق لاستراتيجية الأمن المائي في الجزائر
من البديهي أننا ندرك حجم القيود والتحديات التي تواجهها الجزائر والتي ازدادت تفاقما بسبب آثار تغير المناخ خلال العقد الماضي، وكذا انخفاض معدلات تساقط الأمطار إذ أنها أصبحت تقل عن 300 ملم/سنويا بالمناطق الغربية، بينما تتراوح بين 650 إلى 800 ملم/سنويا بالوسط وبالجهة الشرقية من البلاد ويسود مناخ شبه جاف في الشمال، إلى جاف في الهضاب والصحراء إذ نسجل قيمة تتراوح بين 150 و300 ملم/سنويا مع تسجيل تباين شديد في كميات الأمطار بنسبة تتراوح بين 30% و80% على المستوى المكاني، هذا من جهة.من جهة أخرى، نسجل انخفاضا حادا في احتياطي مياه السدود اعتبارا من سنة 2020، حيث يبلغ حجم المياه القابلة للاستغلال في السدود عند نهاية شهر أغسطس، نحو 2.3 مليار متر مكعب، أي 30% وهي نسبة ثابتة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، على عكس عامي 2018 و2019 حيث كان معدل منسوب المياه خلال نفس الفترة، أكثر من إيجابي إذ بلغ حوالي 54% أي ما يعادل سعة بقدر 3.5 مليار متر مكعب وهذا دون إغفال ظاهرة التبخر الكبيرة بقيم تتراوح بين 1200 و1500 ملم /سنة في بعض المناطق الداخلية، لاسيما في الصحراء. بطبيعة الحال، تسببت هذه العوامل السالفة الذكر في إحداث إجهاد مائي مزمن تمثل في انخفاض نسبة مخصصات المياه للفرد الواحد سنويا إذ نسجل كمية سنوية تقل عن 300 متر مكعب سنويا للفرد الواحد وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالعتبة الموصى بها من قبل الأمم المتحدة بمقياس 1000 م3 مكعب سنويا للفرد الواحد. يضاف إلى هذه القيود والعوائق عوامل أخرى لا تقل تأثيرا عن سابقتها وتتمثل في التحديات البنيوية على غرار قدم وضعف فعالية بعض شبكات التوزيع، مما أدى إلى ارتفاع نسبة كميات هدر للمياه الضائعة ببعض المدن إذ بلغت الخسائر نسبة 40% في بعض المناطق، لاسيما بالمدن الساحلية التي تزود بمياه البحر المحلاة مع تسجيل انقطاعات متكررة في الخدمة وضياع كميات معتبرة من المياه والمقدرة بـ35% . يحدث هذا رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات العمومية في إطار إنجاز برامجها الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية لمياه الشرب والصرف الصحي. فقد تجاوزت عملية توصيل المنزل بالشبكة نسبة 95% لكن معالجة مياه الصرف الصحي لم تبلغ بعد الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني للماء بالرغم من كل الجهود التي تبذلها السلطات العمومية منذ الاستقلال، حيث إنه لا يتم معالجة سوى 40% من مياه الصرف الصحي مما حال دون الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروة وتسبب في فقدان مورد إضافي مربح من شأنه أن يعزز المرونة من خلال استخدامه في مجالات الري الفلاحي وضمن إطار تنظمي يعزز الاستعمالات للمياه المصفاة وفق المعمول الدولية المعمول بها. من ناحية أخرى، تجدر الإشارة أن استمرار الضغط البشري الناجم عن النمو الديمغرافي حيث سيصل تعداد السكان الى أكثر من 50 مليون نسمة مع حلول سنة 2030، مما يقتضي توفير احتياجات إضافية ماسة من مياه الشرب، تلبية لاحتياجات الساكنة إذ سيبلغ سقف الإنتاج تمكنا إلى من 9,3 مليون م3 مكعب يوميا، أي المخصصات لتغطية الاحتياجات والمقررة للفرد الواحد بمقدار150 لتر مكعب يوميا ونسبة التسربات للمياه لا تفوق20 %. واستشراف التزايد السكاني مع تطور النسيج الحضري بسرعة من المحتمل أن يصل إلى نسبة 75% من مجموع الساكنة بالمناطق الحضرية. كما لا يفوتنا ا ننوه بضرورة إمداد قطاع الزراعة بكميات المياه الضرورية والمنتظمة التي من شأنها أن تدفع بعجلة الإنتاج وتعمل على تنويع العائدات للنشاط الاقتصادي قصد الحد من الاستيراد وكذا التقليل من التبعية لعائدات المحروقات. كل هذا يدفع بنا للقول بكل تأكيد أنه قد بات من الضروري إقحام نهج علمي وتكنولوجي حديث يعمل على الاستغلال الفعال والمستمر والمحين للموارد المائية المتجددة وغير العادية الكفيلة بتحقيق التنمية والسيادة الوطنية في ظل التحولات الجيواستراتيجية التي يعرفها العالم اليوم. ما هو دور ومساهمة الجامعة في رفع تحدي مكافحة الإجهاد المائي؟ بالنظر لهذه القيود والتحديات، أعتقد أنه قد بات من الضروري على الجامعة ومن خلال مهامها المنوطة بها، أن تعبئ إمكاناتها البشرية وتنظم لأجل وضع استراتيجية وطنية ذات أهداف وأبعاد قابلة للتحقيق والقياس تهدف من خلالها إلى المساهمة الفعالة في وضع استراتيجية ناجعة تضمن الأمن المائي من خلال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي والقدرة على الصول في تطوير المستدام للمياه من أجل تحقيق أسباب العيش والرفاهية والتنمية الاجتماعية للمواطن. وهذا بفضل التركيز على النقاط الأساسية التالية: 1/ توفير وتنويع الموارد المائية، 2/ تحسين البنية وامكانات الوصول إليها، 3/ تطوير نوعية مياه الشرب من خلال الامتثال إلى المعايير الصحية والبيئية الصارمة، 4 / تحقيق موثوقية لأنظمة التسيير وقدرتها على الصمود واستمرارية التشغيل مع استدامة من خلال الحفاظ على المياه من أشكال التلوث وكذا التطوير لأساليب التسيير والإدارة لضمان المورد المائي للأجيال القادمة. في هذا السياق، تلعب شبكة المؤسسات الجامعية والبحثية العلمية من مراكز بحث ووكالات موضوعاتي دورا مهما لتعزيز البحث عن المعرفة والعلوم في إطار إدراج مشاريع ومواضيع بحثية ذات صلة بالاستراتيجيات الوطنية للماء على سبيل الذكر البرنامج الوطني للبحث العلمي وغيرها من الفرص المتاحة في المشاركات في البرامج التعاون الدولية والإقليمية مثل برنامج بريما (PRIMA) وشراكة للبحث والابتكار في البحر الأبيض المتوسط (PRIMA) والشبكة الأوروبية للتعاون في البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (ERANET-MED)، وبرنامج المياه والزارعة والاستدامة في منطقة البحر المتوسط (MIRA) وهما عبارة عن مبادرة لتعزيز التعاون العلمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط… الخ. كما يجب أن تلح جميع فرص البحث وعروض التكوين في الهندسة وعلوم المياه على الموضوعات المهمة ذات الصلة بتعزيز قدرات الإنتاج وتثمين المورد المائي لاسيما عن طريق استغلال البيانات الضخمة المتعلقة الموارد الأحفورية والمياه الجوفية وكذا المياه السطحية بالاستعانة بالقياسات وال


من البديهي أننا ندرك حجم القيود والتحديات التي تواجهها الجزائر والتي ازدادت تفاقما بسبب آثار تغير المناخ خلال العقد الماضي، وكذا انخفاض معدلات تساقط الأمطار إذ أنها أصبحت تقل عن 300 ملم/سنويا بالمناطق الغربية، بينما تتراوح بين 650 إلى 800 ملم/سنويا بالوسط وبالجهة الشرقية من البلاد ويسود مناخ شبه جاف في الشمال، إلى جاف في الهضاب والصحراء إذ نسجل قيمة تتراوح بين 150 و300 ملم/سنويا مع تسجيل تباين شديد في كميات الأمطار بنسبة تتراوح بين 30% و80% على المستوى المكاني، هذا من جهة.من جهة أخرى، نسجل انخفاضا حادا في احتياطي مياه السدود اعتبارا من سنة 2020، حيث يبلغ حجم المياه القابلة للاستغلال في السدود عند نهاية شهر أغسطس، نحو 2.3 مليار متر مكعب، أي 30% وهي نسبة ثابتة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، على عكس عامي 2018 و2019 حيث كان معدل منسوب المياه خلال نفس الفترة، أكثر من إيجابي إذ بلغ حوالي 54% أي ما يعادل سعة بقدر 3.5 مليار متر مكعب وهذا دون إغفال ظاهرة التبخر الكبيرة بقيم تتراوح بين 1200 و1500 ملم /سنة في بعض المناطق الداخلية، لاسيما في الصحراء.
بطبيعة الحال، تسببت هذه العوامل السالفة الذكر في إحداث إجهاد مائي مزمن تمثل في انخفاض نسبة مخصصات المياه للفرد الواحد سنويا إذ نسجل كمية سنوية تقل عن 300 متر مكعب سنويا للفرد الواحد وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالعتبة الموصى بها من قبل الأمم المتحدة بمقياس 1000 م3 مكعب سنويا للفرد الواحد.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post ورقة طريق لاستراتيجية الأمن المائي في الجزائر appeared first on الشروق أونلاين.