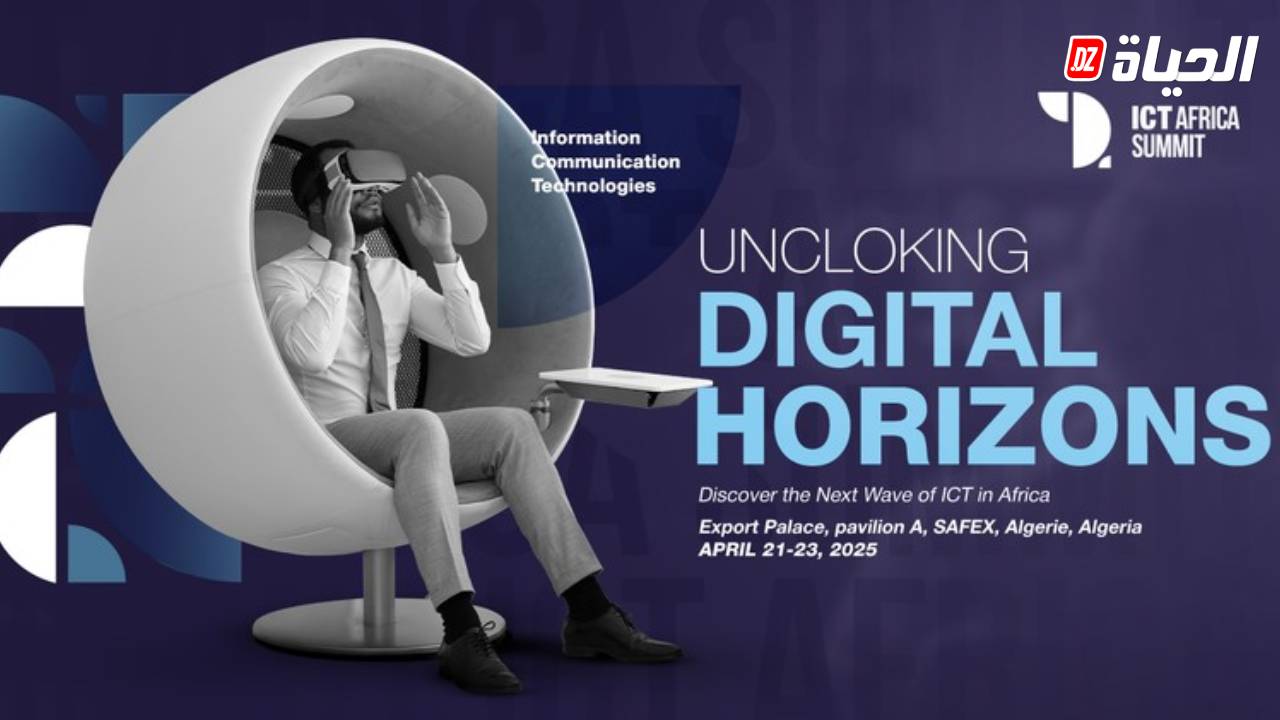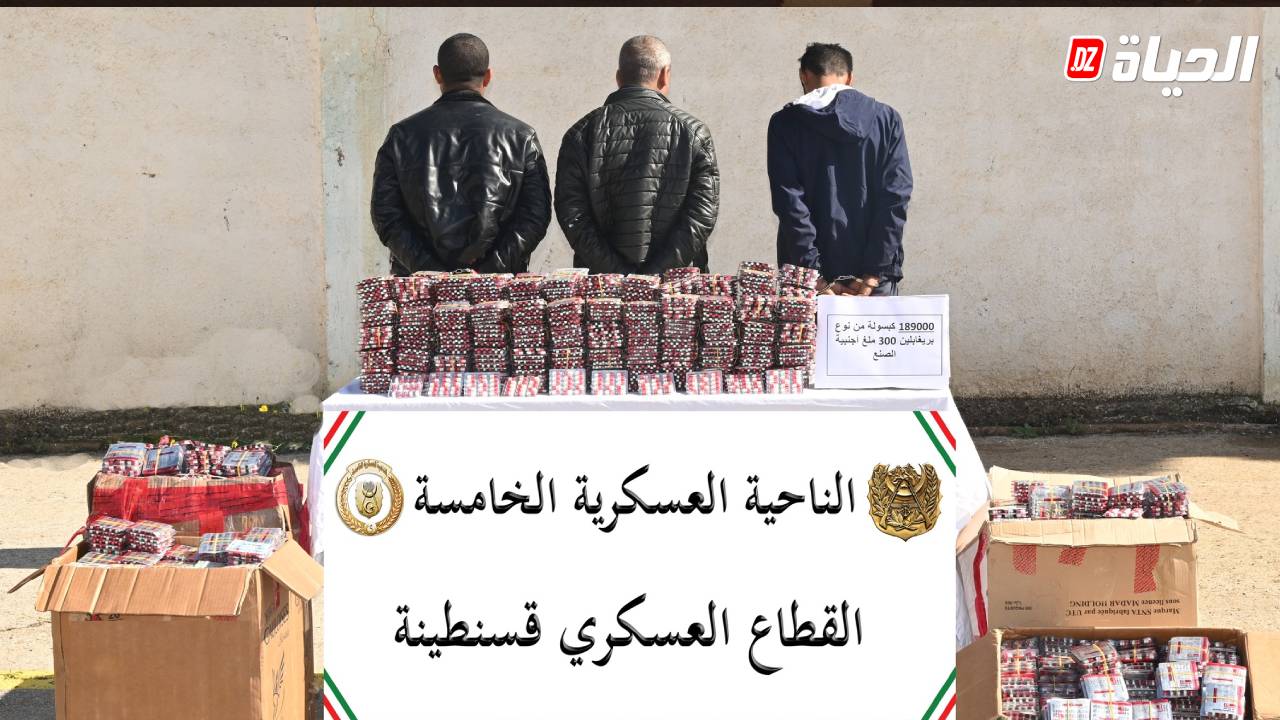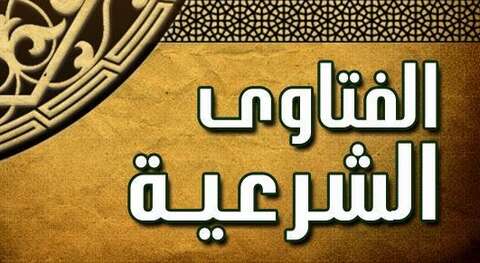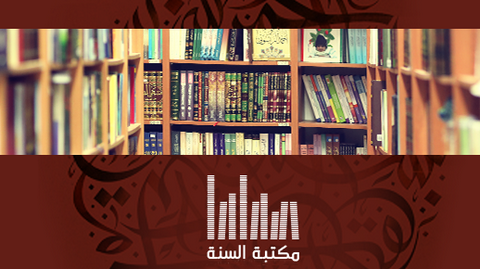الإتجاه العربي –الإسلامي الإستقلالي (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) *
د. محمد مراح/ مضى تقسيم الحركة الوطنية إلى إتجاهات أنفذها أثرا اتجاهان هما: الاتجاه الاستقلالي {حزب الشعب} والحركة الإصلاحية . لكننا نقرر أن حركة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حركة إصلاح واستقلال . يذهب الدارسون إلى أن ظهور جمعية العلماء، سبقته جهود فكرية وعملية إصلاحية، غير أنها كانت منقوصة من الهيكلة والتنظيم. وتمتد جذور الد عوة …

د. محمد مراح/
مضى تقسيم الحركة الوطنية إلى إتجاهات أنفذها أثرا اتجاهان هما: الاتجاه الاستقلالي {حزب الشعب} والحركة الإصلاحية . لكننا نقرر أن حركة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حركة إصلاح واستقلال .
يذهب الدارسون إلى أن ظهور جمعية العلماء، سبقته جهود فكرية وعملية إصلاحية، غير أنها كانت منقوصة من الهيكلة والتنظيم. وتمتد جذور الد عوة إلى الإصلاح إلى السبعينيات من القرن 19، من خلال كتابات عبد القادر المجاوي 1848ــــ1945 ، والذي نشر أفكاره عن طريق المدرسة وتلقاها تلاميذه كابن ابي شنب، 1867 ــــ 1929 وابن الموهوب 1866 . 1939 وابن الخوجة 1865 .1915، كذلك شيوع فكرة الجامعة الإسلامية ووصول رسل السلطان عبد الحميد إلى الجزائر وزيارة محمد عبده للجزائر عام 1905، وزيارة، علماء ومشايخ الجزائريين للشرق والحجاز .
غير أنه عدا المسألتين الأخيرتين من هذه الجذور الأسباب، يمكن عد العوامل المذكورة قليلة الأثر في ظهور الإصلاح، وحركته النظامية بالجزائر. وعوامل النشأة الحقيقية والمباشرة، فيضبطها على وجه دقيق الشيخ محمد البشير الإبراهيمي(1889 /1965) على النحو الآتي:
1. فليست مجرد زيارة محمد عبده للجزائر هي التي نهضت بالعلماء إلى الإصلاح، بل الأثر الحقيقي والفعال هو ما ينقل عنه من معجبين وشانئين مخاصمين، في النفوس الضائقة بالواقع المتطلعة لتغييره، يضم إليه فعل (المنار)، وكتب المصلحين كابن تيمية وابن القيم والشوكان
.2. الثورة التعليمية التي أحدثها ابن باديس، وطريقته الجديدة في التربية والتعليم، التي أنتجت الفوج الأول وما تلاه من طلائع العهد الجديد.
. 3. التطور الفكري الذي بان على الناس إثر الحرب العالمية الأولى، فسقطت من أعينهم كثير من الأوهام التي كانوا يقدسون بعد أن تكالب أصحابها على الدنيا وملذاتها.
.4. عودة فئة من الجزائريين من أرض الحجاز، بعد تلقيهم العلم، بفكرة إصلاحية ناضجة، متأثرة بقوة وحرارة الإصلاح المنبعث من القرآن والسنة؛ لا بحال غالبة في الحجاز آنذاك.
فهذه العوامل إن أنبأت عن تأثر حركة الإصلاح للجزائر، بمناخ وحركية الإصلاح التي عمت العالم الإسلامي أنئذ، إلا أن أصالة الحركة في تفكير زعمائها وآبائهم الإصلاحي يدل عليها بعض العوامل كاعتماد التربية والتعليم مسلكا لتغيير الناشئة، بوصفها عمدة التوجيه –مستقبلا- للمجتمع كذلك إحداث نقلة فكرية متطورة فيه، أصبحت فئات كثيرة منها مستعصية عن الإستدلال بإسم الدين المحرف والمعتقدات الضالة.
وقد أبان هذا الإصلاح المنظم المخطط عن وعي عميق بخطورة الوضع الذي آلت إليه الأمة، لدى رواد الحركة خاصة زعيمها ابن باديس، وهناك وثائق هامة تكشف عن ذلك، منها ما جرى في إجتماع خاص سنة 1928، عرف باسم «اجتماع الرواد» فقد «دعا ابن باديس ثلة من العلماء العائدين من الزيتونة، والمشرق العربي لدراسة الحالة الراهنة، والتعاون على وضع خطة عمل لإنقاذ الشعب الجزائري قبل فوات الأوان … وألقى ابن باديس فيهم خطابا استعرض فيه الخطة التنفيذية للإستعمار من إغتصاب أرضنا، والدفع بالشعب للسكن في الكهوف والمغاور و الجبال-شغله الشاغل إضعاف الشخصية الجزائرية، وإحلال الشخصية الفرنسية محلها، وعرض سياسة الإستيطان المعروفة والقوانين الجائرة. ثم شبه يوم العلماء أنذاك بموقف طارق بن زياد مع المجاهدين على ربوة جبل طارق، فقال: وأنا اليوم أقول لكم لم يبق لنا إلا أحد أمرين، لا ثالث لهما إما الموت والشهادة في سبيل الله منتظرين النصر الذي وعد الله به عباده المؤمنيين أو الإستسلام، ومد أيدينا إلى الأغلال وإحناء رؤوسنا أمام الأعداء فتكون النتيجة لا قدر الله أن يجري علينا ما جرى ببلاد الأندلس وغيرها من البلاد الإسلامية حين تركت الجهاد واستسلمت للأعداء فأجابه العلماءبالإستعداد للأمر الأول وهو التضحية في سبيل الدين والوطن.
أسفر هذا الإجتماع عن مخطط عمل أهم بنوده هي:
1. تكوين لجنة من العلماء للتسيير والتنفيذ.
2. الشروع فورا في إنشاء المدارس الحرة لتعليم اللغة العربية، والتربية الإسلامية.
.3 الالتزام بإلقاء دروس الوعظ لعامة لمسلمين في المساجد الحرة، والجولان في أنحاء الوطن لتبليغ الدعوة الإصلاحية لجميع الناس.
.4 الكتابة في الصحف والمجلات لتوعية طبقات الشعب.
.5 إنشاء النوادي العربية للإجتماعات والخطب والمحاضرات.
.6 إنشاء فرق الكشافة الأسلامية في كافة أنحاء البلاد.
.7 العمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب لتحرير البلاد من العبودية، والحكم الأجنبي، لأن المبدأ الذي يجب أن نسير عليه هو إتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم أصحابه أولا، العقيدة والإسلام، ثم سلحهم بالسيوف وأدوات القتال، فكلا السلاحين لا يغني أحدهما عن الآخر.
فأهداف الجمعية –إذن- ومنها جهاد ووسائل عملها المنظم واضحة-على الأقل بالنسبة لقادتها- قبل تأسيسها، مما يفيد أن الإصلاح كان منهجا مُحْكما، وغاية محددة ووسائل مرصودة، لعمل شُرْع في إنجازه، وما زاد تأسيس جمعية العلماء في الأمر سوى أن ترقى بها إلى مصاف الأعمال التي تحويها القوانين، وتثبتها الإجراءات ثم تسري أعمالا في تطبيقات الأمة، بكيان معروف الاسم محدد المعالم.
وإذا صح إعتبار عوامل نشأة الإصلاح المنظمة السابقة الذكر، عوامل داخلية أو ذاتية فهناك أسباب أخرى خارجية عن الحركة، ذهب مؤرخون إلى إعتبارها في تأسيس جمعية العلماء منها.
1- أن ذلك رد عملي على المؤتمر المسيحي الذي انعقد بالعاصمة (الجزائر) في 5/07/1930، وقد حضره مئات من رجال الدين المسيحي من شتى البلاد الأوروبية وأعلنوها صليبية جديدة وصرح بمناسبته كبير أصاقفة الجزائرقائلا: إننا لا نحتفل اليوم بمرور مئة سنة على احتلال فرنسا للجزائر، وإنما نحتفل بدخول المسيحية من جديد إلى إفريقيا الشمالية.
. 2 الوقوف في وجه النخبة المستلبة للثقافة الفرنسية، والمتنكلرة لقيم الأمة المستمدة من الاسلام.
.3. رد الفعل على الإحتفالات المئوية.
لكن دون الانتقاص من هذه العوامل ودورها في الدفع بالجمعية إلى هيكل قانوني معلن، خاصة السبب الأخير، لردات الفعل الملحوظة آنذاك في الأوساط الشعبية والسياسية الجزائرية، فإننا لا نراها ترقى لأهمية الأسباب الأولى، المتسقة مع سنة التجديد، التي قضى الله ورسوله أن تشهده الأمة متى أدركها الوهن، وانحطت إلى دركات الجهل والضلال، والفوضى العارمة. صحيح أن الإستعمار أُمُّ كل ذلك، لكننا نعتقد أن الجمعية كانت ستوجد لو أن الأمة أصيبت بهذه النواقص ولا إستعمار هناك .فهي حركة تجديدية تغيرية، ممتدة الأروقة على جميع مناحي الواقع الجزائري.
كان قادة الجمعية يدركون أنهم يزاولون عملا حركيا بالمفهوم العصري للحركة التي تعني «كل مبدأ تعتنقه جماعة، وتتساند لنصرته، ونشره، والدعاية والعمل له عن عقيدة، وتهيئ له نظاما محددا، وخطة مرسومة، وغاية مقصودة».
قامت هذه الحركة على (الأصول عشرين) صاغها ابن باديس، ملخصا مفاهيم الجمعية ومبادئها العقائدية، والإجتماعية، والخلقية، والسياسية، والإقتصادية. وهي تمثل المنهج الذي إلتزمته جمعية العلماء في جهادها التغيري عبر المجالات الآتية:
– في المجال الديني: أسسوا المساجد، وكونوا الأئمة والمفتين الذين حافظوا على الإسلام وشريعته وعملوا على العودة بالناس إلى صفائه، واجتهدوا في التأسي بالسلف الصالح.
– في المجال الثقافي: عملوا على بعث الثقافة العربية الإسلامية، وإحياء اللغة العربية، وابراز تاريخ الجزائري لصد محاولات التزييف والتحريف، وتجلى هذا المجهود الحضاري في المسجد والمدرسة، والصحيفة، والنادي، والمشاركة في المؤتمرات، والندوات، والتجمعات.
– في المجال الإجتماعي: حاربوا الفساد الإجتماعي، والانحرافات كالخمر، والميسر، والبطالة و الفجور، ونادوا بتجرير المرأة المسلمة، بتعليمها تعليما عربيا إسلاميا كي يتأتى لها تخريج الأولاد والبنات الصالحين والصالحات.
– في المجال السياسي: حاربوا الطرقيين المبتدعين الموالين للإستعمار، وهاجموا الإدارة الإستعمارية، وصفوا أعمالها بالوحشية وغير الإنسانية، وأحبطوا مساعي حركة الإندماجيين . والعمل من أجل إتحاد الأحزاب الوطنية الجزائرية.
فما من نشاط من هذه الأنشطة إلا أمكن رده لأصول الحركة العشرين، فإحباط مساعي الإندماجيين –مثلا- من باب إرشاد الضال منهم، والشدة مع المعاند. في المسجد والمدرسة، والصحيفة، والنادي، والمشاركة في المؤتمرات، والندوات، والتجمعات.
ومدار الإصلاح لدى قادة الجمعية –خاصة لدى ابن باديس – اصلاح الباطن باعتباره أساس الإصلاح الإجتماعي إذ الأخلاق تنبع من داخل النفس الإنسانية، والوسيلة هي تطهير القلوب، وتغيير النفوس، مما يؤدي إلى تغيير المؤسسات الإجتماعية. ويظهر أثر هذا الفقه في الأولويات عند تناول مسألة الجمعية السياسية، «فلم يكن القيام بأي عمل في النظام السياسي أو الإجتماعي ممكنا قبل تحرير الضمائر»، بتصحيح العقيدة، وإنقاذ الأمة من سطوة الطرائق الضالة، وريقة الجهل والأمية وقد اعتمدت جمعية العلماء في آداء رسالتها، وتحقيق أهدافها الوسائل الآتية:
– التعليم بفتح المدارس والمساجد لتعليم القرآن والعربية.
– تأسيس الأندية للشباب في الوطن، وفي فرنسا للعمال الجزائريين .
– إرسال الوفود التي تجوب البلاد لتبليغ الدعوة، وتنشيط الحركة الإصلاحية .
– إنشاء الصحافة الوطنية.
– إنشاء الكشافة الاسلامية والهيآت الرياضية والفنية .
وعن دور الأندية، والهدف منها ورد في التقرير الذي قدمه المجلس الإداري بإسم الجمعية إلى الإدارة سنة 1363هـ، ما يلي «جمعية العلماء ترى أن النواب التي أسستها أو تأسسها هي في حكم مدارس التعليم ومكملة لوضائفها لأن طبقات الأمة ثلاث : صغار تضمهم المدارس الإبتدائية وكبار تجمعهم المساجد وشبان تتخطفهم الأزقة وأماكن الخمر، والفجور فإذا أرادت الجمعية أن تقوم بواجبها الديني معهم لم تجدهم في المساجد ولا في المدارس، فمن واجب الجمعية أن تنشط النوادي لتقوم بمهمتها التهذيبية فيها».
إن ما عرضناه يسلك الجمعية ضمن الحالة الثقافية أو الدينية ، فما المبرر لإدراجها ضمن الحالة السياسية ؟ خاصة أن قانونها الأساسي ينص (الفصل الثالث) من (القسم الأول) على أنه: «لا يسوغ لهذه الجمعية بأي حال من الأحوال أن تخوض أو تتدخل في المسائل السياسية»؟ الحق أن الحديث عن الجمعية في غياب بحث دورها سياسي، سيطمس على مساحة شاسعة في طريق الحركة الوطنية ، كما سيحيف على دورها في شقه السياسي الذي يوازي، ما قامت به في المجالات الأخرى غيره.
فمن حيث مفهوم الإصلاح لدى العلماء أنه شامل ويمتد ليغطي كل مظاهر الحياة ومجالاتها، ومنها المجال السياسي بالضرورة، وهذا ما فعله المصلحون في الجزائر. فالإسلام دين و دولة فلا حديث عن الإصلاح في الإسلام مجردا عن معنى الدولة فهو السياسة عينها فقد كان الواجب عليهم إصلاح الجانب التعبدي والسياسي أيضا.
وقد أحتاطت الجمعية بكيانها فلم تعلن هدفها، وطابعها السياسي صراحة لإيمانها بمبدأين هما:
أولا:
1. العمل السياسي الواضح سوف يعرضها لبطش الإدارة الإستعمارية، فتموت قبل أن تقوى.
.2. إن بناء الدعامة الوطنية الأصيلة يتمثل في عودة الشخصية الجزائرية، وبعدها يأتي الإستقلال الذي يقوم على دعائم متينة الأركان. وقد تجلى العمل بهما خاصة في سنواتها الأولى.
وكما سبق الذكر فإن المبدأ الثاني ينبىء عن فقه جيد لمسألة الأولويات و الدلائل على ممارسة الجمعية السياسية كثيرة منها : – إتفاق معظم الكُتّاب على أن أهدافها السياسية أرادت ذلك أم أبت – خضوع كثير من رجالها للإجراءات القمعية، والتعسفية مثلما خضع لها السياسيون، فقد سجنوا وعذبواو نُفُوا – المشاركة الفعلية في المؤتمر الإسلامي الجزائري – إعتبار إبن باديس الإستقلال حقا طبيعيا لكل شعب ومنه الشعب الجزائري – معارضة الإدماج – رفض تأييد فرنسا في الحرب العالمية الثانية – تخطيط ابن باديس للإستقلال خلال تلك الحرب.
يعد المؤتمر الجزائري الإسلامي فكرة العلماء، وابن باديس تحديدا، فقد دعا عام 1935 أعضاء المكتب الدائم للجمعية، وطرح على أعضائه حال البلاد العامة المتدهورة، والفوضى السياسية السائدة، واختلاف الأحزاب ثم أعرب عن رغبته في الدعوة لمؤتمر، غايته الجمع و توحيد الصف، وتحديد الهدف، لأن المرجع في الأمور يعود إلى الأمة وبما أن الإجماع أصل في التشريع، فلماذا لا نعمل به في السياسة؟ ثم طلب موافقتهم ورأيهم لتوجيه دعوى لكل من يهمه أمر البلاد والعباد، لعقد هذا المؤتمر، لمناقشة وتدارس الحالة وأبعادها ونتائجها. فوافقه الحاضرون، وظهرت الدعوى في جريدة الدفاع للأمين العموري1891 . 1957 بتاريخ 03/01/1936 . ولهذا كان إبن باديس موضع ثقة الجميع في المؤتمر، على إختلاف إتجاهاتهم، وكانوا يقبلون منه عن رضى ما يقترح عليهم .
وفي يوم 06/06/1936، اجتمعت بنادي الترقي القوى الجزائرية، وتدارسوا مطالب الأمة، واتفقوا على أن يضم المؤتمر النواب والعلماء، وحتى نجم شمال إفريقيا لبعض ممثليه ومشاركة بعض فروعه في التنظيم أو حفظ النظام يوم المؤتمر، الذي انعقد يوم 07/06/1936 بقاعة الماجستيك بالعاصمة، وحضره حوالي خمسة ألاف شخص، وقد عرض العلماء فيه المطالب الخاصة بالعربية والدينية .
– المطالب الخاصة بالعربية: -ترسيمها كالفرنسية، تكتب معها في جميع المناشير الرسمية، وتعامل صحافتها كالصحافة الفرنسية، وتعطى حرية تدريسها في المدارس كالفرنسية – المطالب الدينية هي:
أ- المساجد: تسلم للمسلمين مع تعيين قدر من ميزانية الجزائر لها، وتسيرها جمعيات دينية إسلامية (حسب مقتضى فصل الدين عن الحكومة).
.ب- التعليم الديني: تأسيس كلية للعلوم الدينية، لتخرج موظفي المساجد من أئمة وخطباء ومدرسين ومؤذنين وقيمين .ج- القضاء : ينظم بوضع مجلة أحكام شرعية، تتولى هذا الأمر هيئة إسلامية، تنتخب بإشراف الجمعيات الدينية المسلمة.
وقد كان مسلك العلماء في المؤتمر موضع نقد، بلغ حد القسوة، خاصة من مالك بن نبي، الذي ذهب إلى «أن الظروف الساخنة وضعت العلماء أمناء على مصلحة الشعب، فسلموا الأمانة لغيرهم، لأنهم لم يكونوا في مستواها العقلي، وسلّموها لمن يضعها تحت أقدامه كَسُلّم يصعد عليه للمناصب السياسية.
ونرى أن هذا الرأي صائب إلى حد بعيد، ذلك أن العلماء بمبادرتهم للدعوة للمؤتمر، وبروز قيادتهم في تنظيمه، وصياغة قراراته، ثم المشاركة في وفد المؤتمر إلى باريس بأربعة من قادتهم في مقدمتهم ابن باديس والإبراهيمي، لم يعد مقبولا معه القول بتجنب الجمعية الظهور بمظهر القيادة الُمحرّكة للمؤتمر سياسيا، فضلا عن أن كل ذلك وما خفي كان معلوما لدى الإدارة الإستعمارية التي كانت ستسعى لإفشاله . يؤكد هذا نظرة الإدارة لدور العلماء الرئيس في المؤتمر، فهي تراهم قد حملوا النواب على المطالبة بالتمسك بالهوية الإسلامية، بوصفها إحدى مطالب المؤتمر، واستفادوا منه في الدعاية ضد التجنيس الذي كان أمنية المنتخبين. كما ترى أن فشله لم يمنع العلماء من المضي في إنشاء المدارس، وإحياء الإسلام ، والعمل على نشر أفكارهم، والنضال ضد الإندماج و الفرنسة.
أما صفة (الإستقلال) التي أضفناها لهذا الإتجاه في الحركة الوطنية، فقد تضافرت النصوص والشهادات ثم الوقائع على أنه كان أحد أهم أهدافه، فهذا إبن باديس يخاطب الشعب إثر عودة وفد المؤتمر من فرنسا قائلا: «برهنت على أنك شعب متعشق للحرية هائم بها تلك الحرية التي ما فارقت حدودنا منذ كنا الحاملين لواءها، وسنعرف في المستقبل كيف نعمل لها، وكيف نحيا ونموت لأجلها . إننا مددنا إلى الحكومة الفرنسية أيدينا وفتحنا قلوبنا، فإن مدت إلينا يدها، وملأت بالحب قلوبنا فهو المراد، وإن ضيعت فرنسا فرصتها هذه فإننا نقبض أيدينا، ونغلق قلوبنا، فلا نفتحها إلى الأبد».
وذكر الشيخ خير الدين: «أنه ذات يوم من عام 1933 إلتف نفر من الشباب المتحمس حول الإمام إبن باديس بنادي الترقي، وطلبوا منه أن يرفع صوته قويا مدويا عاليا مطالبا باستقلال الجزائر وحريتها، وقال لهم… هل رأيتم أيها الأبناء إنسانا يقيم سقفا دون أن يشيد الجدران؟ فقالوا: كلا ولا يمكن هذا، فقال لهم: إن من أراد أن يبني داره فعليه أن يبني الأسس، ويقيم الجدران ومن أراد أن يبني شعبا، ويقيم أمة فإنه يبدأ من الأساس لا من السقف».
وقد قسم الدكتور أبو القاسم سعد الله مراحل تجربة ابن باديس على النحو التالي: الأولى: (1910- 1920) تحضيرية.
– الثانية: (1921- 1930) إختبارية.
. الثالثة: (1931- 1939)، مواجهية. وكانت الرابعة هي المرحلة الهجومية لولا الموت، فشتان بين ابن باديس في العشرينيات يوطد أركان النهضة ويزرع التربية، وابن باديس وهو في سنة 1939 يناجي الحرية ويهاجم ماسينيون 1883 .1962 ويهدد (دلادييه) رئيس وزراء فرنسا 1884 .1970، كل ذلك في وقت كادت تختفي فيه كل أصوات الزعامة في الجزائر وقد أعلنت (البصائر) في إحدى إفتتاحياتها؛ أن الإسلام يحرم الإستعمار. ونعتقد أن هذا – في ميزان الشرع- مما يُحْتَجُّ به، بصدد إثبات أن الإستقلال كان هدفا رئيسا للجمعية.
وقد امتدت عناية العلماء إلى الجزائريين المغتربين في فرنسا، فاتصل بهم إبن باديس أثناء زيارته لفرنسا ضمن أعضاء وفد المؤتمر الإسلامي، وتداول معهم الحديث عن أحوال الإصلاح بفرنسا. وأرسل في السنة نفسها الشيخ الفضيل الورتيلاني، الذي نظم لفائدة أمنهم على ديانتهم، وخلقهم، ولسانهم، وقوميتهم، برنامجا للعمل . ونقرأعن نشاط الشيخ الفضيل هناك في رسالة نشرتها (الشهاب) بعث بها للشيخ باعزيز بن عمر، يحدثه فيها عن ما أنجزه من فتح مدارس للتربية والتعليم، وانشاء ستة نواد في مختلف أحياء باريس، وإلقاء المحاضرات العامة في قاعات يحصلون عليها بالكراء، أو بالطلب من الحكام المحليين وشمول التعليم للكبار والصغار، وما أصبح عليه المغتربون هنالك من معرفة الحلال والحرام والسنة والبدعة، ومبادئ الإسلام، وانضوائهم تحت راية الإصلاح بالآلاف .
وعلى الإجمال فإن جمعية العلماء الجزائريين كما قال المرجع الجليل الدكتور سعد الله رحمه الله، تعد أقوى التنظيمات أثرا في المجتمع الجزائري، وأوسعها إنتشارا، وإذا كانت المنظمات الأخرى (بما في ذلك الأحزاب السياسية) قدخاطبت فئة معينة فقط أو إنحصرت في أبرز المدن فحسب، فإن خطاب جمعية العلماء كان قد وصل، أفقيا وعموديا، إلى مختلف الطبقات الإجتماعية، أينما كانت ريفية أو مدنية. ومن ثم فقد هزت المجتمع الجزائري هزا عنيفا كما أنها لم تستعمل الخطاب السياسي الذي لا يفهمه كل الناس ولا الخطاب المادي الذي لا يهم كل الفئات، وإنما استعملت الخطاب العقلي والروحي… الذي لا يستغنى عنه أحد في المجتمع».
ونميل إلى أن المقصود بعدم إستعمال الجمعية «للخطاب السياسي، هو الخطاب الحزبي الديماغوجي، الذي تلجأ إلى استعماله-كثيرا- الأحزاب السياسية مضطرة إليه أو مختارة . . أما الخطاب السياسي الواضح المباشر فهو أحد أكثر مستويات خطاب زعماء جمعية العلماء وكتابها، بروزا وحضورا. فضلا عن مواقفهم ومشاركاتهم السياسية- كما أشرنا- بل يمكن إعتبار نشاطها بمثابة الأرضية الإيديولوجية التي تقف عليها الحركة الوطنية خاصة في اتجاهها الثوري هذه الأرضية الإيديولوجية المُشَكّلة من جهودها في ميادين الإحياء العلمي والتاريخي، والتراثي، والإصلاح الإجتماعي، العقائدي، الذي أعد النفوس، ووحد الشعب، وأيقظ الحس الوطني وما الثورة التحريرية إلا ثمرة لهذا الغرس . وبهذا أثبتت جمعية العلماء أن التحرير الفكري والعقائدي والثقافي مقدمة للتحرير السياسي والعسكري.
خلاصة القول إن الحالة السياسية اتسمت بخوض الجزائريين عبر منظماتهم السياسية والثقافية الدينية، تجربة التدافع الحضاري مع الاستعمار، في شتى تجلياته بما في ذلك سلوك المغالبة عبر الثورات، والتظاهرات, وانتهاء بالثورة المسلحة (القول الفصل).فاحتل الاصلاح (قولا وعملا) قلب التجربة, رغم لبسه غير لبوس السياسة بمظهرها المألوف.
* لم أشأ إرهاق المقال بذكر مراجعه.