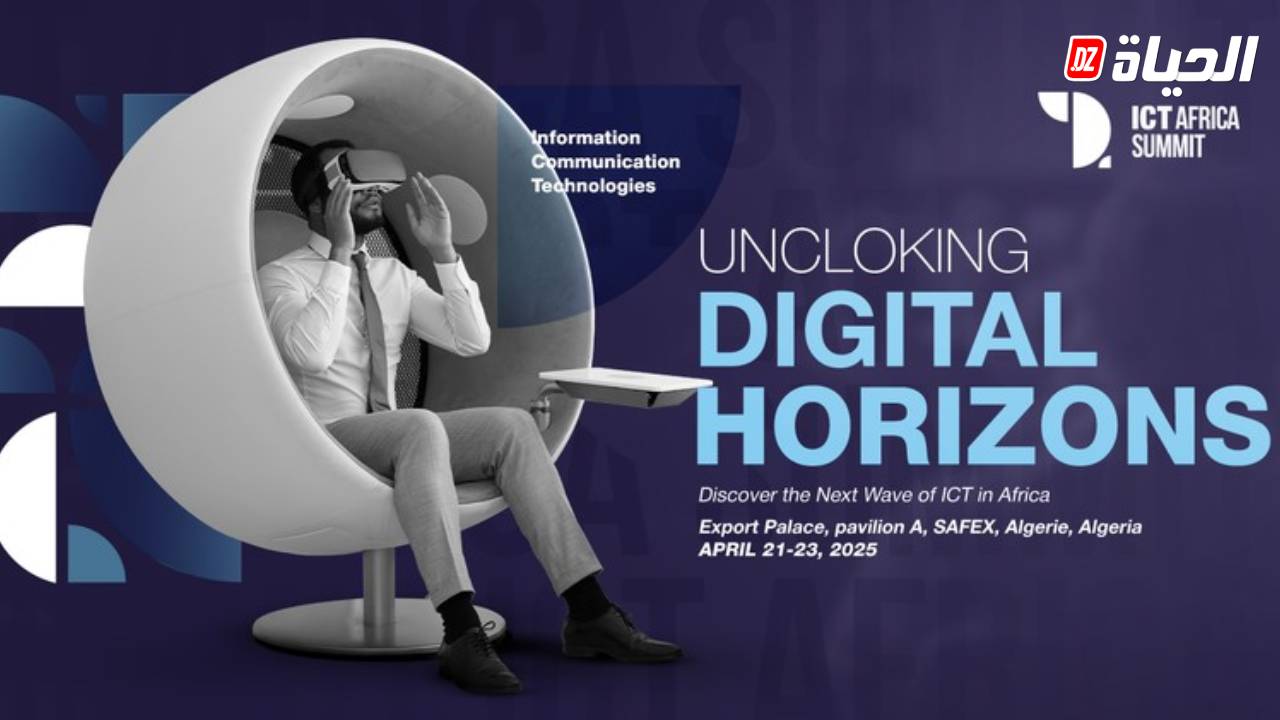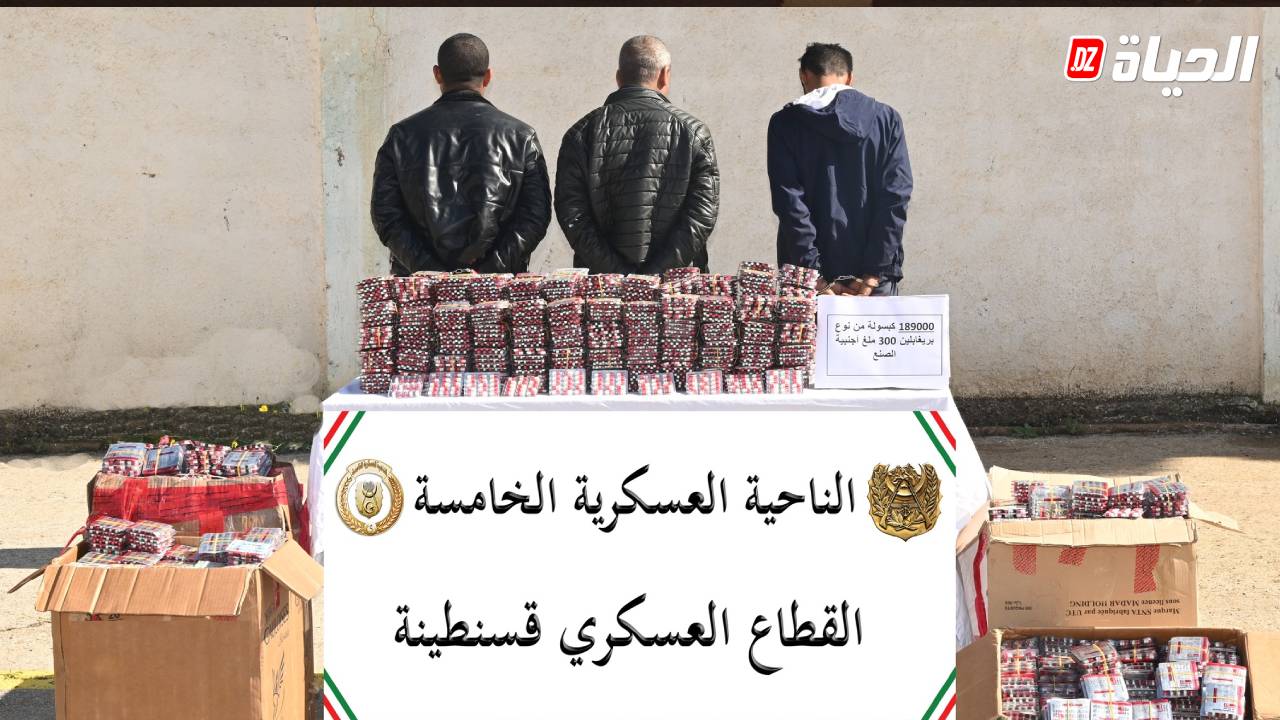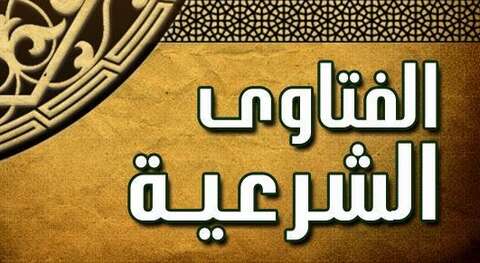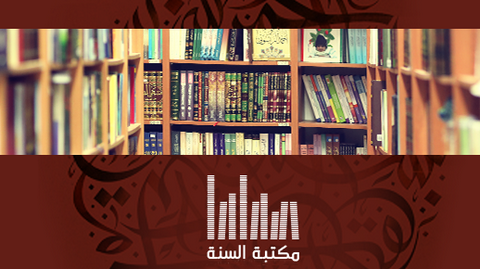البيوتات العالمة بالجزائر -الأسرة السنوسية التلمسانية –
د. عبدالقادر بوعقادة * بيوتات العلم ببلادنا – الجزائر- كثيرة عريقة ومؤثرة، لكن الأقلام التي كتبت عنها قليلة فلم تفها حقها ولا حقيقتها، وهو واجب يظل عبئا حتى يتم الإيفاء بحقه بالاشتغال عليه. ومن البيوتات التي تركت بصمتها وأبانت عن تأثيرها العلمي والاجتماعي البيت السنوسي التلمساني الذي برز من خلال ثلاث شخصيات وهي الأب والابن …

د. عبدالقادر بوعقادة *
بيوتات العلم ببلادنا – الجزائر- كثيرة عريقة ومؤثرة، لكن الأقلام التي كتبت عنها قليلة فلم تفها حقها ولا حقيقتها، وهو واجب يظل عبئا حتى يتم الإيفاء بحقه بالاشتغال عليه. ومن البيوتات التي تركت بصمتها وأبانت عن تأثيرها العلمي والاجتماعي البيت السنوسي التلمساني الذي برز من خلال ثلاث شخصيات وهي الأب والابن والأخ، وحيث لم تشر المصادر – فيما نعلم- إلى شخصيات عالمة أخرى من البيت السنوسي غير ما ذكرنا، فإنّ قيمة البيت السنوسي تظهر في حضوره المميز بتلمسان من خلال الانتساب إلى العترة النبوية من جهة جدة العلامة محمد بن يوسف السنوسي (أي أم أبيه) إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، على ما ذكر ابن مريم في البستان نقلا عن الملالي تلميذ العلامة السنوسي الابن، ممّا يضفي على الأسرة الشرف الكريم، الذي بات علامة مميزة في العصر الوسيط. ولا شك أنّ حضور الأسر الشريفة بمدن المغرب الأوسط كان مبكرا حينما انتشر أبناء الشريف سليمان العائد إلى الحسن بن علي بن أبي طالب عبر مناطق بلاد المغرب الأوسط فتصاهروا وأسسوا إمارات سليمانية «بتلمسان ووهران ومستغانم ومليانة ومتيجة والمدية والمسيلة»، وهي موروث – تمّ التغافل عنه- يجب النظر فيه وإدراجه ضمن المنظومة التربوية والثقافية.
يشير ابن مريم – صاحب كتاب البستان- بشيئ من الاقتضاب إلى أهم عالم لهذا البيت وهو الأب «أب محمد الشهير»، المسمى يوسف أبو يعقوب السنوسي، فيذكر شهرته وصلاحه وحلاّه بالزهد والعلم والأستاذية، وقد كان محققا بارعا ومعروفا بعلم القراءات، وبالنظر إلى قيمته فإنّه كان أول شيخ لعلامة العصر بعده وهو إبنه محمد – حسب توثيق أحمد بابا التنبكتي في الكفاية- ولكن أشهر عالم رفع لواء البيت العلمي هو الإبن محمد الذي أخذ عن أبيه «أبي يعقوب السنوسي» وعن علماء عصره أمثال نصر الزواوي، والولي الحسن أبركان وغيرهم.
اشتهر العلامة محمد بن يوسف بتضلعه في العلوم العقلية والنقلية، وهو ما أثبتته كتب المناقب والتراجم، فقد ألّف تلميذه أبو عبد الله الملالي مصنفا سمّاه «المواهب القُدُّسِيّة في المناقب السنوسية» فأجمل أحواله وسيرته وفوائد، ليختصره ابن مريم في ثلاث كراسات، هذه المدونات تحدثت عن تخصصه في الحديث والعقائد والأصول وعلوم شتى نقليها وعقليها، لكن ما عُرف عنه أكثر هو عنايته بعلم التوحيد والعقائد حيث صار أحد الرواد المتخصصين.
ألّف السنوسي مصنفات غزيرة في علم الكلام وجعل عليها شروحا، أما عقائده فقد درسّها وشرحها – أيضا- وأقام التعاليق عليها، ونال الناس عليها الإجازات والإملاءات، وتميزت فترته بشيوع العقائد في وسط الخاصة والعامة، وقد جلب هذا الاهتمام بالعقائد والكلام فيها إنكار البعض، بل تكلموا بما لا يليق في ذلك باعتبار أنّ علم الكلام من العلوم التي صار لا فائدة منها بعد أن انقرض الملاحدة والمبتدعة، وأن لا حاجة للأدّلة العقلية، لينتفض ضدهم السنوسي فيخرس أولهم وآخرهم بالتأليف فيها والتعمق في شروحها.
وأشهر ما ألفه العلامة محمد بن يوسف السنوسي في هذا الشأن العقيدة الكبرى المسماة «عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقليد المرغمة أنف كل مبتدع عنيد»، وشرحها المسمى «عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد». ثم العقيدة الوسطى وشَرحُها. والعقيدة الصغرى وتسمى أيضاً «أم البراهين» و«السنوسية» وشرحها المسمى العقيدة الصغرى. ثم عقيدة صغرى الصغرى أو صغيرة الصغرى التي تسمى «الحفيدة»، وشرح صغرى الصغرى وله فيها نكت وفوائد مهمة. ثم العقيدة الوجيزة أو عقيدة النساء. وألّف المقدمات وشرحها وهي مجموعة لمشروعه العقدي وبخاصة العقيدة الصغرى التي حازت الشهرة الوافية. كما شرح منظومة شيخه أبي العباس أحمد بن عبد الله الجزائري (ت884 ﻫ) وهي المسماة «كفاية المريد في علم التوحيد». وله شرح على منظومة تلميذه أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمٰن الحوضي (ت 910 ﻫ) وهي المسماة «واسطة السلوك». مثلما شرح مرشدة محمد بن تومرت صاحب الموحدين.
وقد برع العلامة السنوسي في علم المنطق والفروض والحساب وله في ذلك رسائل وورقات وصل بعضها واندثر عدد منها، لكن أهم مجال تميز فيه بعد الخوض في العقائد هو علم الحديث حينما اندمج في سلسلة العناية بالحديث بتأليفه كتاب مكمل إكمال الإكمال. فقد ألف أبو عبدالله محمد بن علي المازري مصنفه «المعلم بفوائد مسلم» ثمّ جاء القاضي عياض الفاسي فكمله بموسوم «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للنقص الذي رآه، ثم جاء كتاب سمي بـ «إكمال الإكمال» وقد نسبه ابن فرحون إلى عالم بجائي من آل منجلات الزواويين وهو عيسى أبو الروح بن مسعود بن منصور المنجلاتي الحميري الزواوي المالكي (664 – 743هـ)، الذي شرح صحيح مسلم «إكمال الإكمال» في أثنى عشر جزءا، حيث جمع فيه أقوال المازري وعياض والنووي وابن عبد البر والباجي وغيرهم، ثم جاء بعدهم محمد بن يوسف السنوسي(ت895هـ) فألف مكمل إكمال الإكمال. كما كان العلامة السنوسي ينافح عن الفهم الصحيح للدين الحنيف فيرد ردودا ضابطة على كل متنطع أو مارق أو خاطئ في فهم، ومنها كتابه «نصرة الفُقَيّر في الرّد على أبي الحسن الصغير» الذي صنفه في الرد على فقيه كان قد أثار الناس «برسالة» كتبها جاءت في أربع ورقات شغلت وشوشت عقول الناس، فكان رد السنوسي عليه بهذه الرسالة «نصرة الفُقير». وتلك هي مهمة العلماء في حفظ الأمن الفكري وصون العامة ومواجهة الفكرة بالفكرة.
كما يحضر في إثراء هذا البيت أخوه من جهة أمه والمعروف بعلي بن محمد التالوتي الأنصاري الذي وصفه صاحب البستان بالشيخ الحافظ، والفقيه المتقن والعالم المتفنن، وأنّه كان شيخا صالحا. وأشارت التراجم بأنّ العلاقة العلمية بين الأخوين كانت في غاية التوادّ والتواصل، من حيث أخذهما عن بعضهما في الفقه على وجه التحديد، وممّا عرف عن التالوتي هو اشتغاله بمدونات ابن الحاجب، وقد توفي التالوتي قبل أخيه محمدًا سنة 895هـ/1490م.
وهكذا شكل البيت السنوسي قيمة علمية فريدة بلغ مداها الآفاق، وكان للعلامة محمد بن يوسف السنوسي فيها القدح المحلى والمعلى، حيث تداول الناس مدوناته مشرقا كما بلاد المغرب، وأقاموا على عقائده شروحا، وباتت دروسه وكتبه تتداول في حواضر العالم الإسلامي حتى بلغت بلاد الهند، ونحن عن علمائنا غافلون، وعن تراثهم وفكرهم بعيدون، ولا يسعنا إلا إعادة بعثها والاستفادة من مكنونها، ولا يكون ذلك إلاّ بمزيد عناية وتكاتف جهود، ليصان التراث فلا يهمل أو يُغَيّب أو يُسرق.