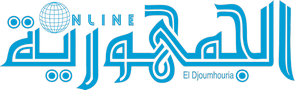الزمن… البُعد الغائب في ثقافتنا
عبد الفتاح داودي */ إن من أعظم الأبعاد التي أُهملت في الوعي الإسلامي المعاصر، وأحد أشد العناصر غيابًا عن المنظومة العقلية للأمة، هو بُعد الزمن. هذا البُعد الذي يمثّل في التصور القرآني شرطًا أساسيًا لفهم الحياة، ساحة للامتحان، ووِعاء للتكليف ومعيارًا للنجاة أو الهلاك. وحين يغيب هذا البعد من الفكر والممارسة، تنقطع الأمة عن شروط …

عبد الفتاح داودي */
إن من أعظم الأبعاد التي أُهملت في الوعي الإسلامي المعاصر، وأحد أشد العناصر غيابًا عن المنظومة العقلية للأمة، هو بُعد الزمن. هذا البُعد الذي يمثّل في التصور القرآني شرطًا أساسيًا لفهم الحياة، ساحة للامتحان، ووِعاء للتكليف ومعيارًا للنجاة أو الهلاك. وحين يغيب هذا البعد من الفكر والممارسة، تنقطع الأمة عن شروط الفعل الحضاري، وتتوه في دوائر التكرار والعجز والضياع بين ماضٍ مُمَجَّد دون وعي، ومستقبلٍ غائمٍ دون أفق. فالزمن في الرؤية القرآنية ليس مجرّد خلفية لحركة الإنسان، بل هو مكوّن في أصل الوجود، حاسم في تحقق المقاصد، ومعيار في بناء المسؤولية الأخلاقية والتكليفية.
لقد أقسم الله عز وجل في كتابه بالزمن في أشكاله المختلفة: الليل والنهار، الفجر والضحى، العصر والدهر، وهو ما يدل على عظمة الزمن وخطورته في ميزان الله، وليس القسم هنا لمجرد التعظيم، بل للإشارة إلى ما في الزمن من دلالات تربوية وسنن اجتماعية وقيم أخلاقية. يقول تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾، فالخسارة محققة ما لم يُستثمر الزمن في الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر، وهي أركان تندرج جميعًا في منظومة الزمان. ولذلك قال الإمام الشافعي: «لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم»، أي أنها كفيلة بوضع الإنسان على الطريق القويم إذا وعى دلالتها الزمنية والعملية.
وهذه القيمة المركزية للزمن أكدها رسول الله ﷺ حين قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»، فالفراغ ليس غياب الشغل فقط، بل غياب الهدف، وغياب الرؤية الزمانية التي تجعل الإنسان يعيش لكل لحظة معناها وقيمتها. كما جاء في حديثه ﷺ: «اغتنم خمسًا قبل خمس: حياتك قبل موتك…»، مما يدل على فقه استباقي في التعامل مع الزمن، يُراكم الإنجاز، ويرتّب الأولويات وفق منطق المرحلة، لا العاطفة. ومن هنا كان الزمن عند النبي ﷺ موردًا استراتيجيًا يُدار بالحكمة، يُخطَّط له، ويُوزَّع بدقة، ويُربى عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك نشأ الجيل القرآني وهو يدرك أن التغيير لا يأتي دفعة واحدة، بل عبر مراحل زمنية تُراعى فيها النفوس والوقائع وسنن التحول.
ومن هنا يتضح أن فقه الزمن في الإسلام ليس هامشيًا، بل يُعد من صلب فقه المقاصد؛ إذ لا تتحقق المقاصد إلا بالزمان، ولا تُقدَّر المصلحة إلا وفق الوعي بالسياق الزمني، سواء في الأفراد أو المجتمعات. يقول الإمام القرافي في «الفروق»: «إن الجهل بالمصالح الحقيقية والزمانية يؤدي إلى فساد الفتوى والحكم»، ويُشير إلى قاعدة جوهرية: «تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان والمكان والحال والنية والعرف». فالعقل المقاصدي لا ينظر إلى الزمن كإطار خارجي، بل كعنصر داخلي في تركيب الحكم ذاته، لأنه يُحيل إلى السنن، والتطور، والمآلات.
وقد سار الطاهر بن عاشور في هذا المسلك حين قرر أن الزمن هو «أحد عناصر الواقعة الاجتهادية»، أي لا يمكن إنزال النص الشرعي إلا بعد فهم اللحظة الزمنية والمرحلة التاريخية، وإلا صار الفقيه كالطبيب الذي يصف دواء قديمًا لمرض تطوّر. ويضيف في تفسيره أن من «تمام مقاصد الشريعة إدراك التوقيت، وإعمال النظر في الآجال»، فليس من الحكمة أن تستعجل الأمة نتائج لم تنضج بعد، ولا أن تُحمّل نفسها من الواجبات ما لا تطيق بحكم طورها الزمني.
ابن خلدون من جهته أقام علم الاجتماع الإسلامي على الزمن، بل يمكن القول إن فلسفته العمرانية كلها مبنية على فقه الدورة الزمنية في حياة الدول والمجتمعات. فقد بيّن أن الدول تمر بمراحل الطفولة، والشباب، والكهولة، ثم الشيخوخة والانهيار، ولكل طور أحكامه، ومن لا يعي هذه الأطوار يُنكر على المجتمع ما هو من سننه، أو يُطالب الدولة بما لا تطيق. ولذلك كانت رؤيته للنهضة مشروطة بإدراك قانون التدرج التاريخي، حيث يقول: «ومن طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»، وهو من أبلغ ما قيل في التنبيه على أهمية الوعي بالزمن في مشاريع الإصلاح والبناء.
أما المفكر الكبير مالك بن نبي، فقد جعل الزمن عنصرًا حاسمًا في تحليله لواقع الأمة، إذ ربط القابلية للاستعمار بفقدان الإنسان المسلم الإحساس بالزمن، وبفقدان الإرادة التي تربط بين اللحظة والهدف. ففي كتابه «شروط النهضة» أشار إلى أن الأمة الإسلامية تعيش خارج التاريخ لأنها فقدت التفاعل مع اللحظة الحضارية، وصارت تتغنى بماضٍ مجيد دون أن تُحوّله إلى طاقة فاعلة في الحاضر. وعبّر عن ذلك بمرارة قائلاً: «لقد فقدنا العلاقة العضوية مع الزمن، ونحن لا نعيش التاريخ، بل نحفظه»، في إشارة إلى أن الشعوب التي لا تصنع الزمن، تُستهلك فيه. ولذلك دعا إلى «إحياء الزمن الفعّال»، عبر ربط الفكر بالفعل، والوعي بالحركة، والتخطيط بالتنفيذ، لأن الزمن هو رأسمال الفكرة.
ومن المظاهر الكاشفة عن غياب البعد الزمني في ثقافتنا: الاستغراق في التفكير القصير المدى، والعجز عن بناء المشاريع التراكمية، وغياب التخطيط الاستراتيجي طويل النفس في المجالات التعليمية، الدعوية، والسياسية. كما يظهر ذلك في الفقه السطحي الذي يتعامل مع الوقائع المعقدة بمنطق التجزيء والتقعيد النظري دون إدراك لمآلات الفتوى في الزمن. ويظهر كذلك في التربية الأسرية التي لا تُربّي الطفل على استشراف المستقبل، ولا تُنمّي فيه حس الأولويات الزمانية. وحتى في الأدبيات الإسلامية المعاصرة، غالبًا ما يُقدَّم الماضي على أنه النموذج الكامل دون اعتبار الفوارق الزمنية، فيتم نسخ التجارب بدل إبداع حلول معاصرة ضمن سنن الزمان.
إن تجاوز هذا الخلل يقتضي ثورة فكرية في منظومتنا الثقافية، تُعيد الاعتبار للزمن كمقصد من مقاصد الإصلاح، وكعنصر في فقه الواقع، وكمنطلق في بناء الوعي الحضاري. فالمطلوب ليس فقط احترام الزمن، بل إعادة هندسة علاقتنا به: عبر تربية النشء على إدارة الوقت، وتدريب العلماء على فقه المآلات، وتحفيز الدعاة على مراعاة سنن التدرج، وتكوين المفكرين على النظر التاريخي، وإلزام صناع القرار برؤية زمنية استراتيجية تمتد إلى أجيال لا إلى دورات انتخابية.
إنّ من مقتضيات الاستخلاف في الأرض أن تكون الأمة جديرة بالتاريخ، أي أن تبني حاضرًا منتجًا في ضوء وعيها بالماضي، وبصيرتها بالمستقبل. ولن يكون ذلك ممكنًا إلا إذا عادت الأمة إلى القرآن لتقرأ الزمن كما يقرأه الوحي، وتفقهه كما فقِهه الرسول ﷺ، وتُفعّله كما فعّله الصحابة والعلماء والمصلحون. فالأمة التي تُضيّع الزمن، إنما تُضيّع أعمارها، وتفرّط في مقاصدها، وتُفرغ رسالتها من محتواها.
* عين ولمان – جامعة المسيلة –