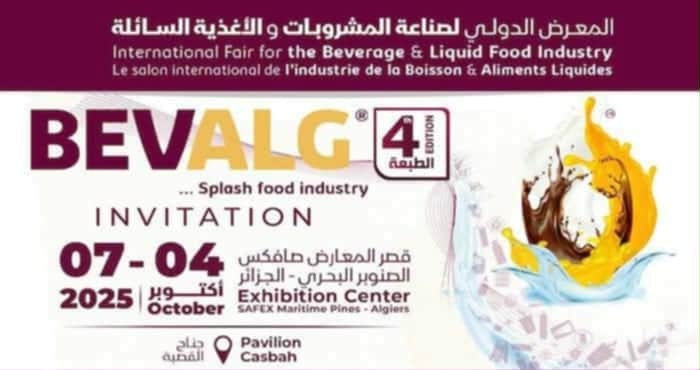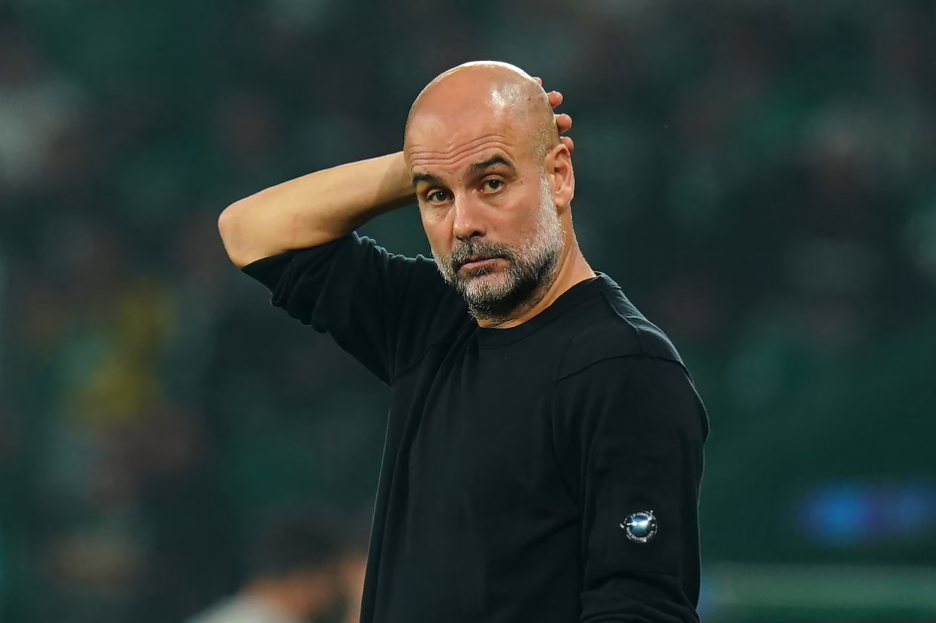خارطة طريق للمسرح الجزائري في العصر الافتراضي
الباحث: مراد ترغيني جامعة خنشلة إذا كانت مداخلة الأستاذة جميلة الزقاي قد أرست الجدلية الفلسفية حول علاقة مسرح الطفل بالذكاء الاصطناعي، فإن مداخلة الأستاذ الدكتور قاسم بوزيد، عميد كلية الفنون والثقافة بجامعة قسنطينة 3، جاءت لتنقل النقاش من حقل التنظير إلى أرض الواقع، ومن دائرة التساؤل إلى مربع الفعل الاستراتيجي. لم يتحدث بوزيد …

الباحث: مراد ترغيني جامعة خنشلة
إذا كانت مداخلة الأستاذة جميلة الزقاي قد أرست الجدلية الفلسفية حول علاقة مسرح الطفل بالذكاء الاصطناعي، فإن مداخلة الأستاذ الدكتور قاسم بوزيد، عميد كلية الفنون والثقافة بجامعة قسنطينة 3، جاءت لتنقل النقاش من حقل التنظير إلى أرض الواقع، ومن دائرة التساؤل إلى مربع الفعل الاستراتيجي. لم يتحدث بوزيد كباحث أكاديمي فحسب، بل كمسؤول عن مؤسسة فريدة من نوعها، “الكلية الوحيدة على المستوى الوطني” التي تقع على عاتقها مهمة تجسيد رؤية الدولة في النهوض بقطاع الفنون كـ”قطاع استراتيجي” و”دبلوماسية ناعمة”.
تجاوز “المسرح الورقي” نحو مسؤولية “الفنان الافتراضي”
يتمثل جوهر الطرح الذي قدمه الأستاذ بوزيد في حتمية تجاوز النموذج التقليدي للمسرح، أو ما أسماه بـ”المسرح الورقي”، والانتقال بجرأة نحو “المسرح الافتراضي” (le théâtre virtuel). هذه ليست دعوة للقطيعة، بل هي إقرار واعٍ بتحول جذري في طبيعة المتلقي نفسه، الذي لم يعد “الإنسان المؤنسن” التقليدي، بل أصبح “الإنسان البيوتقني” (l’homme bio-technique)؛ جيل نشأ في قلب الثورة الرقمية، وأصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من تكوينه.
1.تفكيك “المسرح الافتراضي”: ليس خياراً بل ضرورة
بمشاركة أحد طلبته المتميزين، انتقل بوزيد من التعريف النظري إلى الشرح العملي، موضحاً أن المسرح الافتراضي ليس مجرد شاشة، بل هو توظيف واعٍ للتكنولوجيا الحديثة لخدمة الفرجة المسرحية وإثرائها. وقدّم أمثلة حية على ذلك:
السينوغرافيا المعززة: استخدام تقنية “الفيديو مابينغ” (Video Mapping) لخلق فضاءات وعوالم متغيرة على الخشبة، تتفاعل مع الممثل وتعمّق من التجربة البصرية.
خلق شخصيات افتراضية: إمكانية تجسيد حيوانات أو كائنات خيالية عبر إسقاطات ضوئية تفاعلية، مما يحل معضلة إحضار عناصر يصعب توفيرها واقعياً على الخشبة، خاصة في مسرح الطفل.
العرض المتكامل: توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم الإضاءة، والمؤثرات الصوتية، وحتى في تغيير نبرات صوت الممثل، لخلق تجربة حسية غامرة.
بهذا المعنى، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد “مُدخل” خارجي، بل أصبح جزءاً من نسيج العملية الإبداعية نفسها.
2.الأسئلة الاستراتيجية: من يملك مفاتيح المستقبل؟
رغم حماسته الواضحة لهذا التحول، طرح بوزيد سلسلة من الأسئلة الاستراتيجية التي تكشف عن وعي عميق بالتحديات المصاحبة، وهي أسئلة تتجاوز الفن لتمس البنية التحتية الثقافية بأكملها:
مصير الفنان: هل سيأتي اليوم الذي نستغني فيه عن “الإنسان الموجود” على الخشبة لصالح شخصيات افتراضية؟ أم أن دور الفنان سيتطور ليصبح متحكماً في هذه التقنيات، جامعاً بين الموهبة والمهارة التكنولوجية؟
مآل الفضاءات المسرحية: ما هو مصير المسارح الجهوية والوطنية ببنيتها الحالية؟ هل نحن مطالبون بتزويدها بتجهيزات حديثة لتواكب هذا التطور؟
معضلة الهوية: وهذا هو السؤال الأخطر والأهم، كيف يمكننا أن نخوض غمار هذه “العولمة” الرقمية ونواكب تغيراتها، مع الحفاظ على هويتنا وثقافتنا الجزائرية؟ كيف نصنع جيلاً “يبقى شعوري أصيلي، أمازيغي، عربي، مسلم” في ظل هذا الانفجار التكنولوجي؟
3.كلية الفنون كـ”قاطرة” للتغيير: نحو تكوين فنان المستقبل
وهنا تبرز فرادة طرح الأستاذ بوزيد، فهو لا يترك هذه الأسئلة معلقة في الهواء، بل يقدم إجابة عملية تتمثل في دور مؤسسته. لقد وضع “كلية الفنون والثقافة” كـ”قاطرة مؤثرة” ومختبر حقيقي لصناعة المستقبل، معلناً عن فتح تخصصات جديدة مثل “الإبداع والتصميم (Création et Design)” و”الموسيقى الافتراضية”، وهي تخصصات تهدف إلى تكوين فنان الغد القادر على التحكم في هذه الأدوات.
في نهاية المطاف، كانت مداخلة قاسم بوزيد دعوة صريحة ومباشرة. فبالنسبة له، لم يعد النقاش يدور حول إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي، بل حول كيفية امتلاك ناصيته والتحكم فيه. لقد لخص رؤيته في عبارة حاسمة ومصيرية: “فالبقاء لمن يجيد هذه التكنولوجيا”. إنها ليست مجرد رؤية أكاديمية، بل هي خارطة طريق لمستقبل قطاع استراتيجي، تؤكد أن على الجزائر، بمؤسساتها وفنانيها، أن تكون فاعلاً في هذا التحول، لا مجرد متلقٍ له.