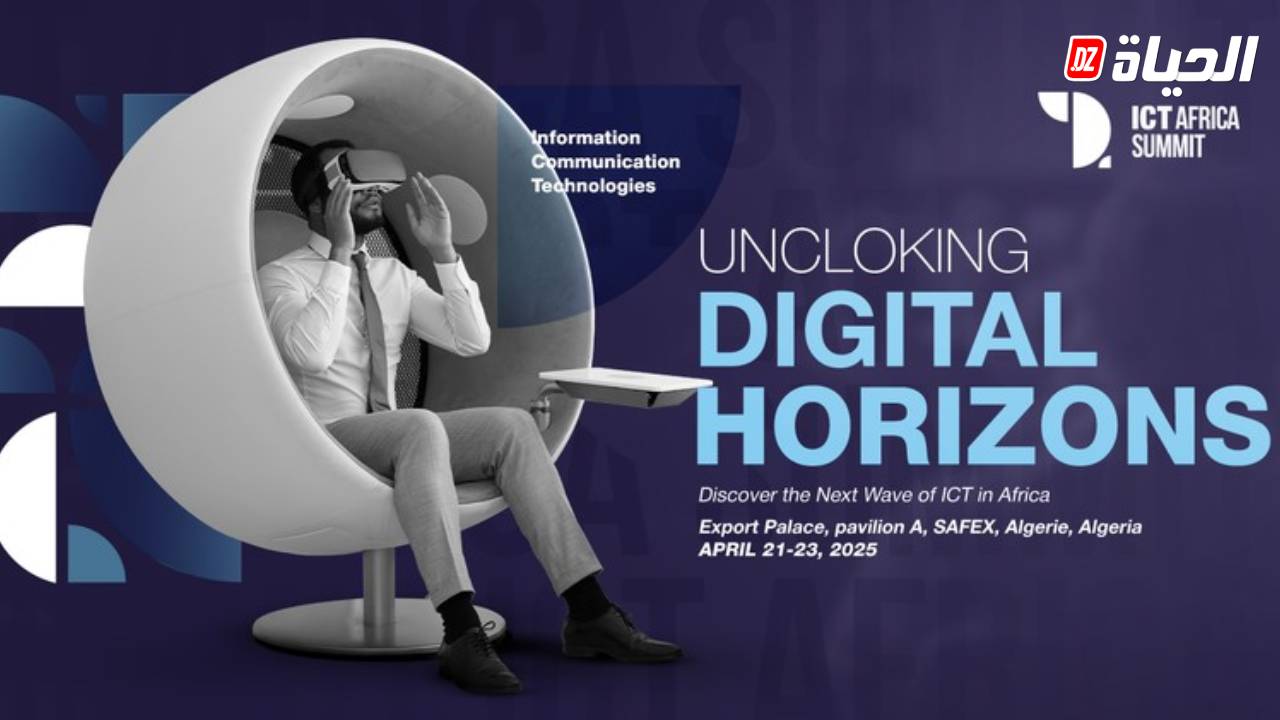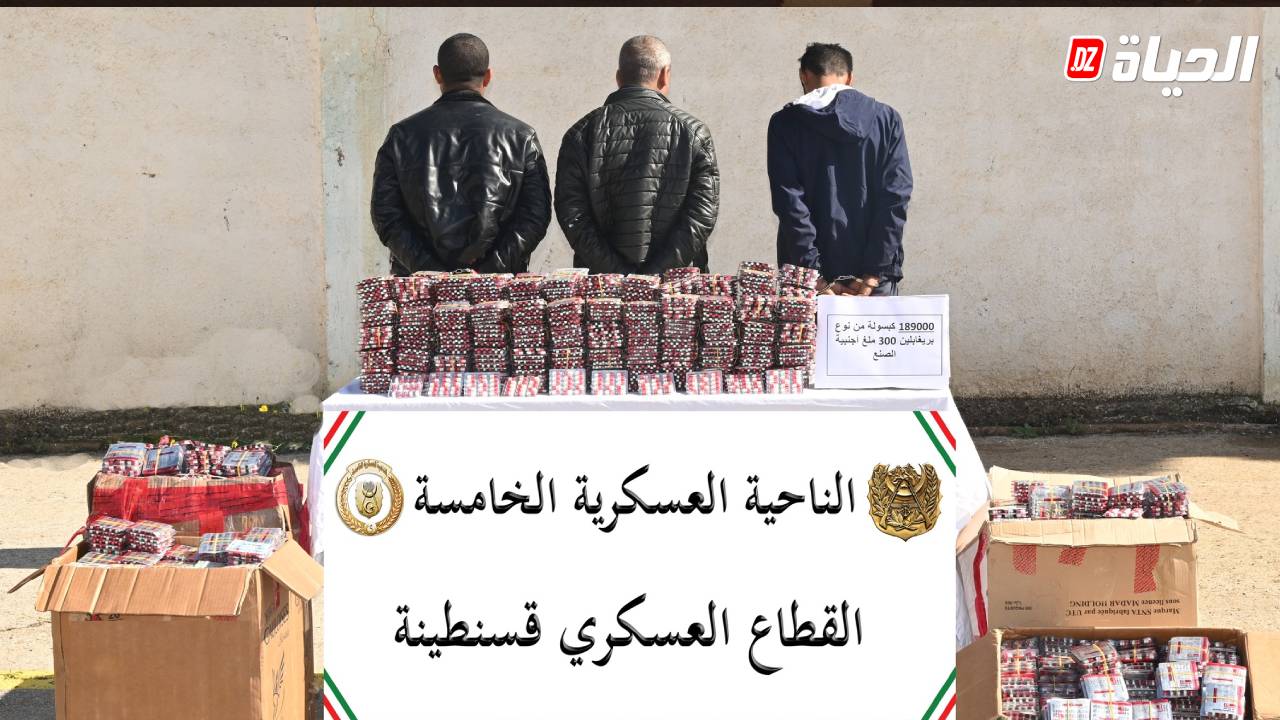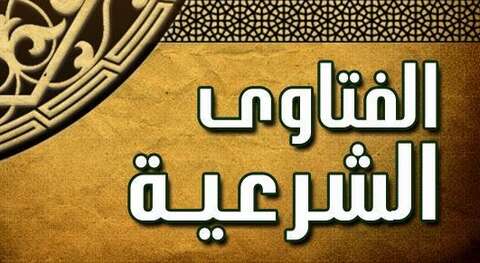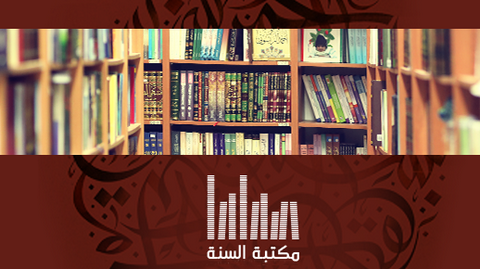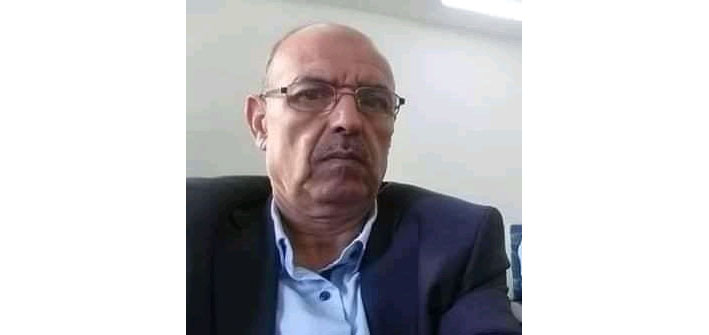إنكار الذَّات: من أعلى درجات السمو في النفس البشرية
البدر فارس/ إنَّ إنكار الذات خُلق من أخلاق الذين سمت هممهم وعلت نفوسهم، فصاروا من الأبطال الصادقين في هذه الحياة، لأنَّ حُب الذات والأثرة والأنانية من الغرائز المُستكنة في صدور الناس، فإذا استطاع المرء أن يقتلع من نفسه جُذور هذه الذاتية أو يقطع عليها طريقَ تأثيرها، أثبتَ أنَّه قد صار بطلًا مُضحيًا في سبيل غيره، …

البدر فارس/
إنَّ إنكار الذات خُلق من أخلاق الذين سمت هممهم وعلت نفوسهم، فصاروا من الأبطال الصادقين في هذه الحياة، لأنَّ حُب الذات والأثرة والأنانية من الغرائز المُستكنة في صدور الناس، فإذا استطاع المرء أن يقتلع من نفسه جُذور هذه الذاتية أو يقطع عليها طريقَ تأثيرها، أثبتَ أنَّه قد صار بطلًا مُضحيًا في سبيل غيره، صادق الكفاح في سبيل مبادئه وعقائده، وقومه ووطنه.
ولعلَّ المُجتمعات الهزيلة تُصاب بداء المُفاخرة العريضة والتباهي المُسرف، لأنَّ هذا الداء يصرف الهممَ والعزائم إلى الرياء والادعاء، ويحول بينها وبين الإخلاص والتواضع، وقد يفتح عليها أبواب النفاق والتلون، ولذلك وصف القرآن المُنافقين بأنهم: «يُراءون الناس»، وجاء في الحديث الشريف: «إنَّ الله يحب الأبرارَ الأتقياء الأخفياء».
ولقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، أرأيت رجلًا غزا يلتمس الأجْر والذكر، ما له؟ فأجاب النبي: لا شيء له. فأعادها الرجل ثلاث مرات، فقال النبي: لا شيء له، إنَّ اللهَ لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا، وابْتُغِيَ به وجهُه!
وكذلك جاء رجل إلى الرسول، فقال: يا رسول الله، إني أقف الموقف أُريدُ وجهَ الله، وأريد أن يُرَى موطني، فتلبث الرسول في الرد، حتى نزل قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (سورة الكهف، الآية: 110).
والإسلام الحنيف يدعو أهله إلى هذا الخُلق النبيل، وهو خُلق إنكار الذَّات، ويُحرضهم على أن يُؤدوا أعمالهم المُختلفة، يُريدون بها وجه الله، ويبتغون بها ما عنده من الثواب العظيم والنعيم المُقيم:
﴿وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (سورة الأعلى، الآية: 17)، ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَار﴾ (سورة آل عمران، الآية: 198)، ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة العنكبوت، الآية: 64)، والحيوان في هذه الآية يقصد به -الحياة الكاملة-.
ولذلك لا يُقيم الإسلام كبيرَ وزنٍ للصدقة إذا أُريدَ بها الافتخار والاشتهار: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية: 9)، والمؤمن المُنكر لذاته هو ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ (سورة الليل، الآية: 18-21).
ولقد استطاع الإسلام أن يُخرِّج من أبنائه أبطالًا عمالقة، سادوا وقادوا، وفعلوا المكارمَ، وأتموا جلائلَ الأعمال، ومع ذلك لم يتباهوا بما فعلوا، ولم يفخروا بما قدموا، بل أنكروا ذواتهم، وكتموا أعمالهم، وابتغوا وجهَ ربهم الذي لا يُضيّع أجرَ من أحسن عملًا، والذي يعلم السر والنجوى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ﴾ (سورة النجم، الآية: 32).
وهذا موقف من مواقف البطولة الخالدة، ومعرض من معارض الجندية المجهولة، يتألق في تاريخ الإسلام والعرب، فقد كان الأمير الفاتح «مسلمة بن عبد الملك» -ابن عم «عمر بن عبد العزيز»- المُلقب بـ «خالد بن الوليد الثاني» على قيادة جيش المسلمين الذي حاصر ذات يوم حصنًا، فاستعصى فتح هذا الحصن من طرف جنود المسلمين، فوقف «مسلمة» يخطب بينهم ويقول لهم: «أما فيكم أحد يقدم فيحدث لنا نقبًا في هذا الحصن؟»… وبعد قليل تقدم جندي مُلَثَّم غير معروف، وألقى بنفسه على الحصن، غير مُبالٍ بسهام الأعداء، ولا خائف من الموت واحتمل ما احتمل من أخطار وآلام، حتى أحدث في الحصن نقبًا، كان سببًا في فتح المسلمين له، وعقب ذلك نادى «مسلمة» في جنوده قائلًا: «أين صاحب النقب؟»… فلم يجبه أحد، فقال «مسلمة»: «عزمتُ على صاحب النقب أن يأتي للقائي، وقد أمرتُ الآذن بإدخاله عليَّ ساعة مجيئه»… وبعد حين أقبل نحو الآذن شخص مُلثم، وقال له: استأذن لي على الأمير، فقال له: أأنت صاحب النقب؟ فأجاب: أنا أخبركم عنه، وأدلكم عليه، فأدخله الآذن على «مسلمة»، فقال الجندي المُلثّم للقائد: إنَّ صاحب النقب يشترط عليكم أمورًا ثلاثة: ألَّا تبعثوا باسمه في صحيفة إلى الخليفة، وألَّا تأمروا له بشيءٍ جزاء ما صنع، وألَّا تسألوه من هو؟ فقال «مسلمة»: له ذلك، فأين هو؟ فأجاب الجندي في تواضعٍ واستحياء أنا صاحب النقب أيها الأمير، ثمَّ سارع بالخروج… فكان «مسلمة» بعد ذلك لا يُصلي صلاةً إلَّا قال في دعائه: اللَّهمَّ اجعلني مع صاحب النقب يوم القيامة.
وكأنَّ هذا الرجل المُحتسب المُجاهد المُتستر بجهاده، كان يتذكر خير التذكر أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه- فقال له: يا رسول الله، الرجل يُقاتل للمغنم، والرجل يُقاتل للذكر -أي ليرتفع ذكره-، والرجل يُقاتل ليُرى مكانه -أي ليشتهر بالشجاعة بين الناس-، فمن في سبيل الله؟…فأجاب الرسول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
وكأنه كان يتذكر أيضًا نعم التذكر أنَّ «عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: «يا «عبد الله»، إن قاتلتَ صابرًا مُحتسبًا بعثك اللهُ صابرًا مُحتسبًا، وإن قاتلتَ مرائيًا مكاثرًا، بعثكَ اللهُ مرائيًا مكاثرًا».
ونُضيف إلى الموقف السابق موقفًا آخر، فيه عِظة رائعة، وفيه إنكار للذات باهر:
جاء في «تاريخ الطبري»: لما هبط المسلمون -المدائن- وجمعوا الأقباض -أي الغنائم قبل أن تُقسم- أقبل رجلٌ بحُقٍّ معه، فدفعه إلى صاحب الأقباض -أي المُختص بجمع الغنائم وحراستها-. فقال هو والذين معه: ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله ما عندنا ولا يُقاربه. فقالوا: هل أخذتَ منه شيئًا؟ فقال: أما والله لولا الله ما أتيتكم به. فعرفوا أنَّ للرجل شأنًا، فقالوا: من أنتَ؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني، ولا غيركم ليقرظوني، ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه… فأتبعه رجلٌ حتى انتهى إلى أصحابه، فسأل عنه فإذا هو «عامر بن قيس»…!!.
وهذا التوجيه الإسلامي الرائع إلى البطولة المُحتسبة هو مثلٌ أعلى، يُصوّر الحرص على نشر روح الجندية المُضحية في تواضعٍ وصمتٍ وإنكارٍ للذَّات، ومن أجل هذه البطولة أرادت بعض الدول في العصور الأخيرة أن تحتفل احتفالًا ماديًا ومعنويًا بتكريم «الجندي المجهول»، وهو اتجاه أوحت به الرغبة في تمجيد الكفاح الصامت الذي يعمل في الخفاء، ولا يُثير من حوله الصخب أو الضوضاء، لأنَّ الجندي المجهول كما يقول «أحمد شوقي»: «تمثال من إنكار الذات والفناء في الجماعات، وصورة من التضحية المُبرأة من الآفات، المُنزَّهة عن انتظار المُكافآت».
ونُضيف إلى الموقفين السابقين موقفًا آخر، ثالثًا، فيه إحسانٌ عظيم، وفيه إنكارٌ للذَّات خارقٌ للعادة:
لما توفي العابد المؤمن: «علي زين العابدين بن الحُسين بن علي بن أبي طالب»، وغُسِّلَ وُجدَ على كتفيه جلبٌ -مكان الجُرح- كجلبِ البعير، فقيل لأهله: ما هذه الآثار؟ قالوا: «من حمله للطعام في الليل يدورُ به على منازل الفقراء»…!! فلما سمع الناس بهذه القصة الغريبة، تعجبوا منها وأرادوا معرفة تفاصيلها، وهذا ما دفع ببعض الفضوليين منهم إلى استقصاء حقيقة هذا الخبر، وحاولوا معرفة صدق ما رُوي عن كرم «علي زين العابدين»، فتفاجؤوا بأكثر من ذلك، حيث علموا واستنتجوا أنَّ فقراء المدينة كان يأتيهم «علي زين العابدين» في الليل بالمؤونة خِفية، فيضعها بقرب باب دارهم ثم ينصرف دون أن يعلم به أحد، فيقوم من بعده الفقراء بإدخال تلك المؤونة إلى ديارهم والاستفادة منها وهم لا يدرون من صاحبها…!! حيث يقول «محمد بن اسحاق» في هذا المضمون: «كان ناسٌ بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين يعيشون، ومن يعطيهم، فلما مات «علي بن الحسين» فقدوا ذلك فعرفوا أنَّه هو الذي كان يأتيهم في الليل بما يأتيهم به»…!!.
هذه أخلاق المؤمنين الكُمَّل، الأبرار الأتقياء الذين لا يُريدون عُلوًا ولا فسادًا في الأرض، بل يُريدون إرضاء الخالق مهما كانت التضحيات الجسام التي يُضحون بها في سبيل إرضاء خالقهم ورازقهم، ولا يهمهم إن كان الناس على دراية بهذه التضحيات أم لا، بل بالعكس من ذلك فإنهم لا يُريدون مدحًا ولا أجرًا لهذه التضحيات، بل يُريدونها خالصةً لله عزَّ وجلَّ، فطوبى لـ»علي بن الحسين» وأمثاله، فهم بالفعل الذين يُمثلون حقيقة مبادئ دينهم الحنيف، فهذا الموقف الذي اتخذه «علي زين العابدين» إزاء الفقراء يكشف لنا حقيقة إنكار الذَّات التي تعد من أعلى درجات السمو في النفس البشرية، حيث لا يرى الإنسان نفسه مُطلقًا، وليس له حظٌ في حياته، وإنْ كان حلالًا ومقبولًا في عرف الناس، مُضحيًا في سبيل الآخرين، صادق الكفاح من أجل مبادئه وعقيدته ودينه.
والمؤمن المُتخلق بهذا الخُلق السامي والنبيل: إنكار الذَّات، سيكون جزاؤه في الدنيا والآخرة جزاءًا عظيمًا، وأجرًا لا يفوته أجرٌ آخر، وصدق «علي زين العابدين» عندما قال: «صدقة الليل تُطفئ غضب الرب، وتنور القلب والقبر، وتكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة». ويعني هنا بصدقة الليل: الصدقة التي لا يعلمها إلا الله وصاحبها.
ونختم هذه المواقف النبيلة في إنكار الذَّات والبُعد عن التباهي المُسرف، بموقفٍ رابع، فيه صمت ولكن فيه عزيمة، وليس فيه جلبة ولكن فيه تصميم، والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مُستقيم.
يروي تاريخ الإسلام أنَّه في عهد الخليفة الراشد، العادل الزاهد: «عمر بن عبد العزيز»، كان الخليفة -عمر- يخاف المُباهاة في خُطبه، فإذا رأى أنَّ الناسَ قد أُخذوا بقوله وافتتنوا ببلاغته قطع كلامه مخافة أن يطغى رنين الكلام على معناه، ومخافة المُباهاة، ومع أنه كان شديد التحفظ في كلامه، عظيم الحرص على الحق فيه، حتى قيل: ما رؤى رجل أشد تحفظًا في منطقه من «عمر». مع ذلك كله كان يقطع كلامه إذا فُتن به الناس.
وقد خطب يوم عيد فأرق كلامه فأبكى النّاسَ جميعًا يمينًا وشمالًا، ثمّ قطع كلامه والنّاس ينتظرون أن يكمل، ونزل من المنبر، فدنا منه «رجاء بن حيوة» -أحد مُستشاريه- فقال له: يا أمير المؤمنين، كلَّمتَ الناسَ بما أرق قلوبهم وأبكاهم ثم قطعته أحوج ما كانوا إليه، فقال: يا «رجاء»، إني أكره المُباهاة…!!.
ولا ننسى أيضًا ذكر موقف «عمر بن عبد العزيز» عندما شارك في الجهاد في سبيل الله، ضد جيش الإمبراطورية الرومانية بعدما عُزل من إمارة «المدينة» و»الحجاز»، أيام ابن عمه الخليفة «الوليد بن عبد الملك»، ولقد شارك في هذا الجهاد كجندي عادي!! فهو كان يرجو الشهادة أو الظفر بالنصر المُبين… ولم يغره أنَّه أمير معزول، ذو مكانة عالية ويجب أن يكون قائدًا مُطاعًا!!.
هذا هو إنكار الذَّات، في سبيل إرضاء الخالق، وقهر النفس التي تُريد إلَّا إشباع غرائزها الهدَّامة!!
فعلى الذين يؤمنون بربهم وعقائدهم وأوطانهم ومبادئهم، أن ينطلقوا خِفافًا وثِقالًا في ميادين العمل المبرور، والسعي المشكور، ليُناصروا مبادئهم، ويخدموا بلادهم، واثقين أنَّ العُرْفَ لا يذهب بين الله والناس:
﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (سورة الشورى، الآية: 36)، ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَار﴾
(سورة آل عمران، الآية: 198).