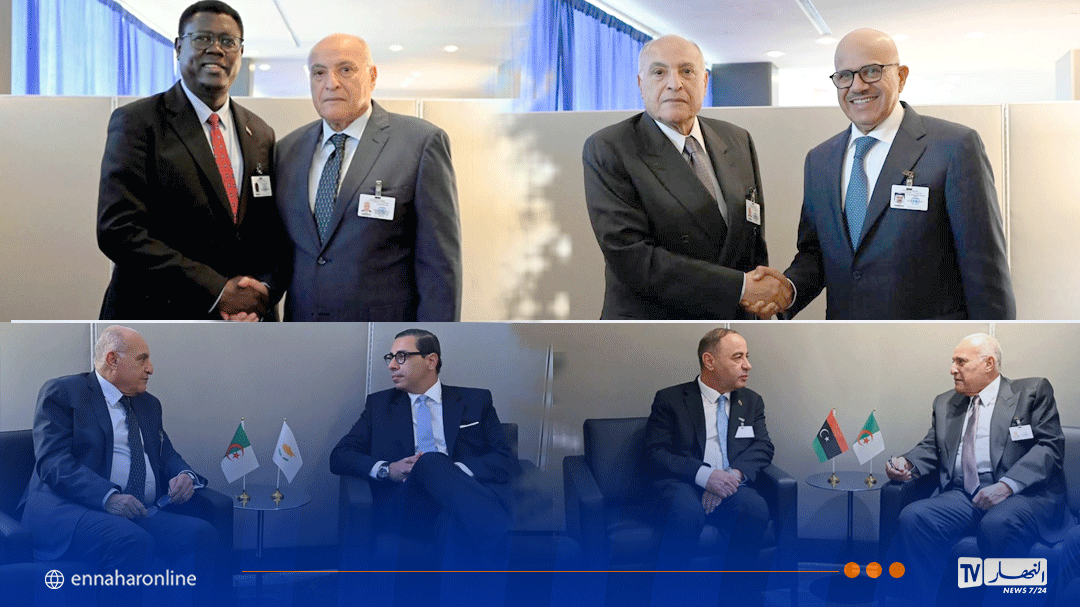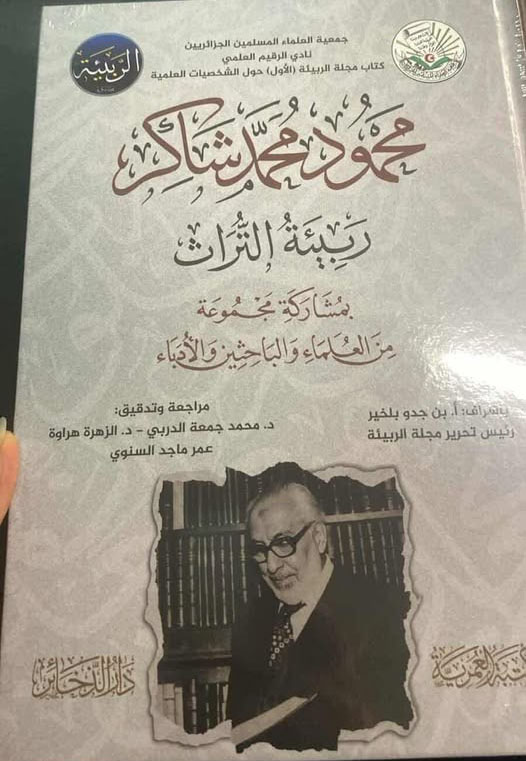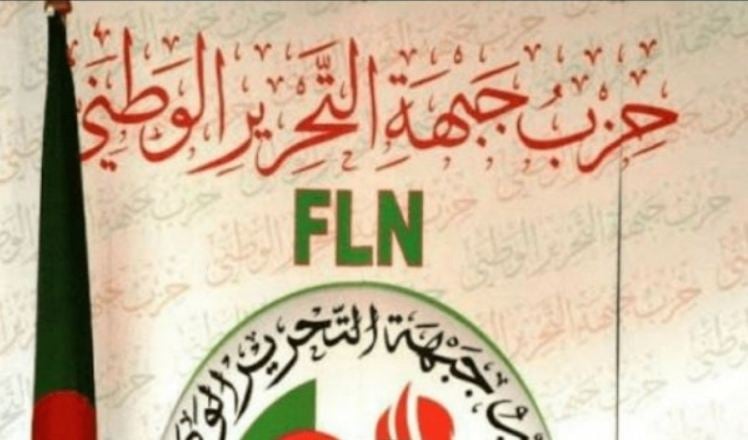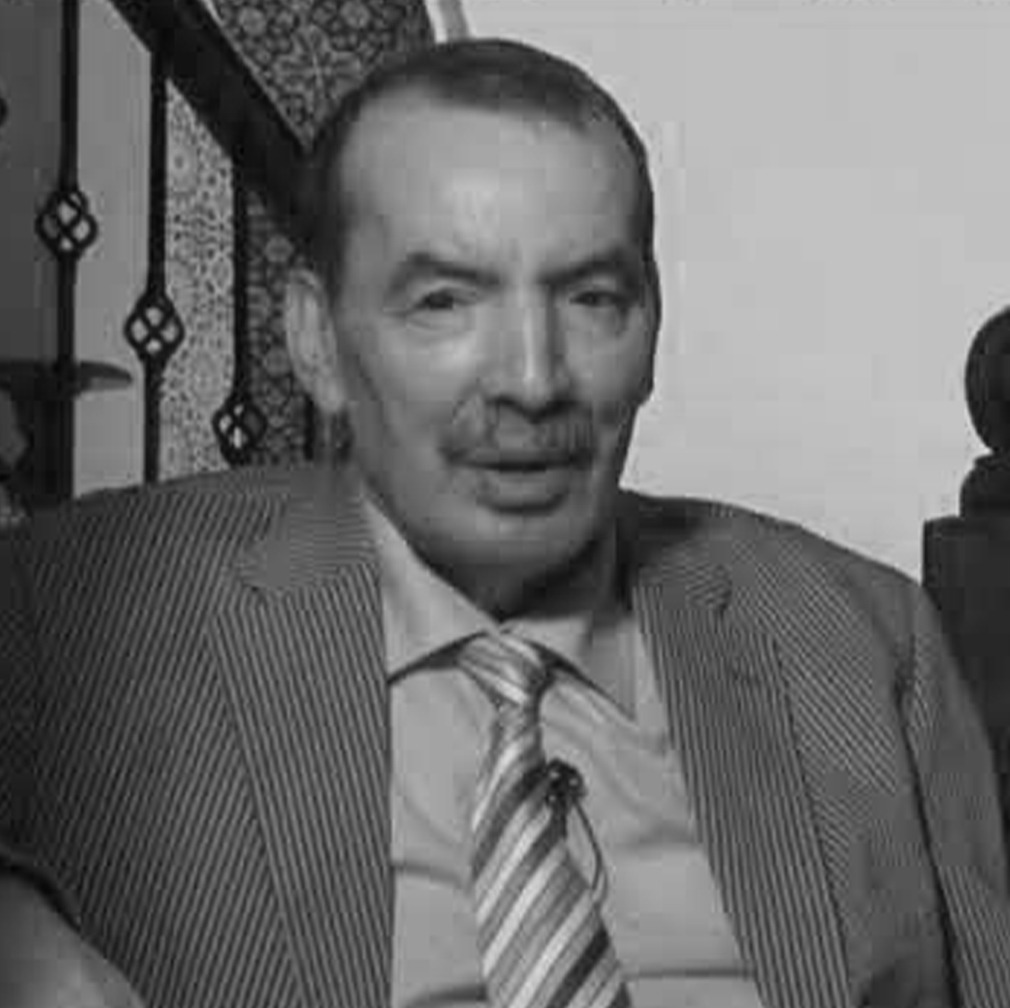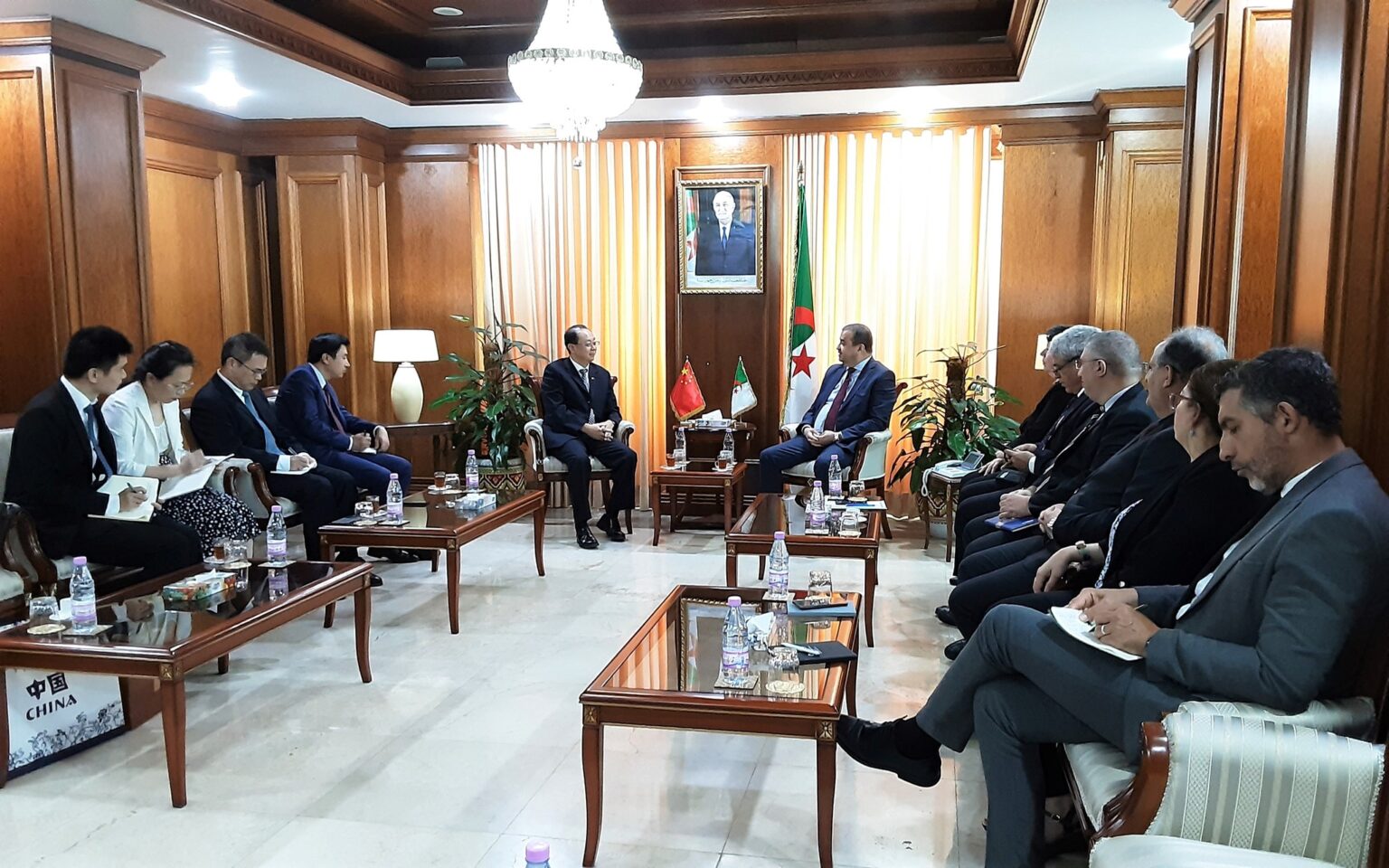قراءة هادئة في أطروحة آلان دونو
رياض رمضان بن وادن في زمن تتراجع فيه العناية بالعمق لصالح راحة السوق، ينبري كتاب “نظام التفاهة” للفيلسوف الكندي آلان دونو ليقول ما قد لا يجرؤ الكثيرون على نطقه صراحة: إن التفاهة لم تعد حالة عابرة أو ذوقا شخصيا، وإنما صارت نظاما مُحكما يحكم المؤسسات ويعيد تشكيل العقل العام. فالمؤلف لا يكتفي بترديد شكاوى عامة …

رياض رمضان بن وادن
في زمن تتراجع فيه العناية بالعمق لصالح راحة السوق، ينبري كتاب “نظام التفاهة” للفيلسوف الكندي آلان دونو ليقول ما قد لا يجرؤ الكثيرون على نطقه صراحة: إن التفاهة لم تعد حالة عابرة أو ذوقا شخصيا، وإنما صارت نظاما مُحكما يحكم المؤسسات ويعيد تشكيل العقل العام. فالمؤلف لا يكتفي بترديد شكاوى عامة عن الانحدار الثقافي، وإنما يرصد آليات ملموسة -من الجامعات إلى الشركات الرقمية- تُعلي من قيمة “المتوسط” وتجعل منه معيارا للحكم والقرار، فتغدو “المواءمة” بديلا عن التميز، و”القبول العام” أقوى من الحقيقة والنقد، وهنا نستحضر مقولة هربرت ماركوز عن «الإنسان ذو البعد الواحد»، إذ يتقاطع تشخيصه مع رؤية دونو في تصوير مجتمع يتكيف مع ما هو سهل ومرضي، ويعجز عن التفكير بما يتجاوز المألوف.
ولكي نفهم كيف تتحول التفاهة إلى بنية، يقترح الكتاب ثلاثة ممرّات متشابكة: تربية تُقوِّض التفكير النقدي، منطق سوق يُعاقب التفرد، وثقافة جماهيرية تحتفي بالسهولة أكثر من تقديرها للجدية. وفي الحقل التربوي مثلا، يُظهر دونو أن كثيرا من الجامعات لم تعد ساحات للتفكير الحر، وإنما مراكز لتأهيل الطلبة بما يتوافق مع حاجات السوق، وهذا يُذكّرنا بما قاله بيير بورديو حول “العنف الرمزي”؛ إذ تُفرض على الطلبة معايير النجاح الممزوجة بقواعد السوق، فيتخرجون كحاملي «رأسمال بشري» لا كعقول نقدية قادرة على طرح أسئلة مزعجة.
وفي عالم الاقتصاد والعمل، تتكامل النزعة الربحية مع البيروقراطية لإنتاج نموذج الموظف “المناسب” لا “المتميز”؛ فتُفضّل المؤسسات الشخص القابل للإدارة، المنضبط بالقواعد، على حساب المبدع المختلف أو الجريء في طرح البدائل، والأمر هنا يشبه ما لاحظه ماكس فيبر حين تحدث عن “قفص الحديد” الذي تفرضه العقلانية البيروقراطية، حيث يتحول الفرد إلى مسمار داخل آلة ضخمة، ويُكافَأ التوافق أكثر مما يُكافأ الابتكار، والنتيجة أن النظام يطرد الطموح الاستثنائي أو يهمّشه، فيكرّس ثقافة الاكتفاء بـ”الكفاية” بدلا من ثقافة الامتياز.
أما الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، فهي الميدان الأوسع اليوم لترسيخ “نظام التفاهة، فعلى (فيسبوك) أو (تيك توك) أو (إنستغرام)، تُكافأ المحتويات الخفيفة والسطحية بعدد المشاهدات والإعجابات، بينما يظلّ المحتوى المعرفي أو التحليل العميق في الهامش، لأن خوارزميات هذه المنصات لا تهتم بجودة ما يُنشر، وإنما بقدرته على إثارة التفاعل اللحظي، فتتصدّر “الترندات” مقاطع راقصة أو نكات سريعة، بينما تُقصى القضايا المعقدة التي تحتاج إلى وقت للتأمل، وهنا يتجلّى ما يسميه دونو “اقتصاد المعنى” بأوضح صوره: فالمعنى لا يُقاس بعمقه، ولكن بمدى قابليته للاستهلاك الفوري، وهذا بالتحديد يشه ما حذّر منه نيل بوستمان حين كتب عن “التسلية حتى الموت”، حيث تتحول الثقافة العامة إلى عرض مستمر يطلب من الجميع أن يصفّق، لا أن يتفكر.
وإذا انتقلنا إلى السياق العربي، نجد الصورة أوضح مما نتخيّل، فكم من (يوتيوبر) أو (مؤثر) جمع مئات الآلاف بل الملايين من المتابعين بمقاطع لا تتجاوز دقائق من المزاح أو (المقالب)، بينما تُعاني القنوات الثقافية والتعليمية من ضعف المشاهدة وربما الاندثار، ففي بعض البلدان العربية، يحقق فيديو ساخر أو مشهد تمثيلي قصير نسبا خيالية من المشاهدة، في حين تظل ندوات فكرية أو مناقشات جامعية حبيسة قاعات شبه فارغة، هذه المفارقة تجسّد بدقة ما قصده دونو: نظام يعيد إنتاج التفاهة لأنه يضمن التفاعل والانتشار، بينما يهمّش التفكير النقدي لأنه يقتضي وقتا وصبرا وتأملا.
الأدهى أن هذه المنصات لا تُنتج التفاهة فحسب، وإنما تُعيد تدويرها بلا توقف، فالمقطع السطحي يُشارك آلاف المرات، ويتحوّل إلى “ترند” يُغطي على كل ما عداه، وبهذا تُخلق دوائر مغلقة تجعل من التفاهة مركزا، وتجعل من المختلف أو الجاد هامشا شبه غير مرئي، والنتيجة: أجيال كاملة تعيش في فضاء يُدربهم على الاستهلاك السريع بدل التفكير النقدي، ويجعل من “الإعجاب” و”المتابعة” بديلا عن النقاش والحوار.
غير أن المؤلف لا يتوقف عند تشخيص العلة، وإنما يفتح نوافذ نحو إمكان العلاج، فهو يدعو إلى إعادة الاعتبار لوظيفة الجامعة كفضاء للتساؤل والنقاش الحر، لا مجرد مصنع لشهادات، كما يلح على ضرورة وضع حدود للهيمنة المطلقة لرأس المال الرقمي في توجيه المعرفة. وفي السياق نفسه، يرى أن المجتمع بحاجة إلى فضاءات عمومية بديلة -قد تكون منصات مستقلة أو مبادرات ثقافية- تستعيد النقاش العميق من براثن التسلية السريعة، وهنا يمكن أن نجد صدى لما نادى به يورغن هابرماس عن “الفضاء العمومي” باعتباره الشرط الأساسي لحوار عقلاني يعيد للمجتمع قدرته على صياغة مصيره.
ما يمنح أطروحة دونو قوتها هو أنه لا يكتفي بالتنظير، وإنما يُدخل القارئ في شبكة أمثلة قريبة: من انحدار النقاش العام في البرلمانات، إلى انفجار التفاهة في مقاطع الفيديو القصيرة، وصولا إلى طغيان “المؤثرين” على حساب المثقفين، فهذه الأمثلة تكشف أن “الميديوقراطية” ليست فكرة تجريدية، وإنما واقع ملموس يعيشه القارئ يوميا في المدرسة، ومكان العمل، وحتى في شاشة هاتفه المحمول.
مع ذلك، لا يغلق الكتاب أبوابه على اليأس، فدعوته ليست بكائية ولا رثاءً لعصر ذهبي، بل نداء لاستعادة القدرة على النقد والإبداع، فهو يقترح مقاومة جماعية تبدأ من التعليم، وتمر عبر الفضاء الرقمي ذاته، ولا تنتهي إلا باستعادة السياسة دورها بوصفها مجالاً لاتخاذ قرارات جريئة تخدم المصلحة العامة، حتى لو بدت غير مريحة أو صعبة التسويق، فمواجهة نظام التفاهة ليست حربا على الناس العاديين الذين يُغريهم السهل، وإنما هي معركة ضد الآليات التي تُغلق أمامهم أبواب التفكير الحر وتُحوّل “المتوسط” إلى أفقٍ لا فكاك منه.
في النهاية، يقدّم دونو صرخة فلسفية وسوسيولوجية في آن واحد: إذا استسلمنا لمنطق التفاهة الرقمي فلن نخسر رفاهية فكرية وحسب، بل نفقد القدرة على صياغة مصيرنا، وهنا تكتسب كلماته وزنها، لأنها تُعيد إلى الواجهة السؤال الأخلاقي والسياسي الأهم: كيف نُحصّن وعينا ضد ما يُراد له أن يكون مقبولا بسهولة، كي لا نغدو مجرد “مواطنين متوسطين” في عالم بلا معنى.