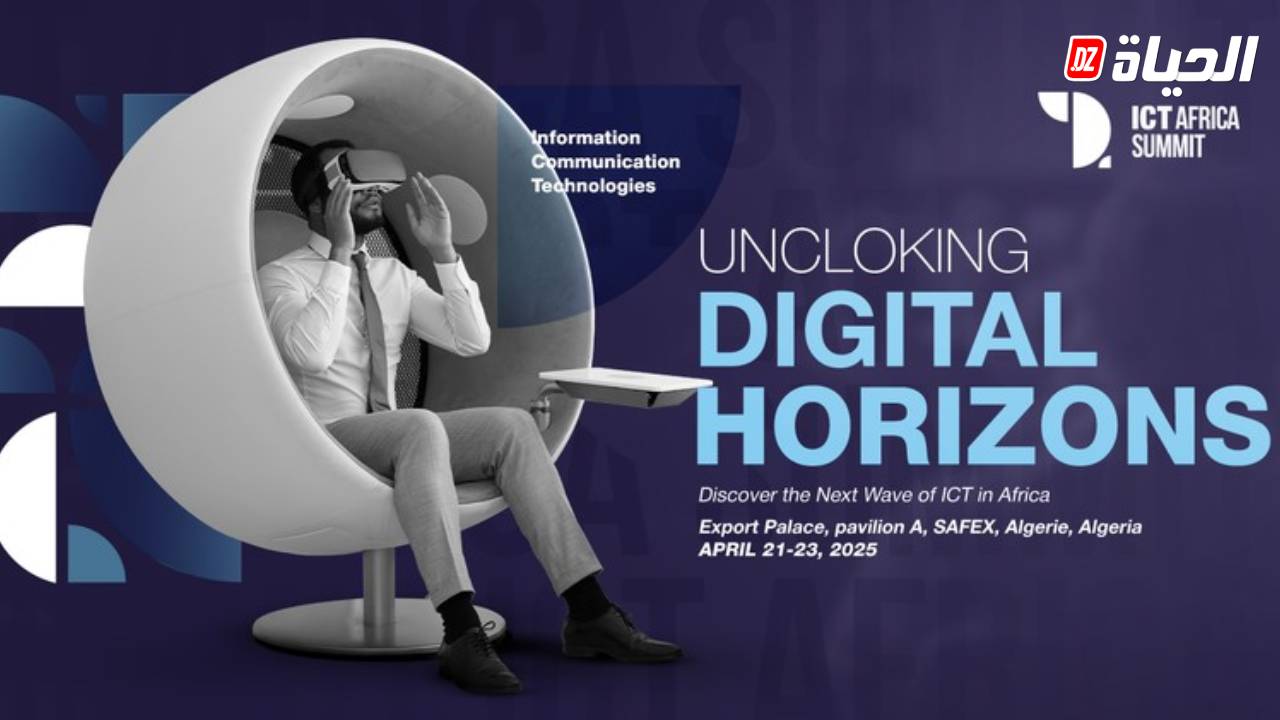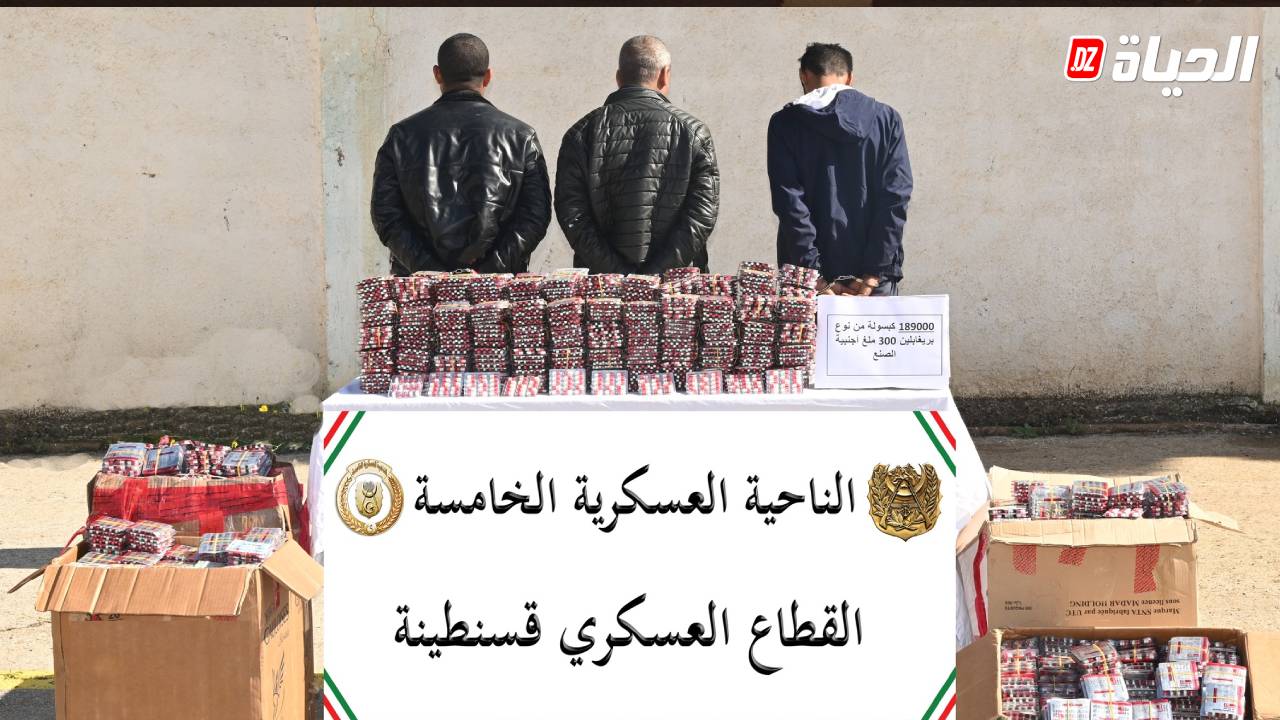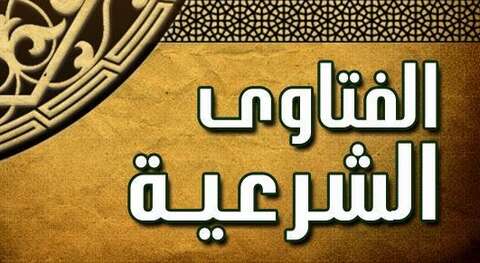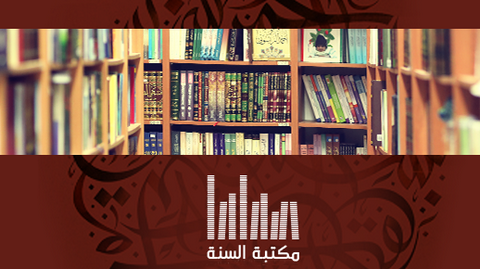ما بعد الاتفاقات والتوافقات
صرفا للنظر عما يتم التركيز عليه في الخطابين السياسي والإعلامي في الضفتين، من اعتبار المرحلة الحالية من تاريخ العلاقات الجزائرية استثنائية وبكونها الأسوأ، وربما أنها بلغت نقطة اللارجوع، فإن ما يفترض أن يقع على رأس اهتمام هؤلاء، ولا سيما الجزائريين، هو معرفة مدى التأثيرات العميقة المستقبلية التي ستنتج عن هذا “السوء” غير المسبوق في العلاقة …

صرفا للنظر عما يتم التركيز عليه في الخطابين السياسي والإعلامي في الضفتين، من اعتبار المرحلة الحالية من تاريخ العلاقات الجزائرية استثنائية وبكونها الأسوأ، وربما أنها بلغت نقطة اللارجوع، فإن ما يفترض أن يقع على رأس اهتمام هؤلاء، ولا سيما الجزائريين، هو معرفة مدى التأثيرات العميقة المستقبلية التي ستنتج عن هذا “السوء” غير المسبوق في العلاقة وعلى عتبة اللارجوع التي بلغها مثلما يذكر، والأكثر منه معرفة كيفية التعامل مع هذا المعطى بوصفه جزء من التقلبات التي تعرفها العلاقات الدولية والتي صارت تمضي في سريع إيقاع تقلباتها تلك، على شاكلة البورصات في كبريات دورها في العالم.
فالتركيز الانفعالي غير المفهوم على الأحداث وبناء التحليل الكلية عليها، أعمى الكثير عما يمكن فهمه في المسألة العلاقات الجزائرية الفرنسية في الماضي والحاضر، دون الحديث عن المستقبل الذي يبدو صناعة غربية وتأبى أن تكون عربية لأسباب بعضها مُتفهم والبعض الاخر غير مفهوم، كما أن التركيز على وقائع الاحداث المتقلبة في الشريط التاريخي للعلاقات الجزائرية الفرنسية وعدم الايغال في عناصره البنيوية، بما يفضي إلى الحسم في الإشكالات التي تطفو بين الفترة والأخرى، على شاكلة الحساسية الموسمية، سيبقي في الأخير على هذا السلوك التناوشي الوظيفي بين البلدين مستمرا ومن دون توقف.
من هنا تبدو لنا الإشكالية في هذا سياق قائمة على سؤال موضوعي وهو: كيف يمكن للوعي الجزائري الاستثمار في راهن أزمة العلاقات الفرنسية الجزائريةـ، لفهمها بشكل أعمق من خلالها اكتساب ثقافة التعامل مع خطاب السياسة والاعلام المتصلة بالأزمات الدبلوماسية؟
طبعا تعقُّد الإشكالية المتصلة بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، باعتبارها قامت منذ الاستقلال على مراحل من سجال التدبير الذي كان نشب في كل محطة مأزومة بين البلدين، تجعلنا نفترض بأن الاختلاف في منظومتي البلدين ومستويات وشاكلة الانخراط المؤسسي والجماهيري فيها ، هي من أهم عناصر أزمة التعامل معها لا سيما لدى الجزائريين,
فمثلما أشرنا سابقا، فقد تشكلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مند الاستقلال سنة 1962 على مراحل عدة كان بعضها وليد اتفاقات أبرمت بين الطرفين قبيل وبعيد الاستقلال، رام من خلالها الطرفان إلى الإبقاء على الاتصال بما يخدم مصالحيهما، وبعضها كان وليد توافقات ظرفية التي يتم في العادة من خلال اللجوء إليها، تجاوز تلك الاتفاقات وفق ما تفرضه تحديات جديدة، لكنه مثلما تصل الاتفاقات إلى نهاية صلاحياتها الزمنية والتاريخية، فإن التوافقات قد تعرف هي الأخرى توقفات في حال وصلت الأمور إلى حد الانسداد.
مرحلة الاتفاقيات
ظل الجزائريون طويلا يعتقدون بأن حرب التحرير الوطنية التي مكنتهم من التحرر واستعادة سيادتهم على ارضهم ومصيرهم، كانت ساحتها القتال فقط، وهذا ما كان يزيد من منسوب الفخر الوطني لديهم المرتبط بمنسوب الدم الذي قدموه فداء للوطن، قبل أن يعلموا بأنه كانت ثمة سوحٌ أخرى للمعارك، منها الدبلوماسية والثقافية والفكرية، التي عادة ما لا يتم تناولها خارج تأثير معركة القنال، فعلموا لاحقا أنه كانت هناك اتفاقية حملت اسم “ايفيان” تراضى بوجبها الطرفان الفرنسي والجزائري على جملة من المسائل التي حددت مستقبل العلاقة بين البلدين، طبعا خضعت هاته الاتفاقية إلى حالة من التعتيم من الجهتين أو حالة من التهوين والتهميش في التحليل التاريخي والسياسي، الشيء الذي سيدفع بالبعض إلى غاية الحديث عن بنود وفقرات سرية اتفقا الطرفان على اخفائها خدمة لمصالح البلدين وخوفا من الأصوات المعارضة من الجهتين كانت تشوش على مسار المفاوضات.
هكذا تصرف سياسي مع اتفاقيات مصيرية ظلت لفترات طويلة قيد التهميش وعدم الايغال التحليلي لها، بما يمكن أن يشكل إطارا لفهم متجدد للتاريخ المشترك، من جهة ولفهم طبيعة التعامل الدبلوماسي بين الجزائر والبلدان التي تشتبك معها في مسارات التاريخ وتتعالق معها في الوقع، مثل إسبانيا والاتحاد السوفيتي والعمق الإفريقي الكبير، سيبدو لاحقا عنصر قلق في المعادلة الوطنية وما يرتبط بها من وعي استراتيجي للبلد.
فاليوم تبدو مرحلة الاتفاقات التي حصلت بين فرنسا والجزائر، والآخذة بعضها الآن في التكشف، منها ما لم يكن متداولا في الخطاب السياسي ولا القانوني بين البلدين، كاتفاقية 1968 – تبدو – لدى الجزائريين من مكتشفات الازمة الحالية، وهو ما يستدعي الان التأسيس لوعي جديد في فهم واسع وعميق لطبيعة العلاقات ما يفضي بالضرورة إلى فهم واقع أي أزمة حين تندلع، ولا يظل العبث أو الاندفاع أو العواطف العدائية أو الوطنية على حد سواء، أداة التفاعل معها كما هو ملاحظ في الضفتين.
بناء على ما تقدم فبالوسع القول بأنه يمكن الحديث عن تجاوز حصل في وعي، على الأقل لدى بعض النخب، لمنطق الاتفاقيات كمرحلة من مراحل التطبيع في العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد الاستقلال، مرحلة كانت أبعد من تحقق ما رامه الطرفان من مشروع التطبيع، لأسباب عدة منها ما بقي متصلا بالذاكرة ومنها ما تعلق باختلاف البلدين في التوجهات الخارجية خصوصا منها المتعلقة بالبعد الجيوبوليتيكي للجزائر وعمقها المغاربي والإفريقي.
مرحلة التوافقات
هذا البعد الجيوبولتيكي الخاص بالمنطقتين المغاربية والافريقية بل الدولية هو حتى، كان دائما ما يعالج وفق توافقات آنية بين الطرفين، وهو ما رسم اليوم وضعيتها في هذا الجانب، أي في الحيز المغاربي حيث أزمة الصحراء الغربية المستعصية عن كل حل، وأزمة الساحل التي صارت تشكل تهديد للحدود الجزائرية مع جيرانها الأفارقة المباشرين الذين دخلوا في لعبة للتمدد الامبراطوري الجديد الذي يتضح يوما بعد يوم أنه يشكل ملمح الغد في العلاقات الدولية وطابع صراعها الجديد البادي والبادي الآن بالاقتصاد وسينتهي لا محالة، مثلما تعتقد عديد الأصوات إلى حرب أو حروب كونية أخرى من أجهل الاستحواذ على خيرات الشعوب الضعيفة أو المستضعفة.
فالفرنسيون ظلوا لفترات طويلة ينهبون دول الساحل ويحكمون الوصاية من بعد فترة الحماية، عليهم عبر مستويات عدة، اقتصادية بصك عملة موحدة خاصة بهم تذر على باريس الخيرات، حاولوا الاحتفاظ بتلك المناطق من خلال توظيف خطاب الإرهاب ورفعه كشماعة في هذا الاطار، مستغلين معناة الجزائر مع الظاهرة الإرهابية لعشرية كاملة، لتحقيق توافق حصل في مرحلة واحدة تحت ذريعة الهدف المشترك، لكنه ما لبث أن انفض.
أما في مسألة الصحراء الغربية، فحتى وإن ظلت فرنسا لأحقاب عدة تميل إلى دعم المغرب، في مناكفته المستمرة للجزائر، ولكل بلدان المنطقة المغاربية، بسبب قلق طبيعة نظامه “الملكي الوحيد” بها، وذلك عبر كل الرؤساء الذين تداولوا على قصر الاليزي سواء كانوا من اليمين أو من اليسار، إلا أنها يقيت على صعيد الحسم في هذا الملف على الحياد، قبل أن تقلبت الاوضاع الدولية لتقلب معها عديد المواقف الدبلوماسية والسياسية وفق مصالحها فيعلن مانويل ماكرون اعترف بلده بمغربية الصحراء الغربية ودعمه لمخطط المغرب، الدي هو في أصله مخطط فرنسي، القاضي بمنح الحكم الذاتي للصحراويين على أرضهم، وبذلك تكون مرحلة التوافقات التي صاحبت ثم تلت مرحلة الاتفاقيات قد انقضت بدورها، وبالمرة ايقظت أو يفترض ذلك، نوعا من الأسئلة الجديدة في وعي الجزائريين بشأن المقاربات السياسية والجيوبولوتيكية التي ظلت ثابتة لديهم وهي اليوم بفعل ما ثار من غبار الأزمة الجزائرية الفرنسية تظهر عارية من كل حمولة خطاب مدار لحقيقة الواقع فيها.
الانفكاك التاريخي
فالعبور إذن في الوعي من مرحلتي الاتفاقيات والتوافقات، يفترض أن يقود بالضرورة إلى مرحلة الانفكاك التاريخي الذي يبدأ على المستوى الرسمي شريطة أن لا يحدث التراجع عنه، وذلك باستقلال الذاكرة وليس فقط هذا، بل وبتحريرها، فعدم بلوغ مستوى تجريم الاستعمار، وفق ما سقناه، يبدو أنه ظل رهينة الاتفاقيات والتوافقات، بحيث كانا الطرفان يتحاشيان تناوله سياسيا، وعلى الصُعد الرسمية، بما يعني أن الطرفين كانا يتحكَّمان سياسيا في التعامل مع الذاكرة المشتركة، وإذا كان الأمر ذلك، قد خدم الطرف الفرنسي إلى حد كبير، نتيجة طبيعة نظامه القائم باعتبار الهامش الكبير للحرية التعبير تجد لها ممارسة من خلال طبقة سياسة متجذرة في التاريخ بين يمين بشقيه المعتدل والمتطرف ويسار هو كذلك، حيث عادة ما تستعمل ورقة الجزائر من زوايا عدة في معارك فرنسا الانتخابية، بإثارة أطروحة الجنة المفقودةـ ملف الأقدام السوداء وممتلكاتهم، أو ملف الهجرة وغيرها، فإنه من الجانب الجزائري لم يخدمه قط هذا التحكم السياسي في قضايا الذاكرة حيال فرنسا، وحقوق البلد من الاستعمار وطبائع بطشه التي نكلت بالإنسان وبالبيئة وغيرها من القضايا التي لا يزال المجتمع الجزائر واقع رهينة اشكالاتها.
فالانفكاك التاريخي عبر استقلالية الأطروحة بشأن مشترك التاريخ، وتحرير ذلك بحيث يغدو بوسع الفاعل السياسي التعامل معها بمثل ما تعاملت قوى التحرر في العالم من قضايا الاستعمار بالحسم والجزم الضروريين، الشيء الذي سيمكن الأجيال من تجاوز العوائق النفسية التي تشكلت بفعل هذا القبض أو التحكم الرسمي في الذاكرة والمعرفة الموضوعية بالتاريخ الوطني.
في هذا الاطار تحديدا تابعت مؤخرا عبر قناة RTL الفرنسة نقاشا حادا حول الأزمة الراهنة بين الجزائر وفرنسا، جمع منشطه بين محللين فرنسين والكاتب الجزائري الكبير ياسمينة خضراء، وهنا تجلى التاريخ في أوضح تشابكاته بين الأصوات المتحاورة، حيث في الوقت الذي استمات فيه المحللان الفرنسيان في إدانة النظام الجزائري واعتباره سبب ما آلت إليه العلاقات الجزائرية الفرنسية من وضع غير مسبوق في التأزم بلغ، باستدعاء فرنسا لسفريها من الجزائر، حد القطيعة الدبلوماسية، بقي ياسمينة خضراء يسعى إلى النأي بنفسه عن إصدار الاحكام أحد من غير وزير داخلية فرنسا برونو روتايو، والإصرار على أنه كاتب وروائي وليس سياسيا، طبعا فهو يكتب بالفرنسية التي لم يترك فرصة للظهور الإعلامي حال كل إصدار له إلا وكال لها المديح والتقديس لأنها ببساطة مكنته، كما يقول، من العالمية، وبالتالي فعنصر الثقافة من خلال عامل اللغة يتضح، من المأزق الذي وجد الروائي ياسمينة خضراء نفسه فيه، يحكم ويحسم كما كان الحال مع الضيفين المؤيدين للرواية الرسمية الفرنسية، على اعتبار أن اللغة ينظر بها إلى ذاته هي ذاتها التي ينظر بها إلى الآخر، وعليه فإن حالة الانفكاك التاريخي التي هي من أبرز ما يمكن استثماره في راهن الازمة بالواقعة بين الجزائر وفرنسا، يجب أن تمتد إلى أعماق المغيارة التي قامت عليها الثورة التحريرية من أبرز عناصرها العنصر الثقافي وعلى رأسه اللغة، وهو المسار الذي بدأ فعليا الآن بالتحول في عالمية اللسان من الفرنسة إلى الإنجليزية بدء بدور المعرفة ومؤسسات التعليم على أن يمتد ذلك إلى الاعلام لاحقا.
الاستفتاءات والتجييشات
حالة ياسمينة خضراء ومأزق التبعية اللغوية والثقافية في حسم الموقف حيال الأزمة الدبلوماسية الجزائرية وسرعة إدانة المتسبب فيها مثلما فعلا محاوراه على بلاتو قناة أر تي آل، تفسر لنا الأساليب التي تستعمل في الضفتين المتوسطيتين في التعامل أو بالأحرى التفاعل مع الأزمة، أين تقوم وسائل الإعلام الفرنسية بالتجييش عبر الاستعانة بخطاب عنصري يميني متطرف لا يقف عند حد إدانة الجزائر بل وإدانة الصوت الفرنسي المستقل أو الموضوعي أو الذكي فيها، ممن يرفض التصعيد مع الجزائر، وبالموازاة يحرص هذا الاعلام على أن يظهر فعاليته من خلال الاستفتاءات القاعدية التي يجريها في كل مرة كي يظهر الشعب الفرنسي ماضيا في التأييد لمسار نظامه السياسي، في مقابل بقاء الجزائريين منفعلين على منصات التواصل الاجتماعي يدافعون عن الموقف الرسمي باعتباره موقف وطني، من دون الإيغال في جوهر ما أشرنا له من مراحل الخلاف بين البلدين.
إذن فالأزمة الحالية في العلاقات الجزائرية الفرنسية والتي ستجد لها دون أدنى ريب نهاية طال أمد أو قصر، كما كل الازمات التي عرفتها الدول، باتت تقتضي حالة من الفهم والوعي ومن التعامل الجديد لدى الجزائريين، وأن لا يظل عامل الزمن واجترار الاطروحات القديمة الانفعالية في التفاعل مع طبيعة هذه الازمة وبالتالي عدم الاستفادة منها في التأسيس لوعي جديد بالنطاق الدبلوماسي كنشاط حيوي ومصيري لاستمرار الدولة واستقرار الامة، فما ظهر بجلاء في هذا المعترك المحموم بين الطرفين هو قدرة الطرف فرنسا على حشد كل قواها المؤسسية والفردية لتعبئة الراي العام الفرنسي وجعل القضية قضيته، والتواري بها، بالتالي، عن النقد المتعلق بفشل منظومة الحكم عن إدارة الملفات المتعلقة بيومية المواطن وكذا توجهاتها حيال عديد القضايا الدولية التي خسرتها منها مناطق النفوذ التقليدي في افريقيا، والمسألة الروسية الأوكرانية، في مقابل ذلك بدأ الجزائريون يعاودون الكرة بإظهار الحماسة الوطنية التي تميزهم عن غيرهم في حدتها واتقاد جدوتها، من دون استحضار لسؤال العقل وأعمال بمبضعه بغية بلوغ فهم جديد للمسألة الفرنسية الجزائرية يقود حتما إلى أفق جديد.
بشير عمري