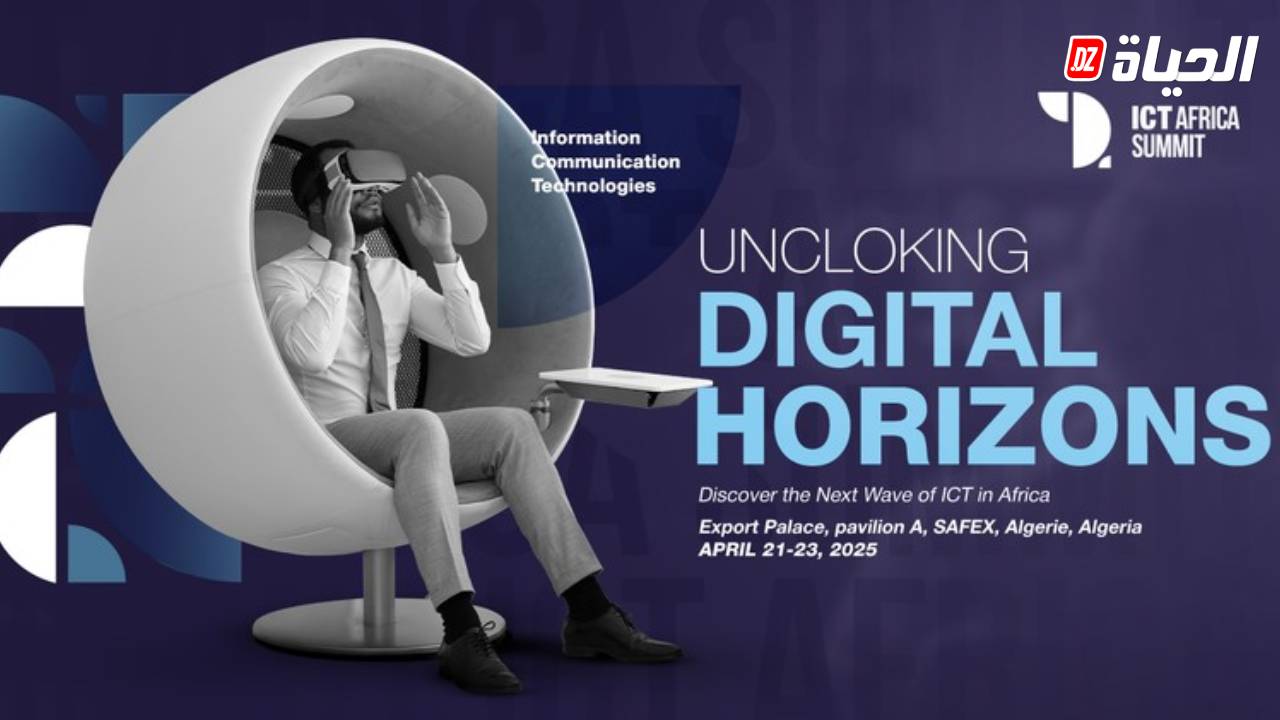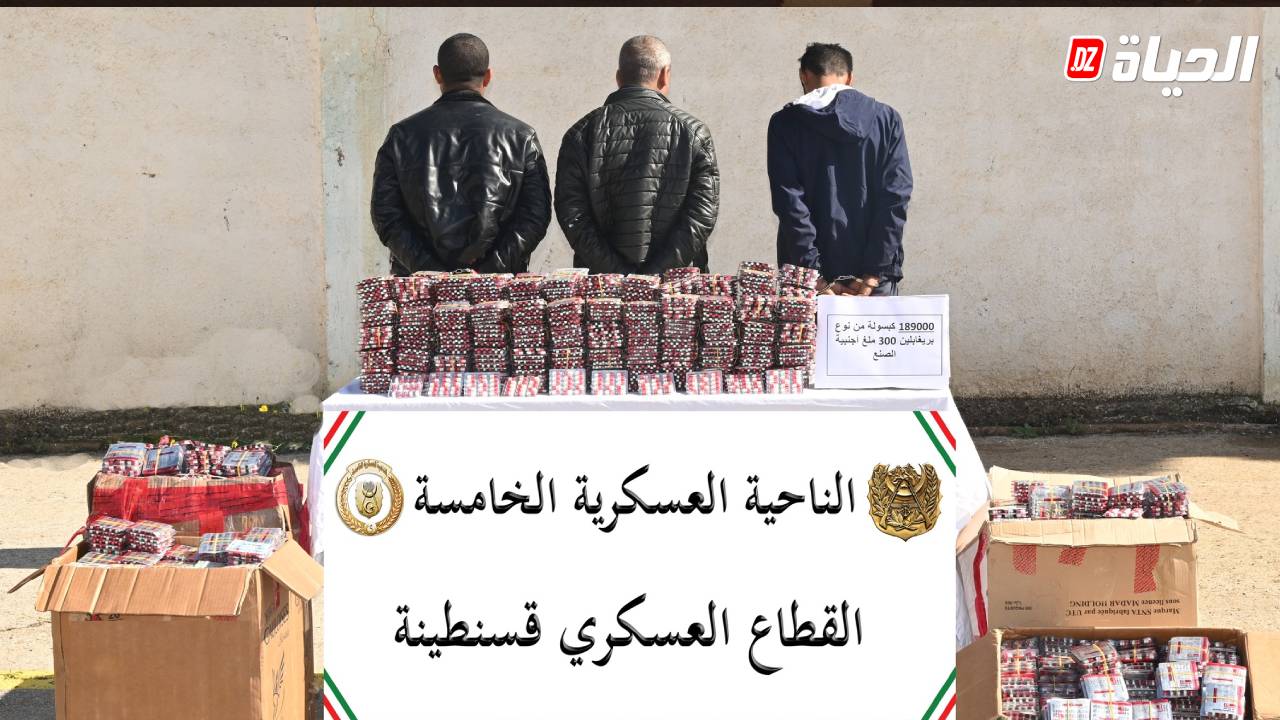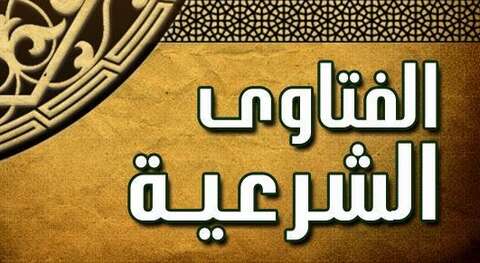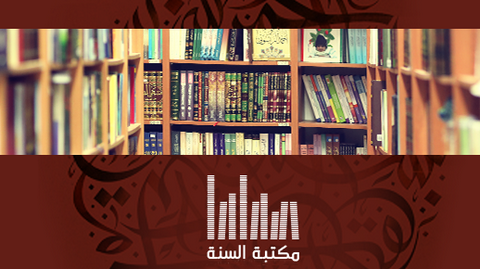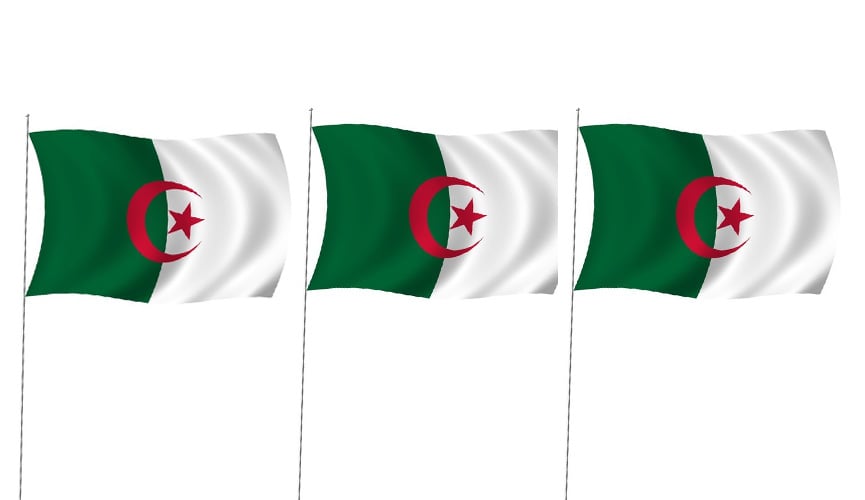في كسر الاحتكار النظري للتاريخ
عادة ما يغيب عن بال بعض المهتمين بالوضع الدولي ومتقلب قضاياه، أن مسألة رهانات القوة كأساس للصراع فيه، إنما هي، من قبل ومن بعد، نتاج قوة “الاقتراح النظري” والفكري، والعقل الذي ينتج ويسوق فكره هو الذي يمسك في الأخير بتلابيب التاريخ ويتربع على عرشه، لهذا تُرى اليوم الأمم ذات السيادة والقدرة العقلانية في التاريخ، دائمة …

عادة ما يغيب عن بال بعض المهتمين بالوضع الدولي ومتقلب قضاياه، أن مسألة رهانات القوة كأساس للصراع فيه، إنما هي، من قبل ومن بعد، نتاج قوة “الاقتراح النظري” والفكري، والعقل الذي ينتج ويسوق فكره هو الذي يمسك في الأخير بتلابيب التاريخ ويتربع على عرشه، لهذا تُرى اليوم الأمم ذات السيادة والقدرة العقلانية في التاريخ، دائمة في محاولة تعزيز أطروحاتها و رؤاها وأفكارها، باعتبارها حاجة لبقائها النموذجي في الريادة الحضارية وهيمنتها على باقي الشعوب والأمم ذات المرجعيات الحضارية الأخرى.
وإذا سلمت جدلا بواقع هذا التمايز في المقترح النظري، الذي يجعل العالم لا يتجدد ويتفسر إلا من خلالها، بدء بالليبرالية، والاشتراكية، والفاشية، فإننا سنكون حتما بإزاء الإقرار بهيمنة أقلوية على كثرة عالمية تمتد بجذورها في عمق الحضارة والتاريخ، ما يفرض السؤال الحتمي حول أسباب هذا التشكل في المقترح النظري الحضاري، الذي اختزل العقل البشري في ما ينتجه العقل الأبيض أي الغربي دون سواه، فما الذي يبقى على تغييب صوت الدوائر الحضارية الأخرى في الإسهام النظري واقتراح بدائل يكون من شأنها، ليس فقط التغيير من وجه البشرية، وإنما أيضا فك الهيمنة الفكرية المطبقة على الوعي الوجودي السياسي للشعوب والأمم غير الغربية في العالم؟
حيال هذا موضوع مستشكل بأسئلة عميقة تروم خلخلة المفاهيم السائدة حول التجارب النظرية التي قيدت الزمن السياسي والحضاري للإنسانية منذ قرون، يجدر بنا في هاته الورقة البسيطة افتراض أن التاريخ تشكل بالقوة وقوة الفكرة لا يمكنها لوحدها أن تحفظ لنفسها فرصة الانبساط والديمومة إذا لم تصاحبها القوة المادية وهو ما يعجز العقل غير الأبيض اليوم لا سيما منه العربي، بالرغم ما ينهض عليه من تراث تاريخي في السياسة وسياسي في تاريخ يمنحه القدرة على أن يبت في حال مستعصيات فكرية، يرقى به إلى الاسهام النظري فيما لو أمتلك القوة التي لا محيد عنها، كما أشرنا، للاعتراف.
الاحتكار الأبيض للتاريخ
لقد اعتبر أليكسندر دوغين أن الغرب بهيمنته الثقافية والفكرية على العالم (والتي لم تكن كلها مجردة وغير كدعومة بألية القوة كرستها خاصة حركة الاستعمار) قد انفرد بسلطة الاقتراح النظري كآلية وقانون لتفسير التاريخ وتشكيل ملامحه للناس، حتى أنه لم يعد ثمة من نموذج انساني في الاجتماع والسياسة والاقتصاد قادر على أن يتراسم في مخيال العالم، غير ذلك الذي يقترحه لا بل يفرضه الغرب بما امتلكه من قوة رخوة كانت أم صلبة، وهذا الاستفراد بالقدرة والحق في الاقتراح النظري، من يقف خلف المشاكل التي تعانيها الإنسانية اليوم، في جميع مجالات الحياة، ما دفع أليكسندر دوغين إلى اقتراح ما أسماه بالنظرية الرابعة التي تستكمل ما غفلت عنه النظريات الثلاث الأخر.
طبعا لسنا هنا بصدد دراسة نظرية دوغين الرابعة تلك التي تدفع بالتجربة الروسية كأساس نموذجي للنظرية تلك إلى الامام، وإنما لنعرف سبب العجز الإسلامي والعربي عن الإسهام النظري في تفسير التاريخ واقتراح ما يلزم من فكرة لإعادة تشكيل المشهد الحضاري لهاته الإنسانية، واجتثاث الهيمنة الغربية على العقلانية فيها.
الأزمة مع التراث كعنصر إنتاج البديل
إن من أهم أسباب التخلف العربي والإسلامي اليوم، والتي ما فتأت نخبه ونخب غيرة تشير إليها، هي عدم القدرة على قراءة الذات خارج سلطان وسياج التراث، وما نجم عن ذلك من احتباس حضاري لهذا العالم، كان من مر نتائجه، حالة الفوضى الحالية وعدم القدرة على تحقيق النهضة المنشودة والمأمولة من قبل كل شعوب العالم العربي والإسلامي.
في هذا التحديد لعنصر التخلف، إقرار بأن عملية تأمل التراث وفهمه لم تتأتى للعرب والمسلمين بعد، وبالتالي فهذا التراث المتهم بكونه عائق الامة نحو التطور لم يكشف كلية عما يحتمله من عناصر غير معيقة للعقل، طالما أنه لا يزال قادرا على شد هذا العقل، لا بل والتوفق عليه في عملية التفاعل مع الواقع ومع معطيات التاريخ، ذلك لأن أي تجاوز للتراث من غير تسوية تأتى عقبى فهم وتأمل كامل له، سوف لن تكون سوى مشكلة أخرى مستقبلية للعقل,
إن ما يواجهه العقل الغربي اليوم من أزمات متعددة الابعاد، ومتشابكة الأزمنة، خصوصا في سياق استكمال مشروعه الهيمني على التاريخ، إنما هو، فيما يبدو لنا، آت من حسابات الماضي، حيث تم التشكل على فرضية القطائع غير ذات التأسيس المرجعي، فالاعتماد على فرضيات الفلسفة المادية باعتبارها أداة التفسير الوحيدة للتاريخ، أوقع العقل الغربي، فيما يبدو اليوم، في حالة اغتراب سياسي وجيوبولتيكي في سياق ما اعتقد أنه نهاية الإنسانية في أرقى محطاتها التاريخية والزمنية وهي العولمة.
فعندما يأتي دونالد ترامب على هرم الغرب، بمشروع مناهض للعولمة، فهو يكون بذلك قد سدد ضربة لانسيابية العقل الغربي وسعيه لاقتياد التاريخ إلى حيث التسليح والتسليع بل والتجنيس (الجنس) مثلما أشارت إليه عالمة الاجتماع اليهودية إيفا إليوز فيما سمته بـle capital sexe, la fin de l’amour كاشفة من خلاله على ما سبق وأشار إليه المراحل عبد الوهاب المسيري من مسعى لـ”حوسلة” الانسان أي تحويله ليبراليا ورأسمالياً، من مركز الوجود والوعي، إلى مجرد وسيلة من وسائل التاريخ في بعده المادي.
فترامب نبذ وراء ظهره المشروع الغربي ذي الأصول الأوروبية الذي أريد من خلاله الانتقال من مرحلة غربية للتاريخ إلى مرحلة أخرى تتسم بالسيولة الكاملة، يُفتقد فيها الإنسان بوصفه مركز الوجود والوعي من خلال ما طالته من تغيرات، تتعلق بما بعد الإنسانية le Trans humanisme والمثلية وزووفيلية وغيرها من مظاهر الفلتان الإنساني التي ظهرت مع تطور وحدة العلوم وإخضاع الإنسانية لقوانينها، وهو ما بات يتهدد العنصر الغربي باعتباره حقل التجارب تلك، على ضوء ما أبدته البشرية في باقي ثقافتها من مواقف رافضة ومعارضة لذلك، وعليه فقد أصر ترامب على أن تقطع أمريكا مع هذا التمشي الغربي الأوروبي في مشروع إعادة تشكيل الانسان، معيدا شعبه وبلده ومؤسساته إلى الارتباط بعناصر الذات الأولى الثقافية والدينية والحضارية ككل.
لا يمكن فهم هذه الإرادة الترامبية في مخالفة الحلفاء الأصلاء لبلده، سوى من كون ذلك السبيل الوحيد لامتلاك المناعة التاريخية والقدرة على مواجهة شرق متقحم متقدم لقيادة البشرية وفق قيمه غير التدميرية لعنصر الانسان، ونعني به هنا الصين والعالم الإسلامي من وجهة نظر أخرى تعلق أكثر بالمحافظة الفطرية لا غير.
كما لو أنه ثمة وعي جديد بأمريكا بشأن مخاطر الاستمرار في المضي على نهج الأوروبيين في عملية صياغة الإنسان ما بعد الحداثي وتقديمه على أساس أنه النموذج الذي يعبر عن حاجة العصر المتقدم، فيما تبرز جهات أخرى في الصراع على مقود التاريخ، مستمسكة بنموذج الإنسان المتأصل في فطرته المستقوي بها، الذي يضمن بطبيعته وفطرته استمرار النوع والثقافة لأمته ودائرته الحضارية، فهو بالتالي تيار أمريكي، ربما كان ترامب وفريقه الحكومي على رأسه، أو كانوا عرضا من أعراضه الظرفية.
الحرية والاستقلال الفكريين
وإذا كان ليس يهم هنا اعتبار أن التوجه الروسي من خلال مقترح اليكسندر دوغين النظري الرابع، هو الذي سبب الشرخ العميق في العلاقة الغريبة بين أوروبا المتحالفة في إطار سردية العالم الحر مع أوكرانيا وأمريكا المتطلعة لوقف تقدم الصين في سباق التاريخ من خلال السعي لتجريدها من أهم حلفائها (الروس)، بالاستناد على نواقض الفكر الغربي الجديد وتفسيره للإنسان كمحور للوجود، بالتمسك بطبيعته (الانسان) الأولى، ما جعل الأمم الأخرى تنحاز إلى الطرح الروسي، أو أن البراغماتية الامريكية نظرت إلى ما هو أبعد من البقاء مع حلفاء ليسوا بالقدرة التي تتيح لهم مواجهة شرق يزحف بأشياء جديدة وقيم قديمة وعليه كان لا بد من تحديد موقف، فكان الشرخ الغربي الحاصل اليوم.
هذا الموقف الأمريكي وقبله الصياغة الأوروبية الجديدة لنموذج إنسان ما بعد الحداثة وفق منظور الحوسلة المسيرية، وما قابلها من رفض شرقي وأوراسي، يكشف على أن سوق الاقتراح النظري ليس في متناول كل الدوائر الحضارية، فليس ما يعيق الإنتاج النظري هو ضعف آلية العقل غير الأبيض، بل العكس منه تماما، لكن العقل بوصفه منتج التاريخ يحتاج إلى الدعم والحماية لكي يفرض بضاعته وبالتالي فهو يحتاج لعنصر القوة !
والقوة هنا بدورها توفر القدرة على الاستقلال الفكري أو عدم الوقوع في ما أسماه الراحل مالك بن نبي بـ”القابلية للاستعمار”، فهاته القابلية قد تفلت من الوعي لبعض الفئات أو الشرائح في بعض محطات التاريخ، ولكنها قد تغدو مفروضة على الوعي في حال اتفقد المجتمع للقوة بوصفها عنصر مناعة وحصانة للذات.
زائد القوة والاستقلال الفكري أي ضعف مستوى الاستلاب النخبي والشعبي وسقوطه أمام النموذج السائد والمتسييد، هناك عنصر إرادة المشروع الوطني، فكلما كان هناك مشروع واضح وإرادة جدية مصاحبة له تحقيقا وتوقيعا، كلما استطاع العقل الوطني أن يجد له موطأ قدم في سوق الاقتراح النظري والفكري للتاريخ، والصين اليوم تبدو نموذجا يحتذى في هذا الاطار، فهي تمزج في مركب مشروعها المجتمعي والسياسي المتماسك بين مستويات عدة، وأبعاد مختلفة، فعلى صعيد الثقافة ثمة حرص على أن تظل الخلفية الثقافية الصينية بمثابة الاسمنت الماسك لوحدة المجتمع، سياسيا لا شيء يبدو قادر على زحزحة القناعة الأحادية لسياسة البلد، أي استمرار الحزب الشيوعي قائدا للمشروع الوطني، لكن مع تحرر كبير من الارادة الأيديولوجية المتكلسة البائدة، وما يؤكد هذا التحرر هو اللجوء إلى الاقتصاد الحر كتوجه بنيوي تحتي، مكن البلد من تحقيق قفزة نوعية في عملية التجاوز الحضاري، جعلت من الصين قاب قوسين أو أدنى من أن ينفرد بصدارة الحضارة.
قوة التاريخ وتاريخ القوة
كل هذا الذي مر في سياق التحليل، ليدفع باتجاه تأكيد ما افترضناه أعلاه من أنه ثمة إقصاء لغير العقل الغربي في عملية إنتاج النقيض الحضاري وهذا سعيا لتصحيح مسار التاريخ وفق مقاربات جديدة أو بديلة من خلال ما تطرحه من رؤى وأفكار أو حتى نظريات مفسرة لهذا التاريخ ومتنبئة لأفاقه، وهذا بسبب امتلاك القوة المحققة للندية الحضارية، فالدوغنية التي على أساسها النظري يمضي مشروع بوتين الانبعاثي الامبراطوري لروسيا ما بعد نهاية الاتحاد السوفياتي، لولا الإرث النووي والقدرة على الردع الذي امتلكته روسيا الاتحادية ما كانت (نظرية دوغين الرابعة) لتجد لها مسمع في سوق الأفكار المغلقة على غير الأقوياء دون الاتقياء.
والعالم الإسلامي والعربي بعوزه لعوامل الإنتاج البديل الحضاري ذات الصلة بمشاكله الذاتية أي تلك المتعلقة بسبل تفكيكه لتراثه وإعادة قراءته قراء معاصرة، بما يفضي إلى عملية استيعاب سليمة من خلال هذا التراث للواقع ومن خلال الواقع لهذا التراث في كيمياء تفاعل مكتملة العناصر، ظل عديم القدرة على امتلاك قوة العصر التي تجعله يفرض نفسه في سوق التاريخ فكرا وتدبيرا، وظهرت نخبه وشعوبه مستلبة من الآخر ومستريبة منه بثراتها الطاغي على نظرتها لهذا التاريخ وبالتالي رهنت إرادتها لتأسيس لمشروع وطني يكون القاعدة الخلفية والمعيارية لهذا المقترح الذي يرام التأسيس له ليكون بديلا لما هو مفروض غربيا على باقي الثقافات والحضارات النائمة منها والنامية أو تلك التي تمضي باتجاه النمو كما هو طاغ في الخطابات الإعلامية والسياسية الرسمية.
بشير عمري