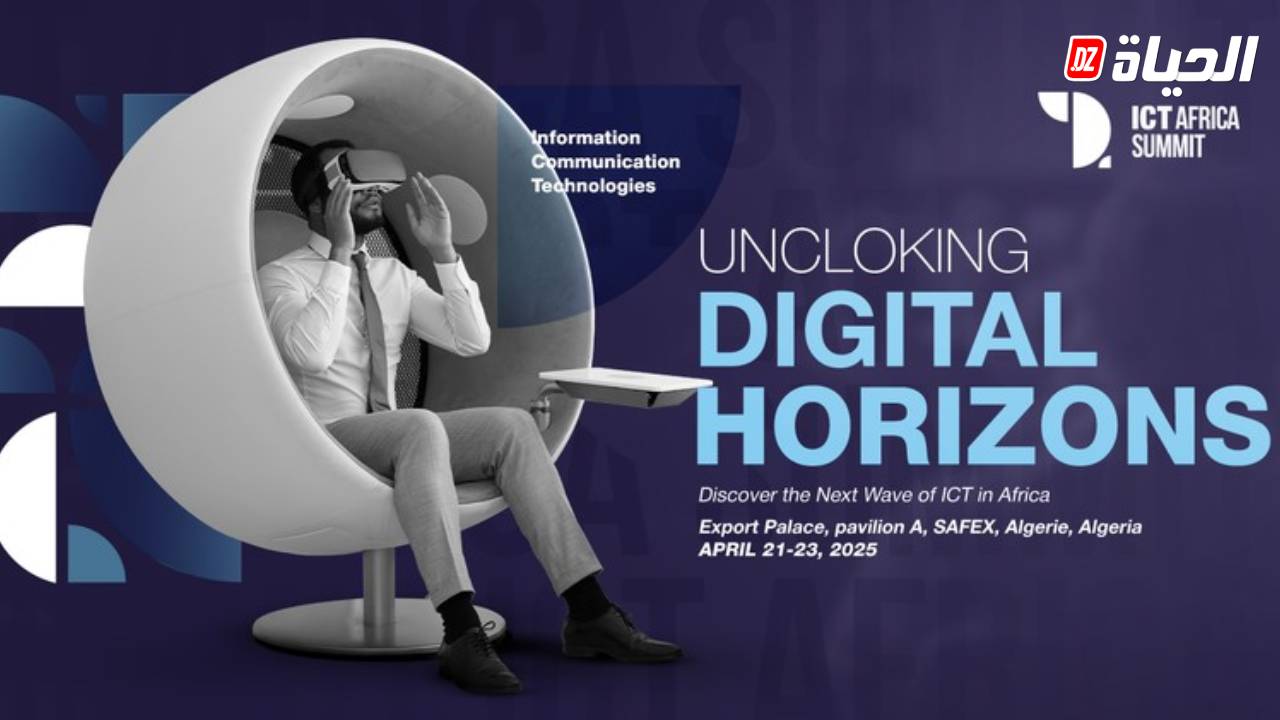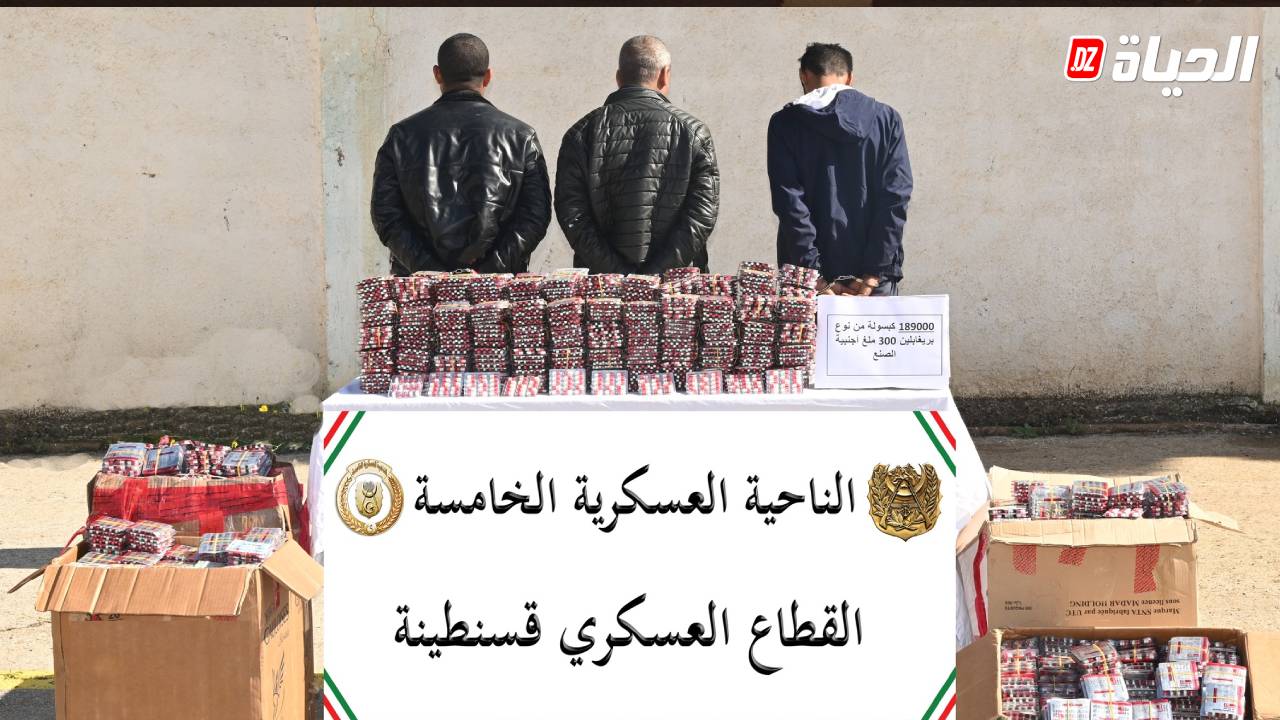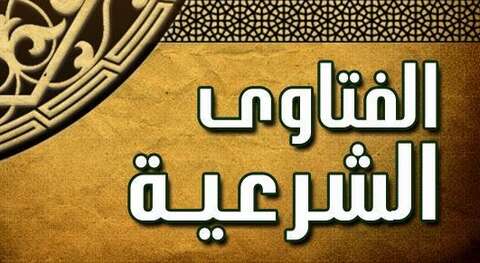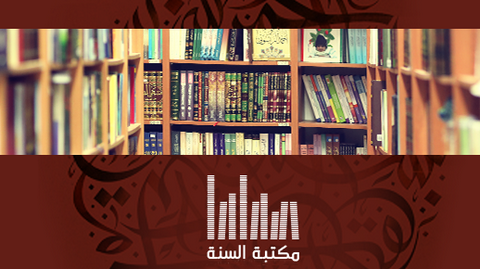البصائر تحاور الباحث والدكتور “نوح دربال”: المسلم مكلف أن يفهم القرآن الكريم بلغة عصره ولسان بيئته
حوارته : فاطمة طاهي/ في البداية أستاذ نوح دربال لو تقدم لنا نبذة عن شخصكم الكريم؟ – نوح دربال من مواليد 24/05/1987م، بقرية كرومت الصيد ولاية باتنة، حفظت القرآن الكريم على يد الشيخ يوسف مدور حفظه الله، متحصل على شهادة الماستر تخصص فقه وأصول من جامعة باتنة1، والدكتوراه من جامعة الجزائر1، تخصص فقه مقارن، أستاذ …

حوارته : فاطمة طاهي/
في البداية أستاذ نوح دربال لو تقدم لنا نبذة عن شخصكم الكريم؟
– نوح دربال من مواليد 24/05/1987م، بقرية كرومت الصيد ولاية باتنة، حفظت القرآن الكريم على يد الشيخ يوسف مدور حفظه الله، متحصل على شهادة الماستر تخصص فقه وأصول من جامعة باتنة1، والدكتوراه من جامعة الجزائر1، تخصص فقه مقارن، أستاذ مادة العلوم الإسلامية بالثانوية، وخطيب بمسجد الإمام مالك بوادي الطاقة وعضو لجنة إصلاح ذات البين بذات المنطقة، لي كتابان مطبوعان، الأول: معنون بعصر الكورونا، والثاني حجية قول الصحابي وأثره في فقه الإمام مالك.
لكم كتاب فكري بعنوان: ( عصر الكورونا – رؤية فكرية وتجليات سننية – )، حدثنا عن مضمونه وأهم المحاور التي تطرقتم إليها؟
– الحقيقة أن الكتاب كان وليد الأحداث الساخنة حينها، فقد ألفته في ظرف قياسي لا تتعدى فترة مخاضه الخمس عشرة يوما، فبعد الدخول في الحجر غير الكلي في البلاد بسبب وباء الكورونا، ازدحمت الأفكار في ذهني بين دعوة لقراءة الكتب المنتظمة في الرفوف أو المطمورة في الأدراج، وبين كتابة شيء يؤرخ للوقت العصيب الذي أقلق الساسة وأرعب الشعوب، فانتهى السجال في الذهن إلى ضرورة الكتابة والتدوين، فالفكرة الناضجة تقطف في أوانها، فإذا ما فات وقتها فإما أن تسقط في أرض النسيان، أو تتعفن في الغصن لما تتأخر اليد لقطافها في حينها.
ولم تكن كتابتي هدرا للحبر ولا تسويدا للصحائف، فقد كانت المشاعر تضطرم في الحشا لتسابق العبارات، لقد كتبت الكتاب في وقت عصيب وفي وأيام قليلة، حطمت خلالها السد المنيع بين مشاعر الرهبة والتخوف، كفرد يعيش في مجتمع تكتنفه مخاوف عدوى الطاعون، وبين نداء العقل الذي ينادي بالتبصر في التصرف، والحكمة في التحليل.
لقد كنت على يقين أن العالم سيقوم من العثرة العالمية عاجلا أو آجلا، لكن الذي يشغل الألباب هو ما بعد الوقفة من السقطة المريعة، وماهي معالم القيامة العالمية الجديدة؟ وما هو محل أمتنا وموقعها في النظام العالمي الجديد؟ وهل سيراجع العالم القوانين الخاطئة والأعراف البائدة التي كانت تسير العالم؟
– هي أسئلة حملت إجاباتها أطواء صفحات الكتاب، وشملتها مباحثه المفصلة.
هل لكم مؤلفات أخرى غير عصر الكورونا؟
– صدر لي قبل أشهر كتاب في أصول الفقه المالكي وقد وسمته بـ: (حجية قول الصحابي وأثره في فقه الإمام مالك)، فالكتاب يجمع بين التأصيل الأصولي والتفريع الفقهي، فهو بالإضافة إلى كونه كتابا يؤصل لأصل من الأصول التي بنى عليها الإمام مالك فقهه، فهو يحوي بين جنباته فصولا من النماذج الفقهية من كتاب الموطأ التي تمثل الجانب التطبيقي العملي لإعمال هذا الأصل عند الإمام مالك، والحقيقة أن الكتاب لطلاب العلم والمتخصصين في العلوم الشرعية خاصة في تخصصات الفقه والأصول.
لكم أبحاث حول التفسير المعاصر والرؤية العصرية للآيات القرآنية، فما معنى الرؤية العصرية للآيات القرآنية؟
– القرآن الكريم كلام الله المعجز، الذي يخاطب الأسماع والأفئدة على اختلاف الأماكن والأعصار، وهذه الخاصية تفرد بها القرآن الكريم وجعله صالحا لكل الأزمان، فالمسلم مكلف أن يفهم القرآن الكريم بلغة عصره ولسان بيئته، فالبدوي الذي عاش بين الشعاب والتلال في زمن الخيل والسيف قد فهم القرآن الكريم بلسان حاله ومقامه، والرجل المعاصر الذي يعيش في كنف المدنية المعاصرة والحضارة القائمة، سيفهم القرآن من موقعه، فالدعوة لفهم القرآن وعرضه على الناس بلغة العصر ليس معناه تطويع المعاني المحكمة لتتناسب مع تفكير الرجل المعاصر، أو ليُ أعناق النصوص لترويض المفاهيم في قوالب جاهزة، بل إنها نظرات من زوايا العصر لكتاب خالد المعنى والمبنى.
فتراث التفسير اليوم لم يعد يحيص الشق ويشبع النهمة، إن القرآن كلام الله المحفوظ الذي لا يجب أن نحيد عنه، وأما التفسير فهو جهد بشري لبيان مراد الله تعالى من كلامه، وتقريب للمعاني التي تعجز عنها الأفهام القاصرة، وتجلية للغامض منها حتى يكون نفاذها في القلوب أجدى، والجهد البشري لاشك أن النقص يعتريه، وأن الصواب والخطأ يتخللانه، والصواب لا يستمد كرامته من صاحبه بل من الحق الذي يكتنفه، وجهود الرجال الذين مضوا في هذا الفن جليلة ومشكورة، بيد أن تلك الجهود لا تكفي وحدها لتسد هذا الباب الكبير على مر الأعصار، بل لابد من تضافر الجهود في كل عصر بحسب احتياج عقول كل عصر.
لذلك من أولى الأولويات إعادة صياغة علم التفسير في قالب معاصر يواكب ثقافة العصر، ولسنا نقصد بذلك تطويع نصوص القرآن لثقافة العصر، ولكن بيان مراد الله من كلامه بلغة الناس التي يفهمون، وخطابهم بالكلام الذي يعرفون، وأيضا يجب تلافي المثالب التي وقعت في هذا العلم قديما، وتجاوز الزلات والمغالط التي اقترفت سابقا، وقد وقفت على كلام جليل لابن خلدون في ذلك فقال: ( وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا، إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود، والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية، فإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات، وبدء الخليقة، وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى، وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم، مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها، مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك، وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم، فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم، في أمثال هذه الأغراض، أخباراً موقوفة عليهم، وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى في الصحة التي يجب بها العمل. وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملؤوا كتب التفسير بهذه المنقولات، وأصلها كما قلناه عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية، ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك، إلا أنهم بعد صيتهم وعظمت أقدارهم، لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة، فتلقيت بالقبول من يومئذ ) .
ولعل مما نحتاجه اليوم هو التفسير القائم بيان المعاني القرآنية مجردة عن كل صبغة فقهية أو عقدية أو أصولية أو فكرية، فمجرد بيان المعاني وتقريبها لذهن المتلقي من غير ملابسة لما ذكرناه من صنوف العلوم، يجعل المعاني أكثر نفاذا في القلوب، وبذلك يأخذ الوحي طريقه إلى النفوس، وتتربع معانيه في الأعماق، وتسري أنواره في الشرايين، ولا يكون ذلك مجرد ترجيع لصدى الحروف والكلمات في الصدور بعد أن ترددها الأفواه.
إن الدعاة ورجال الدين مطالبون اليوم بضرورة الإنصات إلى صوت الشباب والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم ومناقشتهم، فما رأيك في الخطاب الديني (المسجدي ) هل يفي بالغرض؟ ولماذا لا يؤثر بالشكل المطلوب في الناس؟
– الخطاب الديني عموما يشمل الخطب والدروس المسجدية، وكذا الكتب الدينية سواء ذات الصبغة الفقهية أو العقدية أو الفكرية، فهي كلها قنوات لإيصال المعلومة الشرعية إلى المتلقي، وفي غالبها ما زالت تعتمد على الأسلوب الكلاسيكي القديم في تقديم المعلومة الشرعية.
فإذا كانت الفتوى وهي أبعد الأمور عن التغير تتغير بتغير المكان والزمان والأفراد، فكيف بالخطاب الذي في أصله هو أداة للتبليغ وليس غاية مقصودة لذاتها لا تتغير، لكن الذي حصل أن الفكر الإنساني تقدم وتغير عبر أعصار وحقب طويلة، بينما الخطاب الديني بقي مراوحا لمكانه من لدن ازدهار الفكر الإسلامي أيام قوته.
إذن فالخطاب الديني التقليدي السائد في مناب الدعوة هو ذلك الجمود الحاصل في لغة إيصال الثقافة والتعاليم الإسلامية وعدم مواكبتها للغة العصر القائمة، وهو الأمر الذي أنتج هوة سحيقة بين المتلقي والملقي وخلق ازورارا رهيبا عن التعاليم الإسلامية بسبب عجمتها وغربتها أمام المتلقي.
والخطاب متعلق بفكر الملقي وثقافته، فكلما تقادم الفكر كلما كان الخطاب مواكبا لتلك الثقافة، ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في كتابه دستور الوحدة الثقافية: ( ويحزنني أن أذكر هنا أن أعدادا كثيفة من المنتمين إلى الدين فقيرة إلى سعة الإدراك والنفاذ إلى الأعماق، وعمل هؤلاء في ميادين الدعوة يضر أكثر مما ينفع … وعندي أن علماء الإسلام يجب أن تكون لهم أقدام راسخة في كل مجالات المعرفة، وتكون إحاطتهم بالمذاهب الجائرة أكثر من أهلها ..) .
وتعد مؤسسة المسجد من أكثر المؤسسات تجسيدا للخطاب الديني التقليدي، فلا يكاد مسجد يتخلف فيه الإمام عن غيره من أئمة المساجد في طريقة إلقاء الخطب والدروس ومعالجة المواضيع، حتى أن الأمر أصبح تقليدا لا يخرق قانونه، حتى أصبح التغيير فيه غير مستساغ حتى من المتلقي ولو شعر بالملل من الخطاب القديم، إذ أنه يعتبر طريقة الخطاب اكتسبت قدسيتها من مضمون الخطاب نفسه، بل ويعتبر من غايات الخطاب.
إن الكثير من الخطباء مازالوا يلوكون فوق المنابر خطبا ألقيت في القرن الثالث أو الرابع، وأصبحت الخطب اليوم مقطوعات معروف نسقها مسبقا، حتى صار الملل هو السمة الطاغية على رواد المساجد.
لقد بلغ الأمر بأحد الأئمة لشدة نقوله الكثيرة للخطب القديمة، أنه في الدعاء دعا بقوله (اللهم انصرنا على المغول التتار ) ؟؟؟ .. إنه جنون منبري لا يليق بمقام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نجد أمثال هؤلاء ومن على شاكلته هم السواد الأعظم من خطباء المنابر، فالإسلام اليوم هو أحوج ما يكون إلى خطباء متمرسين حاملي لواء التبليغ عن الله ورسوله، يدخلون ميدان الخطابة والدعوة متسلحين بالسلاح الناجع في عصرهم، المستنهض للهمم والرافع وليس المخور لها المسكن لثورتها.
وفي مجال التأليف والكتابة مازالت الأقلام تستلهم أساليبها من محابر القرون القديمة، فعندما تتعطل آلة العقل، وتخبو جذوة التفكير، تتحرك آلات الإتباع بلا دليل، وتتوقد جذوة التقليد بغير برهان، حينها تنسخ حضارة الإنسان الحي، وتبرز حضارة الأموات الحاكمة بين ظهراني الأحياء، والتأليف على طريقة الخطاب الديني القديم مازال حبره لم يجف ومازال قلمه سيالا، فكثيرا ما نقرأ للمعاصرين وكأننا نقرأ لإنسان القرن الرابع أو الخامس هجري، وهذه ثلمة في الخطاب الديني أزرت بالخطاب الديني وحيدته عن الحياة الفكرية المعاصرة النابضة بالحياة.
لقد غرقت الأمة في لجج من الانحطاط المعرفي أيام الجمود والتقليد، فظهر لون من الكتابة والتأليف يعكس تلك الحالة من التدهور، وذلك الوضع من الجمود، فانتشرت الشروح والحواشي على الشروح ثم المختصرات وشروح المختصرات ثم اختصار الشروح، وغيرها من ألوان الكتابة السائدة آنذاك والتي ألغت آلة العقل والتفكير، وتطامن الإبداع في النفوس، وحل الجمود مكانه، وبقي هذا اللون من التأليف مدة من الزمن يطوي إبداعات العقول والأقلام إلى أن انتهى عصر الجمود والتقليد، بيد أن هذا اللون من الكتابة مازالت روحه تسري في الكثير من الأقلام لتتولد في الكتب والمؤلفات مخلفة بذلك الآثار نفسها التي كانت إبان عصر الجمود والتقليد، إن قضية خلق القرآن التي ماتت في الأفكار قبل اثني عشر قرنا مازال مواتها يُحيى في النفوس من طرف مؤلفين وكتاب، بل ويوقظون في النفوس أحقاد القرون الماضية ليشعلوا بها اختلافات كان من المفروض أن تموت بموت أصحابها، وإلا فما معنى من إحياء هذه القضية في هذا العصر وفيه من المشاغل والمشاكل ما لا يترك مجالا للعودة لمضغ خلافات القدامى.
ومن النماذج التي مازالت كتب المعاصرين تنضح بها نموذج الاشتغال بالفروع التي لا معنى من تسويد الصحائف بها، لا لشيء إلا أن المسألة موجودة في بطون كتب القدامى، فمازالت مسألة الخل مثلا تثير جدلا في الكتب المعاصرة تأسيا بذكرها في كتب الأوائل، بل وحتى تخصيص محاضرات خاصة بذلك.
وهناك لون من ألوان التأليف والكتابة في المجال الديني، هو ثقافة الردود والرد على الردود، ولو كانت الردود علمية، تتخللها مساجلات معرفية يستفيد منها القاريء لحسن الأمر، لكن أن تتحول الكتب إلى حلبات مصارعة، تستعرض خلالها العضلات الفكرية، وتعتمد فيه الطرائق الجدلية القديمة التي كان الفلاسفة وعلماء الكلام قديما يعتمدونها، فلا يخرج القاريء بشيء يفيده أو ينفعه.