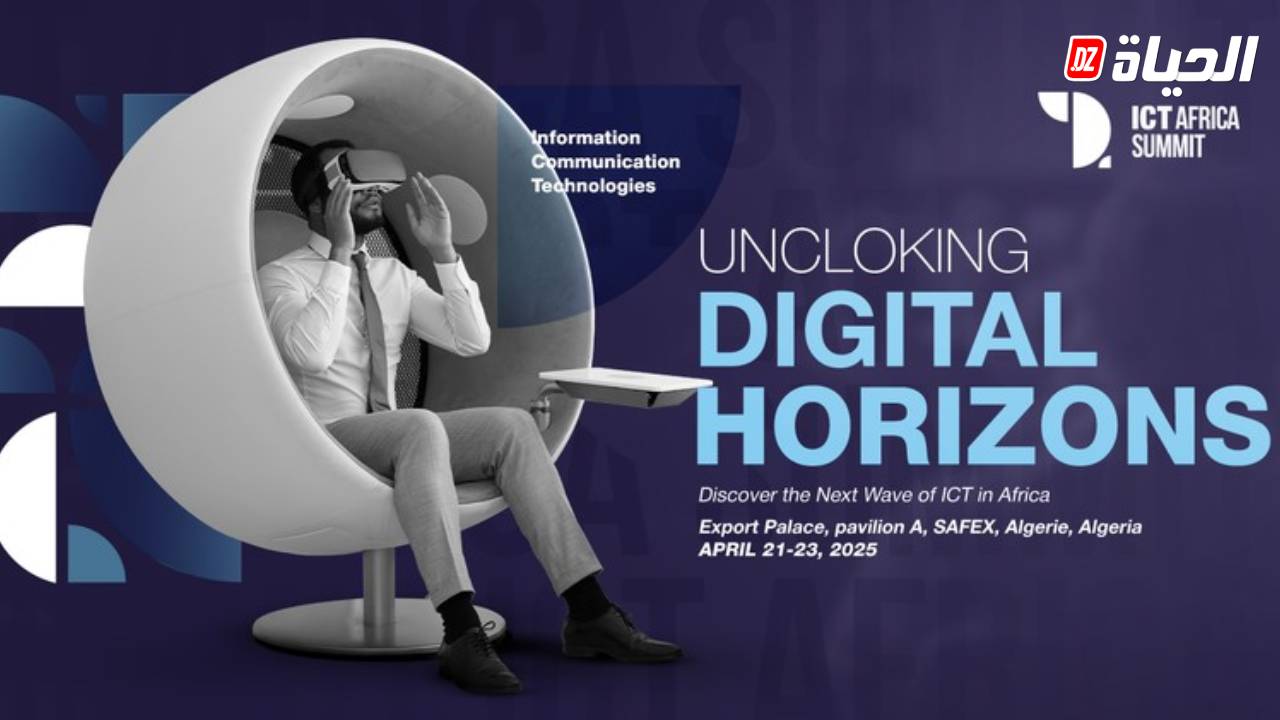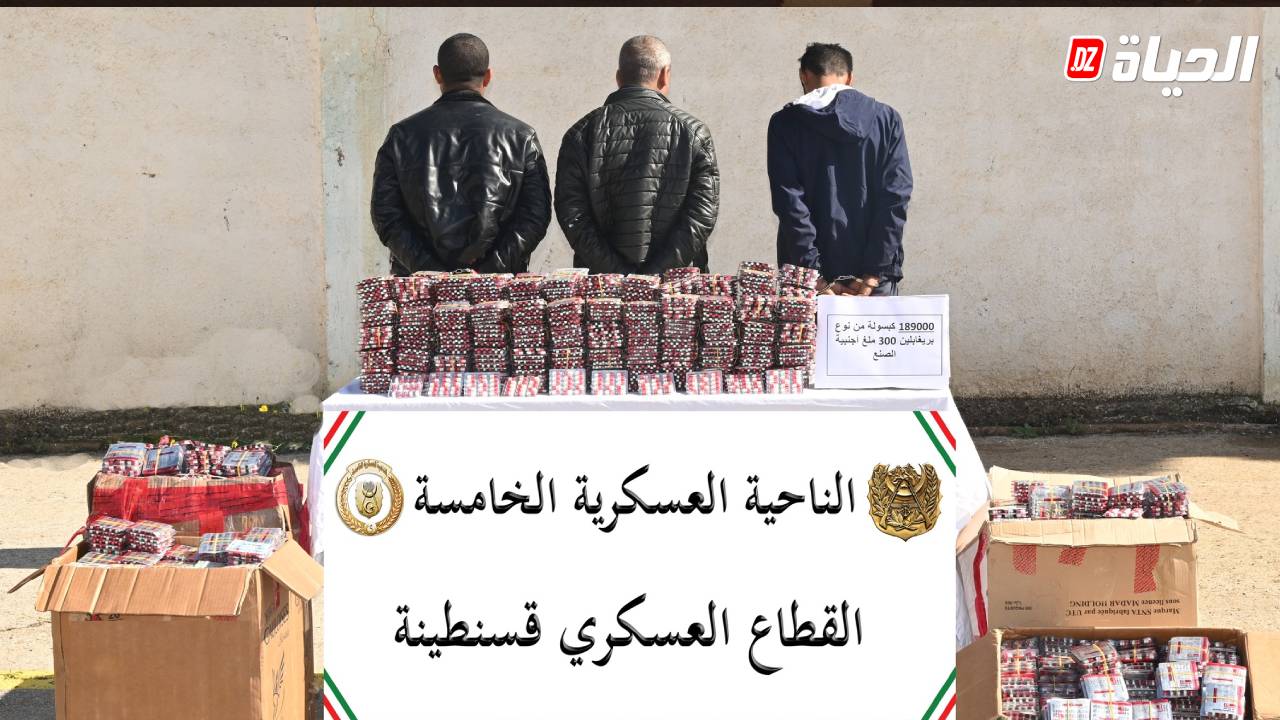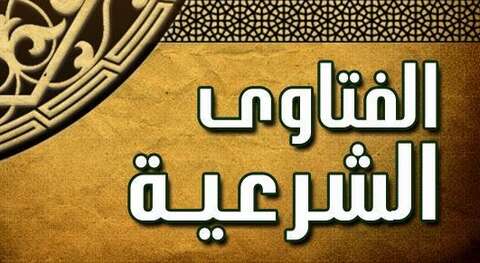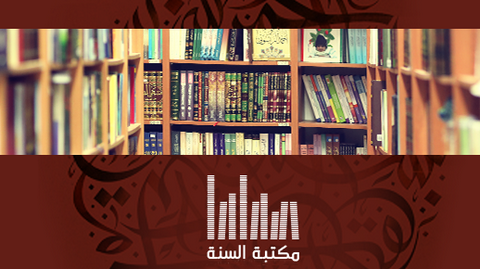التحول في مركزية خطاب العولمة
ما يثير الاهتمام اليوم في ما تداعى ولا يزال من قدوم دونالد ترامب، أو بالأحرى، عودته لقيادة القوة العظمى الأولى في العالم اليوم، هو تلك النقاشات التي لا تكاد تتوقف عن تناول تفاصيل سياسات إدارته الخارجية وأثرها على كل دول أصحاب النقاشات تلك، وهنا يبرز الغرب بحلفه العسكري (الناتو) وكتله الاقتصادية، الأكثر احتداما وازدحاما في …

ما يثير الاهتمام اليوم في ما تداعى ولا يزال من قدوم دونالد ترامب، أو بالأحرى، عودته لقيادة القوة العظمى الأولى في العالم اليوم، هو تلك النقاشات التي لا تكاد تتوقف عن تناول تفاصيل سياسات إدارته الخارجية وأثرها على كل دول أصحاب النقاشات تلك، وهنا يبرز الغرب بحلفه العسكري (الناتو) وكتله الاقتصادية، الأكثر احتداما وازدحاما في هاته النقاشات والحوارات والتساؤلات بعدما عبث ترامب بالخطوط التي ظلت راسمة لوجه العلاقات الدولية وذلك حتى في ظل ما كان يُزعم من انتشار مضطرد لظاهرة العولمة باعتبارها تجاوز حتمي وطبيعي لكل حدود المعنى في الجغرافيا والتاريخ، وقولبة العالم والإنسان في نمط واحد من الوجود التاريخي، فإذا بهذا الغرب لا سيما الأوروبي منه يكشف عن صدمة كبرى من تولي القوة الأولى بزعامة ترامب عنه وتحوله لاهتمامه تلقاء الطرف الروسي الذي يقف بعتو وعناد في وجه الحلف الأطلسي الذراع الحديدي الواقي للعالم الموسوم بالحر !
فهل يمكن الحديث فعلا عن نهاية سلطان كتلة الغرب على التاريخ، واعتبار بالتالي ذلك نقضا للعولمة التي رام مدعوها ومروجو مشروعها أنها فوق الاختلافات والتنوعات التي طبعت قصة الوجود الإنساني؟
الإجابة على هكذا سؤال متصل بعلاقة الافكار بعالم حركة الأشياء في مسار صناعة التاريخ وأفق لاكتمال معنى الوجود الإنساني، تنطرح أمامنا فرضية أن البشرية اليوم هي تقف أمام أزمة عميقة في منظورها واقع فكريها بفكرها الواقعي الذي لا يزال يقاوم في التنظير والممارسة كل النماذج العملية المفسرة للسياسة ومسارات تطورها وآليات نشاطها، حيث تبرز الديمقراطية والعولمة في اتجاه متضاد، بفعل حتميات الصراع الدولي وايقاع تمشيه.
المرونة الديمقراطية والعولمة الصلبة
وكإطار نظري أولي نسعى من خلاله لضبط مصطلحات الموضوع قيد التحليل، يجب أن حدد مفهوم الديمقراطية في سياق تمرحلات التاريخ وليس من المنظور الاصطلاحي الذي قُتل تحديدا وتوضيحا، فالديمقراطية وفق هذا الاتجاه هي معيار العصر في النمذجة التنظيمية للسياسة والاجتماع تلزم بعناصر انتشارها شمولها الجماعة البشرية على تبينها بوصفها كذلك.
في حين تعني العولمة نهاية النموذج الكلاسيكي للبشرية في الاتصال والتواصل الذي كان محدودا بعوامل ومعاول ثقافية وطبيعية والسياسية وأيديولوجية، وبالتالي تحول البشرية إلى كينونة كونية متجاوزة لكل معاني الاختلاف والتنوع التي هي من نتاج التاريخ؟
من خلال محاولة الضبط الاصطلاحي الذي وضعنا للمفهومين الديمقراطية والعولمة خارج نطاق التعريفات التنظيرية الاكاديمية الصرفة، يمكن ملاحظة أن الديمقراطية هي مشترك ثقافي وسياسي انساني، قابلة للتأويل والتفسير التاريخي وفق المرجعيات الفكرية والأيديولوجية وكل التراث الإنساني باتجاه تحقيق الاكتمال المثالي، في حين تبدو العولمة سعي لإنهاء لهذا الاختلاف والتنوع عبر فرض النموذج الغربي المادي للتاريخ بوصف المادة مدار الفكر والعقل لديه وأساس تفسيره للتاريخ.
هذا التضاد المفهومي بين البعدين (الدمقراطي والعولمي) يتجلى على الأرض من خلال سمات الصراع الدولي الذي تتمرد فيه الثقافات الخصوصية على المركزية العولمية الغربية وتمرد هاته الأخيرة على ديمقراطيتها بعد إذ اتضح أنها إما أن تكون بيضاء (الجنس الأبيض) أو لا تكون، أي أن تخدم مصالح الغرب، وتحديدا زعيمته الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن توضع ضمنيا في الثلاجة.
فترامب، حسبما ذكر البحث الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية الشهير وليد عبد الحي، في تدخله بإحدى الندوات التي عقدت مؤخرا بالعاصمة الأردنية عمان، هو أقل الرؤساء الـ46 الذين حكموا الولايات المتحدة الأمريكية، استعمالات للديمقراطية في خطاباته، وهو ما سيعمي بالضرورة أنه الأكثر، من بينهم، استعمالا للمصالح القومية الامريكية.
هذه الملاحظة، تبرز مقدار ما آل إليه الخطاب العولمي بحسبانه أمركة للتاريخ، من تحول في الآونة الأخيرة وذلك طبعا بدافع وضغط من الصراع الدولي، وبروز قوى واعدة، بات ينظر إليها بكونها المنافس المباشر للغرب في قيادة العالم، أبرزها الصين والقوى الناشئة المتحالفة معها في مشروع كسر الهيمنة الغربية ولا سيما منها الأمريكية على العالم؟
إذ يذكر الجميع كيف أن مشروع بوش الابن منذ عشرين سنة خلت كان نشر الديمقراطية في العالم لا سيما في الشرق الأوسط وذلك باستعمال القوى وتفكيك منظومات الحكم بالمنطقة عبر ما عرف بنهج الفوضى الخلاقة، والقد من وراء ذلك كله كان الإخلال بالتوازنات التي قامت على غير إعداد أمريكي، وهذا مذ نجحت الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979، ومن ثم فرض مشروع “الشرق الأوسط الجديد” كشكل جيوبوليتكي مستحدث يقفز على خصوصية المنطقة عبر اختراق ثقافي وسياسي لها يقوي وثبت وجود وأمن الكيان الصهيوني بوصفه وكيل الغرب بالمنطقة.
فكل الخطابات السياسية والعسكرية للإدارات الأمريكية السابقة كان تتمحور على جانب من القيم وبها تتدثر، مثل حقوق الانسان، استئصال الإرهاب، تحرير الشعوب من الديكتاوريات، ونشر الديمقراطية، إلى أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض الأمريكي، متجاوزا تلك الأدبيات وقاطعا مع أسلوب الخطاب من سبقوه في الإدارة الامريكية، بالكف عن الحديث في غير ما يعنى بمصالح أمريكا، والديمقراطية لديه وفق هذا المنظور، تصريحا أو تلميحا، باتت لا تليق بأمريكا وهيبتها في العالم، وأن أي شعار آخر غير تعزيز قوة أمريكا والقدرة على تحقيق مصالها القومية ليس يغدو في الابجدية السياسية الترامبية مجرد لهو من القول، وزلل في التصور والتصرف.
يتضح لنا بذلك أن الديمقراطية بمرونتها وعقلانيتها، ليست عنصرا من عناصر مشروع العولمة لا وحتى شرطا من شروطها الضرورية لتستمر في التاريخ، وأن هاته العولمة لست بدورها حاجة أو حتمية لانبساط الديمقراطية، الدليل أنه في الوقت الذي تصاعد فيه مد النقد للعولمة فكريا وتجاوزه سياسيا وسياديا لصالح المشروع الوطني والقومي كما هو الحال مع ترامب، فإن الديمقراطية لم تفقد قدسيتها ومكانتها في الخطاب العالمي.
ففي موضوع غزة مثلا، لم يتحدث ترامب في أولى تصريحاته التي تلت حفل تنصيبه على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، عن الجانب الإنساني الذي خله العدوان الهمجي الصهيوني على المدينة وساكنتها وعدد الشهداء الذي فاق الخمسين ألفا، ودمار العمرتان بها الذي كان شاملا وكليا، وإنما طرح فكرة تهجير سكانها، لتحويلها إلى منتجع سياحي كبير يدر الأموال الطائلة على أصحابه (الأمريكيين).
فمنطق التجارة والمقاولة والعقار هنا إذاً يبدو طاغيا، على نفسية وذهنية الرجل الذي قذف به الناخب الأمريكي إلى قيادة البلد ومنه إلى قيادة العالم، منطق لا يرقب في الإنسانية إلا وذمة، كما أن الصحبة التاريخية مع دول الغرب الأخرى، لم تجد لها اعتبارا في منطق المصلحة الذي يوسم مشروع ترامب وإدارته الجديدة القائمة اليوم على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أدل على ذلك من سعيه للتقارب مع الروس أكثر من أي اهتامم بتعزيز التعاون من حلفائه الاوربيين، وهو ما أوقد نارا من النقد والحنق الغربي لا يبدو أنها ستنطئ قريبا، أكثر من ذلك سارعت أصوات أوروبية من خبراء ومفكرين إلى توظيف مبدأ النهايات بالحديث عن نهاية الحلف الأطلسي الوشيكة، وهو ما قد يسرع من مسار أفول الغرب كله.
صناعة السياقة أو القدرة على القفز عليها !
إن هكذا منقلب تاريخي للغرب في هيمنته الحضارية، وسيطرته على العالم، والتناقضات التي اكتنفته، لتكشف عن قدرة رهيبة لديه في صنع السياقات، أو على أقل القدرة على موجهتها إذ حصل تم انتاجها في خارج نسقه الذاتي، ففي سياق مشروع تسويق الديمقراطية مثلا، ونشرها في منطقة الشرق الأوسط، استندت الإدارة الأمريكية على القوة العسكرية، فككت بها منظومة حكم صدام حسين في العراق، وبها أيضا مزقت النسيج المجتمعي للبلد عبر تعديل في الميزان الحكم وفق الاستقطاب المذهبي، وذلك بتقديم العراق إلى إيران، فيما سيفسر من قببل عديد الملاحظين وقتها بكونه تغيير في المعادلة الاستراتيجية لإدارة بوش الابن بالمنطقة، بلجوئه إلى خيار الاعتماد على إيران بدل العرب.
كان ذلك في سياق الدمقرطة بالمنطقة الذي اتبعته إدارة بوش الابن، أمام في سياق التطبيع، التي تلت المرحلة السابقة، فقد تم اللجوء إلى القوة الناعمة والاختراق البنيوي للمنظومة العربية الرسمية، وذلك باستعمال الإمارات كرأس القطار في ذلك التوجه، وحضور هذا البلد في كل المشاكل وبؤر السخونة بالمنطقة ليس ثمة ما هو أعظم دلالة في هذا الاطار.
فلقد نابذ الاماراتيون كل الممتنعين عن التطبيع بأن ظاهروا عليهم أعداءهم أو من يختلفون معهم حدودا وتوجها، فعلى سبيل المثال، تقع موريتانيا حاليا تحت ضغط وإغراء رهيبين من الامارات من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية، فيما فسر بكونه يدخل في إطار السعي لتطويق الجزائر ودفعها بالتالي للرضوخ للأمر الواقع والالتحاق بركب المطبعين!
أين النقاش العربي؟
الغريب هو أن كل هذا الهرج والمرج الذي خلفته مقدمة مشروع الرئيس الأمريكي، قد وجدت لها اهتماما من قبل الدوائر السياسية والحضارية في العالم، من مثلما أشرنا إليه الأوربيين الذين نسوا مجازر غزة وأوكرانيا وراحوا يتناولون مستقبل كيانهم في ظل ما أبداه ترامب من استدارة الظهر لهم وتحبيبه الدفاع عن مصالح بلده القومية، خارج الأنساق المشتركة التاريخية وحتى الدفاعية (الأطلسية) طالما أن القوة بيده، إلا العرب الذين حولهم وبأيديهم وأموالهم تتم التحولات في السياقات العامة وبالمنطقة، ومع ذلك لا رؤية ولا حديث واهتمام بهذا الأمر، لكون أفق الوعي دان بشكل كبير حتى لا يكان يلمس بالأصابع !
إن مثل هذا الغياب العربي في باحة النقاش الاستراتيجي الدولي، لأوضح دليل على طبيعة كينونتهم المتشظية المتشرذمة في التاريخ، كما ويؤشر إلى طبيعة قادم حضورهم في الصراع الدولي الذي، بالأشكال التي يتم الاعداد إلى معاركه، والتي بسببها يتم دوس منظومات القيم وأسس قيام العلاقات الدولية، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادات الشعوب والدول، كما وبسببها انكشف الزيف العولمي ومشروعه الوهمي العابر للانتماءات والتمنيات، حصور لن يكون بأحسن من مراحل التاريخ السابقة، ما قبل وما بعد الاستعمار الحديث.
الغرب والعرب والأفق القاتم
فالخلاصة إذن هي أنه ثمة تجول كبير في مركزية خطاب العولمة الذي كان يتبنى جملة من المفاهيم باعتبارها عناصر التأسيسية لهاته لمنظومة، غير أن السياق الذي مضت عليه وما خلفه من إعادة تشكيل للقوة وملامحها الجديدة في العالم، ببروز فاعلين جدد في القرار الكوني، أحدث رجَّة بنيوية في منظومة التفكير والتدبير السياسي الغربي، جعل من الديمقراطية بطبيعة تركيبها وقيامها على التنوعات والاختلافات، وهو عنصر المرونة والقوة فيها، تصادم وتضاد العولمة التي بتبضيعها وتسليعها للتاريخ، قفزت على كل عناصر الاختلاف والتنوع تلك وصارت بالتالي النقيض الظاهر للديمقراطية والمظاهر عليها.
ومثل هكذا فصل في شأن العلاقة المتباينة والمتضادة بين الديمقراطية والعولمة، التي كشف عنها مشروع ترامب المتحور عن تقاليد السياسة الخارجية للبيت الأمريكي، والمتمحور حول المصلحة القومية، بالارتكاز إلى العنصر المادي الصرف، يكشف بحق عن عمق الازمة التي يقع فيها الفكر السياسي الغربي، وهو ما يبرر تبعا لذلك هذا الانتشار الواسع للنقاش حول قرب نهاية الغرب كرائد للتاريخ والحضارة، في الوقت الذي يكشف فيه أيضا عن قتامة الأفق العربي على ضوء ما هو جار من استعداد لمعارك الصراع الدولي، كونهم بدوا، وعكس الغرب، بلا نقاش بشأن مستقبلهم، لفرط فقدانهم للمشروع الذي يفترض أن نبني على الرؤى المحددة والمعدة سلفا، ولعل هذا ما يفسر عدم قدرتهم على إدارة شؤونهم الجماعية، لإنجاح مشاريعهم الكبرى، فتكتل اقتصادي سياسي مثل مجلس التعاون الخليجي بعد أزيد من 45 سنة عن تأسيسه، لم يستطع أن يتجاوز الوظيفة التمويلية الموجهة في العلاقات الدولية، وهو الذي نشأ أصلا، بعد سنة أو أقل من نجاح الثورة الإسلامية في إيران (1980) – لم يستطع – أن يوحد العملة بين الدول الأعضاء، ولا أن يؤسس لمنظومة دفاع مشترك تفوق مبادرة درع الجزيرة التي (حمت) البحرين من مطامع إيران، في حين كان الأوروبيون قد وحدوا عملتهم، ومن بعد فترة قصيرة من قيام اتحادهم الإقليمي أي الاتحاد الأوروبي.
.
بشير عمري