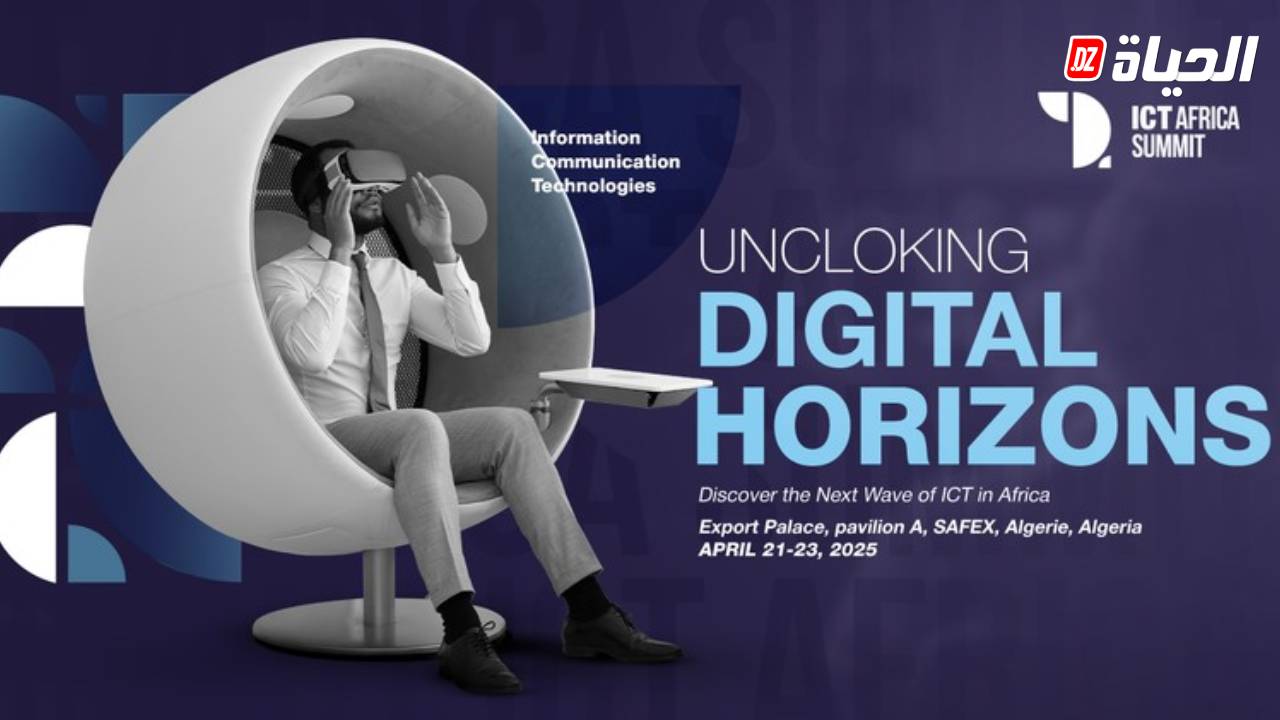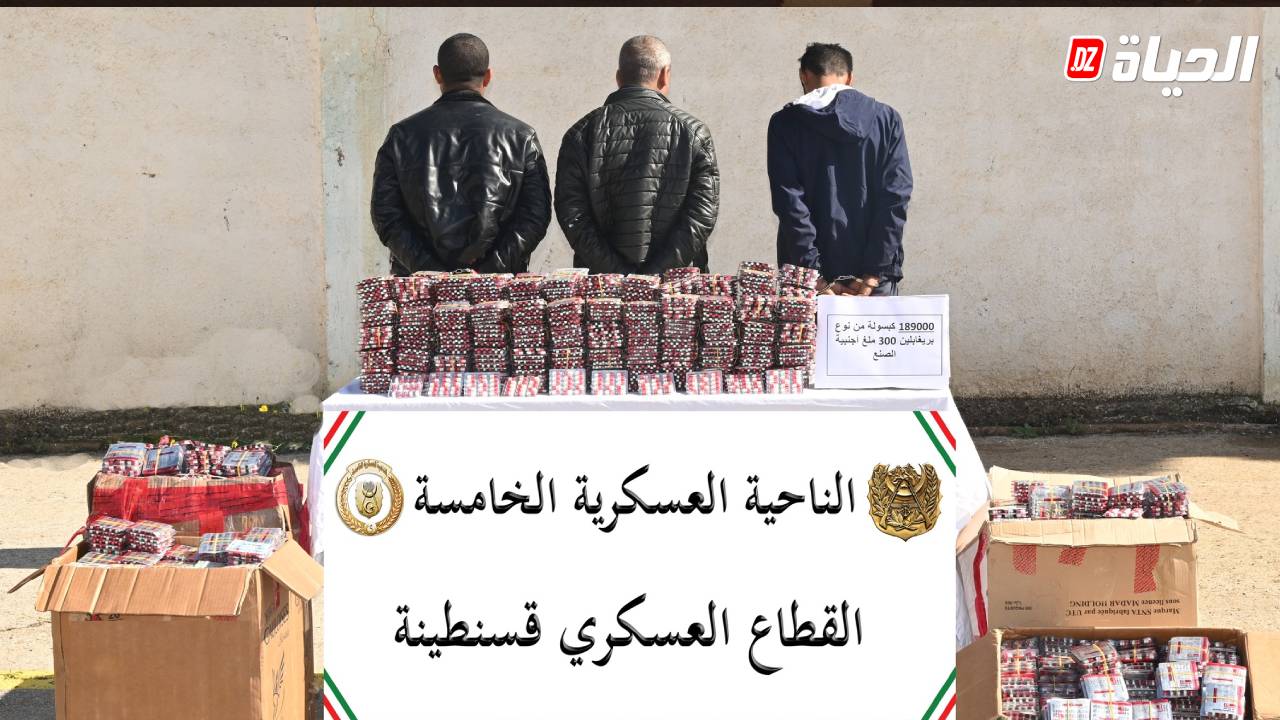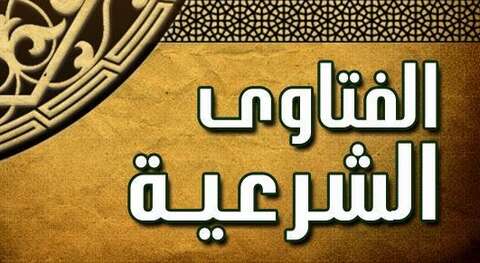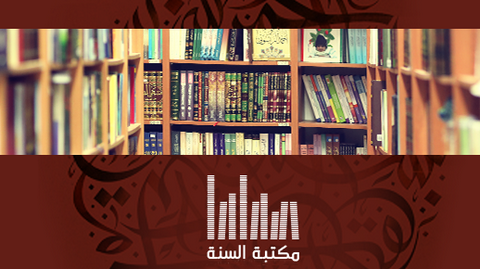نموذج من الغرور
د. مسعود صحراوي*/ كثيرٌ من الناس في أيامنا يتجرأون على القرآن العظيم ويخوضون فيه دون استجماع الأدوات، وجلهم يأخذون برأي من ينفي “مسألة الترادف” في القرآن الكريم خصوصا دون أن يبينوا ماذا يقصدون بهذا “المصطلح” على وجه الدقة، ويكثر لغطهم واختلافهم دون أن “يُحرروا محل النزاع”، ودون بيان الرؤية اللغوية/اللسانية المعتمدة ومرجعياتها النظرية وجانبها الإجرائي… …
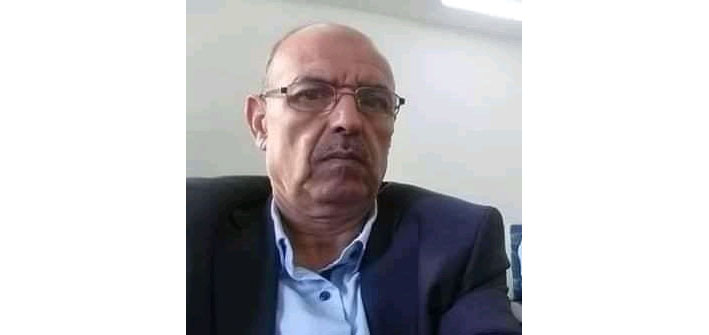
د. مسعود صحراوي*/
كثيرٌ من الناس في أيامنا يتجرأون على القرآن العظيم ويخوضون فيه دون استجماع الأدوات، وجلهم يأخذون برأي من ينفي “مسألة الترادف” في القرآن الكريم خصوصا دون أن يبينوا ماذا يقصدون بهذا “المصطلح” على وجه الدقة، ويكثر لغطهم واختلافهم دون أن “يُحرروا محل النزاع”، ودون بيان الرؤية اللغوية/اللسانية المعتمدة ومرجعياتها النظرية وجانبها الإجرائي… ومن الأخطاء المنهجية المجترحة في المسألة أنهم لم يحاولوا أن يستبينوا أي نوع من “أنواع الترادف” يَعْنُون، وأيها إليه يَقصدون، إلا قلة قليلة منهم:
-ألترادف التقريبي يعنُون؟ أم الترادف الإشاري؟ أم الترادف التام (التطابقي)؟
-وهل هذه الظاهرة اللغوية واقعةٌ في الأسماء أم في الصفات؟ أم فيهما جميعا؟ أم في شيء آخر؟
-وهل ينتج عنها بالضرورة- إذا وقعت في الصفات مثلا- أن تختلف الذوات الموصوفة؟
-وهل تباينُ الأوصاف والألقاب المشيرة إلى الشيء الواحد ينتج بالضرورة تباين المشار إليه بها؟
– وما دور “السياق النصي” في تحديد دلالات الألفاظ؟
– وهل درسوا هذه الظواهر اللغوية دراسةً وافية أولاً في لغة العرب؟ ثم في استعمالات القرآن الكريم؟
لقد أهملوا الأسئلة العلمية الأساسية المعرفية والإجرائية -إلا فئة قليلة منهم- وذلك منذ أيام الدارس السوداني الفقيد حاج حمد رحمه الله (تـ 2004م) في كتاب: “العالمية الإسلامية الثانية/ط2: 1995” لأنه هو الرائد في هذا المجال “التحديثي” ويحملون مجمل أقوالهم عنه، وكان إسهامه متقدما بمراحل بل بمسافات فلكية على المهندس محمد شحرور وعلى الذين نالوا شهرة على مواقع التواصل في المعاصرين، وقد كانت آراء أبي القاسم رحمه الله –إجمالا- أقرب إلى المعقولية العلمية والمنهجية السليمة، ومع ذلك لم يسلم من الخطإ والتحكم والاعتباطية، وسبحان من لا يُخطئ ولا يضلّ ولا ينسى، وقد كان لصاحب هذه التدوينة شيءٌ من المراجعة اللغوية (في نص القرآن) معه في حياته ولكنه لم يطّلع عليها إذْ أعجلته المنية قبل أن يُطلعه تلاميذه عليها، ثم كان لي مقال علمي(بحث) (أظن منذ ما يقرب من 20 سنة) نُشرَ في مجلة “الدراسات اللغوية” السعودية بعنوان: “دلالات الألفاظ في القرآن من منظور سياقي” في قراءة نقدية لجانب من أطروحته، وحاولت فيها أن أكون موضوعيا منصفا قدْر الإمكان ولا أدّعي العصمة والكمال، بينتُ فيه موضع الشرود المنهجي الأساسي في فهمه لبعض الآيات القرآنية والخروج عن معطيات السياق الموضوعية، وقد قصّر في اعتمادها تقصيرا بيّنا، وأشرت فيه كذلك إلى مواطن إبداعه وتوفيق الله له (إشارة بالصورة المرفقة).
ما يميّز إسهام حاج حمد عن إسهام المهندس محمد شحرور -الذي كثر عنه الحديث وحسبه المفتونون به أنه على شيء كبير من الفهم ففُتنوا به- أنّ الأول كان على قدْر وافر من “المعقولية العلمية” وذا إلمام بأدوات تحليلية كثيرة وقدْر من الانفتاح على الرأي الآخر بآيةِ أنه عَرَض “اجتهاداته” على صفوة العلماء والمفكرين آنذاك (منهم الشيخ الغزالي رحمه الله وغيره)، وعَرَضه على مفكّري المعهد العالمي للفكر الإسلامي الذي كان يُديره طه جابر العلواني عليه رحمة الله، وأُجْريَت آنذاك نقاشات معمّقة في أطروحته مع فريق من العلماء والمفكرين، وكان فيها ما يُقبل وفيها ما لا يُقبل بالنقاش المسؤول والعلم والتحقيق… بخلاف الثاني الذي هو فاقد للتأهيل المعرفي الضروري لفهم النص القرآني، وصورُ عبثه بأحكام الإسلام وقيمه وآدابه مشهورةٌ معروفة، وطريقة فهمه لبعض الآيات الكريمة تثير السخرية والاستهزاء والاستغراب “والضحك المر” أحيانا “ولكنه ضحكٌ كالبكا” -بعبارة المتنبي- على الاستهزاء بعقول الناس، وعلى تمييع أحكام الله واتخاذ تشريعاته هزؤا.
أقول: بفعل اقتحام النابتة لمجال لا يحسنونه وبفعل اتفاق حدثاء الأسنان الغرباء عن هذا المجال المعرفي مع من لا يركّب جملة عربية صحيحة، كأنهم اتفقوا عليه أو “تواصوا به”… اقتحامهم بتعجرف لمجال علمي محترم هو أمّ العلوم الإسلامية وأصلها الأصيل… فحدث بسبب ذلك التهجم على علم التفسير لغطٌ كثير وإزراءٌ بخبرة الأمة العلمية في علوم متعددة ذات صلة بالقرآن العظيم (أعني: علم التفسير وعلم اللغة وعلم البلاغة وعلوم القرآن وعلم أصول الفقه)، وتقحّموا طرقا وعرة ملتوية ذات مضايق من القول المنسوبة إلى القرآن زورا دون علم ولا هدى، بل بأفكار ساذجة وأذهان كليلة، ولعل أكبرَ خطيئة أورثهم إياها المهندس محمد شحرور هي السخرية من التراث وعلمائه وخبرته العلمية المعترف بها عالميا، ومع أننا نشهد في القرنيْن العشرين والحادي والعشرين عودة فلاسفة الغرب وعلمائه إلى تراثهم اليوناني البعيد جدا يدرسونه ويستنطقونه (شاييم بيرلمان وبلاغته الجديدة/ نعوم تشومسكي ولسانياته التوليدية التحويلية…الخ)، وهؤلاء يسخرون من خبرة أمتهم العلمية الممتدة في الزمان والمكان بسبب الجهل والغرور.
ومنهم من أصيب بما أَطلقَ عليه مالك بن نبي رحمه الله: “ذُهّان السهولة (Psychose de facilité) ” فركبوا موج الحداثة دون علم، وهي حداثة غير منخولة، واستحسنوا “الموضة المجتلبة” دون وعي، واستسهلوا الحديث في القرآن العظيم دون استجماع الأدوات الضرورية لفهم النص، حتى صار كل واحد مفتيا ومفسرا عليما بكلام الله الحكيم جل وعلا…! وغدا من لا يفرق بين عبارتيْ: “يجب ألا تفعل” و”لا يجب أن تفعل”… فقيها من فقهاء اللغة ومرجعا في النحو والبلاغة والمعجم والنص والخطاب…! فحوّلوا “العلم” “سائلا” لا شكل له ولا لون ولا طعم، ولا معالم هادية ولا مبادئ مقررة ولا قوانين محررة ولا قَسَمات معروفة، فاستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون… وأستثني من هذا بعض “العقلاء” و”الأساتذة الأثبات المتقنين”… ولله في خلقه شؤون.