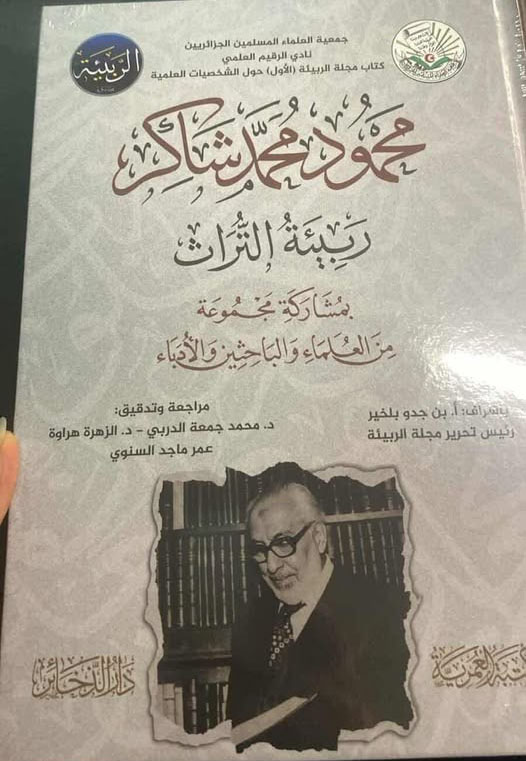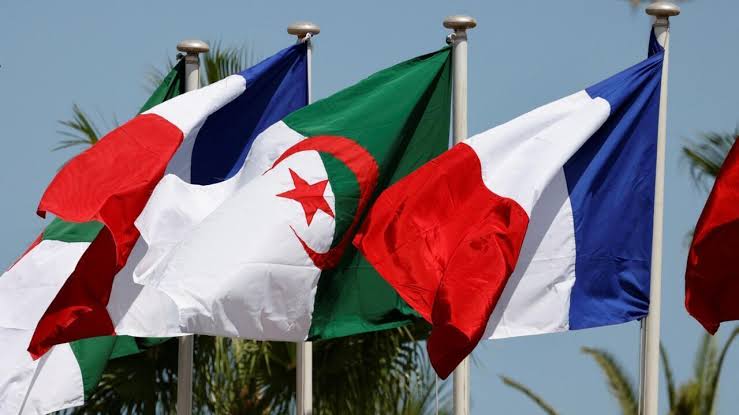يوم تساوى العالم والجاهل على منابر وسائل التواصل
د. بن زموري محمد / لم يكن أخطر على أمة الإسلام من يومٍ تساوى فيه العالم والجاهل، يومٍ جلس فيه الأحمق على منبرٍ يُزاحم به العلماء، وصار الهاتف الصغير يرفع صوت الجاهل فوق صوت الحكيم، وتحولت الكلمة في ميزان الناس إلى «إعجاب» و«متابعة» بدل أن تتحول إلى علم ودليل. هناك انقلبت الموازين، وتجرأ الصغير على …

د. بن زموري محمد /
لم يكن أخطر على أمة الإسلام من يومٍ تساوى فيه العالم والجاهل، يومٍ جلس فيه الأحمق على منبرٍ يُزاحم به العلماء، وصار الهاتف الصغير يرفع صوت الجاهل فوق صوت الحكيم، وتحولت الكلمة في ميزان الناس إلى «إعجاب» و«متابعة» بدل أن تتحول إلى علم ودليل. هناك انقلبت الموازين، وتجرأ الصغير على الكبير، وارتفع الضجيج على البيان، وامتدت الألسنة تطعن ورثة الأنبياء طعنًا وسخريةً وتجريحًا، فإذا بالأمة تسير مبهورةً بجهل، معرضةً عن نور، غافلةً عن ميراثٍ عظيمٍ هو ميراث النبوة الذي يحمله العلماء.
لقد رفع الله مكانة أهل العلم وأعلى شأنهم، فقال: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}، وقال سبحانه: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}. وجعل النبي ﷺ العلماء ورثة الأنبياء، فقال: «إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورّثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر». فالعلماء هم المصابيح التي تضيء الطريق، والبوصلات التي تهدي الأمة عند اشتداد الظلمات، وحينما يُطعن فيهم فإن الأمة لا تخسر أفرادًا فحسب، بل تخسر مرجعيتها وركائز ثباتها.
ومع ذلك، ابتُلينا في هذا الزمن بوسائل تُمكّن كل من هبّ ودبّ من اعتلاء المنابر، حتى غدا لكل واحد قناة، ولكل متعالم أتباع، ولكل حاقد سلاح يصوّب به نحو العلماء. يسقطونهم بمقاطع مجتزأة، أو عبارات مبتورة، أو اتهامات بلا بينة. بل صار التطاول على العلماء تجارة رائجة في سوقٍ مفتوح، يُكسب صاحبه الشهرة والرواج، حتى لو كان لا يملك من العلم مثقال ذرة.
وليس هذا ببعيد عما أخبر عنه النبي ﷺ حين قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جُهّالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». فهذا الحديث يكشف لنا المشهد الذي نعيشه اليوم بجلاء: حين يُهمَّش العلماء، ويُقدَّم الجهال، تتجرأ العامة على الفتيا، ويضيع الناس بين الضلالات.
ومن أخطر ما يُلاحظ أن هذه الظاهرة لم تأتِ صدفة، بل تغذيها أسباب متعددة: أولها ضعف التربية على توقير أهل العلم، فقد نشأ كثير من الجيل الجديد في بيئة لم تتذوق مجالس العلماء، ولم ترَ بأعينها كيف كان السلف يُجلّون العلماء ويهابونهم. وثانيها الجهل المركب، حيث يظن الجاهل أنه أعلم من أهل العلم، فيجادل وينكر، ويجعل من جهله معيارًا يحاكم به العلماء. وثالثها حب الشهرة والظهور، فما أسرع أن يجلب الطعن في عالم شهرةً لصاحبه، ولو لم يكن له في ميزان الحق نصيب. ورابعها الحسد والعداوة، إذ لا يحتمل بعض النفوس أن ترى عالمًا مكرمًا، فيسعون إلى تشويه صورته. وخامسها الأيادي الخفية التي تدرك أن إسقاط العلماء إسقاطٌ للأمة كلها، فتستثمر في هذه الحملات وتشعلها حتى لا يبقى للناس مرجع صادق.
والنتائج مدمرة: يسقط احترام العلم من القلوب، ويُفتح الباب لكل من يملك لسانًا أن يتحدث في أمور عظيمة، فيُضل الناس بجرأة، ويشيع الاضطراب في المجتمع. إن الأمة التي تستهين بعلمائها إنما تسلّم نفسها إلى التائهين، وتجعل قيادتها في يد من لا يفرّق بين الحق والباطل. وما أشبه حالها بسفينةٍ في بحرٍ هائج إذا استهزأ الركاب بربانها وطعنوا في خبرته، فإن مصيرهم الغرق لا محالة.
ألا نتذكر كيف كان السلف يعظمون العلماء؟ كانوا يعدّون الطعن فيهم طعنًا في الدين ذاته. قال الإمام أحمد: «لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة». وما أحكمها كلمة! فمن تجرأ على العلماء، فقد تجرأ على حمى الدين، ومن اعتاد انتقاصهم فلن يبقى له إلا سواد القلب وضياع البصيرة.
قد يقول قائل: العلماء بشر يخطئون، فلماذا لا يُنتقدون؟ نعم، العلماء بشر يصيبون ويخطئون، ولا عصمة إلا للأنبياء. لكن الفرق كبير بين النقد العلمي المؤدب الذي يقصد بيان الحق، وبين السبّ والتشهير الذي لا يبتغي إلا الإسقاط. نحن مأمورون أن ننصح العلماء كما ننصح غيرهم، لكن بميزان الشرع والأدب، لا بميزان الهوى والتشفي. فالعالم حين يُخطئ، يُرد خطؤه بالعلم لا بالهجوم، وتُبقى مكانته محفوظة لأن مكانته من مكانة العلم نفسه.
إن أخطر ما نخشاه أن تستمر هذه الموجة حتى يأتي زمانٌ لا يثق فيه الناس بأي عالم، ولا يلتفتون إلى أي مرجع، فيبقى كل واحد يأخذ دينه من وسائل التواصل، من أشخاص مجهولين، بلا سند ولا منهج. عندها تتحقق مقولة السلف: «إذا أُسقطت العلماء، لم يبقَ إلا أن يتخذ الناس رؤوسًا من الجهال، فيضلوا ويُضلوا».
أين نحن ذاهبون إذن؟ إذا استمر الحال على هذا المسار، فإننا ذاهبون إلى فوضى لا تُبقي ولا تذر، إلى أمة بلا بوصلة، بلا قائد، بلا مرجع. ذاهبون إلى زمن يقود فيه الجهال الناس كما يقود الأعمى أعمى آخر. وإذا ضاعت البوصلة، فلن يكون المصير إلا التيه والضياع.
لكن الأمل لا يزال قائمًا. الحل أن نعود إلى الأصل: أن نحيي في قلوبنا وقلوب أبنائنا توقير العلماء، وأن نعلمهم أن الطعن فيهم جناية على الدين، وأن النصيحة لهم تكون بالرفق والعدل لا بالتشهير والقدح. أن نُعلّم الجيل الجديد أن مكانة العلماء ليست تقديسًا لأشخاصهم، بل احترامًا للوحي الذي يحملونه. أن نفرّق بين من يجتهد فيصيب أو يخطئ، وبين من يتجرأ بغير علم فيضل ويُضل.
إن وسائل التواصل ليست شرًا محضًا، بل يمكن أن تكون منابر خير، إذا سخّرها العلماء وطلبة العلم وأهل الفضل لنشر العلم الصحيح والوعي الرشيد. لكنها إن تُركت مرتعًا للجهال والحاقدين، فلن تحصد الأمة إلا الفوضى. فإما أن نملأ هذه المنابر بالعلماء وأهل الحق، أو سيملؤها الجهال والأدعياء.
فلنحذر جميعًا، فإن الطعن في العلماء ليس طعنًا في أشخاصهم فحسب، بل طعن في ميراث النبوة الذي يحملونه. ومن أطفأ المصابيح، لم يبق له إلا السير في الظلام. والأمة التي تطفئ أنوارها، لن تجد غدًا إلا التيه والضياع.