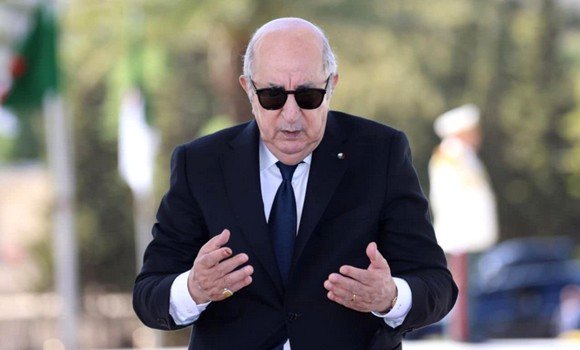«أحكام الإرث والعدل بين الجنسين: كشف المغالطات المعاصرة»
د. وهيبة بوصبيع/ يمثل مبدأ العدل بين الرجل والمرأة ركيزة أساسية في التصور الإسلامي، سواء على مستوى الخلق، أو التكليف، أو الجزاء. فالمرأة مكرَّمة، مكلفة، ومثابة، تتمتع بحقوق التملك والتصرف والتعلم والعبادة كالرجل، دون انتقاص. وفي ظل الحراك الحقوقي المعاصر، ظهرت انتقادات للتشريع الإسلامي بزعم عدم المساواة، مستندة إلى بعض الأحكام التي تختلف فيها الأنصبة …

د. وهيبة بوصبيع/
يمثل مبدأ العدل بين الرجل والمرأة ركيزة أساسية في التصور الإسلامي، سواء على مستوى الخلق، أو التكليف، أو الجزاء. فالمرأة مكرَّمة، مكلفة، ومثابة، تتمتع بحقوق التملك والتصرف والتعلم والعبادة كالرجل، دون انتقاص. وفي ظل الحراك الحقوقي المعاصر، ظهرت انتقادات للتشريع الإسلامي بزعم عدم المساواة، مستندة إلى بعض الأحكام التي تختلف فيها الأنصبة أو المسؤوليات، خاصة ما تعلق منها بتوزيع الإرث، تحديدا عند قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11]، حيث يُتَّخذ هذا النص ذريعة للطعن في عدالة الشريعة، واتهامها بالتمييز ضد المرأة. ومن هنا، يسعى هذا المقال إلى كشف المغالطات المرتبطة بفهم هذه الأحكام، وبيان أوجه العدل التي تحملها في طيّاتها.
* العدل في الشريعة لا يعني التماثل:
كثيرا ما يُخلط في الطرح المعاصر بين «العدل» و«المساواة المطلقة»، فيُظن أن اختلاف الأنصبة بين الذكر والأنثى دليل على ظلم أو تمييز، بينما الحقيقة أن العدل في ميزان الشريعة الإسلامية يعني وضع الأمور في مواضعها، وردّ الحقوق إلى أصحابها وفقا للتكاليف والمسؤوليات.
وقد أقرت الشريعة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية والجزاء الأخروي، كما في قوله تعالى: {أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى}[آل عمران: 195]، وقوله: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}[النحل: 97]، وقول النبي: «إنَّما النِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ»(رواه أحمد وأبو داود والترمذي). أما التساوي المطلق في الوظائف والأحكام، فلم يقره الإسلام؛ لاختلاف الخِلقة والتكاليف، كما قال تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى} [آل عمران: 36].
ومن هنا، فإن العدل في التصور الإسلامي أوسع وأعمق من المساواة العددية؛ إذ قد يقتضي العدل أن يُعطى أحد الطرفين أكثر من الآخر، لا تفضيلا لذاته، بل بما يترتب عليه من مسؤوليات وواجبات شرعية. فالرجل مُلزم بالنفقة، والمهر، والكسوة، وتحمل نفقات الأسرة، في حين أُعفيت المرأة من ذلك كله، حتى وإن كانت ثرية. لذا، فإن تفاوت الأنصبة في الميراث ليس تمييزا لجنس على حساب آخر، بل هو جزء من منظومة عدلية متكاملة تراعي التكليف، لا النوع.1
* معايير التمايز في الميراث بين الذكر والأنثى
الاعتراضات المعاصرة على أحكام المواريث في الإسلام غالبا ما تنبع من فهم قاصر أو مجتزأ، إذ يُتصوَّر أن التمايز بين الذكر والأنثى في بعض المسائل نابع من مفاضلة قائمة على النوع، وهذا غير صحيح. فالتمايز في الميراث لا يقوم على معيار الذكورة والأنوثة، بل على ثلاثة معايير شرعية موضوعية:1-درجة القرابة بين الوارث والمورث: فكلما كانت الصلة أقرب زاد النصيب. 2-الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة ترث أكثر من الأجيال التي تودعها، بغض النظر عن الجنس. 3-العبء المالي الشرعي: فالذكر يتحمل نفقة الأسرة، في حين تُعفى الأنثى منها، مما يفسر بعض حالات تمايز الميراث2.
ومن هنا، فإن قاعدة: «للذكر مثل حظ الأنثيين» لا تُعد قاعدة عامة مطردة، بل هي حكم خاص ببعض الحالات لا يتجاوز أربع حالات من أصل أكثر من أربعين حالة توزيع: فالمرأة ترث نصف الرجل في4 حالات فقط، وترث مثل الرجل في أكثر من 30 حالة، وترث أكثر منه في أكثر من 10 حالات؛ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل3.
وهذا التنوع في الأنصبة يعكس عدالة الشريعة التي راعت مسؤوليات كل طرف، فجعلت للمرأة في الغالب نصيبا مساويا أو أعظم من الرجل، خصوصا عندما تقل ضمانات النفقة عليها، أو تنعدم كفالتها.
* صور متكاملة من عدالة الشريعة تجاه المرأة:
وليس الإرث وحده الذي يُفهم خطأً في سياق «المساواة المطلقة»، بل تتجلى عدالة الشريعة الإسلامية تجاه المرأة في جملة من التشريعات المتكاملة التي تُراعي فطرتها وتُحقق كرامتها دون تحميلها أعباء لا تتناسب مع طبيعتها. ومن أبرز هذه الصور:
– النفقة: الشريعة أعفت المرأة من أي التزام مالي حتى لو كانت ثرية، وأوجبت على الرجل الإنفاق، كما في قوله تعالى: {وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34].
– الذمة المالية المستقلة: للمرأة الحق في التملك والتصرف المالي دون وصاية، كما في قوله تعالى: {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ} [النساء: 32].
– تعظيم الأمومة: قدّمت الشريعة برّ الأم على بر الأب، وخصّتها بالتكرار في حديث «أمك، ثم أمك، ثم أمك…» (رواه مسلم)
– حرية الزواج: لا يُعقد نكاح المرأة إلا برضاها، كما قال النبي: «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن» (رواه البخاري).
– الحماية التشريعية: جرم القذف ووضع له عقوبة مغلظة، كما في قوله تعالى: ?فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً? [النور: 4].
– طلب العلم: فرض الإسلام العلم على المرأة والرجل، وبرز في تاريخنا عدد من العالمات الفقيهات والمحدّثات.
– حق التظلم: للمرأة حق رفع الظلم والاحتكام إلى القضاء، ويكفي أن الله جل وعلا خلّد شكوى امرأة في كتابه: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ…} [المجادلة: 1].
* تفنيد أبرز المغالطات المعاصرة
أولا: الإسلام ذكوري التشريع؟
هذا الادّعاء يخالف ما قررته الشريعة من تكريم المرأة في جميع مراحل حياتها: بنتا، زوجة، وأما. فقد ضمنت لها الحقوق كاملة، وأعفتها من كثير من الأعباء، في مقابل إلزام الرجل بالنفقة والرعاية والمسؤوليات. مما يُظهر أن المساواة الشكلية ليست هي معيار العدالة.
ثانيا: القوانين الوضعية أكثر عدلا؟
القوانين الوضعية قامت على مساواة عددية تهمل الفروق في الأعباء والمسؤوليات، مما أدى إلى خلل مجتمعي. أما الشريعة فقد بنَت أحكامها على مبدأ العدل القائم على طبيعة التكليف، وهو عدل موضوعي يُراعي الخصائص والوظائف، لا عدل عاطفي يقوم على الانفعال أو ضغط الواقع.
ثالثا: القِوامة تسلّط؟
القِوامة في الإسلام تكليف لا تشريف، ترتبط بالإنفاق والتدبير، ولا تُلغي استقلال المرأة أو حقها في الطلاق ورفع الضرر، بل تحفظ لها كرامتها في إطار التكامل الأسري.
رابعا: تعدد الزوجات انتقاص من كرامة المرأة؟
قيَّدت الشريعة التعدد بشرطَي العدل والقدرة، كما قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3]. وقد شُرع لحِكَم، ككفالة الأرامل، أو معالجة مشكلة العنوسة، أو عقم الزوجة، مع حفظ حقوق الزوجة الأولى. فالتعدد في إطاره الشرعي أرحم من الخيانة أو الطلاق، وليس فيه إهانة للمرأة، بل مراعاة لمصالح المجتمع والأسرة ضمن ضوابط دقيقة تحفظ الكرامة والعدل.
خامسا: الشهادة تنقص عقل المرأة؟
الشهادة في الإسلام تتعلق بالضبط والخبرة. واشتراط امرأتين في بعض المواضع لا يعني النقص، بل هو إجراء احترازي لتعزيز التوثيق، بدليل أن المرأة تُقبل شهادتها منفردة في قضايا لا يُقبل فيها الرجل، كالولادة والرضاع والعدة. فلو كان اشتراط العدد يدل على نقص، لكان الرجل ناقصا في تلك المواضع.
وهكذا يتبيّن أن أحكام الإرث في الإسلام، وسائر ما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين، تقوم على عدالة محكمة تراعي التكليف والوظيفة، لا مجرد النوع. وإن الانسياق خلف دعاوى المساواة المطلقة دون فهم السياق الشرعي والتشريعي، يُفضي إلى مغالطات تُجتزئ النصوص من سياقها وتُشوّه مقاصدها.
الهوامش:
1 ينظر: عبد الكبير العلوي المدغري، المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير، المغرب، مطبعة فضالة، ط1، 1999م، ص137-138.
2 ينظر: محمد عمارة، التحرير الإسلامي للمرأة، القاهرة، دار الشروق، ط1، 2002م، ص68
3 ينظر: حسن السيد حامد خطاب، من قضايا الفقه الإسلامي ميراث المرأة في الإسلام، مصر، مجلة كلية الآداب بالمنوفية، العدد42، ص26، 42.