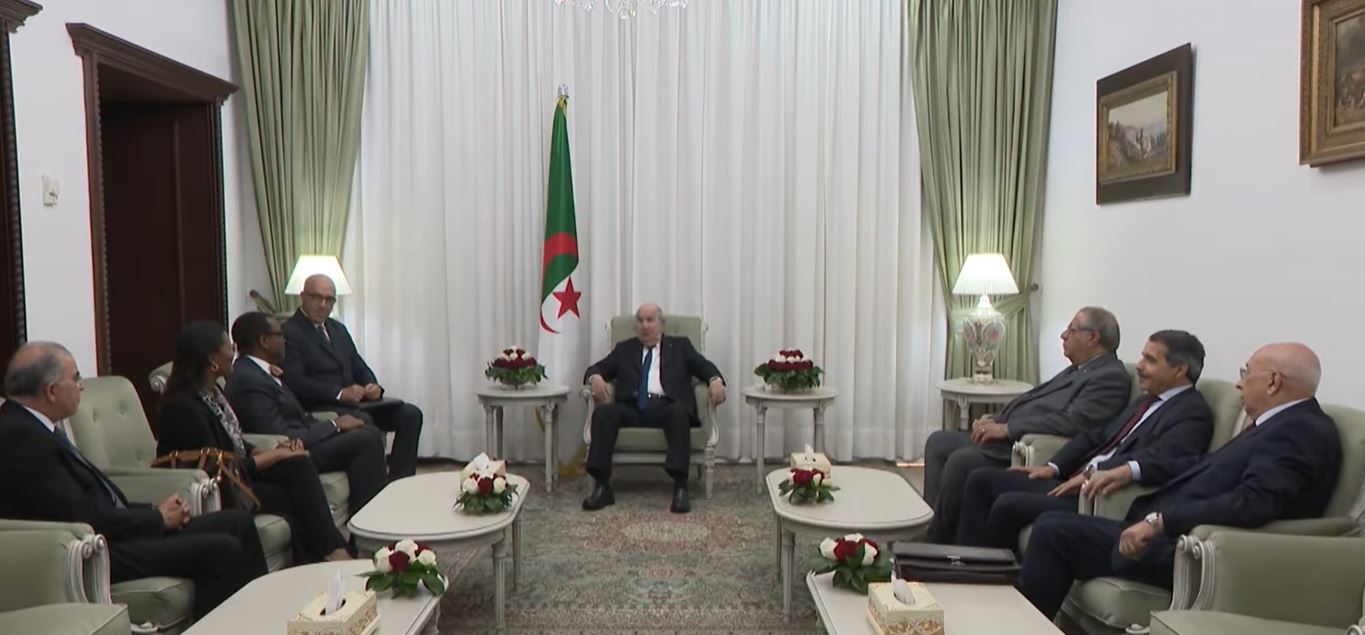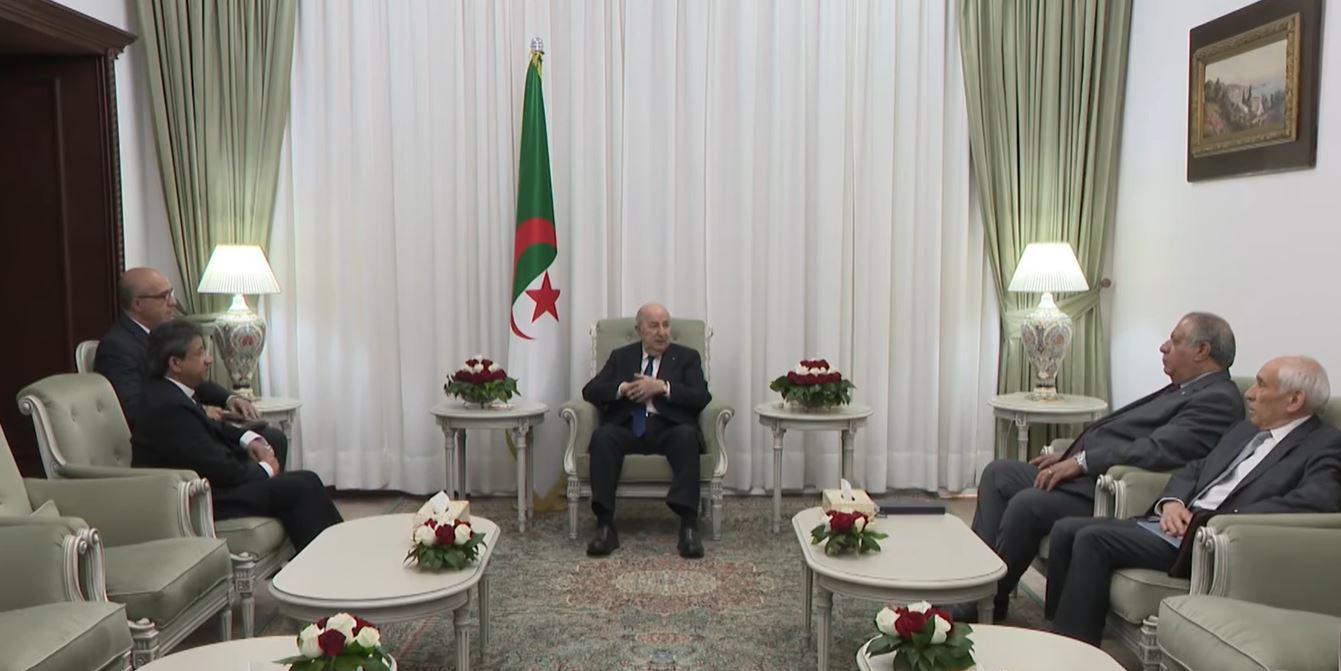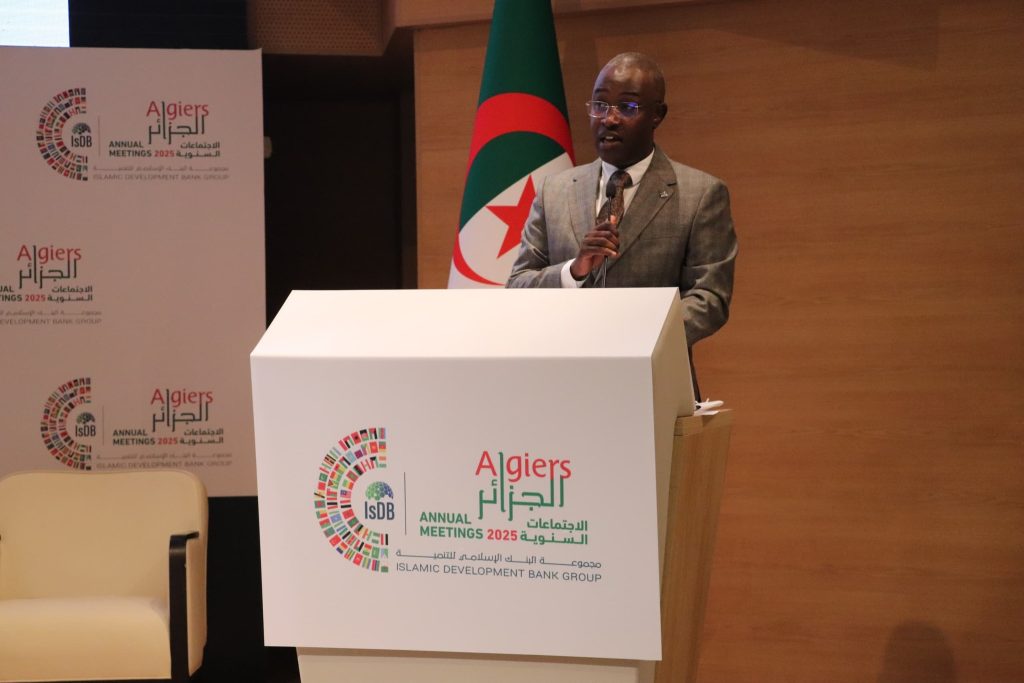منابر التواصل الاجتماعي وتشكيل الوعي الديني
أ. يمينة عبدالي/ من الملاحظ اليوم أن التثقّف والتعلم والتعليم فتحت له التكنولوجيا بابًا واسعًا تداخلت فيه المحاسن والعيوب، وبخاصة جانب التديُّن في العصر الرقمي حيث لم يعد محصورًا في فضاء المساجد أو الكتب أو مجالس العلم، بل أضحى مجال الإنترنت وخصوصًا منصات التواصل الاجتماعي؛ جزءًا لا يتجزأ من تشكيل المفاهيم الدينية وأنماط التدين في …

أ. يمينة عبدالي/
من الملاحظ اليوم أن التثقّف والتعلم والتعليم فتحت له التكنولوجيا بابًا واسعًا تداخلت فيه المحاسن والعيوب، وبخاصة جانب التديُّن في العصر الرقمي حيث لم يعد محصورًا في فضاء المساجد أو الكتب أو مجالس العلم، بل أضحى مجال الإنترنت وخصوصًا منصات التواصل الاجتماعي؛ جزءًا لا يتجزأ من تشكيل المفاهيم الدينية وأنماط التدين في العالم الإسلامي. فلقد برزت هذه المنابر كقوة جديدة في ساحة الدعوة، تملك أدواتها المختلفة من مقاطع الفيديو القصير، أو التغريدة الملهمة، أو البث المباشر، أو الرموز التعبيرية… ووسط هذا التحول، طفت على السطح تساؤلات جادة حول طبيعة هذا الخطاب الجديد، ومدى مصداقيته، وآثاره العميقة على البنية الفكرية والدينية للمجتمع المسلم. فهل نحن أمام نهضة معرفية دينية مدعومة بتكنولوجيا حديثة؟ أم أمام موجة ترويجية سطحية تنشر الوعي المشوّه باسم الدين؟ وهل الخطاب الديني هو من يقود أدوات التواصل؟ أم أن هذه الأدوات هي من بدأت تشكل ملامحه وتحدُّ من عمقه؟
أدمجت وسائل التواصل الاجتماعي في عمق الحياة اليومية، واحتلت موقعًا مركزيًا في تشكيل الآراء والتوجهات، بما في ذلك القضايا الدينية. كما أتاحت هذه المنصات للدعاة وعلماء الدين فرصة غير مسبوقة للوصول إلى جمهور واسع، عابر للجغرافيا والثقافات واللغات. غير أنّ هذا الانفتاح لم يكن بلا ثمن؛ فمن جانب صناعة الشخصيات برز ما يمكن تسميته بـ”الداعية الرقمي” وهو شخص يملك أدوات التواصل الحديثة، ويُتقن لغة الصورة والمؤثرات البصرية، وقد لا يكون لديه التأهيل العلمي التقليدي المعروف ليتصدر المشهد؛ لنلحظ في المقابل تراجع حضور الخطاب الديني الأكاديمي العميق في هذه المنصات ممكن أن خاصية الخطاب الأكاديمي لا يواكب هذه المنصات من حيث الإيقاع أو الأسلوب! فتولد عندنا خطاب جديد بمنابر جديد هذا من جانب؛ ومن جانب آخر ساعدت هذه المنابر على إحياء بعض القيم الإسلامية، ونشر الأخلاق، وتقديم محتوى توعوي ميسّر، إلا أنها في كثير من الحالات، اختزلت الدين في جرعة عاطفية، أو “محتوى ترفيهي ديني” لا يبني وعيًا، بل يُشبع حاجة لحظية.
وخاصة أن الخطاب الديني الرقمي اليوم يشكل مصدرًا أساسيًا للمعلومة الشرعية لدى فئات واسعة من المسلمين، وبخاصة الشباب. حيث أن نسبة كبيرة من الجيل الجديد لا يتلقى المعرفة الدينية من خلال المؤسسات التعليمية أو العلماء، بل من خلال مقاطع الفيديو القصيرة والبث المباشر والتغريدات الدينية. فهذا التحول له آثار عميقة؛ إذ أصبح من السهل إنتاج “نجم ديني” بناءً على أسلوبه في الحديث، لا بناءً على علمه. وهكذا تتشكل صورة “الشيخ العصري” الذي يتماشى مع القضايا الرائجة، ويُكثر من استخدام الأمثال والقصص والمواقف العاطفية. وهو بلا شك نموذج ناجح من ناحية الانتشار، لكنه قد يكون قاصرًا في نقل معاني الدين كما أرادها الوحي متدرجة، عميقة، مؤسسة على فقه وأصول… فبات من الممكن أن يكوّن المتلقي قد أخذ تصورًا عامًا عن الإسلام من خلال بضع دقائق على “تيك توك” أو “إنستغرام” دون أن يقرأ آية بتفسيرها، أو حديثًا بسنده، أو يفهم سياق الأحكام.
ولعل كون وسائل التواصل ليست محايدة بالكامل؛ فهي تفرض آليات عملها على المحتوى، وتدفع بالخطاب نحو ما هو أكثر إثارة، وجذبًا، وتفاعلًا. وهذا ما جعل بعض الدعاة يتحولون من دور “المرشد” إلى دور “المؤثر”، حيث يتتبعون ترندات المجتمع، ويشاركون في قضايا الجدل، ليظلوا في دائرة الضوء. وهذا ما أدى هذا إلى تحولات عميقة في طبيعة الخطاب الديني نفسه حيث: ازدياد التبسيط المخل في قضايا تحتاج إلى تأصيل وتدرج، وانتشار الفتاوى السريعة والجاهزة على حساب الفقه المدروس. وصعود الخطاب الانفعالي والعاطفي على حساب التحليل الموضوعي، واستخدام لغة الإثارة والصدمة لجلب المشاهدات بدلاً من الحكمة والموعظة الحسنة.
فهذا التأثر قد ينعكس على صورة الإسلام نفسه في نظر المتلقي، فيراه دينًا قوليًا بلا مسؤولية، أو دينًا انفعاليًا لرد فعليٍّ، أو دينًا خاضعًا لمزاج المنصة والجمهور. وفي ظل كثافة المعلومات وسرعة تداولها، تبرز الحاجة إلى “التمييز الواعي” عند تلقي الخطاب الديني. فلم يعد يكفي أن يتأثر الفرد بكلام مُنسقٍ أو صوتٍ مؤثرٍ، بل لا بدَّ من مساءلة المصدر: من المتحدث؟ ما خلفيته العلمية؟ هل يعتمد على مصادر موثوقة؟ هل يقود العقول نحو الفهم، أم إلى التعصب أو المداهنة؟ فالمسؤولية اليوم لم تعد تقع فقط على الدعاة أو العلماء، بل على المتلقي نفسه، الذي عليه أن يتحلى بـالوعي النقدي فلا يقبل كل ما يُقال، بل يتحقّق ويُفكر. كما أن الرجوع إلى المصادر الأصيلة ضرورة يجب مداومتها والتحقق منها وخاصة نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة وأقوال أهل العلم والتخصص. بالإضافة إلى التدرج في التعلُّم؛ فالفهم العميق لا يأتي من مقاطع قصيرة فقط! كما الإحاطة بالسياق نصف التعلم؛ ففصل المسائل عن سياقاتها التاريخية والشرعية يؤدي إلى فهم مشوّه.
لننتهي بهذا الطرح إلى ضرورة أخرى؛ وهي كيفية استثمار هذه المنابر الرقمية في خدمة الدين دون الوقوع في فخ التسطيح؟ ليكون الجواب ليس بالرفض المطلق أو القبول المطلق، بل بإعادة هندسة الخطاب الديني ليتناسب مع الوسيط الرقمي دون أن تفريط في المضمون. ولعل من عناصر بناء هذا التوازن:
– إعداد جيل من العلماء يتقنون لغة المنصات دون التخلي عن أصول العلم.
– دعم المبادرات الجادة التي تقدم محتوى ديني عميق بصيغة عصرية.
– تفعيل دور المؤسسات العلمية الرسمية في الفضاء الرقمي بقوة واحترافية.
– تربية المستخدم المسلم على الانتقاء والمساءلة وعدم الوقوع في الانبهار السطحي.
فإن كان واقعًا أن منابر التواصل الاجتماعي تفتح بابًا واسعًا للدعوة، إلاّ أنها أيضًا أدخلت الخطاب الديني في معترك جديد، حيث تُختبر مصداقيته، وعمقه، وقدرته على الصمود أمام منطق السوق الرقمي. وبخاصة أننا نعيش زمن التأثير السريع دون الوعي الحقيقي؛ فهذا الأخير لا يصنعه التأثر العابر، بل المعرفة المتجذّرة، والمساءلة الواعية، والموازنة بين الوسيلة والغاية؛ وبين التأثير والتأثر. وتبقى الحقيقة الراسخة أن الرسالة النبويّة أكبر من أي منصة، وأعمق من أن تختصر في فيديو أو تغريدة. غير أنّ الحكمة تفرض أن نستثمر هذه الوسائل بما يليق بجلالة هذه الرسالة، لا بما يخضعها لمزاج الجمهور أو إيقاع الشاشة.