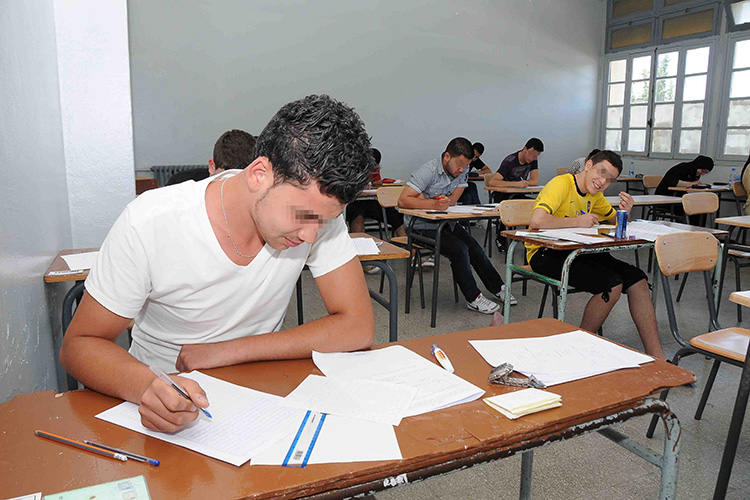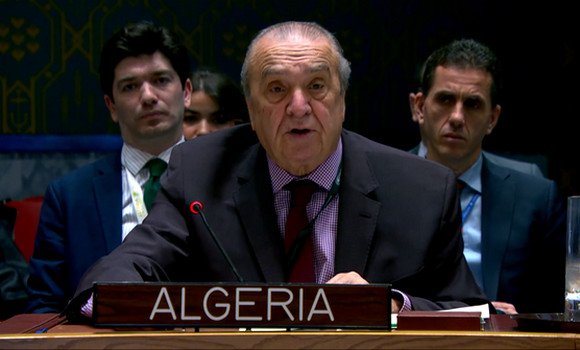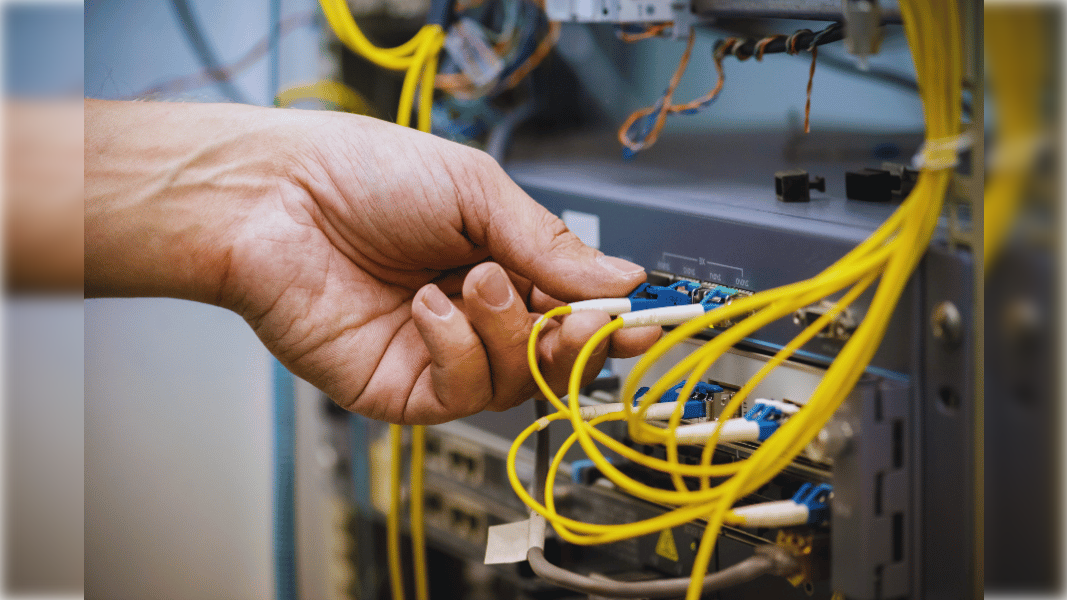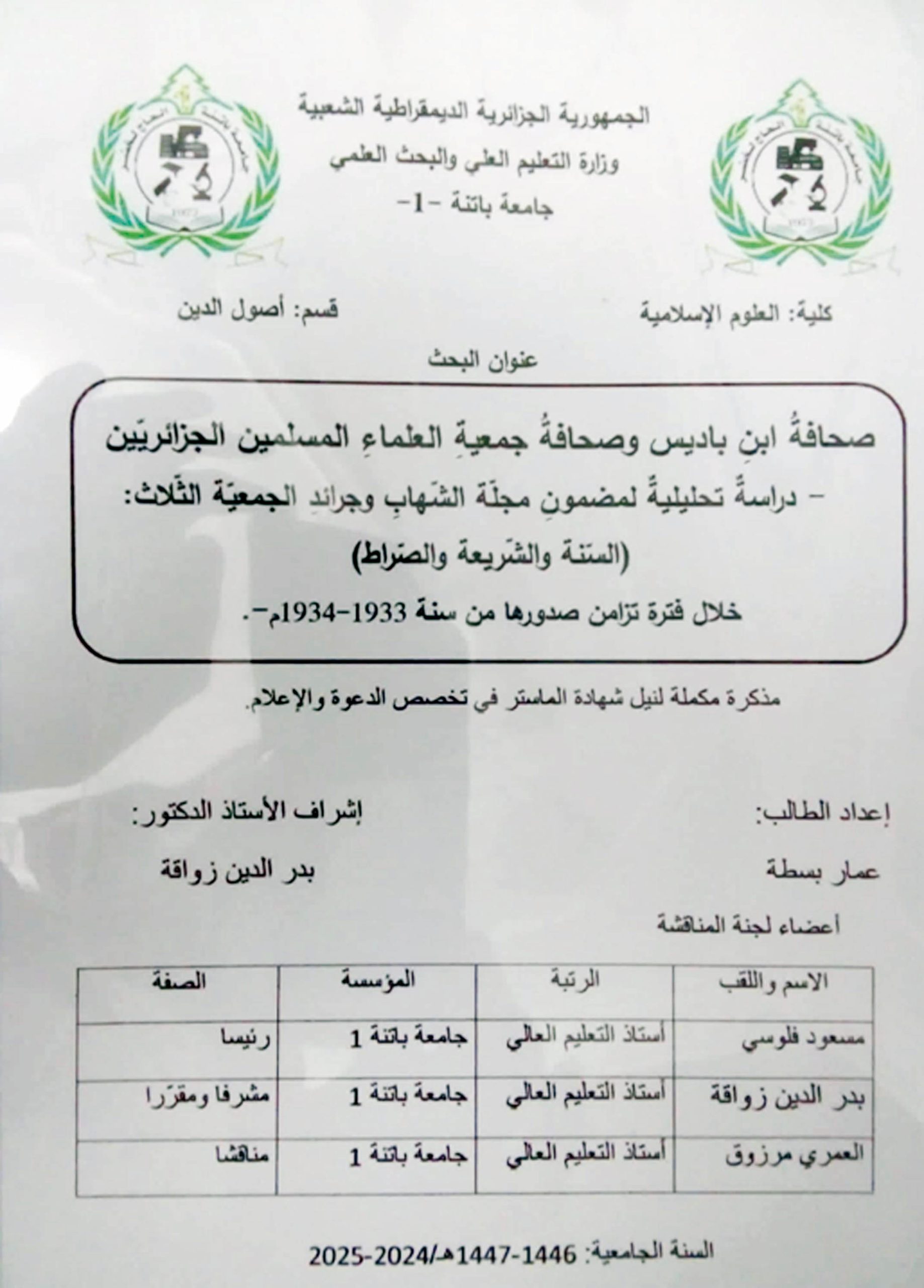الارتكاس: هروب المتعلمين من المنهج العلمي إلى الأحلام والمنامات
د. بدران بن الحسن */ مقدمة: في زمن تتسارع فيه عجلة المعرفة ويزداد فيه التنافس الحضاري على قاعدة «من يملك أدوات التفكير يمتلك المستقبل»، تبرز أمامنا ظاهرة مؤلمة تستحق الوقوف والتأمل، بل وتستلزم المواجهة والإصلاح الجاد، وهي ظاهرة الارتكاس في الكسل الذهني والجهل العلمي، تلك التي تنكشف حين نرى بعض طلاب الشريعة، أو طلاب الرياضيات، …

د. بدران بن الحسن */
مقدمة:
في زمن تتسارع فيه عجلة المعرفة ويزداد فيه التنافس الحضاري على قاعدة «من يملك أدوات التفكير يمتلك المستقبل»، تبرز أمامنا ظاهرة مؤلمة تستحق الوقوف والتأمل، بل وتستلزم المواجهة والإصلاح الجاد، وهي ظاهرة الارتكاس في الكسل الذهني والجهل العلمي، تلك التي تنكشف حين نرى بعض طلاب الشريعة، أو طلاب الرياضيات، أو طلبة العلوم عامة، يؤسسون مواقفهم وتصوراتهم ومعتقداتهم لا على أساس النظر العلمي أو التفكير المنهجي، وإنما على مجرد أحلام ومنامات، أو إيحاءات غامضة، أو خيالات لا سند لها من نقل أو عقل.
هذه الظاهرة ليست مجرد خطأ معرفي يمكن تجاوزه، بل هي انتكاسة فكرية عميقة تعيدنا إلى مراحل ما قبل الوعي، حيث تغيب أدوات التمييز العقلي، وتنعدم شروط النظر المنهجي، ويُعطَّل العقل الذي هو مناط التكليف، كما تُهدر الجهود العلمية والتعليمية وتُفرّغ من مضمونها. فما جدوى الجامعات والمدارس ومراكز البحوث إذن، إذا كان المتعلم ينتهي به المطاف إلى الإيمان بالخرافة وتقديس الوهم وتغليب الهوى على البرهان؟
أولًا: وهم الرؤى والمنامات وإلغاء منطق الدليل
من أكبر المؤشرات على هذا الارتكاس أن يقوم طالب علوم شريعة، أو من يدرس تخصصًا علميًا دقيقًا كالهندسة أو الفيزياء، ببناء موقف فكري أو شرعي على حلم أو رؤية شخصية. فبدلًا من أن يحتكم إلى النصوص المحكمة، أو المبادئ العقلية المنضبطة، أو منهج أصول الفقه الذي يدرب على النظر والاستنباط والتعليل، نراه يُعطَّل منهج أصول الفقه لصالح منامات لا ضابط لها، وتُهمّش قواعد الرياضيات من أجل خواطر مبهمة، ويُتجاهل منطق العلم لصالح الانفعالات النفسية والمخاوف المسقطة على الواقع، فإننا لا نكون أمام قصور فردي فحسب، بل أمام انهيار في منظومة التكوين العلمي والفكري. وهذا يستدعي دق ناقوس الخطر: هل نحن نُخرج من مؤسساتنا التعليمية أشخاصًا مدرّبين على التفكير والتحليل والاستدلال، أم نُنتج أفرادًا مهيئين للغرق في دوامات اللامعقول والانسياق وراء الخيال غير المؤسس؟
بل إن أخطر ما في هذه الظاهرة هو الانفصام بين التكوين العلمي للطالب وسلوكه العملي، إذ يتحول الحلم إلى دليل يُبنى عليه اعتقادات وتصورات ومواقف اجتماعية أو دينية أو حتى سياسية. وهذا يتنافى تمامًا مع قواعد العلم التي لا تقبل إلا ما يُختبر ويُناقش ويُراجع كما هو معهود في العرف العلمي. بل يتنافى مع الإسلام الذي جاء لتحرير الانسان من التفكير الخرافي ومن تعطيل العقل. ففي الإسلام ليس التفكير ترفًا بل فريضة، والبحث عن الدليل ومساءلة الأفكار وتمحيص المعلومات وتحكيم العقل، كلها من متطلبات البناء العلمي والشرعي السليم. أما تعليق الآمال والآلام على منامات وأحلام لا حجة فيها، وتفسيرات ذاتية لا يمكن التحقق منها، فهو ضرب من التواكل، بل هو تزييف للوعي وهروب من مسؤولية العلم والعمل وتحمل مسؤولية التغيير وصناعة التاريخ.
ثانيًا: دور المؤسسات التعليمية بين الفرضية والعبث
وإذا كان بعض طلبة الجامعات، ممّن يُفترض بهم التمرس في مناهج البحث العلمي وأدوات الفهم الرشيد، يبنون تصوراتهم على الرؤى والأحلام، ويتجاهلون الدليل العقلي والنقلي، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: ما جدوى الجامعات والمراكز البحثية إذن؟ وما الغاية من وجود المناهج الدراسية، والبرامج الأكاديمية، والكليات العلمية، إن كانت محصلتها النهائية تكريس الخرافة، وترويج الجهل المغلف بمسحة من التدين العاطفي أو دعاوى العلم الغامض؟
ففي ظل هذا الواقع، تفقد المؤسسات التعليمية رسالتها، وتتحول من منارات للعلم والتنوير إلى مجالس تردد فيها القصص الشعبية والأساطير دون تمحيص أو نقد. وتغدو الجامعات مجرد هياكل فارغة، تُهدر فيها الطاقات، وتُستنزف الموارد، دون أن تسهم فعليًا في ترسيخ العقل أو النهوض بالمجتمع.
وإن استمر هذا المنحى الارتكاسي في أوساط طلبة العلم الشرعي وبقية العلوم الأخرى الاجتماعية والإنسانية وحتى التطبيقية الأخرى، فإن الأمر لا يتعلق فقط بإصلاح مؤسسة تعليمية هنا أو هناك، بل يستدعي مراجعة شاملة لمناهجنا التربوية والتعليمية وللثقافة العامة التي تُسوّق هذا النمط الفكر الخرافي سواء تمسح بمسوح الدين او العلم او غيرها.
بل إن الواجب الملحّ هو إعادة الاعتبار للعقل، وإثراء المناهج بأطر النظر والتعقل والاستدلال والبناء الفكري والفلسفي، والسعي لاستعادة المنهج العلمي القائم على البرهان والتحقق. لا سيما في عصر يُختبر فيه العالم بأسره بقدرته على التمييز بين ما هو علم رصين وما هو زيف مموه، بين الفكر المنتج والتخمين العشوائي الذي يُلبّس لباس الحكمة.
لأن الكسل الذهني في هذا السياق لم يعد حالة عابرة يُكتفى معها بالتسامح أو الشفقة، بل هو خلل بنيوي يتطلب تقويمًا صارمًا، لأنه يُصيب النخبة العلمية والفكرية في مقتل، ويُفرغها من طاقتها الإبداعية، ويفتح الأبواب على مصراعيها للجهل كي يهيمن، لا باسم الجهل، بل باسم الدين وباسم العلم، وفي الحقيقة هي مضادات الدين ومضادات العلم. وحين يُترك الجهل بلا مواجهة، لا يقتصر ضرره على صاحبه، بل يتعداه ليُهدد الوعي الجمعي، ويحوّل الطاقات الشابة من أدوات للنهضة إلى عبء حضاري يثقل كاهل الأمة ويكبلها عن التقدم.
ثالثًا: تعطيل المنهج والانتكاسة الفكرية
إن من أكبر التجليات الفكرية لهذا الارتكاس هو تعطيل أدوات الاجتهاد والنظر ومنهج التفكير المنظم الذي قامت عليه حضارتنا الإسلامية وتأسست عليه معارفها. فعندما يُعطَّل منهج أصول الفقه مثلا –الذي هو في جوهره علم دقيق يُعنى بمنهج الاستدلال والاستنباط والتحقيق والمقارنة– فإن النتيجة تكون انفلاتًا في التفكير، وهروبًا من ضوابط الفهم، وانحرافًا في الاستدلال.
وكذلك الحال مع قواعد الرياضيات والمنطق العلمي، التي تُبنى على اليقين العقلي والتجريب والفحص، فإذا أهملها المتعلمون لصالح الاحلام والخيالات ومقولات الالهام والاشراق، فإن هذا لا يعد قصورًا في الفهم فحسب، بل تراجع عن منطق العلم ذاته. حيث يصبح العالم والمتعلم غارقًا في السيولة، حيث لا يمكن التفريق بين الحقيقة والخيال، وبين الرأي والمعلومة.
فحين يُلغى العقل وتُعطَّل فريضة التفكير، فإن المسؤولية الذاتية كذلك تُلقى جانبًا. يصبح الفرد متواكلًا، ينتظر أن تحل مشكلاته من خلال حلم مفسّر، أو رؤيا منسوبة إلى «عارف» مزيف، أو إلهام مبهم لا يُعرف مصدره. وهنا يتجلى الهروب من تحمل المسؤولية، حيث لا يعود الإنسان فاعلًا في مجتمعه، بل يتحول إلى متلقٍ سلبي، ينتظر أن تدار أموره بطريقة قدرية يتعطل فيها دوره التاريخي في حمل الأمانة كما تشهد بذلك سنن الكتاب وسنن التاريخ.
في هذا السياق، لا يعود المتعلم متعلِّمًا، ولا الباحث باحثًا، بل يصبح شخصًا عالقًا بين العجز والتبرير، في حالة من العزوف عن المبادرة، والانسحاب من المسؤولية الأخلاقية والفكرية التي يُفترض أن يتحملها كعنصر فاعل في مجتمعه. والخطورة الكبرى في هذا الارتكاس لا تتجلى فقط في الفشل الأكاديمي أو الجمود الفكري، بل في «تديين الجهل». حين تُصبغ الخرافات بصبغة دينية، ويُقدَّم الجهل في هيئة «معرفة روحانية»، وتُحاط الخيالات الشخصية بهالة من القداسة، فإننا نكون أمام خطر حضاري داهم. هذه الحالة تؤدي إلى تقديس الخطأ، ورفض المراجعة، ومحاربة العقلاء والمفكرين، وتسفيه العلماء، والترويج لنموذج «العارف الغامض» الذي لا يُسأل ولا يُناقش. وهو نموذج قاتل للنهضة، مدمر للعقل، مانع لأي مشروع معرفي جاد.
خاتمة: الارتكاس ليس قدرًا، وإنما نتيجة – والمسؤولية مشتركة
إن هذا الارتكاس الذي نشهده في بعض الأوساط العلمية والدينية هو نتيجة ثقافية وتربوية، وليس مجرد انحراف فردي. وقد أصبح من الضروري أن تعيد المؤسسات التربوية والتعليمية النظر في وظائفها، وألا تكتفي بمنح الشهادات، بل أن تربي على التفكير، وتُدرّب على النقد، وتُعلي من شأن البرهان.
فالخطاب العلمي والديني السليم يجب أن يتلاقى عند نقطة واحدة: إعمال العقل وفحص الدليل. فليس ثمة تعارض بين الإيمان والتفكير، ولا بين الروح والعقل، بل هما جناحا الإنسان إلى الفهم والرقي.
وعلينا أن نعيد الاعتبار لفريضة التفكير التي جاء الوحي لتأسيسها، ولنُقاوم الكسل الذهني، ولنكن حماة للوعي لا مروجين للوهم، لأن المجتمعات التي تفرط في عقولها، هي مجتمعات تكتب شهادة وفاتها بأيديها.