الأسرة والشراكة المؤسساتية … الدور الوقائي من الانحرافات السلوكية
أ.د رقية بوسنان/ تعد ظاهرت الانحراف من أخطر التحديات الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمعات وتماسكها، إذ لا تنعكس آثارها على الفرد المنحرف فحسب، بل تمتد لتطال الأسرة، المدرسة، والنسق الاجتماعي بأكمله، ولأن الانحراف لا ينشأ في فراغ، فإن مواجهته تستدعي بناء إستراتيجية وقائية متكاملة تتضافر فيها جهود مختلف الفاعلين، فالأسرة باعتبارها النواة الأولى للتنشئة الاجتماعية، …

أ.د رقية بوسنان/
تعد ظاهرت الانحراف من أخطر التحديات الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمعات وتماسكها، إذ لا تنعكس آثارها على الفرد المنحرف فحسب، بل تمتد لتطال الأسرة، المدرسة، والنسق الاجتماعي بأكمله، ولأن الانحراف لا ينشأ في فراغ، فإن مواجهته تستدعي بناء إستراتيجية وقائية متكاملة تتضافر فيها جهود مختلف الفاعلين، فالأسرة باعتبارها النواة الأولى للتنشئة الاجتماعية، تضطلع بدور محوري في غرس القيم، وترسيخ القدوة، وتوفير الاستقرار النفسي والاقتصادي لأبنائها، لكن هذا الدور لا يمكن أن يكتمل دون شراكة مع المدرسة، ووسائل الإعلام، والمؤسسة الدينية، والمجتمع المدني، و لا تحقق فعالية هذه الجهود إلا في ظل منظومة تشريعية وسياساتية صارمة.
الأسرة… الحصن الأول في مواجهة رياح الانحراف
تظل الأسرة المؤسسة الأولى التي تزرع فيها بذور القيم والضوابط الأخلاقية، فهي ليست مجرد إطار اجتماعي، بل حصن يحمي الأبناء من رياح الانحراف وتقلبات العصر، فالأبوان يشكلان النموذج الأول الذي يحتذي به الأبناء في سلوكياتهم وتفاعلاتهم اليومية، إذ يتعلم الطفل منذ سنواته الأولى ما هو مقبول وما هو مرفوض عبر التوجيه، والملاحظة، والتقليد، وفي هذا السياق يؤكد إميل دوركايم، أن الأسرة هي «المدرسة الأولى للتنشئة الاجتماعية»، إذ تمنح الطفل الأدوات الأولية لفهم ذاته وعلاقته بالآخرين، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الروابط الأسرية المتينة تساهم بشكل مباشر في خفض معدلات الانحراف والإدمان، فبحسب دراسة ميدانية أجراها عبد الله محمود سنة 2021، فإن الأسر التي تلتزم بالتواصل المستمر والحوار المفتوح تقل نسبة انخراط أبنائها في السلوكيات الخطرة بنسبة تقارب 60%، وهذا ما يجعل العلاقة العاطفية الدافئة بمثابة «جدار حماية» نفسي واجتماعي، ويمنح الأبناء ثقة بالنفس ويشعرهم بالانتماء، ويذهب بومان في تحليله للأسرة المعاصرة إلى أن غياب الاستقرار الأسري يولد فراغا عاطفيا يكون بوابة سهلة نحو الإدمان، حيث يبحث المراهق عن بدائل وهمية لتعويض نقص الدعم داخل محيطه الأسري، في المقابل، فإن الأسر التي توفر لأبنائها الإحساس بالأمان والاحتواء العاطفي، تمكنهم من بناء مناعة نفسية قوية ضد مختلف الضغوطات، وتؤكد دراسات الصحة النفسية أن العلاقة الأسرية الداعمة لا تمنع الانحراف فحسب، بل تعزز أيضا قدرة الأبناء على التكيف الإيجابي مع الأزمات، بما في ذلك مقاومة إغراءات المخدرات ودوائر الأصدقاء السلبيين من هنا يمكن القول إن الأسرة الواعية، بما تمنحه من دفء ورقابة ورعاية، ليست مجرد وحدة اجتماعية، بل حصن متماسك يواجه رياح الانحراف، ويزرع في الأبناء القدرة على التمييز بين الطريق الصحيح والمنحرف.
القيم الأسرية… لقاح فعال ضد الانحراف
تعد القيم الأسرية -الأخلاقية والثقافية والدينية- أحد أعمدة الوقاية النفسية والاجتماعية من السلوكيات المنحرفة، ففي دراسة مهمة بعنوان «القيم الأسرية كعامل وقائي في حماية المراهقين ذوي الأصول المكسيكية عند تعرضهم لرفاق منحرفين»، خلص الباحثون إلى أن القيم الأسرية التقليدية مثل شعور الفرد بالانتماء والولاء والاحترام تجاه أفراد العائلة قد خفضت بشكل ملحوظ من السلوكيات الخارجة عن نطاق المألوف لدى المراهقين، حتى في بيئات يكثر فيها الأقران المنحرفون وهذا يدل على أن ما يعرف بـ «العائلة المتماسكة» ليس مجرد مصطلح فارغ، بل عامل وقائي فعال يحمي الأبناء من الضغوط الخارجية، كما يذكر ماستن وشافر في سياق دراستها عن المناعة النفسية لدى الأطفال، أن الأسرة المتماسكة، ذات العلاقة الدافئة والداعمة، قادرة على تلطيف آثار المخاطر وتحجيم السلوك العدواني حتى عندما يواجه الأبناء بيئات شديدة التحريض وهذا يجسد دور «التحصين القيمي» الذي توفره القيم الأسرية داخل الشبكة الاجتماعية للأفراد، ومن الناحية النظرية، ينص علماء علم الاجتماع على أن عملية التماس القيمي المبكر داخل الأسرة تشكل «احتواء داخليا» قويا يساعد الفرد على مقاومة الضغوط الخارجية، فوفق نظرية «الضبط الاجتماعي الداخلي والخارجي «التي وضعها والتر ريخلس، فإن الانتماء الأسري والقدرة على تمييز السلوك المقبول من المنحرف يمثل قلعة نفسية تقي الأفراد من الانجراف، وباختصار يمكن القول إن غرس القيم الأسرية في الأبناء لا يشكل واجبا تربويا فحسب، بل هو «لقاح مجتمعي» وقائي بتأثير مستدام، يرسخ في النفوس قدرة على التمييز والإصرار على الطريق الصحيح، حتى في مواجهة الفتن والتحديات الاجتماعية.
القدوة داخل البيت… دروس تعاش لا تقال
يؤكد علماء النفس التربوي أن الأبناء يتعلمون السلوكيات بالقدوة أكثر مما يتعلمونها بالتوجيه المباشر، فالطفل لا يتشكل وعيه الأخلاقي من خلال الكلمات بقدر ما يتأثر بالأفعال اليومية التي يعيشها داخل أسرته، وقد بين ألبرت باندوة في نظرية التعلم الاجتماعي أن الملاحظة والنمذجة تمثلان أساسا في عملية اكتساب السلوك، حيث يقلد الأبناء ما يشاهدونه لدى الوالدين أو الإخوة الأكبر، سواء كان ذلك سلوكا إيجابيا أم سلبيا، وفي هذا السياق، أظهرت دراسات ميدانية كما لخصها هوسكينز، أن الأسر التي يسودها جو من التفاهم والاحترام المتبادل، وينعكس ذلك في تصرفات الوالدين، تخرج أبناء أكثر قدرة على ضبط النفس وأقل عرضة للانحرافات السلوكية ، وعلى العكس من ذلك، فإن وجود ممارسات سلبية داخل البيت مثل التدخين، العنف اللفظي، أو التهاون بالقيم الأخلاقية، يخلق بيئة خصبة لتطبيع الانحراف واعتباره أمرا عاديا لدى الأبناء، إن القدوة الأسرية هنا ليست مجرد ترف تربوي، بل هي ضرورة وجودية لحماية الجيل الناشئ من الوقوع في دوامة السلوكيات الخطرة، فالبيت الذي يجسد القيم في أفعاله اليومية، يقدم لأبنائه «دروسا حية» تفوق أي خطاب وعظي أو توجيهي، وكما يقول التربويون: «الأطفال ينسون ما يقال لهم، لكنهم لا ينسون ما يعيشونه».
الحوار الأسري… جسر يربط العقول والقلوب
يمثل غياب الحوار داخل الأسرة ثغرة خطيرة في جدار الحماية التربوي، إذ يدفع الأبناء للبحث عن بدائل في الشارع أو عبر العالم الافتراضي، حيث قد يجدون رفاق سوء أو محتوى مضرا، وفي هذا السياق يوضح سامي الحسن أن»الأبناء الذين ينشأون في بيئة تتيح لهم التعبير عن آرائهم ومشاعرهم بحرية، يكونون أقل عرضة للانحرافات السلوكية وأكثر قدرة على مواجهة الضغوط الاجتماعية»، كما تشير دراسة أخرى إلى أن الأسر التي تمارس أسلوب الحوار المفتوح، تنجح في تعزيز الثقة المتبادلة بين أفرادها، وهو ما يقلل بشكل ملحوظ من احتمالية انجراف الأبناء وراء السلوكيات السلبية، إذ يؤكد غروثيفان وكووبرن»أن الحوار ليس مجرد تبادل للكلمات، بل هو عملية بناء للثقة، وتوسيع لآفاق الفهم المشترك بين الأجيال»، إن الحوار الأسري الحقيقي هو ذلك الذي يربط العقول بالقلوب، فلا يقتصر على الأوامر أو التوجيهات، بل يمنح الأبناء مساحة للبوح، والآباء فرصة للإصغاء، وكما عبر أحد الباحثين نقله سميث أن» الحوار داخل الأسرة ليس ترفا، بل هو أداة وقائية من الطراز الأول في مواجهة الانحراف».
الاستقرار النفسي والاقتصادي… تربة خصبة للتوازن الأسري
تعتبر الاضطرابات الأسرية الناتجة عن الفقر، أو البطالة أو النزاعات الزوجية من أبرز العوامل التي تزرع بيئة خصبة لانحراف الأبناء، إذ يشير تقرير الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن «الأطفال والشباب في البيئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا هم أكثر عرضة للانخراط في سلوكيات خطرة، بما في ذلك تعاطي المخدرات والانحرافات السلوكية»، وفي السياق نفسه، يرى ماستن في دراسته حول مرونة الأطفال أن»الاستقرار الأسري -النفسي والاقتصادي- يشكل الأساس الذي ينمو فيه الأبناء بصورة متوازنة، ويمنحهم القدرة على مقاومة الضغوط والانحرافات الخارجية»، كما يوضح إبراهيم أن التفكك الأسري الناتج عن العجز المالي أو الخلافات الزوجية يحرم الأبناء من أهم مقومات الحماية، قائلا: «حين تفقد الأسرة استقرارها الداخلي، يصبح الشارع هو المدرسة الأولى، والإعلام الرقمي هو المربي البديل»، ومن هنا، فإن دعم الأسرة اقتصاديا وتوفير بيئة نفسية مستقرة لا يعد ترفا اجتماعيا، بل شرطا أساسيا لحماية النشء من الانجراف نحو السلوكيات الخطرة، وضمان توازنهم النفسي والاجتماعي على المدى الطويل.
المدرسة شريك الأسرة… وقاية ممتدة خارج البيت
لا يمكن للأسرة أن تتحمل وحدها عبء وقاية الأبناء من الانحراف، فالمسؤولية مشتركة مع المدرسة التي تعد الامتداد الطبيعي لدور الوالدين،إذ يشير تقرير اليونسكو «إن التكامل بين البيت والمدرسة في التربية الوقائية يشكل أحد أقوى السبل لحماية المراهقين من السلوكيات الخطرة، بما فيها الإدمان»، ويذهب المربي الأمريكي جون ديوي إلى أن «التربية الحقيقية هي تلك التي تتجاوز جدران البيت لتجد في المدرسة شريكا يعزز القيم ويترجمها إلى سلوك عملي» ، وفي السياق نفسه، يرى مصطفى حجازي «أن المدرسة عندما تعزل عن الأسرة تصبح مؤسسة ناقصة الدور، أما حين تتكامل مع البيت فإنها تتحول إلى خط دفاع ثان ضد الانحراف»، فالمدرسة ليست مجرد مكان للتعلم الأكاديمي، بل فضاء للتنشئة والوقاية، تعزز فيه القيم الأسرية وتترجم عبر الأنشطة التوعوية والممارسات التربوية اليومية، مما يجعلها شريكا استراتيجيا للأسرة في حماية النشء من مخاطر الانحراف.
الإعلام… بين خطر الانحراف وفرص التوعية
لا يمكن الحديث عن الوقاية من الانحراف دون التطرق إلى الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام، فقد أصبحت المنصات الرقمية اليوم المصدر الأول لتشكيل وعي الشباب وأنماطهم السلوكية، فإذا كان بعض المحتوى الإعلامي يروج – بشكل مباشر أو غير مباشر- لثقافة العنف أو يقدم صورة مغرية عن المخدرات والتجاوزات السلوكية، فإن الإعلام ذاته يمكن أن يتحول إلى أداة قوية للتوعية والوقاية، وقد أشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرها حول التواصل الصحي الموجه للشباب إلى أن»وسائل الإعلام قادرة على أن تكون خط الدفاع الأول ضد السلوكيات الخطرة، شرط أن توظف بذكاء وتستند إلى استراتيجيات تواصل فعالة وموجهة»، وفي السياق نفسه أكد الباحث الإعلامي دنيس ماكويل أن»الإعلام ليس مجرد ناقل للمعلومة، بل قوة اجتماعية قادرة على تشكيل القيم والتأثير في السلوكيات على المدى الطويل»، أما في السياق العربي، يرى حسين أمين أن «تعاون الأسرة مع المؤسسات الإعلامية لإنتاج محتوى توعوي موجه للشباب بلغتهم وأسلوبهم، هو الطريق الأنجع لمواجهة حملات الترويج غير المباشر للانحراف والإدمان»، من هنا تبرز الحاجة إلى بناء شراكة ذكية بين الأسر ووسائل الإعلام، تقوم على إنتاج برامج ورسائل شبابية قريبة من واقع الجيل الجديد، تستخدم لغتهم ووسائطهم المفضلة، وتعمل على تقليل جاذبية السلوكيات المنحرفة مقابل تعزيز بدائل إيجابية أكثر جاذبية وتأثيرا.
المؤسسات الدينية… صوت القيم في زمن التحولات
لا يمكن تجاهل الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الدينية في دعم جهود الأسرة والمدرسة والإعلام في مواجهة الإدمان والانحرافات السلوكية، فالمؤسسات الدينية تمثل مرجعية أخلاقية وقيمية قادرة على مخاطبة الوجدان وتعزيز المناعة الروحية لدى الشباب. إن الخطاب الديني المعتدل، حين يقدم بلغة قريبة من الشباب، يساهم في بناء رصيد من القيم التي تحميهم من الانجراف وراء المغريات، وقد شددت رابطة العالم الإسلامي في تقريرها حول التحديات القيمية للشباب على أن «إحياء دور المؤسسة الدينية في التوعية والتثقيف يعد من أهم عناصر الحماية الفكرية والأخلاقية ضد الإدمان والانحراف»، كما أكد الباحث في علم الاجتماع الديني بيتر بيرغر أن: «الدين يشكل شبكة أمان رمزية، توفر للأفراد معنى وغاية، وتساعدهم على مواجهة أزمات الحياة دون السقوط في سلوكيات مدمرة»، وفي السياق العربي، يرى يوسف القرضاوي أن «المسجد والمدرسة والمنزل مثلث تربوي متكامل، إذا صلح أحد أضلاعه ودعم الآخر، صلح البناء كله، وإن فسد أحدها اختل التوازن وانفتح الباب أمام الانحراف»، إن المؤسسات الدينية اليوم مطالبة بتجديد خطابها، ومواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، من خلال برامج توعوية ودروس ميدانية وحملات رقمية تواكب لغة الجيل الجديد، فتكون بذلك شريكا أصيلا للأسرة والمدرسة والإعلام في بناء وقاية مجتمعية شاملة.
المجتمع المدني… الجدار الموازي لدعم الأسرة
يلعب المجتمع المدني دورا لا يقل أهمية عن الأسرة والمدرسة في حماية الشباب من الانحراف، فهو بمثابة «الجدار الموازي» الذي يسند الأسرة ويعزز جهودها التربوية، فالجمعيات والمنظمات الشبابية توفر فضاءات آمنة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، مما يقلل من احتمالية الانخراط في سلوكيات خطرة، كما تقدم هذه المؤسسات برامج إرشاد نفسي ودعم اجتماعي للأسر التي تعاني من صعوبات في التعامل مع أبنائها، خاصة في حالات الإدمان أو الانحراف، وقد أكد الكندري أن «المؤسسات المدنية تمثل شبكة دعم بديلة، إذ تمنح الشباب فرصة للانتماء الإيجابي بعيدا عن دوائر رفاق السوء، وفي السياق نفسه، يشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن»الشراكة بين المجتمع المدني والأسر تساهم في بناء استراتيجيات وقائية أكثر فعالية ضد المخاطر الاجتماعية، خصوصا بين الفئات الهشة»، كما عبر بيير بورديو عن أهمية رأس المال الاجتماعي الذي توفره الجمعيات، موضحا أن: «الانتماء إلى شبكات مجتمعية إيجابية يشكل حصنا واقعيا ضد الانعزال والاضطراب السلوكي»، ويتضح أن المجتمع المدني لا يمثل مجرد ملحق للعمل الأسري، بل شريكا أصيلا في صناعة بيئة متوازنة وآمنة للشباب، تسهم في تعزيز قيم الانتماء والالتزام، وتغلق الأبواب أمام الانحرافات المهددة لاستقرارهم ومستقبلهم.
التشريعات والسياسات… مظلة حماية جماعية
إن الأسرة مهما بلغت من قوة لا تستطيع بمفردها مواجهة التحديات المرتبطة بالانحراف، خاصة في ظل انتشار المخدرات وتفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، لذلك تأتي التشريعات والسياسات العامة لتشكل «مظلة حماية جماعية» تعزز من قدرة الأسرة على القيام بدورها الوقائي، فسن قوانين رادعة لتجريم الاتجار بالمخدرات، وتوفير مراكز متخصصة لإعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، يعد ركيزة أساسية في أي استراتيجية وطنية لمكافحة الانحراف، وقد أشارت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن»الإطار القانوني الصارم، عندما يقترن بخدمات الدعم الاجتماعي، يحد بشكل كبير من معدلات الانحراف والإدمان بين الشباب»، كما يرى دوركهايم أن: «القانون ليس مجرد أداة للردع، بل هو تعبير عن الضمير الجمعي الذي يحمي تماسك المجتمع»، وفي السياق ذاته، يوضح العابد أن»التشريعات الراعية للأسرة لا تقل أهمية عن القوانين العقابية، فهي التي تمنح الوالدين القدرة على أداء دورهم التربوي داخل بيئة آمنة ومستقرة»، وهي ليست مجرد نصوص جامدة، بل هي أدوات عملية لحماية المجتمع، وضمان أن تظل الأسرة قادرة على أداء رسالتها التربوية والوقائية في مناخ قانوني ومؤسسي داعم.
في الختام إن الوقاية من الانحراف والإدمان ليست مهمة تلقى على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتضافر فيها جهود الأسرة، المدرسة، الإعلام، المجتمع المدني، والدولة، فالأسرة تمثل الحصن الأول من خلال القيم، القدوة، والحوار، وهي الأساس الذي يبنى عليه توازن الأبناء النفسي والاجتماعي، غير أن هذا الدور لا يكتمل من دون المدرسة التي تشكل شريكا تربويا أساسيا في تعزيز السلوك الإيجابي، والإعلام الذي يمكن أن يتحول من ناقل للخطر إلى منبر للتوعية، والمؤسسة الدينية التي تتبنى الطرح المقاصدي وتسهم في البناء الروحي والقيمي، كما أن المجتمع المدني يوفر بيئات بديلة للشباب تسهم في احتوائهم وتوجيه طاقتهم نحو الإبداع والاندماج الإيجابي، وفي المقابل، تأتي التشريعات والسياسات العامة لتشكل مظلة حماية شاملة تضمن الاستمرارية والاستدامة في مكافحة الانحراف، وبذلك يتضح أن مواجهة هذه التحديات المعقدة تستلزم تكاملا حقيقيا بين مختلف الفاعلين، لأن نجاح الوقاية مرهون بمدى القدرة على بناء جبهة موحدة تحمي الأجيال القادمة وتصون استقرار المجتمع.
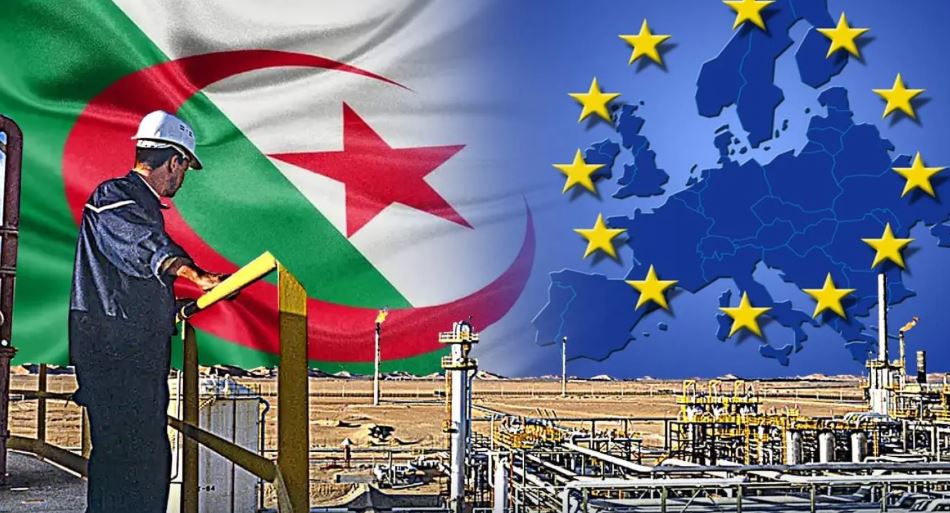






































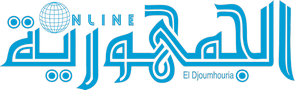


























![في رحاب الإيمان: {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } [الأعراف: 174]](https://cdn.elbassair.dz/wp-content/uploads/2024/04/%D8%A3.%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AE.jpeg)
