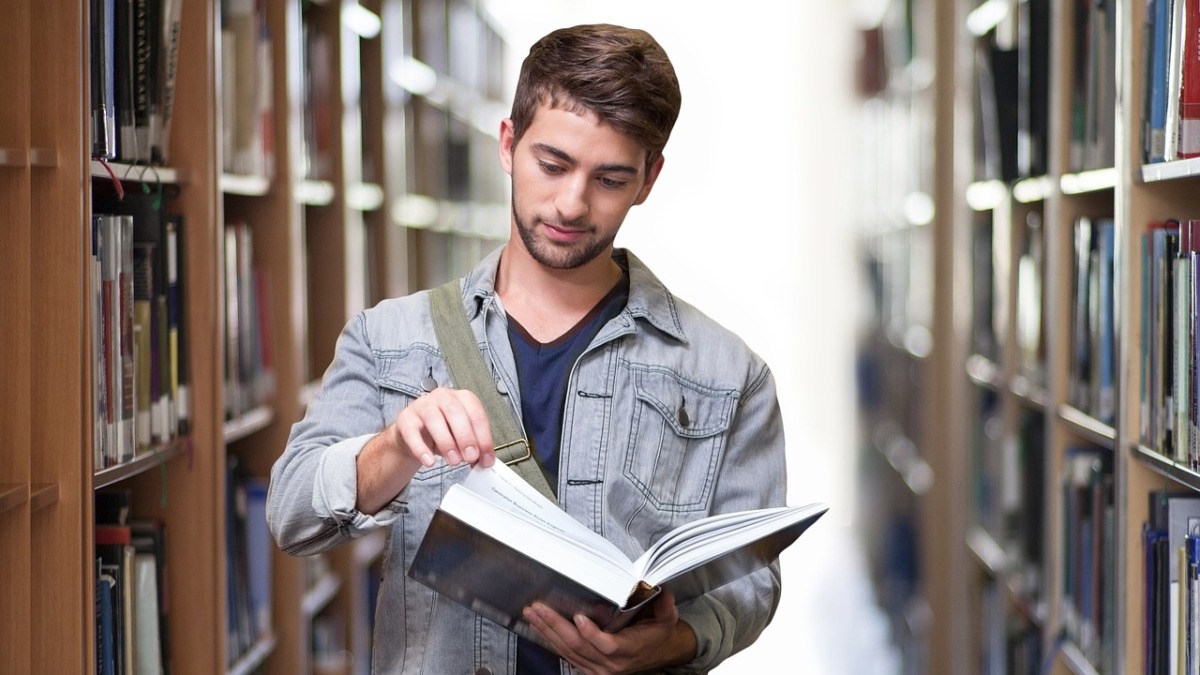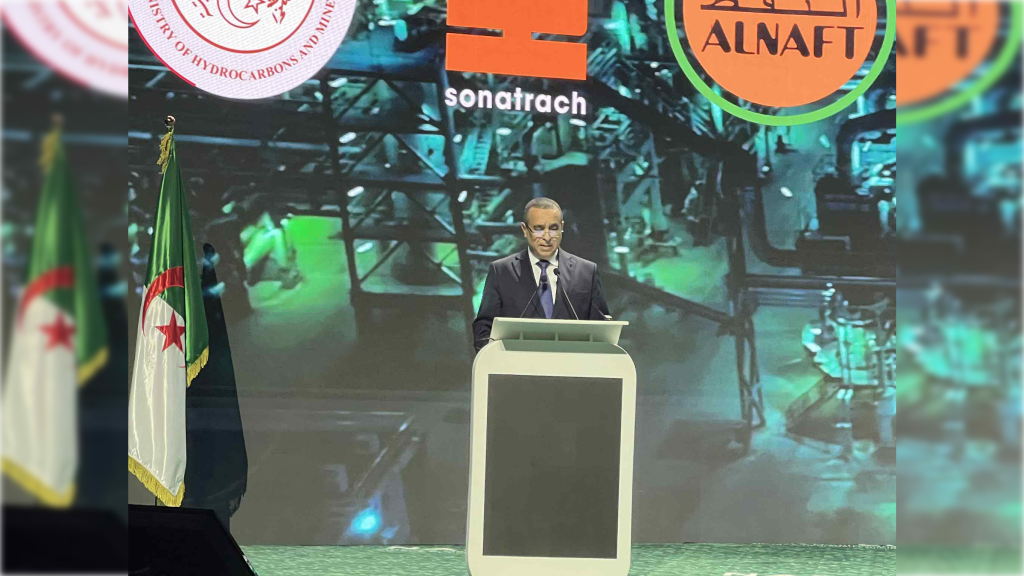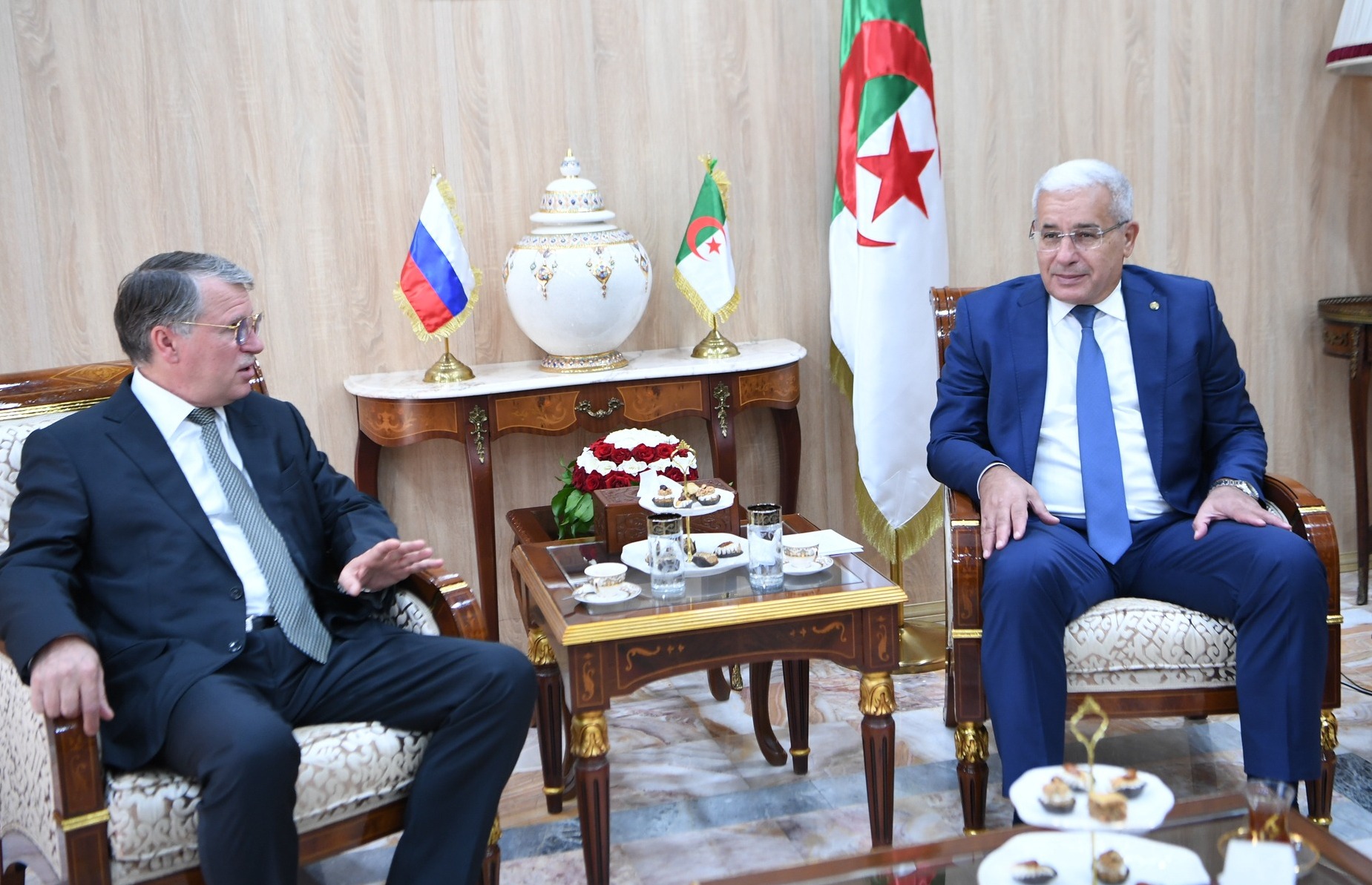التحصيل العلمي لدى طلاب الجامعات: التحديات وأدوار الدعم الأكاديمي واللغوي
د. كريمة عبدالدايم*/ التحصيل العلمي هو أحد أهم مؤشرات نجاح الطالب الجامعي، ليس فقط لأنه يعكس قدرته على استيعاب المعارف، بل لأنه يرتبط أيضًا بجملة من العوامل النفسية، البيداغوجية، والاجتماعية. وقد أشارت دراسات عدّة في مجال التعليم العالي إلى أنّ التحصيل لا يعتمد حصريًا على القدرات الذهنية، بل يتأثر بدرجة عالية بالدافعية الداخلية، واستراتيجيات التعلّم، …

د. كريمة عبدالدايم*/
التحصيل العلمي هو أحد أهم مؤشرات نجاح الطالب الجامعي، ليس فقط لأنه يعكس قدرته على استيعاب المعارف، بل لأنه يرتبط أيضًا بجملة من العوامل النفسية، البيداغوجية، والاجتماعية. وقد أشارت دراسات عدّة في مجال التعليم العالي إلى أنّ التحصيل لا يعتمد حصريًا على القدرات الذهنية، بل يتأثر بدرجة عالية بالدافعية الداخلية، واستراتيجيات التعلّم، والبيئة الجامعية.
من خلال تجربتي كأستاذة لغة أجنبية تدرّس طلبة في تخصصات تقنية، ألاحظ أنّ كثيرًا من الطلبة يقلّلون من أهمية المقررات اللغوية مقارنة بالمواد العلمية الأساسية. هذا التصور المسبق ينعكس على التحصيل، حيث ينظر بعضهم إلى تعلم اللغة على أنه عبء ثانوي لا يخدم مستقبله المهني. غير أنّ الدراسات التربوية تؤكد العكس؛ فقد أظهرت بعض الأبحاث أن اندماج الطالب في مختلف جوانب التجربة الجامعية، بما في ذلك المقررات العامة، يزيد من احتمالية استمراره ونجاحه الأكاديمي.
إضافة إلى ذلك، فإن الضغوط المرتبطة بالتخصصات التقنية ـ من كثافة البرامج وصعوبة المناهج ـ تؤثر في أولويات الطلبة، وتجعلهم يركزون على النجاح الآني أكثر من بناء مهارات طويلة المدى. ومع ذلك، تشير أبحاث حول «الكفاءة الذاتية» إلى أن إيمان الطالب بقدرته على الإنجاز، حتى في المجالات التي تبدو غير مرتبطة مباشرة بتخصصه، له تأثير قوي على أدائه العام. هذا يفسر لماذا يظهر الطلبة الأكثر التزامًا بالمقررات اللغوية قدرات أفضل في تقديم مشاريعهم العلمية، وفي التواصل بفعالية مع أساتذتهم وزملائهم.
ولا يغيب عن الأفق أيضًا الدور الاجتماعي والنفسي في تحفيز التحصيل، إذ ثبت أن التفاعل بين الطلاب وأساتذتهم يشكّل عنصرًا حاسمًا في رفع مستوى التحصيل. في سياق الدعم الأكاديمي، نجد أن نعوم تشومسكي، في تحليله للغة والتعلم، يؤكد أن اكتساب اللغة ليس مجرد اكتساب رموز لغوية بل هو عملية أساسية للامتلاك الفكري والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي، وهو ما يعزز القدرة على استيعاب المفاهيم التقنية وربطها بالسياقات المهنية المتنوعة. ويشير تشومسكي في أعماله إلى أهمية توفير بيئة تعليمية تعزز من «الكفاءة اللغوية» التي تتجاوز النحو والصرف إلى تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداع. كما يؤكد في كتاباته أن التعليم يجب أن يكون محفزًا للاستكشاف والفهم العميق، لا مجرد حفظ معلومات، وهو ما ينسجم مع رؤية الحديث عن دعم الطالب في بناء مهارات التعلّم الذاتي ومهارات التنظيم الذاتي، كما توضح بعض الدراسات حول «التنظيم الذاتي للتعلّم».
في هذا السياق، لا يقتصر دور أستاذ اللغة في الأقسام التقنية على تعليم القواعد والمفردات، بل يصبح دورًا تكامليًا يهدف إلى تغيير تمثلات الطالب للمادة وربطها بواقعه العملي. عند إدماج نصوص تقنية في حصص اللغة، أو توظيف مهام تواصلية مرتبطة بمثل هذه التخصصات، يبدأ الطالب في إدراك اللغة كأداة فعالة لدعم تخصصه، مما يعزز من مستوى تحصيله العلمي ويعتبر تطبيقًا عمليًا لنظرية تشومسكي التي تربط بين اللغة والفكر.
التحصيل العلمي في الجامعة ليس مجرد درجات أو نجاح عابر في امتحان، بل هو مسار تكويني متكامل يحتاج فيه الطالب إلى وعي بأهمية كل مادة دراسية وقدرته على دمجها في مشروعه الأكاديمي والمهني. من جهة أخرى، يقع على عاتق الأستاذ الجامعي توفير بيئة تعليمية محفزة تعتمد على التكامل بين النظرية والتطبيق، ما يجعل من التحصيل العلمي تجربة هادفة وذات معنى متجذر في المعرفة والمهارات الحياتية والفكرية، في ضوء الرؤية التي يقدمها العلماء مثل نعوم تشومسكي حول أهمية اللغة كأداة للفكر والتمكين الأكاديمي.
* أستاذة محاضرة في جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا – باب الزوار