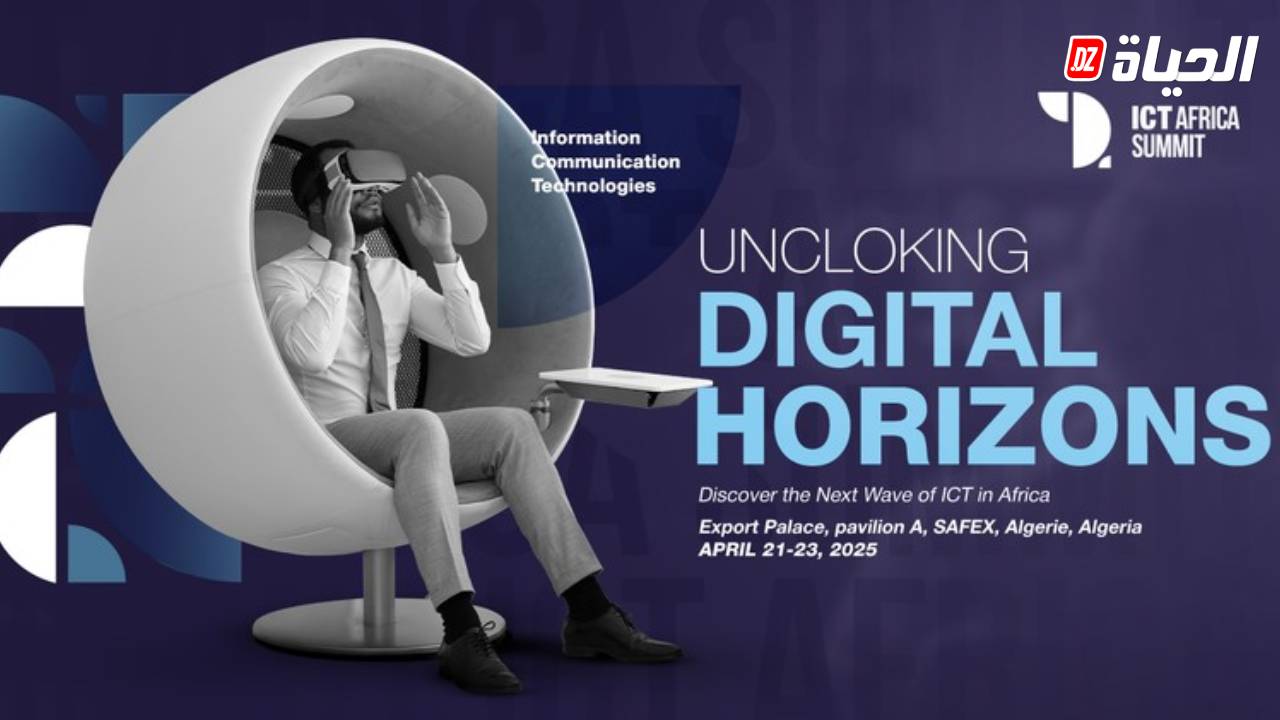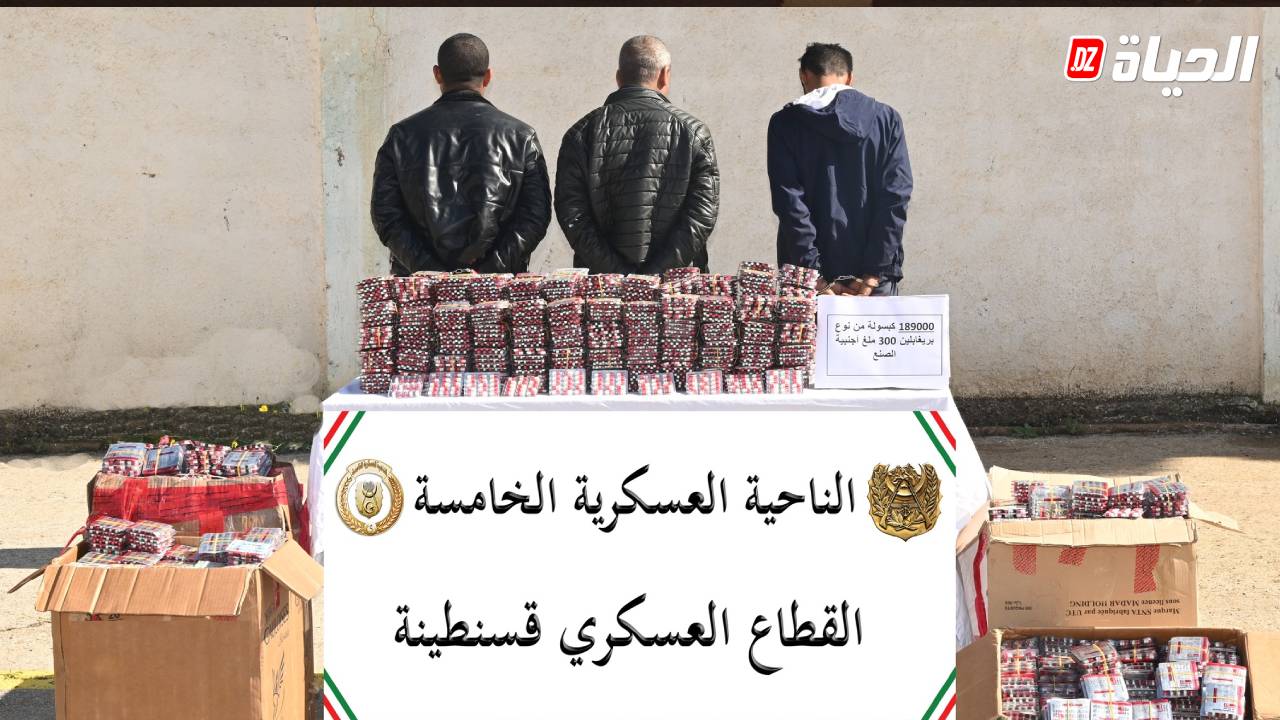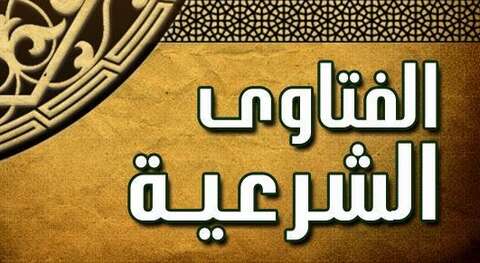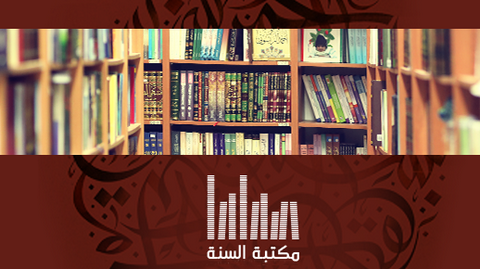جريدة البصائر في حوار صريح مع الشاعر محمد بن رقطان:علم تراجم الأعلام آلـــة الحفــاظ على ذاكـرة الأمــة
حاوره الأستاذ الدكتور مرزوق العمري*/ الاهتمام بالهوية والانتماء والامتداد في التاريخ لا يكون إلا بالاهتمام بالأعلام الذين صنعوا الحدث التاريخي وساهموا في بناء الهوية وعملوا على الحفاظ على مكوناتها، من هنا يكتسي تاريخ الأعلام والاعتناء بتراجمهم أهمية خاصة، وقد كان هذا الاهتمام خاصية من خواص المنظومة المعرفية الإسلامية؛ إذ تكاد تكون المنظومة الوحيدة التي أسست …

حاوره الأستاذ الدكتور مرزوق العمري*/
الاهتمام بالهوية والانتماء والامتداد في التاريخ لا يكون إلا بالاهتمام بالأعلام الذين صنعوا الحدث التاريخي وساهموا في بناء الهوية وعملوا على الحفاظ على مكوناتها، من هنا يكتسي تاريخ الأعلام والاعتناء بتراجمهم أهمية خاصة، وقد كان هذا الاهتمام خاصية من خواص المنظومة المعرفية الإسلامية؛ إذ تكاد تكون المنظومة الوحيدة التي أسست لعلم تراجم الرجال، وظل هذا الاهتمام يُتداول ولكن بتفاوت من قطر إسلامي لآخر، وفي هذا أردنا الوقوف عند واقع الاهتمام بتراجم الأعلام في الجزائر مع أحد المهتمين بعلم التراجم وهو الأديب والشاعر محمد بن رقطان فكان معه هذا الحوار.
كيف يقدم الشيخ بن رقطان نفسه للقارئ؟
– أنا محمد بن رقطان من مواليد03 فيفري سنة 1948م ببلدية الشهيد أحمد بومهرة ولاية قالمة، وينتهي نسبي إلى قبيلة طلحة العربية التي ينتهي نسبها إلى الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه-. حفظت القرآن الكريم في الكتَّـاب على يد ثلاثة معلمين، وزاولت تعليمي الابتدائي والمتوسط على يد الشيخ عبد الحميد بديار في مدرسة حرة، وأخذت دروسا في اللغة والأدب على يد الشيخ محمد بهلول أحد تلاميذ الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس.ا لتحقت بسلك التعليم سنة 1966م، وعكفت على المطالعة، ودراسة مادتي العلوم والرياضيات، بصفة حرة على الأساتذة الشرقيين، حتى تحصلت على كل الشهادات التي أحدثتها وزارة التربية لمعلمي التعليم الابتدائي، ورتبة أستاذ التعليم المتوسط، ومارست أيضا مهمة مفتش للتعليم الابتدائي. وزاولت أيضا دراستي الجامعية، وتخرجت من جامعة عنابة بشهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي. شغلت عدة مناصب منها منصب أستاذ بالتعليم الثانوي، ومدير للتربية بولايات: وادي سوف، والبليدة، وعنابة، ثم مدير للثقافة بولاية قالمة. وفي الميدان السياسي شغلت منصب مسؤول قسمة جبهة التحرير الوطني لبلدية قالمة، ومنصب عضو بمكتب محافظة قالمة، ومنصب أمين محافظة (محافظ) بولاية المدية. كما أنني عضو اتحاد الكتاب الجزائريين منذ سنة 1975م. وخلال هذه المسيرة اشتغلت بالتأليف والكتابة ولدي عدة كتب منها المنشور ومنها المخطوط؛ فمن مؤلفاتي المنشورة:
1ـ ألـحان من بلادي (شعر): نشر في عدد خاص من مجلة آمال، 1977م.
2ـ الأضواء الخالدة (شعر): مطبعة البعث، قسنطينة، 1980م.
3ـ أغنيات للوطن في زمن الفجيعة (شعر): اتحاد الكتاب الجزائريين، مطبعة هومة، 2003م.
4ـ زفرات البوح (شعر): مطبعة المعارف، عنابة، 2005م.
5ـ أعلام زاوية الناظور (تراجم ودراسة وتعليق).
6ـ تحقيق وتعليق لديوان: (نبراس الأوراس) للشاعر المجاهد المرحوم عيسى دهان.
أما المؤلفات المخطوطة: فهي
1ـ هذه أمتي(شعر).
2ـ بسمة الأفق (شعر).
3ـ إليك حبيب الله (شعر).
4ـ أعلام وشخصيات في ذاكرة قالمة (تراجم).
الاهتمام بالأعلام وبالترجمة لهم والتعريف بأعمالهم من المتطلبات الدينية؛ لأن العلوم الإسلامية علوم نقلية، والنقل يقتضي التعريف بالناقل والمنقول عنه. أليس كذلك؟
– إن العلوم الإسلامية منها النقلي الذي لا مكان فيه للرأي والاجتهاد كالقران الكريم، والسنة بأنواعها الثلاثة: -القولية كالأحاديث النبوية الشريفة. -الفعلية مافعله الرسول صلى الله عليه وسلم. -التقريرية مارآه من أفعال وأقره أولم ينه عنه. أما ماعدا ذلك فإنه خاضع للدراسة والتمحيص وإعمال الرأي، ولذلك أثر عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال: كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر؛ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وضع رواة الحديث النبوي منهجا علميا دقيقا وشروطا أخرى جد صارمة فيمن تصح الرواية عنهم من الصحابة الثقات الذين رووا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضعوا ترتيبات دقيقة لدرجات الحديث كالصحيح والحسن، والمرسل، والضعيف، والمتواتر، وأحاديث الآحاد، إلى آخره. وحتى يصح النقل كان لابد من التعرف والتعريف بسيرة المنقول عنه والناقل معا، ولذلك رأينا الإمام ابن حجر العسقلاني يضع كتابه الموسوم بـ (الإصابة في التمييز بين الصحابة) الذي توسع فيمابعد واصطلح على تسميته بعلم الرجال، فظهرت المعاجم التي يقول عنها بن خلكان أبوالعپاس:”المعاجم تختلف في ترتيب مادتها كترتيب السنين، أوطبقات أو وفيات أو فنون وعلوم، إلا أن الترتيب على حروف المعجم أيسر من ذلك كله. ويقول الغبريني أبو العباس عن أهمية الرجال الأعلام:”…فلذلك اهتم العلماء بذكر الرجال، واستعملوا في تمييزهم الفكروالبال، ليوضحوا سبيل التحمل، وليبينوا وسيلة التوصل، وقد اختلفت في ذلك مصادرهم، فمنهم من ذكر التجريح والتعديل، في المحدثين… ومنهم من اقتصر على ذكر العلماء المجتهدين، ومنهم من ذكر المؤلفين والمصنفين، ومنهم من ذكر الصلحاء والمتعبدين، ومنهم من ذكر علماء وقته، ومنهم من اقتصر على ذكر مشيخته، وكل ذلك يحصل الإفادة، ويقول يحي بن خلدون عن علم الرجال وتراجمهم، بأنه من أسباب إطالة الأعمار بما تركوه من آثار وتخليد لهم يقول: “فإن النفوس الكبار، والهمم الأحرار، لاتزال طامحة الأبصار إلى أوج الفخار، راغبة بخليقتها في إطالة الأعمار، بما تخلده من آثار، إذ باَعُ الآثار في الحياة مديد، وحديث المرء بعدما علمت خلق جديد. ويقول العماد الحنبلي عن أخبار الرجال ومآثرهم وسجاياهم، وضرورة حفظ تاريخهم لمافيه من منفعة:”وهذه أخبار رجال أبلوا البلاء الحسن كل في مجاله، وحسب فطرته، جمعت من هنا وهناك لتكون نبراسا يهتدى به، وقدوة تقتدى، فإن حفظ التاريخ أمر مهم، ونفعه من الدين بالضرورة علم، وثبت أن المرء مع من أحب، فكيف بمن زاد على مجرد المحبة بموالاة أولياء الله تعالى وعلمائه، وخدمتهم ظاهرا وباطنا، بتسطير أحوالهم، ونشر محاسنهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم نشرا يبقى على مر الزمان، ويزرع المودة في صدور المؤمنين للاقتداء بهم بحسب الإمكان”. و نختم بما قاله الزركلي صاحب موسوعة الأعلام عن أهمية الترجمة للرجال التي خصص لها بعض المؤلفين موسوعات حسب المهن والتخصصات العلمية فقال:” التراجم والموسوعات المتخصصة تقتصر على تراجم مهنة من المهن، كالاطباء والمهندسين، والقضاة والولاة، والصحفيين والمفتين، والعسكريين والتجار، والمكتشفين والمعلمين… وأخرى بمن اشتهروا بعلم من العلوم كالمحدثين وعلماء اللغة، والفلاسفة والمؤرخين، والثالثة لأتباع دين من الأديان، أوطائفة أومذهب من المذاهب، وهنا تأخذ التراجم اسم الطبقات أو الرجال أو المعاجم” ومن خلال الأقوال السالفة الذكر التي أوردناهاعلى سبيل المثال لا الحصر يتبين لنا أهمية علم الرجال، وقيمته العلمية، في حفظ ذاكرة الأمة، بمافيه من منافع وتجارب وآثار، وكنوز علمية ومعرفية، ومجد زاخر، وتاريخ باهر.
عملية التعريف بالأعلام الجزائريين ما تزال دون المستوى على الرغم من بعض الجهود المبذولة قديمة وحديثا مثل ما فعل الغبريني في كتابه عنوان الدراية، وابن مريم في البستان، ومن المتاخرين الحفناوي في كتابه تعريف الخلف برجال السلف، ما نظرتكم إلى هذه التراجم التي تمت؟
– إن قلة الاهتمام بالأعلام، والتعريف بهم وبآثارهم، ظاهرة قديمة، اشتكى منها العديد من الكتاب الذين اشتغلوا بعلم الرجال، وانحوا باللوم والعتاب على أبناء الأمة في عصرهم، ولاسيما الجزائريين منهم بصفة خاصة، ومن بين المشتكين من هذه الظاهرة المؤسفة المؤرخ الجزائري المغربي عبد الوهاب بن منصور الذي نعى على الجزائريين إهمالهم لعلمائهم ومفكريهم وأدبائهم في مقدمة كتيب ترجم فيه لأحد أعلام وطنه المغمورين بعنوان: (رسائل أبي القاسم عبد الرحمن القالمي) كاتب الدولة الحمادية، ودولة الموحدين- صدر هذا الكتيب عن مطبعة ابن خلدون سنة 1951م بتلمسان- يقول في مقدمته: “… وعفا الله عن أهل المغرب الأوسط فإني ما أظن على وجه البسيطة أمة أتعس منهم في آدابها حظا، أو أعثر منهم في تاريخها جدا، فقد أهملوا أئمتهم وأعلامهم، وزهدوا في أدبهم وحضارتهم، ونسوا عن عمد عظماءهم وكبراءهم، ونفضوا اليد من مشاهيرعصورهم، ومساعير حروبهم، ولم يذكروا بالفخار والإكبار علماءهم وأدباءهم، مثل ما تفعل الأمم الأخرى، حتى أنكر عليهم الخصوم الماضي المجيد، والشرف التليد”. ورغم استفحال الشفهية، وعزوف المثقفين الجزائريين عن الكتابة والتدوين، وجدنا مثقفين نابهين واعين بأهمية الكتابة وتدوين موروث الأمة الحضاري والتعريف بناقليه والمنقول عنهم، في وقت لم تكن وسائل الطبع والنشر موجودة أو سهلة، فما بالك بما هو متاح أوميسور في راهننا هذا الذي يعج بجرائد ومجلات لاتعد ولاتحصي، وإذاعات جهوية فيها حصص ثقافية متنوعة، ودور للطبع والنشر منتشرة عبر ولايات الوطن، وشبكة عنكبوتية تتدفق عبرها المعارف ضخا وإرسالا وتواصلا كأمواج البحار المتلاطمة، وكل معلومة تضخ فيها تنشر عبر أرجاء المعمورة في ثوان معدودة. وبمقدار مافي هذه العولمة الجارفة، من تحديات وأخطار على هوية الأمة وموروثها الحضاري، وخصالها الروحية والأخلاقية، فإنها تمثل طفرة نوعية ومكسبا علميا وتكنولوجيا غير مسبوق في تاريخ البشرية، لمن يحسن استغلاله، ويوطنه وفق ما يخدم مجمتعه ومصالحه العليا، ويوفر العوامل والآليات الكفيلة بحماية أجياله من سلبيات هذه الثورة العلمية، وأخطار العولمة الجارفة.
هناك عقبة يجدها الكاتب في الراهن وهي كيفية إيصال ما يكتب إلى المتلقي، وهذا بسبب تراجع المقروئية . كيف للكاتب أن يتجاوز هذه العقبة؟
– إن ظاهرة العزوف عن كل ماهو ثقافي مطروحة بحدة، ويزداد استفحالها بمرور الشهور والأعوام، سواء في المشهد الثقافي عبر محيطنا الوطني، كدور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة أوالمراكز الثقافية التابعة لوزارة الشبيبة ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وحتى بعض الأنشطة الثقافية التي تنظم داخل المؤسسات الجامعية، تعاني من هذه الظاهرة المؤسفة، والسبب يعود إلى عدة عوامل لعل أهمها فيما أرى مايأتي: ـ عدم اهتمام الأسرة بالشأن الثقافي، وتعويد أطفالها منذ الصغر على حب الكتاب والمطالعة في البيت، ومطالبتهم بتلخيص ما يقرأون، من كتيبات وقصص، ومايشاهدون من أفلام قصيرة، وألعاب، وفتح نقاش معهم، بهدف التصويب والإثراء والتوجيه، حتى يترسخ لديهم حب المطالعة، كحبهم للعب. – وجود خلل في نظامنا التربوي الذي فقدت فيه حصة أسبوعية كانت تعنى بالنشاط الثقافي أدبا ومسرحا ورسما وموسيقى، فعلى ما أذكر أن المؤسسات التربوية في التعليم الثانوي خلال العقدين السادس والسابع من القرن الماضي كانت تفرض حصصا للمطالعة، وتلخيص ما يكلفون بقراءته، والتلاميذ الذين يتمتعون بالنظام الداخلى لهم حصص يومية للمطالعة المحروسة في الأقسام بعد تناول وجبة العشاء. -عدم اهتمام المجتمع ومؤسسات الدولة بالشأن القافي، وتهميش قيمة العلم والفكر، وتثمين مبالغ فيه للاعبي كرة القدم، ورياضات أخرى ولفنانين ومطربين تافهين على حساب قيمة العلم ورمزية كبار العلماء والمفكرين، الأمر الذي رسخ فكرة الزهد، وعدم الاهتمام بكل ماهو علمي فكري، وتقتضي الموضوعية، أن نقر بسلبية المثقف وانسحابه من الساحة، بذرائع وحجج لاتصمد أمام النقد البناء والتحليل العلمي المنهجي الرصين، فالفرص والوسائل المتاحة اليوم أمام الكاتب لإيصال مايكتب إلى المتلقي عديدة ومتنوعة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1-المطابع الموجودة في كل ولايات الوطن
2-الإذاعات الجهوية المنتشرة هي الأخرى عبر البلاد، ولها حصص ثقافية أسبوعية في كل التخصصات.
3-هناك فرص تمحنها وزارة الثقافة والمخابر العلمية في الجامعات لطبع الكتاب الورقي وإيصاله للمتلقي.
4-شبكة التواصل الاجتماعي التي جعلت العالم بمثابة قرية صغيرة أفرادها على تواصل دائم مع بعضهم. فما يدبج قلم الكاتب، أوترسمه ريشة الفنان، أو ينطق به المحاضر، أو يبوح به مبدع، ويضخه عبر هذه الشبكة العجيبة البديعة، ينتشر في ثوان عبر المعمورة بقاراتها الخمس، فأين نحن من الظروف الصعبة التي عاش فيها الكتاب القدماء، الذين لم تكن الوسائل التي ذكرناها متوفرةزلهم، وكانوا يقطعون آلاف الأميال على ظهور الجمال، ويتحملون حرارة الصحاري وأخطارها، من أجل الحصول على معلومة، أوالاستفادة من أحد المراجع؟، ولكنهم كتبوا الأسفارالضخمة في الأكواخ والمغارات والدهاليز، على قناديل بدائية. ولكنني أشاطركم الرأي بأن الكاتب يجدعقبة في إيصال مايكتبه إلى القارئي نظرا لتراجع المقروئية، ولكن ماهومتاح له من فرص ووسائل وإمكانات تجعله قادرا على تجاوز هذه العقبة.
من الجوانب التي يستشعرها المهتمون بتراجم الرجال البعد الهوياتي أو مسألة الانتماء والحضور في التاريخ بما يخدم الهوية، وهو الأمر الذي ذكره الحفناوي في فاتحة معجمه ـ تعريف الخلف برجال السلف ـ كيف العمل في نظركم للحفاظ على هذا الجانب في ظل تحديات العولمة والإعلام الجديد؟
– إن التركيز على البعد الهوياتي والانتماء الحضاري، وإبراز الحضور المتواصل في حركة التاريخ من خلال تراجم الرجال، هو في حد ذاته عملية تاريخية لمسار تاريخي طويل لأولئك الذين، كانوا شهودا ثقاة على ماجرى في تلك المرحلة، ومشاركين في صنع أحداثها، وصوغ مآثرها ومنجزاتها، كل من الموقع الذي كان موجودا فيه، ومن خلال هذه التراجم تتعرف الأجيال المتعاقبة على البعد الهوياتي الذي كرسه التاريخ والدين والبيئة في مسيرة هؤلاء الاعلام، وعلى مدى تمسكهم بالانتماء الحضاري، والاعتزاز به والدفاع عنه، فتهتدي بهم الأجيال في راهنها ومستقبلها، ولذلك نوّه الحفناوي أبوالقاسم محمد في مقدمة معجم تراجمه فقال:«فالظاهر أن القطر الجزائري، قد اجتهد قديما في طلب العلم، بجميع أسبابه، وأتاه من سائر أبوابه، ووفق معقوله ومنقوله، فتمكن من أصوله وفصوله، وكان لعلوم وقته جامعا، ولرايتها رافعا، مثل أخويه المغربيين الأقصى والأدنى، فظهر في الأقاليم بدره اشتهر في التاريخ قدره، بعلماء بنوا تآليفهم على أركان التحقيق، وحصنوها بأسوار التدقيق، فكانوا في عصرهم نجوم اهتداء، وأئمة اقتداء، ولكن طواهم وأضرابهم فلك الانقلاب في مغارب الأفول، فذهبوا ولسان حالهم يقول: تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار» ونظرا لارتباط الأعلام ارتباطاعضويا بتراث الأمة المنقول والمعقول، لأنهم هم الذين قاموابنقله وتحقيقه وإثرائه، أعتنى سلف هذه الأمة بحياتهم وسيرهم لأنها جزء من مسيرة هذه الأمة وذاكرتها الحضارية، في وقت لم تكن هوية الأمة مهددة بأي خطر خارجي مثل ماهي عليه حاليا نظرا للعولمة الجارفة، وتحديات شبكة التواصل الاجتماعي، والفضاء المفتوح وتكنولوجيات علوم الاتصال التي جعلت العالم بمثابة قرية، فإن الاهتمام بتراثنا وتغذية الاجيال بقيمنا وخصوصياتنا الحضارية، وتاريخنا، وتعريفها بسير ومواقف علمائنا ومفكرينا، أصبحت ضرورة وجودية ملحة لحماية هويتنا وأجيالنا من أخطار هذه العولمة الكاسحة، وآثارالإعلام الجديد.
أنتم من الذين اشتغلوا بتراجم الأعلام، كيف تصفون لنا تجربتكم في مجال ترجمة الأعلام؟.
– لا أدعي أنني ترجمت للأعلام وفق ما اصطلح على تسميته بعلم تراجم الرجال، ولكنني قمت بتوثيق سير أئمة وشيوخ زوايا، ومعلمين، قاوموا سياسة فرنسا الاستدمارية التي حاربت الإسلام واللغة العربية بعدوانية وشراسة، وحاولت تغيير مجرى التاريخ في هذاالوطن الغالي، ولمناضلين في الحركة الوطنية ومجاهدين في ثورة نوفمبر حملوا السلاح ضد هذاالمستدمر، وشاركوا في تحرير الوطن، فمنهم من استشهد، ومنهم من كتب الله له الحياة إلى ما بعد الاستقلال، وشارك في تشييد الوطن، وألحقت بهم بعض الأدباء والمهتمين بالتاريخ وفنانين تشكيليين من جيل الاستقلال، مساهمة مني متواضعة لمحاربة ظاهرة إهمال مثقفينا ونسيانهم، وهي ظاهرة سلبية مكرسة في تاريخنا الثقافي، وكثيرا ما اشتكى منها الباحثون والدارسون والمهتمون بالشأن الفكري، ومن بين هؤلاء المشتكين المؤرخ الجزائري المغربي عبد الوهاب بن منصور الذي يقول في مقدمة كتيب له عن أبي القاسم عبد الرحمن القالمي كاتب دولة الحماديين ببجاية، ورئيس ديوان الإنشاء في دولة الموحدين«وعفا الله عن أهل المغرب الأوسط فإني ما أظن على وجه البسيطة أمة أتعس منهم في آدابها حظا، أو أعثر منهم في تاريخها جدا، فقد أهملوا أئمتهم وأعلامهم، وزهدوا في أدبهم وحضارتهم، ونسوا عن عمد عظماءهم وكبراءهم، ونفضوا اليد من مشاهير عصورهم، ومساعير حروبهم، ولم يذكروا بالفخار والإكبار علماءهم وأدباءهم مثل ما تفعل الأمم الأخرى، حتى أنكر عليهم الخصوم الماضي المجيد، والشرف التليد»، وقد واجهتني صعوبات كثيرة أشرت إليها في مقدمة معجمي الموسوم بـ: (أعلام وشخصيات في ذاكرة قالمة) بإمكانكم الرجوع إليها في هذاالمعجم الذي تحصلتم على نسخة منه أثناء الزيارة التي شرفتموني بها مؤخرا في مدينة قالمة.
من الذين ترجمتم لهم الأستاذ الأديب عبد المجيد الشافعي. من هو الشافعي باختصار؟
– عبد المجيد الشافعي أديب جزائري ولد في 22 جويلية سنة 1933 بقرية مغلسة بلدية شلغوم العيد في أسرة محافظة، تشتغل بالفلاحة، والده اسمه إبراهيم الشافعي، وأمه السيدة علجية بولحية، حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه، وتلقى تعليمه الابتدائي في المدرسة باللغتين العربية والفرنسية، ثم التحق بالزاوية الحملاوية، فأتم فيها حفظ القرآن، وأخذ فقه العبادات والمعاملات، ثم شد الرحال إلى جامع الزيتونة بتونس، ومكث به سنوات حتى تحصل على شهادتي الأهلية، ثم التحصيل سنة 1951م وعاد إلى مسقط رأسه، وانخرط في سلك التعليم التابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فعينته بمدرسة لها في شلغوم العيد، ثم نقل إلى مدرستها بالعلمة، ثم إلى مدرسة لها بالرواشد معلما ومديرا لها، وإماما بمسجد القرية. ونظرا لكونه صاحب قلم تفتقت موهبته وهو طالب بالزيتونة، وكتب أول عمل روائي بعنوان:الطالب المنكوب، طبع بتونس سنة،1951م وبعدعودته إلى أرض الوطن كان يكتب مقالات متنوعة، وينشرها في جريدة البصائر، ثم جمعها وطبعها في كتاب تحت عنوان: خواطر مجموعة، كتب مقدمتها الأديب الشهيد أحمد رضا حوحو، الذي ربطته به صداقة أدبية متينة، ولما قررت المخابرات الفرنسية سنة1956م القيام بتصفية أحمد رضا حوحو، أدرج اسم الأستاذ عبد المجيد الشافعي وصديقه المؤرخ سليمان الصيد في القائمة، ولما ذهبوا لإلقاء القبض عليه في الرواشد لم يجدوه، لأنه كان في ذلك الوقت لدى أسرته بمغلسة، ولماعلم بخبر قدوم رجال الدرك الفرنسي للبحث عنه، وسمع باختطاف صديقه أحمد رضا حوحو ليلا من منزله، ولم يظهر عليه أي خبر، فر إلى مدينة قالمة، ومكث بها مدة، ثم اتصل به ممثل جبهة التحرير سرا وأعلمه أن الثورة تطلب منه الالتحاق بفدراليتها بفرنسا، فذهب إلى فرنسا، وأسندت إليه المهمة التي كلف بأدائها، فقام بها على أحسن ما يرام، ولكن علمت المخابرات الفرنسية، به، وبالنشاط الذي يقوم به في وسط العمال الجزائريين المهاجرين بفرنسا بصفة سرية لصالح الثورة، فقررت إلقاء القبض عليه وتصفيته، وعلم نظام الثورة بفرنسا بذلك فطلب إليه مغادرة فرنسا فورا وساعده على ذلك، فعاد إلى مدينة قالمة على الراجح سنة1959م فوجد أن فرنسا فتحت المجال لتعليم اللغة العربية في مدارسها الرسمية بمقتضى برنامج ديغول الجهنمي بأبعاده العسكرية، والاجتماعية، والسياسية والإعلامية، والديبلوماسية لإحداث قطيعة بين الشعب والثوار، والقضاء النهائي على هذه الثورة. فاشتغل بالتعليم بمدينة قالمة إلى سنة 1962م وفي مطلع الاستقلال عين مديرا لمدرسة الفتح، وفي سنة 1968م عين مستشارا تربويا وفي سنة 1971م كلف بمهام التفتيش للتعليم الابتدائي بدائرة قالمة، وتآمر عليه اللوبي الفرنكوفيلي، فألغي تكليفه بهذه المهمة، وعاد إلى منصبه الأصلي مستشارا تربويا، وظل يعاني من هذا التيار إلى أن وافاه أجله المحتوم يوم 23 نوفمبر 1973م بمدينة قالمة، فنقل جثمانه الطاهر إلى مسقط رأسه، ودفن بمقبرة مغلسة بلدية شلغوم العيد.
ما طبيعة إسهاماته في خدمة الأدب الجزائري والثقافة الإسلامية في الجزائر؟
– يعد عبد المجيد الشافعي من أبرز أدباء الجزائر الذين ظهروا في النصف الثاني من القرن الماضي، ويراه بعض الدارسين والنقاد بأنه أول من كتب منتجا أدبيا يحمل ملمح الرواية في الأدب الجزائري المعاصر، فقد كتب القصة الأدبية وتفوق فيها، وعندما نظمت جريدة النصربعد تعريبها سنة 1972م مسابقة أدبية في فن القصة شارك فيها ونال الجائزة الأولى، وكتب مسرحيات وقام بإخراجها، ومثلت على خشبة المسرح المدرسي، قبل الثورة وفي مسرح مدينة قالمة في عهد الاستقلال، وكتب المقالات ذات المضامين التاريخية والتربوية والأخلاقية والاجتماعية، في كتابه الموسوم بـ (خواطر مجموعة)، وكتب المقال السياسي التحليلي، والفكري والنقدي في كتابه الموسوم بـ(الأديب الشهيد) الذي ترجم فيه لصديقه الأديب الشهيد أحمد رضا حوحو، وهو العدد الأول من سلسلة سبيل الخلود التي أنشأها سنة 1964م مع العلامة الشيخ عبدالله بورا.