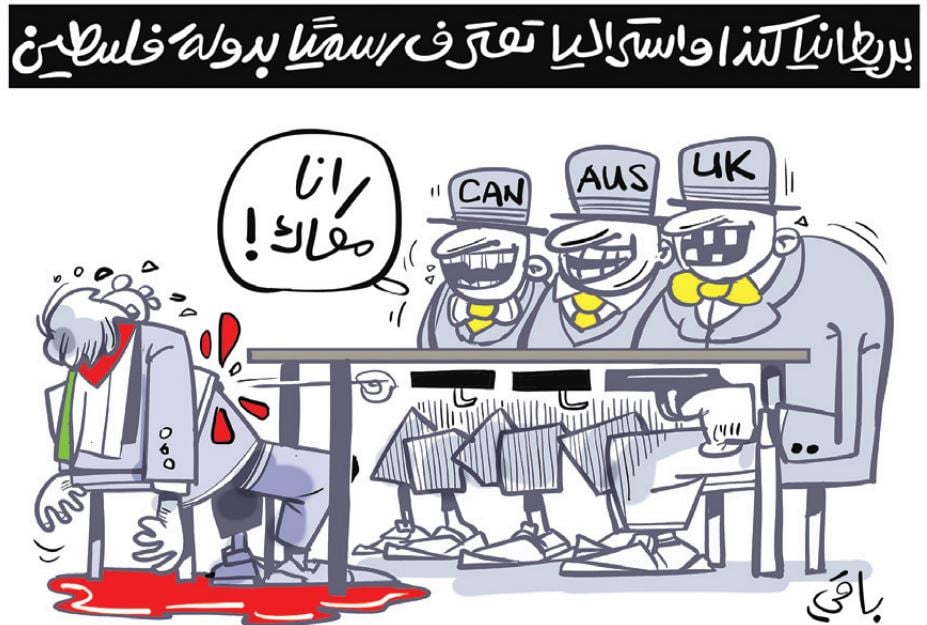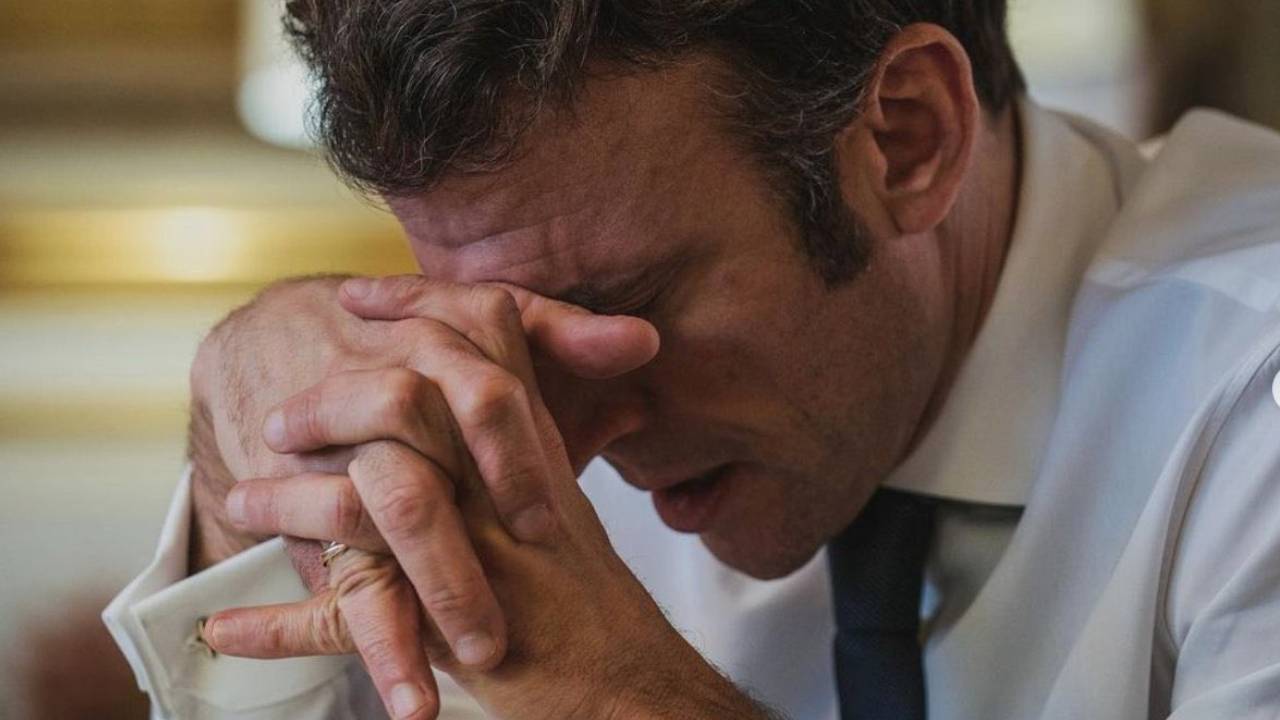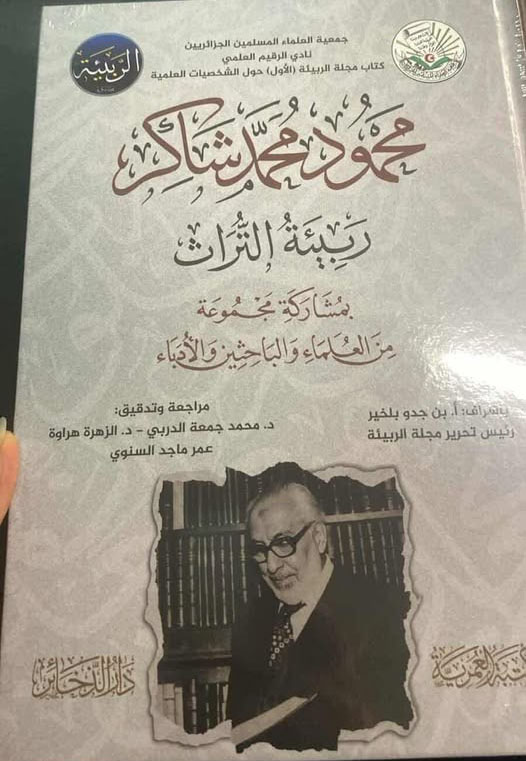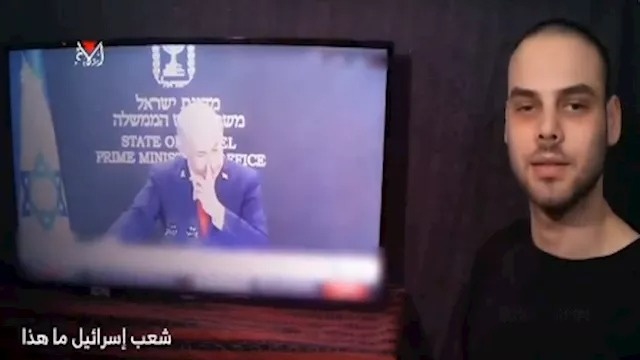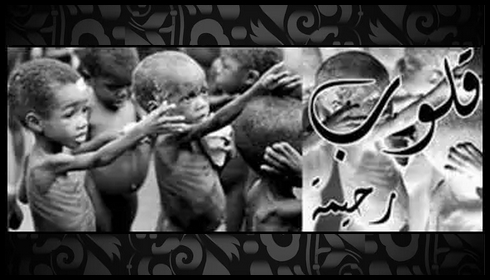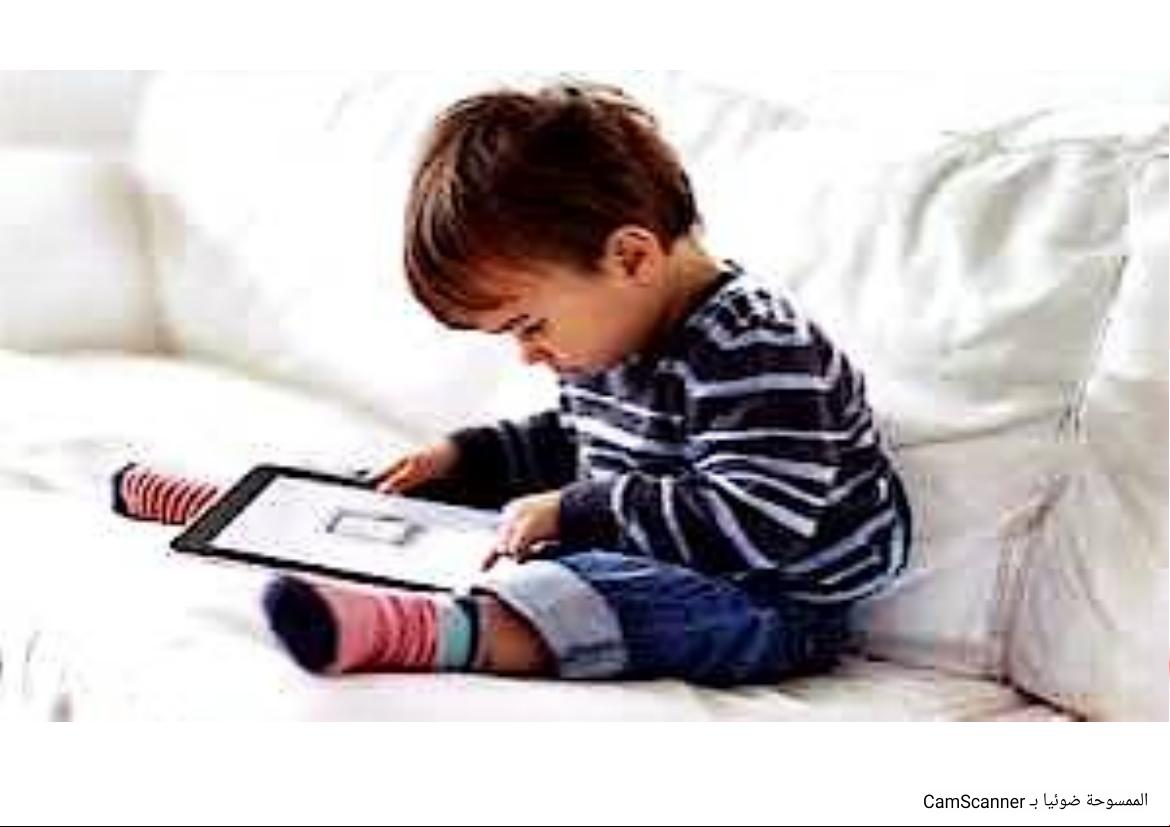أوقاف القنيعي الرجل الذي أوقف الدنيا ليربح الاخرة
د. بن زموري محمد/ في زوايا التاريخ، تختبئ أسماء لامعة لم تلمع، وأيادٍ باسلة لم تُرفع لها رايات، لأن أضواء الشهرة لا تُنصف دائمًا من يعمل في صمت ويهب في خفاء. ومن بين هؤلاء العظماء، يبرز اسم الحاج عبد الرحمن القنيعي، الرجل الذي لم يخلّده المنبر ولا القلم، بل خلّدته وثائق الوقف ودموع الفقراء وركعات …

د. بن زموري محمد/
في زوايا التاريخ، تختبئ أسماء لامعة لم تلمع، وأيادٍ باسلة لم تُرفع لها رايات، لأن أضواء الشهرة لا تُنصف دائمًا من يعمل في صمت ويهب في خفاء. ومن بين هؤلاء العظماء، يبرز اسم الحاج عبد الرحمن القنيعي، الرجل الذي لم يخلّده المنبر ولا القلم، بل خلّدته وثائق الوقف ودموع الفقراء وركعات طلبة الزوايا. لقد قدّم هذا الرجل نموذجًا جزائريًا أصيلًا في البذل والإيثار، حين قرر أن يجعل من كل ما يملك وقفًا لله، لا يُورث ولا يُباع، بل يظل حيًّا في خدمة الضعفاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الحديث عن القنيعي ليس مجرد نبش في الماضي، بل هو استدعاء لقيمة كادت تغيب، ودعوة لإحياء ثقافة الوقف التي صنعت حضارة واحتوت معاناة. فكيف عاش القنيعي؟ ولماذا أوقف ثروته كاملة؟ وكيف أصبحت أوقافه درعًا اجتماعيًا في وجه الفقر والتهميش؟ هذا ما تسعى السطور القادمة إلى الكشف عنه، في رحلة عبر أحد أكثر النماذج الوقفية إدهاشًا في تاريخ الجزائر.
ولد الحاج عبد الرحمن القنيعي في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وينحدر من قبيلة بني قنيع، وقد هاجر إلى قصبة الجزائر حيث بزغ نجمه كتاجر نشيط وصاحب حرفة نافعة، فتنوّعت تجارته بين الحبوب والملابس والجلود، واستطاع في سنوات قليلة أن يكوّن ثروة معتبرة بلغت نحو مليون فرنك فرنسي، وهي ثروة ضخمة آنذاك. غير أن ما ميّز هذا الرجل لم يكن غناه، بل اختياره أن يجعل المال وسيلة لبلوغ المراتب العُليا في العطاء، لا غاية يتباهى بها في المجالس. ففي سنة 1861، وقف القنيعي أمام القاضي في محكمة الجزائر الشرعية، وأعلن أنه يوقف كل ما يملك من عقارات وأموال وأوانٍ وملابس وحتى أدوات الاستعمال المنزلي، وجعلها جميعًا وقفًا دائمًا لله تعالى، لفائدة الفقراء والمساكين والمكفوفين وطلبة القرآن الكريم، في العاصمة الجزائرية وفي مدينة البليدة، خاصة بجامع سيدي عبد الرحمن الثعالبي، والجامع الأعظم، وزوايا التعليم الشرعي.
وقد حرص القنيعي على توثيق هذا الوقف، فقام سنة 1866 بتحرير عقد رسمي مفصل، حدد فيه آليات الإشراف والمراقبة، وقيّده بأن يبقى تحت إدارة القاضي والمفتي المالكيين دون غيرهما، رافضًا أن يكون الوقف تابعًا لأي جهة سياسية أو إدارية، وهو ما يدل على وعيه السيادي والحضاري في الحفاظ على استقلالية المال الوقفي وضمان صيانته من التلاعب. ومن أهم المشاريع التي أنجزها بأمواله الموقوفة كانت «دار الصدقات» قرب مسجد كتشاوة، وهي مؤسسة اجتماعية تستقبل المحتاجين وتؤويهم وتطعمهم وتكسوهم دون أن تنتظر منهم جزاء ولا شكورًا، وقد وُضعت لها ميزانية مستقلة ضمن الأوقاف التي خلّفها، واستمرت في أداء دورها حتى بعد وفاته.
وفي سنة 1868، غادر القنيعي الدنيا، ولم يترك وراءه أبناء يرثون ثروته، بل خلّف ميراثًا خالدًا من العمل الخيري والوقف النقي. وبعد وفاته، حاولت سلطات الاحتلال الفرنسي تغيير معالم وقفه، فأعادت تسمية «دار الصدقات» باسم «المكتب الخيري الإسلامي»، لكن بعض المحسنين من أبناء الجزائر سعوا سنة 1945 إلى إعادة الاعتبار للوقف وإحياء اسمه الأصلي. لقد كان عبد الرحمن القنيعي مدرسة قائمة بذاتها في فقه الوقف وروح الإحسان، ومثالًا حيًّا للغِنى الذي لا يُفسد، وللثروة التي لا تُقعِد صاحبها عن البذل، بل تحوّله إلى لبنة في صرح الأمة.
وإن من أكبر ما يلفت في قصة القنيعي، ليس فقط حجم الوقف الذي قدّمه، بل نوعيته ودقته واستقلاليته، فقد كان يدرك أن الوقف لا يكتمل إلا بحسن التوجيه وصحة الإدارة وضمان النزاهة والاستمرار. ولذلك، كانت أوقافه تشبه المؤسسات في تنظيمها، وتفوقها في روحها وتكافلها. واليوم، إذ نعود إلى سيرته، فإننا لا نقرأ مجرد قصة تاجر خيّر، بل نقرأ سيرة بناء اجتماعي قائم على الرحمة، ونستعيد صورة الجزائر التي لم تكن بحاجة إلى ميزانية دولة لتُطعم جائعًا أو تؤوي مسكينًا، بل كان فيها رجال يحمِلون المجتمع في قلوبهم، ويوقِفون دنياهم لآخرتهم.
في زمن تعاظمت فيه الفردانية، وضعفت فيه روح الوقف، تذكّرنا قصة الحاج عبد الرحمن القنيعي أن أعظم صدقة هي تلك التي لا تُلتقطها عدسات الكاميرا، بل تحفظها صفحات القضاء، وتشهد بها دموع الفقراء. وأن المال إذا صادف قلبًا كبيرًا، أصبح جسرًا إلى الخلود، لا إلى الفناء. فسلامٌ على القنيعي، وعلى كلّ من فهم أن البرّ لا يُشترى، بل يُؤسّس ويُوقف ويُترك لله خالصًا لا تشوبه شهوةُ سُمعة ولا رغبةُ جزاء.