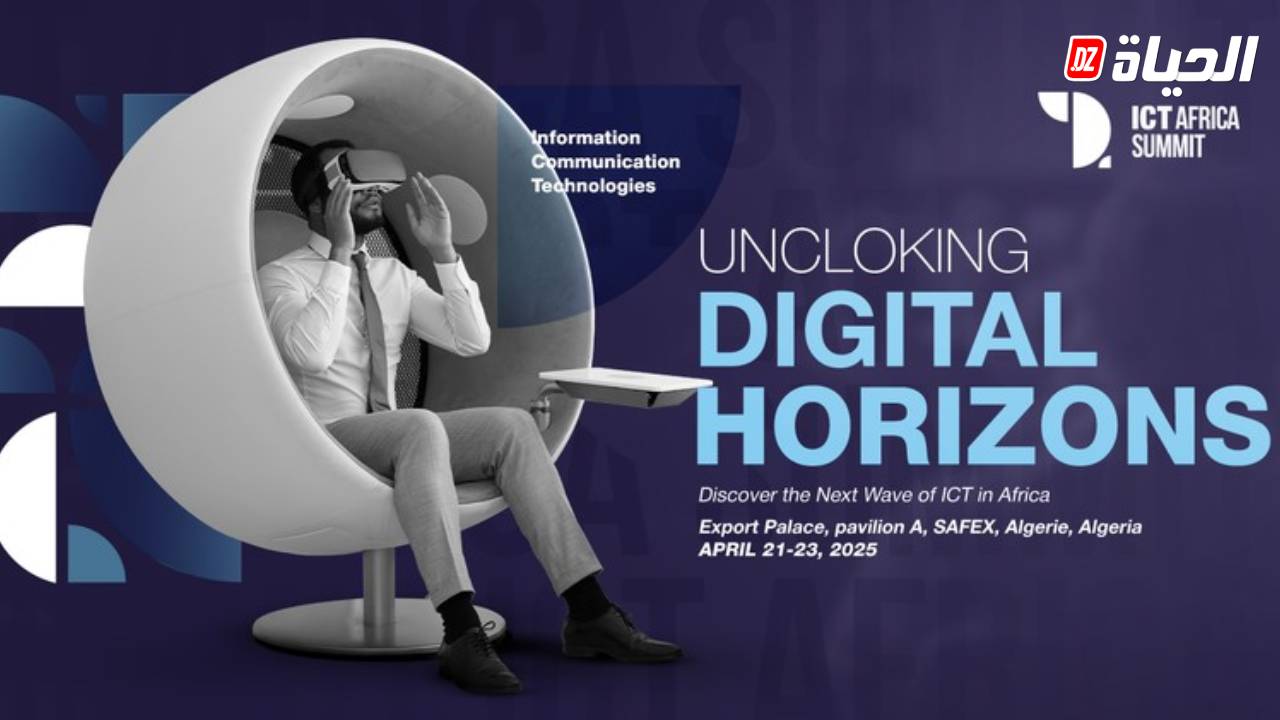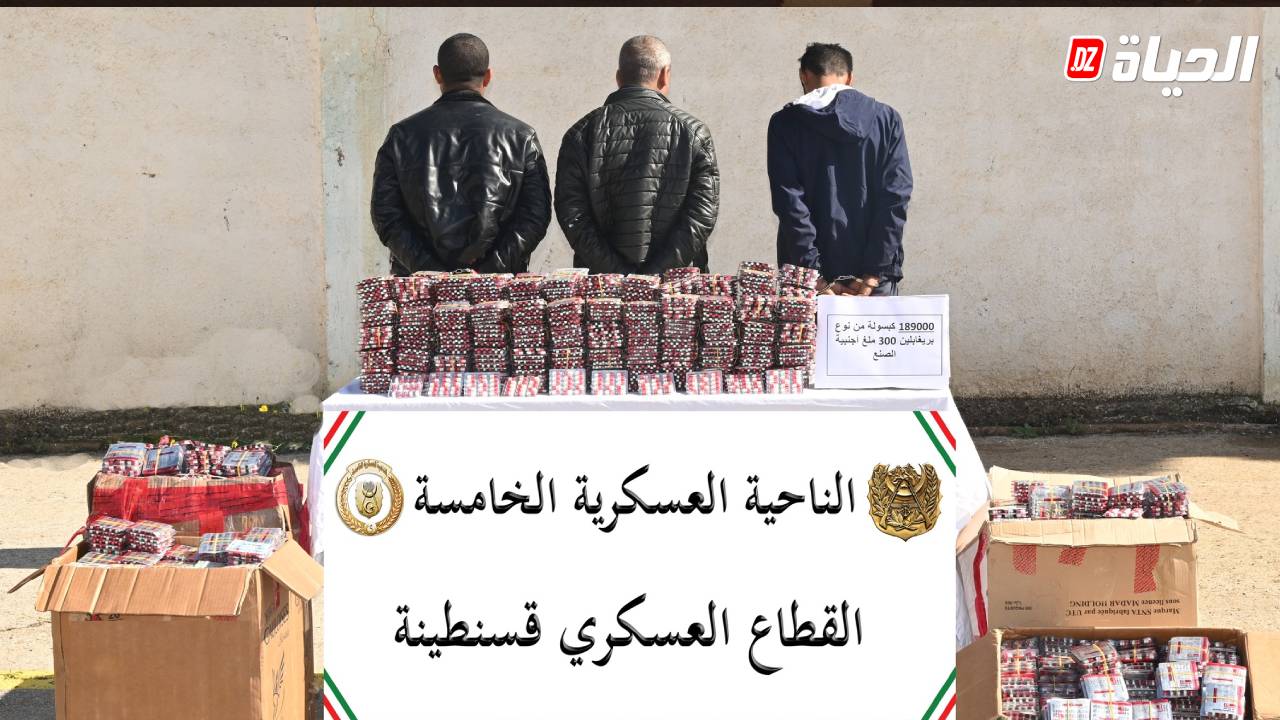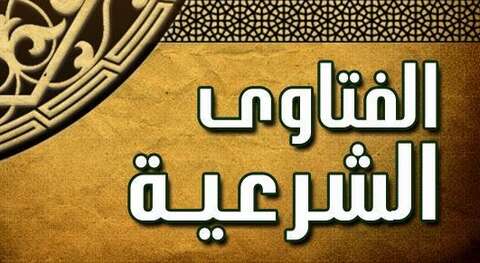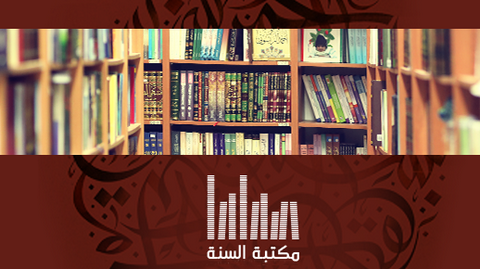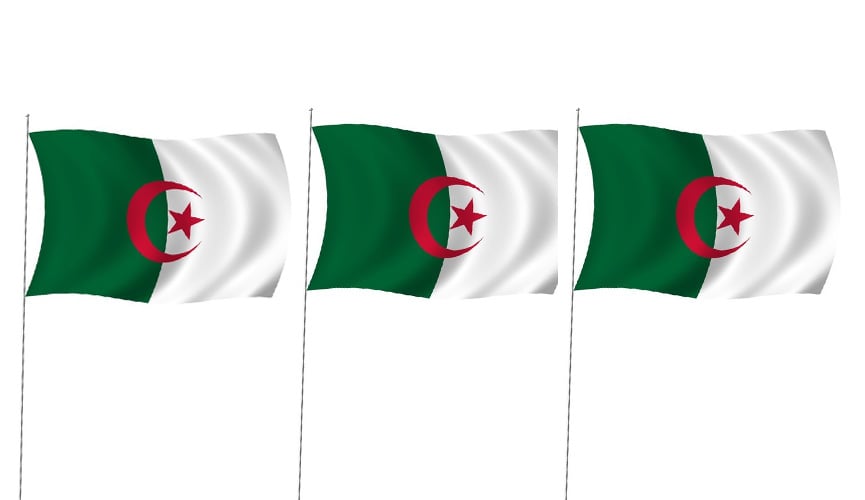مشاغبات لتسفيه خبرة الأمة
د. مسعود صحراوي/ من نكد الأيام على علم اللغة وعلم التفسير معا في عصرنا أن ترى الأكاديمي صاحب الشهادة الجامعية الأعلى يخالف أبجديات المنهج العلمي فيقع في شباك المنصات المشبوهة المتهمة بالإساءة لخبرة الأمة العلمية… هذا إن لم يكن مختارا متواطئا لا مكرها، أما إذا حدث فتلك أكبر من أختها. القضية أن أحد الدكاترة في …
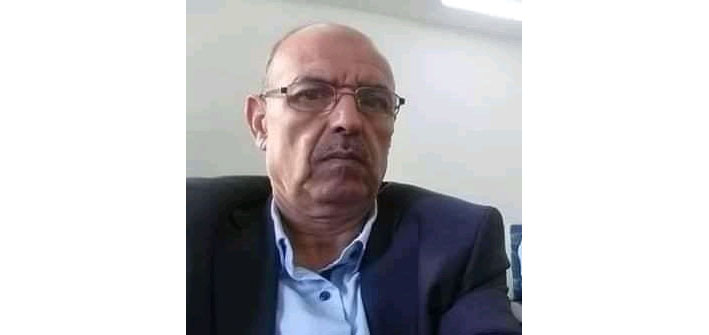
د. مسعود صحراوي/
من نكد الأيام على علم اللغة وعلم التفسير معا في عصرنا أن ترى الأكاديمي صاحب الشهادة الجامعية الأعلى يخالف أبجديات المنهج العلمي فيقع في شباك المنصات المشبوهة المتهمة بالإساءة لخبرة الأمة العلمية… هذا إن لم يكن مختارا متواطئا لا مكرها، أما إذا حدث فتلك أكبر من أختها.
القضية أن أحد الدكاترة في علم اللغة (هكذا قدّم نفسه) تابعتُ برنامجه الحواري منذ يوميْن (عنوانه التطور الدلالي للألفاظ في القرآن) وقد نزل ضيفا على منصة بدأت تبث حصصها وتشتهر شيئا فشيئا في الآونة الأخيرة، جاعلة هدفها المعلن «نقد» تراث الأمة وتقزيمه وبخسه بإبطال مقولاته وتفنيد الأسس التي قام عليها (بزعمهم)… أما خلفيات هذه المنصة ورعاتها ومموّلوها فأمور لا أعلمها الآن فلا أتحدث فيها، لذا سأتناول في هذا المقال الموجز ما سمعت وشاهدت من جانب علمي محض، بعد أن شاهدت حصتيْن أو ثلاثا قبله… وأسجل الآن ملاحظات سريعة إلى أن تُتاح الفرصة للعودة والتوسع أكثر.
ما يفاجئ المستمعَ الواعي -فضلا عن الباحث المتخصص- من غرائب الحوار أمران: الأول أن المتحدث الدكتور المستضاف وصاحب البرنامج قلما يتحفظان التحفظ العلمي المطلوب في مناقشة القضايا الكبرى، فكثيرا ما يقعان في تعميمات وإطلاقات عجيبة، بل كثيرا ما يتحول مدير البرنامج -الذي يعرف كيف «ينتقي» ضيوفه بل كيف «يصطادهم» ليكونوا -جُلُّهم من «لون» واحد – أقول: يتحول إلى موجِّه لضيوفه فيضع على ألسنتهم كلمات وهم يرددونها وراءه فيُملي الآراء والكلمات و»ضيوفه» تابعون له ومرددون -من ثلاث حلقات تابعت نصفها وأكثر قليلا- لكن عليّ أن أستثني من هذا الحكم الباحث القدير «صلاح الدين الشريف» الذي تنبّه إلى إستراتيجية البرنامج فلم ينسق في سلوكه التشغيبي النافي للتراث وللآراء المستقرة، دون تمييز ولا غربلة نقدية علمية مع اختزال للقضايا وتسرّع في إصدار الأحكام… بل بنَفَس إيديولوجي قلما يبني، ومن ذلك أن مدير الحصة عقب على كلام الضيف بوضع عبارة على لسانه: «هذا ما أفتى به العقل التراثي» فوافقه الدكتور الضيف قائلا: «بالضبط»، وقد تكرر هذا أكثر من مرة في الحصص التي شاهدتها.
الثاني: اتباع سلوك استدلالي غريب يقوم على استنتاجات ساذجة ومغالطات -مع في كلامه من إيجابيات قليلة – منها قوله ما دام أن «ما وصلنا مما قالته العرب من شعر ونثر شيءٌ قليل» فكيف يصح أن نبني عليه قواعد وأنظمة لغوية ونظريات في علم النحو والتراكيب والدلالات وغيرها ونطبقها في تفسير القرآن… وهذه العبارة لأبي عمرو بن العلاء قالها في معرض آخر وسياق مختلف غير ما وظفها فيه الدكتور المتحدث. ثمّ ناقض نفسه بعدها بدقيقة أو دقيقتين فحينما طرح عليه مقدم البرنامج سؤالا لغويا أجابه بسرعة ودون تردد: «لسان العرب هو الذي يحكم علينا» (وهذه إجابته حرفيا)، ثم راح يستشهد بابن جني معجبا بفهمه اللغوي! ونسي أن ابن جني أقام علمه كله ومؤلفاته كلها على هذا «القليل الذي وصلنا مما قالته العرب» وكذلك فعل أبو عمرو صاحب العبارة فقد طبق مما جمعه على اللغة العربية والقرآن الكريم، وأجاب عن سؤال سائل: ما تفعل فيما خالفتك فيه العرب؟ قال: أعمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات!
هذا صنيع أبي عمرو بن العلاء صاحب العبارة الشهيرة وصنيع ابن جني الذي اعترف المتحدث بثقوب فهمه، وكلاهما من تراث الأمة بل من أئمتها الكبار!
مما لاحظته -خلال الوقت الذي تابعت فيه المتحدث رجاء الخروج بفائدة علمية من الحوار- أمور:
-أن المتحاوريْن متواطئان على بخس الخبرة العلمية للأمة -ولا سيما مدير البرنامج – ويُحاولان جهدهما تسفيه الآراء العلمية البديعة الممتدة طوال قرون وتضليلها، حتى ما كان منها مؤسَّسا تأسيسا علميا رصينا.
-أنهما يجهلان أو يتجاهلان الفرق-في نطاق المعارف الدينية الإسلامية – بين أمريْن: بين الإسلام الشرعي المؤسس علميا المتفق عليه بين أهل العلم وبين «الإسلام الشعبي» وما يحمله الأخير من مخيال اجتماعي ابتدعته الشعوب ومن خصائص ثقافية ومواضعات أنتروبولوجية، من شأنها صناعة نموذج ثقافي خاص متميز… وهذا يُسمى «تدينا» ولا يُسمّى «دينا».
– وهذا «التدين الشعبي» ليس حجة على الإسلام الشرعي إنما هي تطبيقات بشرية شعبية تصيب وتخطئ، وتبتعد عن النموذج وتقترب منه، والحكمُ عليها إنما يكون بالنصوص المحكمة في القرآن والسنة النبوية الشريفة الصحيحة وبمناهج فهم علمية ثقّفتها التجربة التاريخية طوال قرون ممتدة.
– الدكتور الضيف يبالغ في مسائل فرعية، منها: تضخيم ظاهرة الاعتداد بمعاني الحروف المفردة خارج السياق ويَبني عليها منهجا في التفسير، وأصلُ هذه الفكرة جاء به القدامى الخليل وسيبويه ثم تبعهما فيها ابن جني وعقد لها بعض الفصول في «الخصائص» «منها: تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني/ إمساس الألفاظ أشباه المعاني»… وابنُ جني نفسه بالغ وتكلّف في تعميمها على أمثلة من نماذج الأفعال التي ذكرها، وقد تعقّبه صبحي الصالح رحمه الله وبيّن جوانب الضعف في تعميمات ابن جني بطريقة علمية محققة، وأيّده في قليل منها، وحاول السيوطي متابتعهم فيها في «المزهر»، وكان موقف الإمام الجرجاني مناهضا لهذه المبالغات، وممن قال بها من المعاصرين أيضا أحمد الأخضر غزال -رحمه الله – لكنه لم يُخاطر مخاطرة صاحبنا… بل لقد صار هذا البحث جُلُّه أقربَ إلى الفلسفة منه إلى العلم الإجرائي، وعبارة الأستاذ غزال الشهيرة «فلسفة الحركات».
-أنهما يستبطنان سوء ظن بالعلوم العربية الإسلامية وبعلماء الأمة، ولا سيما صاحب البرنامج وهو أيضا دكتور (كما يُقدّم)، فينتهز كل فرصة لرمي تلك العلوم بالخطأ والنقص، وخصوصا: علم اللغة، وعلم التفسير، وعلم الفقه… وهذا بلا شك تحيّز ثقافي ضدّ خبرة الأمة وخللٌ في الرؤية والمنهج لأنه تعميم بلا استقراء كاف ورميٌ في عماية، والتعميم من دون الاستقراء الكافي خطأ منهجي غير مقبول.
الخطأ في الميزان: هذا وإن تصوّرهم لمسألة «التراث/الحداثة» بالشكل الذي يقدّمون مع مفاضلتهم بين القديم والحديث مُستقًى من وعاء مختلط غير منخول، وذهابُهم إلى تفضيل الحديث مطلقا وتقديمُهم له على القديم دائما وفي كل الأحوال لا لشيء إلا لأنه حديث، ورفضُ القديم ونفيُه وتسفيهُه لا لشيء إلا لأنه تراثي وقديم… هذا كله ميزان خاطئ وتلك قسمة ضيزى، ولا يستقيم هذا علميا، والعلمُ اللغوي خصوصا والمنهجُ العلمي عموما لا يقبل هذا النمط من الفكر الإيديولوجي المنحاز، إنما يُفضَّل القديمُ إذا كان مؤسسا تأسيسا علميا صحيحا، ويُترك ويُطرح إذا غير ذلك، وكذلك يُتعامَل مع الحديث بنفس المعيار. فالعبرة ليست بما تقدم وما تأخر، بل بالصواب وباستقامة المنهج أينما وُجد ومهما كان قائله… وإلاّ لبطل كلّ تراث البشرية وجميع أنساقها المعرفية وجلّ إبداعاتها ومظاهر عبقريتها.