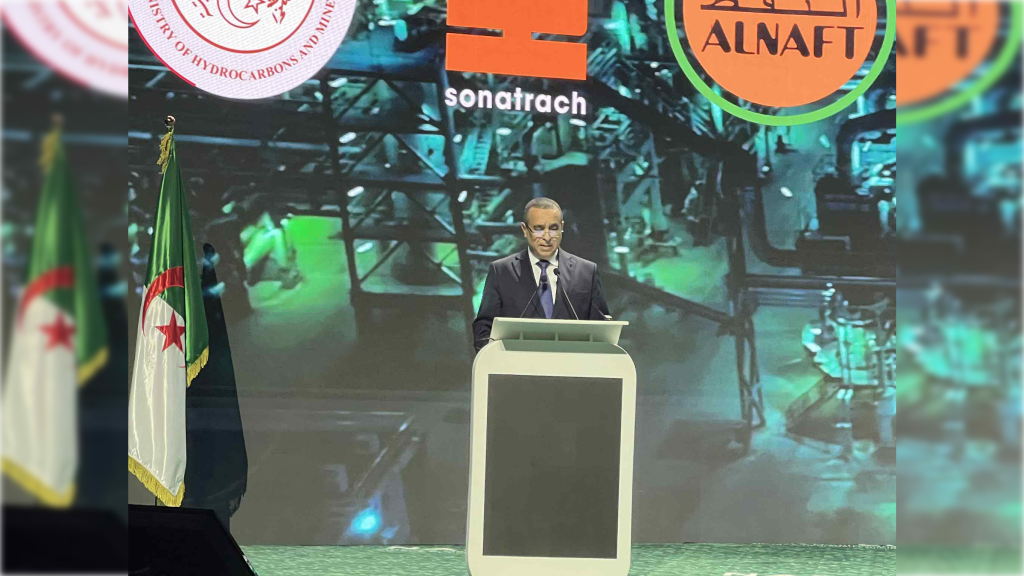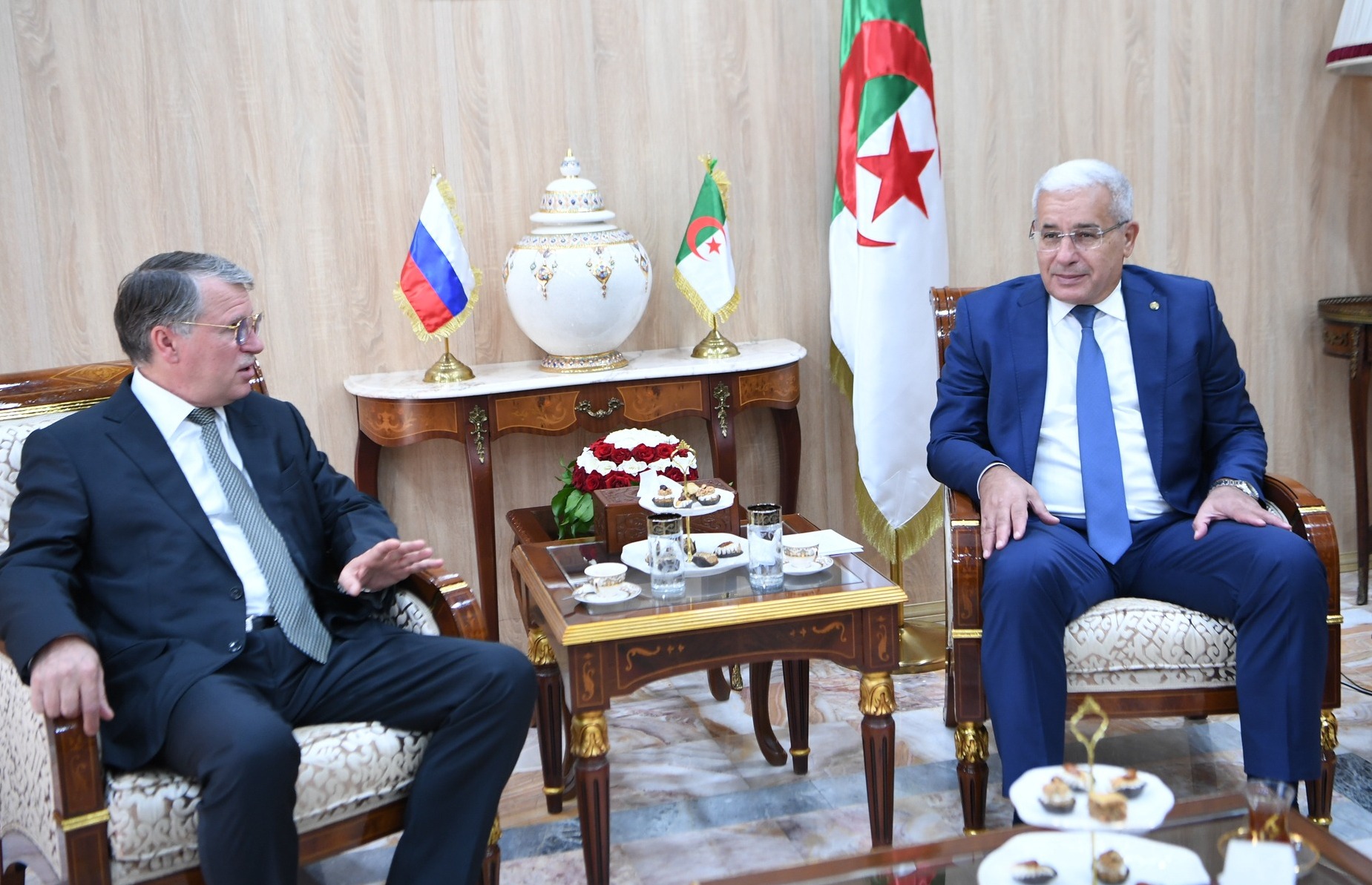الجامعة الجزائرية: من وفرة الكم إلى سؤال الكيف وصناعة المعنى
أ.د.إسماعيل سامعي*/ الجامعة الجزائرية مرت بمرحلتين: الأولى مرحلة العهد الاستدماري منذ تأسيسها عام1907م. حيث كانت جامعة كلونيالية نخبوية بعيدة كل البعد عن أهداف وطموحات الشعب، على الرغم من أنها أقيمت على أرض الجزائر، واستوعبت عددا قليلا من أبناء الشعب، ومن هذا القليل غالبية من أبناء الموالين للاستدمار الذي لون عددا منهم بثقافة المستدمر، ومنهم من …

أ.د.إسماعيل سامعي*/
الجامعة الجزائرية مرت بمرحلتين: الأولى مرحلة العهد الاستدماري منذ تأسيسها عام1907م. حيث كانت جامعة كلونيالية نخبوية بعيدة كل البعد عن أهداف وطموحات الشعب، على الرغم من أنها أقيمت على أرض الجزائر، واستوعبت عددا قليلا من أبناء الشعب، ومن هذا القليل غالبية من أبناء الموالين للاستدمار الذي لون عددا منهم بثقافة المستدمر، ومنهم من تزوج بنسائه، وثلة نادرة هي التي استطاعت أن تسلم من الذوبان، وتسهم في بلورة الحركة الوطنية الاستقلالية في نفوس الجزائريين، وتعطي نفسا لثورة التحرير في عديد المجالات كالطب، والقانون، والنضال السياسي والجهد الديبلوماسي، ولذلك لا يمكن القول أن الجزائر غداة استرجاع الاستقلال الوطني عام1382هـ/ 1962م قد ورثت جامعة، بل ورثت هياكل أسمنتية أتلف وأحرق ما بداخل جدرانها.
ومن المعلوم أنه في بداية السبعينيات من القرن 20م، أقيمت هياكل جديدة في إطار الهوية الوطنية، وحركة التنمية الشاملة، وبعد الإصلاحات الهيكلية، والبيداغوجية، والتقنين لها، وأيضا بعد التحولات في قطاع التعليم الابتدائي والثانوي إذ بنيت العديد من المدارس والثانويات في المدن والأرياف في إطار ديمقراطية التعليم ومجانيته، واستقلالية التعليم المتوسط عن النظام السابق الثانوي، وتم كذلك تعديل المناهج، والبرامج، بالإضافة إلى الخارطة المدرسية والتربوية والإدارية بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة والمتعلقة بالوطن، جاءت الإصلاحات الهيكلية الجذرية الحاسمة لتطوير المنظومة التربوية التي بلورتها أمرية رقم76-35 لعام1396هـ/ 1976م، والميثاق الوطني1396هـ/ 1976م. ومن هنا أخذت معالم الجامعة الجزائرية تبرز للعيان في هياكلها كجامعة قسنطينة، ووهران، والجزائر، وبدأ معها الانفتاح على قضايا المجتمع، ومسايرة أهداف التنمية الاقتصادية، لاسيما المخططات؛ لذلك يمكن القول من هنا اعتبار الجامعة الجزائرية «جامعة شعبية» لإبراز تراث الأمة وهويتها، وبلورة سيادتها واستقلال قراراتها، وخدمة مصالحها، وتطورها في كافة المجالات؛ وفي الوقت نفسه، واجهت الجامعة الجزائرية العديد من الصعوبات استطاعت تذليلها والتغلب على الكثير منها، وحققت الكثير من الأهداف والإيجابيات، وقد نتج عن هذا التطور عدد من النقائص نحوصلها في الآتي:
أولاـ الصعوبات:
1- نقص التأطير البيداغوجي: فغداة الموسم الجامعي 1962- 1963 كان عدد الطلبة 2725 ونسبة التأطير من الجزائريين9.1%، وارتفع هذا العدد سنة1970-1971 إلى 19311 ليصل اليوم إلى قرابة الملونين طالب، وارتفاع طفيف بالنسبة للتأطير14.2%. وكانت الجزائر لجأت بعد المخطط الثلاثي، وفي إطار ديمقراطية التعليم وتعميمه إلى التعاون الأجنبي. (انظر، الرئيس هواري بومدين-التربية والتعليم- مطبوعات جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية – قسنطينة 2004، ص،118 مقال ع بن عراب).
2- النقص الكبير في هياكل الاستقبال البيداغوجية والخدماتية، والتجهيزات، وكان اللجوء إلى هياكل غير مؤهلة للتدريس، والبحث العلمي؟
3- ضعف ونقص التسيير الإداري للجامعة.
ثانيا-الإيجابيات:
1- فتح الجامعة أمام كل أبناء الشعب في إطار تطبيق مبدأ ديمقراطية التعليم، ومواجهة الحرمان الذي عاناه الجزائريون لمدة 132 سنة من الاستدمار الغاشم، وبعد القفزة الكمية والنوعية التي تلت المخطط الثلاثي 1967 -1969 في مجال التعليم الابتدائي والثانوي حيث أخذ الإقبال على الجامعة يشكل ضغطا متزايدا، خاصة وأن هذا الفتح لم يكن لحاملي شهادة البكالوريا فقط. بل عمم لفئات أخرى.
2- استطاعت الجامعة، وفي ظرف قياسي تكوين وجزأرة إطاراتها من المدرسين، ومتطلبات التنمية الوطنية. حتى أن عددا من خريجها اليوم يؤطرون كبريات الجامعات في العالم، وكمثال على ذلك جامعات الخليج العربي، والأطباء في فرنسا، والعلماء والباحثين والمبتكرين في أمريكا…؟
3- توسع الجامعة الجزائرية إلى جامعات ومراكز جامعية ومعاهد ومدارس عليا غطت معظم أنحاء الوطن.
4- تغلبت الجامعة بشكل كبير في مشكلة نقص هياكل الاستقبال خاصة الخدماتية كالإقامات والنقل، والتجهيزات البيداغوجية والعلمية، لاسيما المكتبات.
5- تجديد مناهج التعليم وبرامجه دوريا، وتأصيلها أو جزأرتها عن طريق الخبراء من الأساتذة، واللجان البيداغوجية والعلمية.
6-تطور البحث العلمي تمويلا وتنظيما، وربطه بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
ثالثا-النقائص:
1- تنوع التعليم وفائدته في نوعية وإثراء الفكر والتفكير. إلا أنه سرب أيديولوجيات متنوعة للطلاب وللمجتمع يتطلب وقتا للتخلص منها؟!
2- طيلة 50 سنة لم تستطع الجامعة ربط نشاطها بالمحيط الاقتصادي في مجال الابتكارات، وتطبيق البحوث المنجزة لاسيما في المجالين الفلاحي والصناعي؟
3- الطابع الشعبي للجامعة جعل عددا ممن يلتحقون بها من الطلبة والمؤطرين الأساتذة ليست لهم القدرة ولا الخبرة على التحصيل النوعي، والعطاء العلمي. خاصة وأن معين تزودها مرحلتي التعليمين الابتدائي والثانوي، لا ترتبط به بشكل تكاملي وعضوي، مما جعل عدد هذا المعين أقل مستوى إذا لم يكن ضعيفا؟ ناهيك عن قلة وانعدام الدراسة التطبيقية الميدانية.
4- حسب ما يلاحظ أن عملية التقييم والتقويم في الدراسة الجامعية، وفي البحث العلمي ليست في المستوى المطلوب والمرغوب، وتخضع للضغط العددي، ولبعض الشكليات وللذاتية رغم وجود معايير مقننة.
5- انتشار الجامعات والمراكز الجامعية دون تأطير ولا وسائل بيداغوجية أسهم في ضعف التحصيل العلمي.
6- الخدمات الجامعية التي وفرت الإقامة والإطعام والنقل إضافة إلى المنحة تركت في عدد من الطلبة عدم الاهتمام بالتحصيل العلمي، كما تحولت الخدمات هذه إلى هيكل مواز للهيكل البيداغوجي والعلمي وليس مكملا له ويخدمه.
7- النظام البيداغوجي المعتمد على التلقين رغم الجهود الإصلاحية مع النظام الجديد ل. م. د، وهذا يعود بالأساس إلى عدم الكفاءة العلمية لبعض الأساتذة المكونين، وتكوينهم، حيث الأستاذية عندهم عبارة عن وظيفة يسترزق منها، وسكن يحصل عليه،
8- رغم ما تنفقه الدولة من مال على البحث العلمي في الجامعة، ورغم ما أنجز من هياكل وما وضع من قوانين ومعايير فإنه يلاحظ عليه بعض النقائص تتمثل في: عدم الاهتمام بالبحث العلمي من قبل الطلبة والباحثين، وضعف الباحثين، وعدم التفرغ للبحث، والإشراف الشكلي لكثير من المشرفين، فهل الذي يشرف على10 أو حتى 40 طالبا هو يكون باحثين؟! وكذلك شكلية تقييم البحوث؟ وحتى المنح إلى الخارج للتكوين القصير أو الطويل تحولت عند البعض إلى تجارة؟!، ثم أن إنجاز بحوث دون تثمينها والعمل بها، وتطبيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كانت من أسباب الظواهر التي ألمحنا إليها آنفا.
إنّ من أهداف الجامعة هو تكوين ثروة بشرية مزودة بالمهارات الفنية، وفي الوقت نفسه تكوين وعي سياسي، وخلق طموح، وجدية في العمل، والإنتاج المتقن، وبدا لي أن هذا الهدف لا يزال الطريق إليه طويلا بالنسبة للجامعة الجزائرية، بالمقارنة مع سعة مساحة البلاد وموقعها الاستراتيجي، وتضحيات الملايين من الشهداء رحمهم الله، وما تزخر به من ثروات طبيعية وبشرية، واحتياجات السكان، ونلحظ أن مخرجات الجامعة التي أنفقت عليها الملايير لا تستخدم بالشكل المطلوب، ولا أقول الأمثل في المجالات المذكورة مما ترتب عنه فائض معطل يعيش البطالة، وتضيع خبراته، وما تعلمه بتوالي السنين؟! (انظر، محمد العربي ولد خليفة: المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية.د.م.ج، ص،177…).
*أستاذ التاريخ والحضارة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية