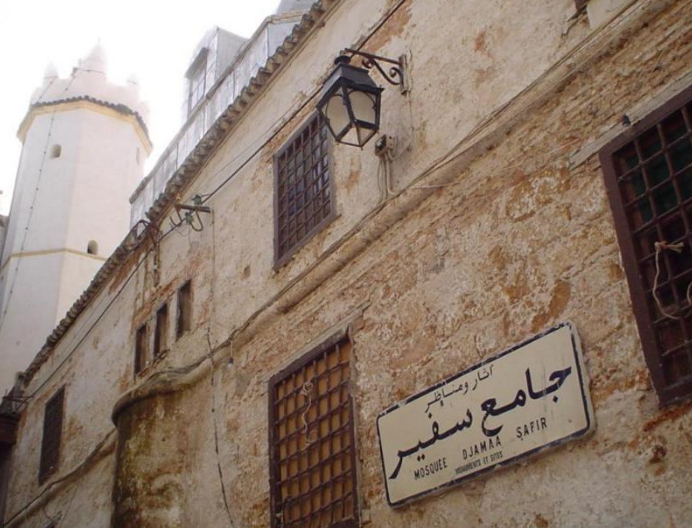الدكتور محمد حميد الله مترجم القرآن بالفرنسية
مصطفى محمد حابس: جينيف / سويسرا كما كنا قد ذكرنا في جزء سابق، من مقال الأسبوع الماضي، حول تحضيرات، ندوة أوروبية قادمة حول تراث و آثار العلامة الهندي محمد حميد الله الحيدر آبادي (1908-2002) مترجم القرآن بالفرنسية وصاحب الباع الطويلة في الدراسات الإسلامية بالفرنسية، إذ ستعقد هذه الندوة – بحول الله …

مصطفى محمد حابس: جينيف / سويسرا
كما كنا قد ذكرنا في جزء سابق، من مقال الأسبوع الماضي، حول تحضيرات، ندوة أوروبية قادمة حول تراث و آثار العلامة الهندي محمد حميد الله الحيدر آبادي (1908-2002) مترجم القرآن بالفرنسية وصاحب الباع الطويلة في الدراسات الإسلامية بالفرنسية، إذ ستعقد هذه الندوة – بحول الله – مع نهاية شهر ديسمبر الحالي بمناسبة ذكرى رحيله الـ 23، رحمه الله.
بعد أن تطرقنا في الجزء الأول من المقال، نتمم تلخيص بقية المقال المغمور الذي عثرنا عليه في مجلة “المسلمون”(المجلد الثامن- سنة 1963- 1964)- التي كان يصدرها “المركز الإسلامي بجنيف”، والمقال بعنوان “خطوط عريضة في : إيمان المسلم وعقيدته” (للدكتور محمد حميد الله – الأستاذ بجامعة إستانبول)، مبوبا إياه في 24 نقطة وقد ذكرنا 9 منها. تحت عناوين فرعية أربع هي :1- الله –2- الملائكة –3- الكتب المنزلة -4- رسل الله ( الأنـبـيـاء)، و بعد أن عرفنا في الجزء الأول، معنى الله جل جلاله والإيمان به و بوحدانيته و تصور ( الله) في العقل البشري، نكمل الجزء المتبقي في نقاط حول: الملائكة – الكتب المنزلة – و رسل الله ( الأنـبـيـاء):
2- الملائكة الأبرار (عليه السلام) :
(9) – حيث أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وأنه – جل شأنه – وراء كل إدراك حسِّيٍّ عن طريق الأعضاء البشرية، كان من الضروري أن تكون هناك وسائل للاتصال بين الله والإنسان، وإلا كان من المستحيل على الناس أن ينظموا سلوكهم في هذه الحياة وفق الإرادة الإلهية. فالله سبحانه ليس خالق أجسادنا فحسب، ولكنه خالق حواسِّنا وقوانا واستعداداتنا الفطرية أيضا. وهذه الحواس والقوى متعددة وقابلة للتطور. فالله هو الذي أعطانا (الوجدان) و(الضمير)، وغيرهما من الأسباب التي نستعين بها للسير في الطريق الصحيح. إن الروح الإنسانية قابلة لتلقِّي موحيات الخير والشر معا، وفي أوساط العاديين من الناس يمكن لأفرادٍ خَيِّرِين أن يتلقوا أحيانا موحيات شريرة (مغريات)، كما يمكن لأفراد شريرين أن يتلقوا إلهامات تدفعهم نحو الخير. ويمكن للإلهامات أو الموحيات أن تأتي عن غير طريق الله، كالوسوسات التي تأتي من الشيطان مثلا، وهدى الله وحده هو الذي يتيح لعقولنا أن تميز بين إلهامٍ سماويٍّ خَيِّرٍ جدير بالاتّباع، ووسوسة شيطانية شريرة جديرة بالرفض والإنكار.
(10) – كانت هناك وسائل متعددة لإنشاء صلة بين الله والإنسان، وكان من الممكن أن يكون التجسد (أي ظهور الإله في شكل مادي أو بشري) هو خير هذه الوسائل. ولكن الإسلام يرفض فكرة (التجسد) لأنها تعني النزول بإله عظيم من مرتبته بحيث يصبح إنسانا يأكل ويشرب ويتعذب على أيدي مخلوقاته، ويجوز أن يعدم أيضا. لذلك فإن الإنسان مهما أصبح قريبا من الله، فإنه – في رحلته إليه – وحتى في أرفع مراحل مرتقاه، يظل الإنسان إنسانا، ويظل بعيدا جدا من الله.
والإنسان قد يفني ذاته، كما يقول المتصوفة، ويلغي شخصيته بالكلية وهو يحاول أن يكون سلوكه مطابقا لإرادة الله، ولكنه يظل – وعلينا أن نكرر هذا – يظل إنسانا خاضعا لكل ما يَعْتَوِرُ الإنسانَ من مظاهر الضعف، في حين أن الله سبحانه وتعالى مُنزَّهٌ عن كل ضعف أو نقص.
(11) – ومن الوسائل الأخرى للاتّصــال بين الله والإنسان، والتي هي في متناول يــد الإنسان (ولعلها أضعفها) هو الرؤيا. فبالنسبة للرسول r تعتبر الأحلام الصالحة إلهاما من عند الله، كما أنها تقود الناس في الطريق الصحيح.
(12- ومن الوسائل الأخرى (الإلقاء) وهو نــوع من (الإيحاء الذاتي)، من (هاتف الوجدان) من ظهور الفَرَج في حالات الضيق وحل المشاكل الصعبة التي تبدو وكأنها لا حل لها.
(13) – ثم هناك (الإلهام) الذي يمكن أن نسميه (بالإيحاء الإلهي). وهنا يقع الإلهام في قلب إنسان تدرّجت روحه تدرجا كافيا في ممارسة فضائل العدالة، والإحسان للغير، والبر بالآخرين. وقد ذاق الصالحون في جميع أطوار التاريخ وفي جميع الأقطار حلاوة هذا النعيم الإلهي. وحين يهب المرء نفسه لله سبحانه وتعالى، ويحاول أن ينسى ذاته، فهناك لحظات – قصيرة جدا في عمر الزمن – يتجلى فيها الوجود الإلهي في مثل التماع البرق، وفيها يتاح للمرء أن يلهم من غير جهد منه ما لم يكن بالمستطاع أن يدركه بكل جهد في الوجود. إن روح الإنسان – أو قلبه كما يقول الأقدمون – تتعلم بهذه الطريقة، ثم يكون هناك شعور باليقين والرضى، والثقة بأنه الحق. إنه الله سبحانه وتعالى الذي يرشده ويسيطر على أفكاره وأعماله. حتى الأنبياء – وهم رسل الله إلى خلقه – يتلقون هذا الإرشاد كالآخرين. ولكن يبقى هناك – على كل حال – احتمال وقوع الخطأ في التقدير، أو الخطأ في الفهم، من جانب الإنسان. ويؤكد المتصوفة أن أشدّ الناس تُقًى وورعا قد يضل أحيانا، لأن سريرته قد عجزت عن تمييز الوساوس السيئة التي تقع للإنسان من باب التجربة والابتلاء.
(14) – أن أرفع مراتب الاتصال بين الله والإنسان وأضمن وسائله هو ما أسماه الرسول r “بالوحي” وهو ليس إلهاماً عادياً، ولكنه اتصال إلهي و”كشف” حقيقي يهبه الله للإنسان. وحيث أن الإنسان كائن مادي، والله سبحانه وتعالى ليس كائناً مادياً، بل هو فوق الروح، كان من المستحيل قيام اتصال مادي محسوس مباشر بين الله والإنسان. ومع أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، وهو أقرب إلى الإنسان “من حبل الوريد” كما يقول القرآن الكريم، فإن اتصالاً فسيولوجياً مباشراً يدخل في باب المستحيل. لذلك كان هو “الملاك” (وهي كلمة معناها من الناحية اللغوية “رسول سماوي”) كان هو الذي يقوم بدور الوسيط، ويتولى تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى للرسول الذي اختاره من البشر. ولا ينبغي لإنسان آخر سوى الرسول أن يتلقى مثل هذا “الوحي” عن طريق “الملاك”. ولا بد لنا أن نتذكر دائماً أن عبارة “النبي” في الإسلام، لا تعني ذلك الرجل الذي “يتنبأ بالغيب” ولكنها تعني الرسول المرسل من عند الله ليحمل للناس رسالة سماوية معيّنة. أما بالنسبة للملاك فإنه ليس من شأن هذه الدراسة أن تبحث في طبيعته، وفيما إذا كان كائناً “روحانياً” لا علاقة له بالكائنات المادية في هذا الكون أو أنه غير ذلك.
جبريل (الروح الأمين) هو أرفع الملائكة قدْراً
(15) – يقول القرآن الكريم إن الملاك الذي نقل الوحي للنبي r اسمه (جبريل) عليه السلام وكلمة جبريل معناها “قوة الله”. ويتحدث القرآن الكريم عن الملاك “ميكال” دون أن يبين وظيفته، أما حارس النار فاسمه “مالك”. وتحدث القرآن الكريم أيضاً عن ملائكة آخرين دون أن يبين أسماءهم أو وظائفهم، وإن كانوا جميعاً يعملون على إنفاذ مشيئة الله. ويقوم الاعتقاد الإسلامي على أساس أن جبريل (الذي يشار إليه في القرآن أحياناً بالروح الأمين) هو أرفع الملائكة قدْراً. وفي أحاديث الرسول r نقرأ أن الملاك جبريل لم يظهر للنبي دائما في نفس الصورة، فقد رآه رسول الله أحياناً كشيء قائم في الفضاء، وأحياناً في صورة رجل، وأحياناً ككائن ذي أجنحة، وهكذا… وقد جاء في حديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله، أن رسول الله جلس يوماً في مجلس يضم جمعاً من الناس، ثم وفد عليهم رجل لا يعرفه أحد منهم، فجعل يلقي على الرسول بعض الأسئلة والرسول يجيبه عليها. ثم انصرف الرجل، وبعد ذلك بأيام قال رسول الله لأصحابه: “إني لأظن أن الرجل الذي جاء يسألني في ذلك اليوم هو جبريل، وقد جاء يعلمكم دينكم. وما تأخرت في معرفته قط كما تأخرت هذه المرة”.
الطريقة التي كان يتنزل بها الوحي على الرسول الأكرم (ص):
(16) – أما الطريقة التي كان يتنزل بها الوحي على الرسول، فقد كانت تبدأ – على حد قوله – بأن يسمع صوتاً أشبه بصوت الجرس، ثم يحس وكأنه ينوء بحمل عظيم. وكانت تعتريه الحرارة حتى في أشد الأيام برودة، فتراه وقد تَفَصَّد العرقُ من جبينه. وكان الرسول لا يتحرك أبداً خلال نزول الوحي عليه. فإذا ما جاءه الوحي راكباً بعيره، استنساخ البعير من ثقل الحمل، فإذا ما قاوم الجمل الاستناخة كان يسيرا على المرء أن يرى قوائمه منحنيات وكأنها على وشك أن تنقصف. ويروى أنه بينما كان الرسول يجلس يوماً في نفر من أصحابه، وقعت ركبته – بحض الصدفة – على فخذ أحد أصحابه، وتنزّل الوحي عليه آنئذٍ. يقول هذا الصحابي الجليل: “لقد شعرت بثقل هائل يقع على فخذي خشيت معه أن تنسحق عظامي، ولو لا أنه رسول الله لصِحت متألما كي أجذب فخذي من تحت ركبته”. وما إن ينتهي الوحي وتبليغ الرسالة الإلهية حتى يعود الرسول r إلى حالته الطبيعية، بعد أن تكون الرسالة قد ثبتت في ذاكرته لا تمحى. ولم يكن الرسول يتلو على المؤمنين رسالة السماء التي تلقّاها في حالة “النشوة” بل بعد أن يعود لحالته الطبيعية. وكان يمليها على الناسخين ليكتبوها ثم يتولوا إذاعتها في أوساط المؤمنين.
”الكتب السماوية” أو “الكتب المنزلة”:
حيث أن الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات والأرض، فإن من واجب الإنسان أن يطيع هذا الخالق العظيم. وبفضلٍ منه ونعمة أرسل الله رسله لهداية الإنسان إلى ما فيه منفعته. فالله هو سيد هذا الكون ومصدر كل قانون. ولقد تحدثنا عن الوحي وعن كيفية وصول إرادة الله للبشر. ونقول الآن إن جماع ما أتى به الوحي للأنبياء هو ما نسميه “بالكتب السماوية” أو “الكتب المنزلة”.
”الكتب” وليس فقط “الكتاب” الذي هو القرآن الكريم!!
(17) – إن الكتاب المعتمد للديانة التي أعلنها وبشر بها الرسول محمد r تتحدث عن “الكتب” وليس فقط “الكتاب” الذي هو القرآن الكريم. هذا التسامح هو طابع تعاليم الرسول محمد. وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الكتب المنزلة في آيات كثيرة. يقول الله تعالى في سورة البقرة، الآية 285: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.. ويقول في سورة فاطر الآية 24: ﴿ إنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ ويقول فى سورة غافر، الآية 78: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ . فالقرآن الكريم إذن يسمي ويعترف بكتاب إبراهيم وتوراة موسى، ومزامير داوود، وإنجيل عيسى عليهم السلام ككتب منزلة عند الله تعالى.
مصير الكتب السماوية المنزلة قبل الرسالة الخاتمة..
(19)- أما بالنسبة لكتاب إبراهيم فلا يوجد له اليوم أثر، وكثير من الناس يعرفون المأساة الأليمة لتوراة موسى ويعرفون كيف أنها دُمِّرت مراراً بفعل الوثنيّين، كما لقيت مزامير داوود نفس المصير المؤلم. وبالنسبة لعيسى المسيح عليه السلام فإنه لم يجد الوقت الكافي ليجمع تعاليمه أو يمليها على أتباعه. بل إن تلاميذه والذين جاءوا من بعده هم الذين جمعوا أقوال المسيح ونقلوها للأجيال، بعد أن نقّحوها وهذبوها مراراً بحيث أصبح مشكوكاً في صحته. ومهما يكن من أمر، فإنه ركن من أركان الإيمان عند المسلم أن يصدق لا بالقرآن وحده، ولكن بمجموع ما جاء به الوحي في عصور ما قبل الإسلام. إن الرسول r لم يتحدث عن (بوذا) ولا عن مؤسس الديانة البرهمية من الهنود. لهذا فإن المسلمين لا يستطيعون الجزم – مثلاً- بأن (الفيدا) الهندية ذات صيغة إلهية، ولكنهم لا يستطيعون كذلك الحكم باستحالة أن تكون (الفيدا) قائمة – من حيث الأصل- على أساس من وحي سماوي، أو أنها لم تلاق مصيراً مشابهاً للمصير الذي لاقاه الناموس الذي نزل على موسى، وتنطبق نفس النظرة على ما يتعلق بديانات الصين واليونان وغيرهما من الأقطار.
رسل الله ( الأنـبـياء الأطهار )
(20)- يأتي الوحي برسالة السماء إلى الرجل الذي وقع عليه الاختيار وهو المسؤول عن تبليغها للناس. وبحسب التعابير القرآنية يسمى هذا “الوسيط البشري” المكلف بتبليغ الرسالة بأسماء مختلفة: منها النبي، والرسول، والبشير، والنذير، الخ ..الخ.
(21)- والأنبياء رجال على قدر كبير من التُّقَى والطُّهر، وهم نماذج للسلوك الطيب روحياً ودنيوياً واجتماعياً. والمعجزات ليست ضرورية بالنسبة إليهم (ذلك على الرغم من أن التاريخ ينسب فعل المعجزات لهم جميعاً)، ولكن دعوتهم وحدها هي مقياس صدقهم في نبوتهم.
(22)- ويتحدث القرآن الكريم عن أنبياء تلقوا وحي السماء في هيئة كتب منزلة، وعن آخرين لم يتلقوا كتباً جديدة، بل كان عليهم أن يتبعوا كتباً نزلت على من قبلهم. والرسالات السماوية لا تختلف مع بعضها البعض من حيث الحقائق الجوهرية، كوحدانية الله، والدعوة إلى فعل الخير وتجنب الشر .. الخ، ولكنها قد تختلف في قوانين السلوك الاجتماعي بما يتفق مع التطور الاجتماعي لشعب ما، وإذا كان الله سبحانه قد أرسل الرسل متتابعين، فإن ذلك دليل على أن التعاليم السابقة قد نُقِضت وحلت محلها تعاليم جديدة، وفيما عدا ذلك تبقى بعض الأسس القديمة بدون تغيير ويتحدث عنها بصورة صريحة أحياناً وضمنية أحياناً أخرى.
(23)- وقد تمايزت مهام الأنبياء، فبينما بُعث بعضُهم في بيت واحد أو قبيلة واحدة أو بضع قبائل أو جنس واحد، أو إقليم واحد، أنيطت ببعضهم مهمة أوسع تشمل الإنسانية بأسرها وتمتد عبر جميع العصور.
(24) – هذا وقد ذكر القرآن أسماء بعض الأنبياء بوضوح كآدم ونوح وإبراهيم ويعقوب وداوود وموسى وصالح وهود وعيسى، ويحيى ومحمد عليهم السلام، ولكنه ذكر أن هناك آخرين جاءوا قبل محمد وأنه r خاتم الأنبياء والمرسلين.
السيرة النبوية في كلمات أربع، أحداث وأحاديث!!
هذا ما، جاء في ورقة محمد حميد الله، والذي يمكن أن نلخصه، في ما ذهب إليه الدكتور عبد الله العمادي، حيث لخص السيرة النبوية في أربع كلمات مفتاحية غاية في الأهمية تصلح لكل الأنبياء و الرسل و المصلحين على نهجهم بدرجات متفاوتة، لكنها أربع لا خامس لها، وهي بالمصطلحات العصرية كالتالي:
التكذيب الإعلامي للنبي و منهجه / الإيذاء النفسي والبدني للنبي/ اللجوء السياسي للنبي و أصحابه/ الإيذاء عابر الحدود للنبي و من معه!!
كان محمد بن عبد الله – ﷺ – قبل البعثة، رجلاً محبوباً في مكة، وكان موضع تقدير واحترام من الجميع، الأطفال والنساء، والسادة، والعبيد، وغيرهم. واشتهر بالصادق الأمين.. وفجأة تغيرت النظرة إليه بعد انتشار خبر الرسالة، فتغيرت النظرة إليه سريعاً، وتغيرت كل الألقاب والأوصاف التي أطلقها القرشيون أنفسهم عليه، فصار هو الكاذب، الساحر، المبتدع، المفرّق بين الأب وابنه، والزوج وزوجه، وهكذا، لماذا؟ لأنه أحدث انقلاباً عظيماً في أم القرى وما حولها. انقلاباً في المفاهيم، والمعتقدات، والأخلاقيات، والسلوكيات، وغيرها كثير كثير، فكان من الطبيعي أن تتغير النظرة القرشية إليه ﷺ.
رجل للتاريخ ، ورقة بن نوفل ، أحد الخمسة الذين بقوا على الملة الحنيفية قبل الإسلام
ما إن علمت السيدة خديجة بخبر الرسالة، حتى أسرعت إلى ورقة بن نوفل ، أحد الخمسة الذين بقوا على الملة الحنيفية، أو دين إبراهيم، بعد أن درس وتمكن من الإنجيل والتوراة، فأخبرته بحدث غار حراء ونزول جبريل على زوجها، فاستبشر ورقة وقال: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، إن كنتِ أصدقتِني يا خديجة، فلقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي لموسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له: فليثبت. ثم رجعت السيدة خديجة –رضي الله عنها- إلى رسول الله -ﷺ- فأخبرته بقول ورقة.
خرج رسول الله -ﷺ- بعد تلك الحادثة بقليل ليطوف بالبيت، فلقيه ورقة فقال: يا ابن أخي: أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله -ﷺ- فقال ورقة: «والذي نفسُ ورقة بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي كان يأتي لموسى، ولتكذّبنّه، ولتؤذَينّه، ولتُخْرجنّه ولتُقاتلنّه، ولئن أدركت ذلك اليوم، لأنصرن الله نصراً يعلمه». ثم دنا من رسول الله ﷺ فقبل رأسه.
يذكر رواة السير عبارة (ثم لم ينشب ورقة أن توفي قبل أن يظهر الإسلام ). أي لم يلبث طويلاً، وكأنما الله سبحانه، أبقى ورقة طوال هذه السنوات ليقول تلك الكلمات القليلة لرسول الله، وينتهي دوره عند ذلك.
السيرة النبوية محصورة بين كلمات أربع، التي ذكرها ورقة بن نوفل للنبي الأكرم:
تكاد تكون السيرة النبوية محصورة بين كلمات أربع، هي التي ذكرها ورقة بن نوفل للنبي الأكرم -ﷺ- حين قال له: “.. ولتكذّبنّه، ولتؤذَينّه، ولتُخْرجنّه ولتُقاتلنّه..”. التكذيب، الإيذاء، الطرد، القتال. هذا تماماً ما جرى للحبيب وصحبه، ومن قبله من الأنبياء.
على رغم أن الدعوة بدأت سرية وعلى نطاق ضيق جداً، على عادة الدعوات الإصلاحية في أي مجتمع وثني أو فاسد، إلا أن التوتر كان قد بدأ يسود بيوت مكة، لاسيما زعماءها وسادتها. فلما بدأت الدعوة الجهرية، دخل النبي الكريم -ﷺ- مجال الكلمة الأولى وهي التكذيب. إذ بدأت الوسائل الإعلامية لقريش، كما هو حاصل اليوم في كثير من الأقطار، بتكذيب ما يصدر عن النبي وصحبه، على رغم قناعاتهم الداخلية أنه يقول الحق، لكنهم وجدوه عاملاً مهدداً لمصالحهم القريبة والبعيدة، فلابد إذن أن تعمل قريش لتكذيب النبي والتشويش على الآخرين، ظناً منهم أن أحاديث المصطفى -ﷺ- والآيات القرآنية التي كان يتلوها، ليست سوى أساطير الأولين، وأنه بالمثل يحفظ منها الكثير الكثير.
الإيذاء النفسي والبدني
لم تجد محاولات التكذيب القرشية للرسالة المحمدية نفعاً، فتحولت قريش إلى المرحلة الثانية كما قال ورقة، مرحلة الإيذاء النفسي والبدني للرسول الكريم وأصحابه الكرام. تفنن القرشيون في ابتكار وسائل التعذيب، لاسيما مع ضعفاء وفقراء المسلمين، وامتلأت زنازين الطغاة بالمصلحين من أصحاب رسول الله، واشتد التعذيب بصورة لم يجد الرسول الكريم من بد، سوى التفكير بالخروج من مكة تدريجياً والحفاظ على الثلة المؤمنة، فكانت المرحلة الثالثة.
اللجوء السياسي
ترك المسلمون أموالهم وبيوتهم وما يملكونه في مكة، هجرة إلى الله وحفاظاً على دينهم، وتحولوا إلى شعب يطلب اللجوء السياسي، وضيوفاً على شعب آخر هم شعب يثرب (المدينة المنورة) ، والتي لم تكن بالثراء والسعة التي يمكنها استقبال شعب كامل لاجئ، خاصة أن النسيج المجتمعي في المدينة لم يكن بذاك النسيج المتحد المتعاضد، بل قبائل متناحرة وعلى رأسها الأوس والخزرج، وقبائل يهودية أخرى في المدينة وما حولها.. لكن من فضل الله أن ألّف بين قلوب المهاجرين والأنصار، على رغم محاولات اليهود والمنافقين، خلخلة ذاك التكاتف وتلك المؤاخاة غير المسبوقة في التاريخ.
الإيذاء عابر الحدود
لم يكتف القرشيون بطرد المسلمين من وطنهم، والحجز على ممتلكاتهم ومصادرتها أو الاستيلاء عليها، بل بدأوا في وضع خطط إرسال الأذى إليهم خارج الحدود، ومحاولة إعادتهم إلى ديارهم، لأن طردهم كان بمثابة مكافأة لهم، ووجودهم خارج مكة هو الخطر ذاته.
خلاصة : في مسيرة تاريخ الأمم، يتجدّد نموذجٌ رباني عجيب!!
السيرة النبوية الشريفة تكرار لسير الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم الى قيام الساعة. ستجد أن كلمات ورقة بن نوفل الأربع للنبي الكريم -ﷺ- هي نفسها تتكرر.. التكذيب، والإيذاء، والتهجير، والقتال بصور مختلفة. وما جاء على لسان ورقة وهوأحد الخمسة الذين بقوا على الملة الحنيفية، أو دين إبراهيم، وهو الذي درس وتمكن من الإنجيل والتوراة، يبين بوضوح شأن الطغاة والفراعنة مع المصلحين في كل زمان ومكان، الذين لا يرون بأساً أبداً في التعايش مع الصالحين، ولكن ليس المصلحين، والبون بينهما شاسع.. و ما يعيشه المسلمون المصلحون اليوم في كل مكان، بداية من فلسطين، ترجمة واضحة لا لبس فيها، عن صراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين النور والظلام، بين الإيمان والكفر، بين العدل والاستبداد، بين الإنصاف الظلم، بين الحرية والاستعباد، بين الأمل واليأس ، هذه المتلازمة تعبر عن الصراع الأزلي بين القوى المتضادة في الكون، وتجسد الصراع الداخلي والخارجي الذي يواجهه الإنسان في حياته.
العالِم المهاجر الذي يترك وطنه وأهله
في مسيرة التاريخ الإسلامي، يتجدّد نموذجٌ عجيب يثير الإعجاب والاندهاش معًا: نموذج العالِم المهاجر الذي يترك وطنه وأهله، ويهجر لذّات الدنيا وزخرفها، ليجعل رحلته لله وحده. علماء حملوا الرسالة إلى آفاق بعيدة، ونشروا نور الإسلام في ديار الغرب، لا يطلبون شهرة، ولا جاها، ولا مالًا، وإنما يبتغون وجه الله، فيكونون منارات للحق في عصور التيه، وحراسًا للعقيدة في زمن الفتن و في بلاد الغرب، ومن هذا السلك المبارك يبرز اسم الدكتور محمد حميد الله الحيدرآبادي، الرجل الذي عاش غريبًا، ومات غريبًا، عاش وحيدا لم يتزوج و لم ينجب، لكنه ترك إرثًا خالدًا يذكّرنا بأن لله رجالًا باعوا دنياهم واشتروا الآخرة.. مصداقا لقوله تعالى: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: 23]