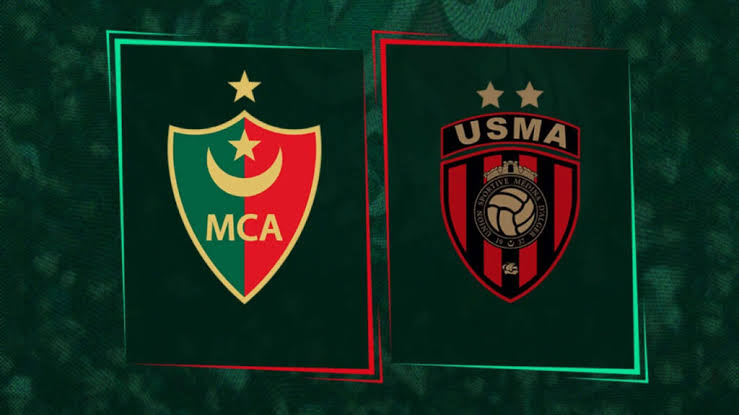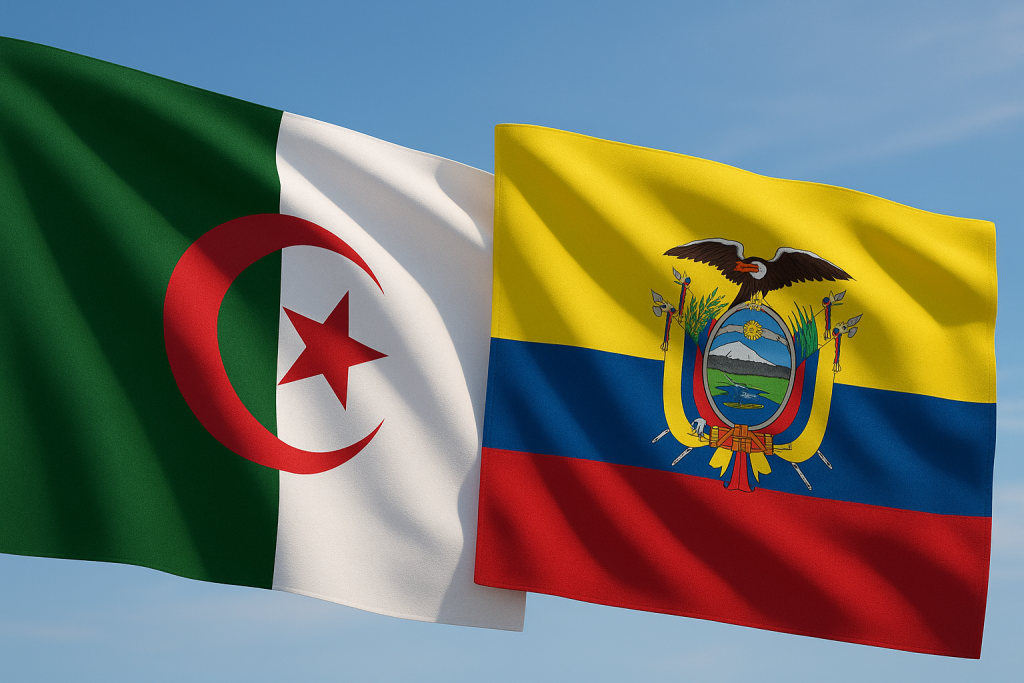التغييب الارادي لمنطق “التحولات” الدولية كعنصر تأثير
خلف جُدر اللغة قد يُعثر على الكثير من العناصر المهملة والمهمة في التحليل السياسي، التي استعصى على العقل الوصول إليها إما لسماقة وعلو الجدر تلك، أو لحجم الضغط الذي يُفرض على المحلل أو يفرضه هو، بفعل التوجيه الإعلامي الكبير الذي أصبح يشكل قوة خارقة للضمائر ومضللة للبصائر، وموجهة للاستراتيجيات أكثر من أتكون مسوقة لها أحيانا. …

خلف جُدر اللغة قد يُعثر على الكثير من العناصر المهملة والمهمة في التحليل السياسي، التي استعصى على العقل الوصول إليها إما لسماقة وعلو الجدر تلك، أو لحجم الضغط الذي يُفرض على المحلل أو يفرضه هو، بفعل التوجيه الإعلامي الكبير الذي أصبح يشكل قوة خارقة للضمائر ومضللة للبصائر، وموجهة للاستراتيجيات أكثر من أتكون مسوقة لها أحيانا.
والقضايا الدولية اليوم مثل الاجرام الصهيوني في غزة، صارت ظاهرتها تنحو في هذا الاتجاه، واقع لغة في الاعلام والتحليل السياسي يقف عند حد التناوش بين خطابي الإدانة للصهاينة والدفاع عنهم، بينما لغة الواقع تمضي نحو التصعيد الاجرامي ومحاولة الانتهاء من سحق واستئصال الانسان الفلسطيني من أرضه.
كل ذلك نجد له حضورا في مسألة أزمة العلاقة بين الجزائر وفرنسا اليوم، حيث ثمة سعي من بعض الأصوات لإدراج هاته الازمة في سياق مثيلاتها التي حدثت في الماضي، بما يفيد أن الزمن كفيل بتبديدها وعودة المياه بين البلدين إلى مجراها عاجلا أو آجلا، في حين يستميت البعض في التأكيد على أن الطرفين بلغا حقا مرحلة اللا عودة وأن العلاقة بين فرنسا والجزائر يمكن إدراجها في طي النسيان، فما حقيقة كللا الطرحين؟ وهل لا يوجد طرح ثالث ليس بالضرورة أن يكون توفقيا بين الطرحين السابقين، وإنما تفسيريا لهما؟
الرهان على تجربة الماضي
بادئ ذبي بدء، يلزمنا العودة إلى قاموس المعاني والألفاظ الذي استند عليه إعلام الازمة لدى الطرفين، لمعرفة ما إذا كان التضليل أو التطبيل للمواقف مقصودا، وهو بذلك يندرج في إطار الحصول على مزيد من العناصر الداعمة لفرض الانجدة، أم أن الأمر متصل حقا بالرؤى الإعلامية التحليلية المحايدة والمحايثة لما يبدر من المتصارعين في عملية، كثيرا ما وصفت “بعلمية كسر العظم” وهي في حد ذاتها عبارة يمكن أيضا احتسابها في قاموس التحليل الكيدي لأزمة فرنسا مع الجزائر، وعنصر من عناصر الدعم اللغوي لهذا الطرف أو ذاك لكسب المعركة.
فمذ ثقلت موازين التطرف في خطاب الضفتين حول كيفية إدارة الازمة الديبلوماسية بين البلدين على خلفية تبني فرنسا للمقاربة الغربية لملف الصحراء الغربية – والتي هي مقاربة فرنسية في الأصل (مثلما يصر عليه الطرف الجزائري)، مع أنه ثمة أصوات تذهب إلى حد التأكيد على أن ملف الصحراء لم يكن مثار الازمة الحالية، وإنما بعض التحليل الفرنسي يتبنى هذا التضليل بغرض التغطية على حقائق أخرى قد تكون أكثر المتغيرات تفسيرا للمنعرج الخطير في العلاقة بين البلدين، سنورد ها في سياق هذا التحليل – فمذ ثقلت موازين التطرف في خطاب الضفتين – أخذ شكل الأزمة يتشكل وفق مصطلحات تسرع من فاعلية اللغة على حساب فاعلية واقع العقل، من مثل تكرار لفظ “القطيعة” مع ما يحمل من مدلول تاريخي وفلسفي، وفكري والسياسي حاد وجاد، أو عبارة “نقطة اللا عودة” التي تحسم حتى في مستقبل القطيعة تحيلها من دلالتها الظرفية إلى الازلية، ولذلك صارت طبيعة التلقي الإعلامي والسياسي على كل المستويات في البلدين رهينة هذا التعارك الطاحن على مستوى اللغة الذي بفعل ضراوته لا سيما في زمن عولمة الصوت والصورة وقوة وسرعة انتشارهما وتدفقهما اللذين مكن الفضاء الأزرق منهما، أصبح (التعارك) ليس فقط توجيها للمتلقي بل للفاعل السياسي نفسه !
وإذا كان معروفا أن الالمام بكل عناصر تشكل الظاهرة محل التحليل، بداء من عنصر الزمن فيها إلى طبيعة الأطراف المشتركة في بروزها، أمر ضروري ومهم في حرفة التحليل كي يخرج منسجما ومنطقيا إلى فضاء التلقي، فإن ذلك في مسألة النظر العقلي في الازمة الجزائرية الفرنسية، كان أبعد من أن يراعى فيها من لدن العديد ممن تورط في التحليل الإعلامي والسياسي بهذا الشأن، ما عسَّر مهمة فهمها في سياقها الصحيح الذي قد يقع فيما بين ما هو بيني، أي بين الطرفين أو الدولي أي ذاك الذي يفرضه الواقع الدولي.
منطق “التحول” أو ذاك الغائب في قاموس التحليل
إن طغوى ألفاظ وعبارات بحد ذاتها في لغة التناول الإعلامي – السياسي بين الطرفين، من مثل ما أسلفنا بالذكر ( القطيعة، نقطة اللا عودة..) قد شكل رأيا عاما في حد ذاته في الجهتين ورسخ موقفا، فاق في حمل قدرة دبلوماسية البلدين، وهو ما يفسره التصريح الشهير لبرونو روتايو وزير داخلية فرنسا من أنه مستعد للاستقالة في حال رضخت فرنسا للجزائر” مستثمرا بذلك في الضغط المهول الذي مارسته اللغة الإعلامي التحليلي في التناوش بين الطرفين، ما عطَّل قدرة الآلة الدبلوماسية للطرفين في التعامل مع الازمة.
لكن من غير عبارتي القطيعة ونقطة اللا عودة، أين راح مصطلح التحولات كعنصر بنيوي في الازمة الحاصلة بين طرفي النزاع في ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ونعني بالتحولات هنا الدولية، وتأثيرها على داخل الطرفين أي في فرنسا وفي الجزائر، لأن مسألة التحولات، سواء في مدلولها اللغوي أو مكنونها التاريخي اليوم، لتعد فارقة في العلاقات الدولية والإقليمية، مهما حاول المحاولون القفز على حقيقتها وحقيقة سلطانها وقدرتها على التأثير.
والواضح بأن الطرفين يحاول كل منها إيجاد صيغة له للتجاوب والتعامل مع هذه التحولات وفق ما يضمن مصلحته، ولعل مصلحتهما معا هنا تتصادم بالضرورة، نتيجة الخيارات والاكراهات التي تفرضها هاته التحولات عل كل واحد منهما، فالجزائر باتت تدرك أنها ملزمة بالتخلي عن الكثير من أجندة خياراتها الدبلوماسية السابقة، وولوج العصر البراغماتي الذي يفرضه سياق الصراع الدولي الجديد، سيما بعد أن طرق تأثير هذا السياق حدودها من كل جانب، لتدرك فيما بعد حجم تأخرها أو عدم استباقها لهذه التحولات التي كانت تلوح في الأفق قبلا، وهذا عبر التوسيع والتنويع من شركائها وحلفائها الاستراتيجيين، وهو ما كان له تداعيات على علاقاتها مع عديد القوى الصديقة التقليدية، بما في ذلك روسا التي راحت تعامل الجزائر عبر مرتزقتها كفاغنر ومن خلال قدرتها على الضغط على فرنسا وطردها من الساحل، بأسلوب التهديد والتأديب، وكذا عبر دعم خاص لمنظومات عسكرية انقلابية في دول الجوار بالساحل لمشاكسة والمناكفة للجزائر.
فالفرنسيون يزعمون اليوم بأن حكومتهم قدمت الكثير من التنازلات فيما ظلت الجزائر متصلبة في ذلك ورافضة لتقديم أي شكل من أشكال التنازل، وهذا ما حتم على الفرنسيين التوجه إلى المغرب وضرب صفح نهائي عن الجزائر كشريك أساسي، رغم القدرات الكبرى للجزائر الاقتصادية والثقافية التي تفوق المغرب بكثير.
زعم فرنسي لا يستند على منطق، باعتبار أن المفاضلة في الاختيار بين المغرب والجزائر غير صحية ولا صحيحة للفارق الوضح، كما أشرنا في القدرات بين البلدين، وإنما يعود السبب الرئيس في ذلك التحول الفرنسي إلى ضغط المعطى الدولي وتداعياته بالمنطقة أي بذلك الحضور الهائل والثقيل للقوى الكبرى في الصراع الدولي من صين وأمريكا وروسيا، أزاح فرنسا جغرافيا ويزيحها تاريخيا، وما ارتسم من خلاله من ملمح قاتم يلزم بالضرورة معاودة رسم الاجندة الدبلوماسية والخيارات الاستراتيجية، وهو ما تلجأ إليه أحيانا بتعثر وأحيانا بصواب، الجزائر من خلال التقارب مع أمريكا عل حساب فرنسا، اقتصاديا، ونسبيا على حساب روسيا عسكريا، وهو ما كان له أثره السلبي على العلاقات مع هذين البلدين وإن بشكل مختلف.
مسارات التعامل مع منطق “التحولات”
وإذا ما حاولنا معرفة مسارات التعامل مع منطق “التحولات” الكبرى الذي عرفته العلاقات الدولية عبر مراحل مختلفة في الإيقاع الزمني، بدء من نهاية الحرب الباردة، فنجد أن الفرسيين كانوا الأسبق في استشراف هاته التحولات وذلك منذ أزمة التحالف العسكري الدولي لتحرير الكويت في حرب الخليج الثانية سنة 1991 التي انسحبت منها فرنسا بعد ان استقال وزير دفاعها آنذاك من منصبه احتجاجا على الهيمنة المركزية لأمريكا على القرار فيها استعداد للاستحواذ على الكعكة الطاقوية (الغنيمة) بشكل شبه كلي، واستمر موقف فرنسا من شاكلة إدارة أمريكا القطبية للصراع الدولي، في ظل حكم الكبيرين فرنسوا ميتران ثم جاك شيراك، إلى غاية أن تفجرت أزمة البلدين حول صفقة الغواصات لأستراليا التي خطفتها أمريكا من فرنسا.
لكن هذا الاستشراف الفرنسي هذا للتحولات التي بلغها الصراع الدولي، لم يمكنها بالضرورة من تلافي مآلاته ونتائجه عليها، ما جعلها تخضع لزوماً إلى منطقه، وذلك بتقلص حضورها الكبير في الأسواق العالمية، وفقدانها لمناطق نفوذ تقليدية ظلت متمتعة بها وبخيراتها لقرون وعقود خصوصا في إفريقيا، رغم مزاعم المؤرخ “الاستعماري” الكاره للجزائر، برنارد لوغان عكس ذلك.
ففرنسا التي تبدو بذلك هدفا في “التحولات” الدولية وليس فاعلا فيه، تسعى قدر ما وسعها الأمر إلى أن تظهر عكس ذلك، من خلال آلية صوتية لغوية إعلامية تحليلية، تتعامل بها مع أطراف دولية وجدتها مثالية لها كمشجب لتعليق عليه خسرانها التاريخي، من جهة مناطق نفوذها، كنتاج لقوة التدافع لقوى الصراع الدولي بتلك المناطق، ومن جهة أخرى فقدانها رهان القدرة على التأثير في العلاقات الدولية وإعادة تشكيلها، من مثل ملف الجزائر وروسيا حيث لا تكف عن المبادرات في أوروبا لشحذ واستجماع قوى القارة العجوز المعادية لروسيا.
الاختزالات السخيفة!
والغريب أن تجد بعض المواقف التحليلية تنأى عن بعد “التحولات” الدولية الكبرى وقوته التي غمر بها فرنسا وكشف بذلك تأخرها الحضاري وعدم قدرتها على التأثر في السياسة الدولية بقدر تأثرها بهها – تجدهم – يختزلون مشكل علاقاتها مع الجزائر في جوانب لا نقول هامشية ولمنها لا يمكن ولا بأي حال أن تغدو فارقة أو سببا في بلوغ ما صيغ من عبارات وألفاظ ذكرناها أنفا كـ”القطيعة” و”نقطة اللا عود” من مثل مشكل الصحراء الغربية، واعتقال بوعلام صنصال، ومحاولة مت زعم من اغتيال معارضين في باريس وغيرها من أدوات التصعيد الإعلامي، ويتجاهل عامل التحولات الكبرى التي أضحت هي الفارقة في كل كبريات وجزئيات السياسة في داخل كما في خارج الدول والأمم.
إن رفضنا لاستعمال لغة التصعيد بألفاظها وعباراتها الإعلامية التحليلية، في الضفتين، كدلالة على نهاية العلاقات بين البلدين، واستبعادنا لأن تكون هاته فاصلة في أمر تلك العلاقات، لا يعني بالضرورة أن تأثير التحولات الدولية عليها سيكون ظرفي وانهما سيعودان حتما إلى ما كانا عليه قبل بروز هاته الأزمة؟
فما يجري حاليا من محاولة معاودة صياغة العلاقات على نحو آخر بين البلدين والسعي الحثيث لترسيخه في ضمير الشعبين، سواء بالتحول على مستوى التحالفات أو تجاوز بعض الروابط التاريخية الثقافة واللغوية، هاته الأخيرة التي تنحوها الجزائر مثلما ما هو مرصود منحى عولمي من خلال الاعتماد على الإنجليزية وهو ما يخلق للدائرة الفرانكفونية ثقبا أوزونيا كبيرا في رقعتيها التاريخية والجغرافية – فما يجري – يؤكد بأن منطق – التحولات – سيكون له سلطانه القوي في صياغة علاقة جديدة بين البلدين، وليس الأمر يتعلق مطلقا بالظرفية وإمكانية العودة إلى ماض لا يقبل به منطق التاريخ.
يبقى السؤال الجوهري والقلق بالنسبة للجزائر اليوم هو مدى قدرتها على استيعاب شروط هذه – التحولات – الدولية في الداخل، وقوة ما قد تفرضه من تغييرات على صعد الاجتماع والاقتصاد والثقافة، والأكثر من ذلك على البنى الهيكلية للدولة لا سيما السلطة منها، وذلك في ظل تعثر الحسم النهائي في قضايا سياسية متشابكة مع التاريخ، ومع مسائل الهوية، فالجزائر في مناكفة فرنسا قبل أن يطرأ عنصر “التحولات” الدولية وما يستند عليه من إرادة قوى دولية كبرى متصارعة على مناطق جديدة وأخرى قديمة، كانت دائما ما تستند على التاريخي الثوري والنضالي للشعب الجزائري ضد هاته “الفرنسا” الاستعمارية، وببلوغ العلاقة معها، بفعل تأثير التحولات الدولية، مرحلة جديدة ليست بالضرورة القطيعة، أو اللا عودة، فإن الحاجة الداخلية للتغيير والتقويم والإصلاح ستفوق فلربما القدرة على التكيف التي تميزت بها منظومة لحكم طيلة عقود ستة من الاستقلال مع المتغير الداخلية الخارجية معا، وهو ما باتت تعيه فربما النخب الحاكمة اليوم، وتبرزه التقارب الملحوظ بين السياسي التقليدي الذي ظل الآمر الناهي لوحده، مع الاكاديمي الباحث والمستبصر في الشأن السياسي، وذلك من خلال جلمة التعيينات الأخيرة في المستشارية بعديد من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الرئاسة التي بإصدارها بيان تعيين الرئيس عبد المجيد تبون البروفيسور زهير بوعمامة مستشارا له في عديد الملفات والقضايا الدولية، يكون قد كشف عن إرادة لتعزيز العقل الاكاديمي باعتباره مسألة ملحة في عملية صنع القرار وهذا في ظل ما بات يكتنف الوضع الدولي و”التحولات” الكبرى التي أخذت تفوق قدرات التفسير للسياسي التقليدي، من ضبابية وصعوبة في الرؤية لا يفلح في اختراق حجبها طرف لوحده بل تظافر الجهود واستجماع كل القدرات وتجاوز منطق الاستعلاء والاستعلام (ادعاء امتلاك المعلومة) الذي ساد في ما مضى أسلوب التعامل مع قضايا البلد الداخلية والخارجية.
بشير عمري