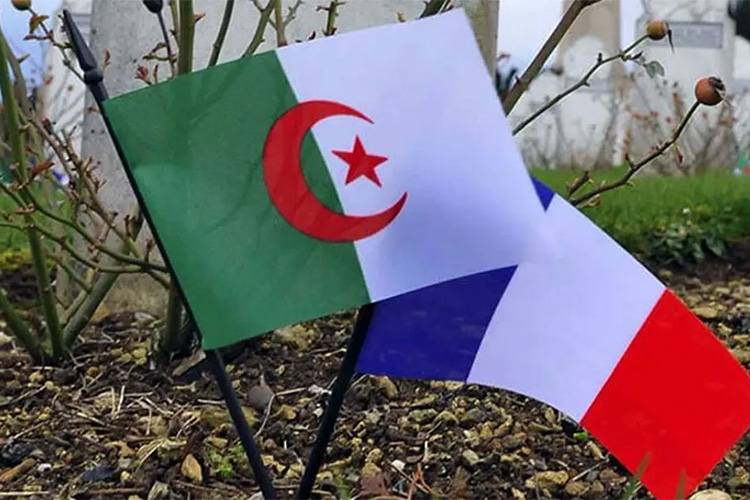الحاج شعبان لوز: قاضٍ بالشرع وقائدٌ بالسيف، سيرةٌ تُجاور مقام الشهادة
وُلد الحاج شعبان لوز سنة 1926 في دوّار “العولمة” ببلدية أولاد قاسم، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي؛ وحيدًا لأسرةٍ مكلومة فقدت أبناءها واحدًا تلو آخر، فصار هو الرجاء المعلّق في عنق الحياة. نشأ في كنف والدَيه، عليّ وكرّوش خديجة، على مزيجٍ من الحنوّ الصارم والرجاء الكبير. دخل الكتّاب مبكرًا، يتلمّس الحرف كمن يتلمّس العهد …

وُلد الحاج شعبان لوز سنة 1926 في دوّار “العولمة” ببلدية أولاد قاسم، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي؛ وحيدًا لأسرةٍ مكلومة فقدت أبناءها واحدًا تلو آخر، فصار هو الرجاء المعلّق في عنق الحياة. نشأ في كنف والدَيه، عليّ وكرّوش خديجة، على مزيجٍ من الحنوّ الصارم والرجاء الكبير. دخل الكتّاب مبكرًا، يتلمّس الحرف كمن يتلمّس العهد الأول مع المصير، وتعلّم القراءة والكتابة وحفظ ما تيسّر من القرآن، ثم مضى أبعد: تعلّم على يد الشيخ الطيب بوذراع، خريج جامع الزيتونة، فصُقلت ملكته في العربية والفقه وأصول القضاء العُرفي. سريعًا تحوّل الشاب الهادئ إلى مرجعٍ ديني بين أهل منطقته؛ لا يقطعون أمرًا ذي بالٍ إلا واستأنسوا برأيه، ولا يختلفون في خصومة إلا واحتكموا إلى ميزانه.
لكن القدر لا يكتفي بصناعة العُلماء؛ إنه يدفع بهم حين يشاء إلى صدارة التاريخ. في 8 ماي 1945 سال الدم الجزائري غزيرًا، وتكشّفت حقيقة الاستعمار بلا مساحيق. هناك، انشقّت في داخله طبقة جديدة من الوعي: نقاشاتٌ عميقة مع مناضلي حزب الشعب الجزائري غذّت يقينًا بأن الاستقلال ليس أمنية بل فرض عين. لم تكن الصحوة انفعالًا عابرًا، بل تأسيسًا معرفيًا: في 1951 أدّى فريضة الحج، ومنها إلى القدس الشريف، فالتقى جموع الحجيج الجزائريين من كل ربوع الوطن، وتشابكت الرؤى والمصائر. عاد محمّلًا بكتبٍ في الفكر والدين والسياسة؛ مكتبةٌ متنقلة تكمل عدّة المجاهد القادم: عقلٌ مُدرّب، وفقه واقع، وبوصلة لا تتيه.
عام 1953 اغترب إلى فرنسا، فاستقرّ في مدينة كيران (Cairanne) جنوبًا، مشرفًا على عمال جزائريين. غير أن الغربة لم تُبدّل نَسَبه إلى القضية؛ حوّل مقامه هناك إلى خليةٍ ذكية للدعم: يجمع التبرعات ويؤمّن القنوات لصالح “المنظمة الخاصة” (OS)، الذراع السرّي للتحضير للكفاح المسلّح. وحين دقّ جرس نوفمبر 1954 كان في المكان الصحيح: عاد إلى الجزائر، وغاص في تفاصيل ما قبل الرصاصة وما بعدها؛ تمويلٌ لوجستي محكم، إسنادٌ مادي ومعنوي للمجاهدين، وعيونٌ على الأوراس، المهد الذي تنفّست منه الثورة رئتها الأولى.
اكتشفت السلطات الاستعمارية مبكرًا أثره الخفيّ، فكان لا بدّ من الانتقال إلى العلن. في 1956 التحق رسميًا بصفوف جيش التحرير الوطني إلى جانب قادة ميدانيين بارزين كالحاج بوجمعة صولاج وبوغرارة السعودي، في نطاقٍ جغرافي ذي حساسية استراتيجية يربط جبال الأوراس بالشمال القسنطيني. هنا تتبدّى فرادة الرجل: لم يحمل بندقية المجاهد وحسب؛ حمل معها قلم القاضي وميزان الشرع. تقلّد مهمة القضاء الشرعي داخل جيش التحرير: يفصل في النزاعات، ينظّم الحياة المدنية في القرى الخاضعة لسلطة الثورة، يضبط السلوك العسكري وفق منظومة قيمية تجعل العدل قاعدة والفساد خطيئة. هذا المزج بين “فقه المقاومة” و”فقه الأحكام” جعله مرجعًا مطمئِنًا للمجاهدين والسكان، وقائدًا يُطاع لأنّه يُقنع.
اتّسعت دائرتُه التنظيمية: قيادةٌ لأكثر من خمسين مجاهدًا، وإشراف على شريطٍ جغرافي ممتد من أولاد حملة إلى عين فكرون؛ مسالك وعرة، ووديان حارسة، وعيون متربصة، تقتضي قيادة صلبة وخبرة ميدانية ودمًا باردًا. في هذا المسرح وُلدت واحدة من أنصع معاركه: “معركة فم الفج” في إقليم بلدية أولاد قاسم يوم 27 ماي 1956. كمينٌ صيغت هندسته بعقلٍ فقهيّ لا يقبل الهشاشة: صبرٌ على الرصد، إحكامٌ في التموضع، وانقضاضٌ في اللحظة الحرجة. انتهت المواجهة بسقوط 22 جنديًا من قوات الاحتلال والعناصر المساعدة، دون أن يفقد المجاهدون شهيدًا واحدًا. غنائمُ سلاحٍ وذخيرةٍ أمدّت خلايا المقاومة بدمٍ جديد، وسمعةٌ قائدٍ صار يُذكر في مجالس التخطيط بصفته “العقل الذي يقيس المسافة بين الرصاصة والشرعية”.
استشهد القائد بوغرارة السعودي لاحقًا، فتقدّم الحاج شعبان إلى واجهة القيادة مع رفيقه بوجمعة صولاج. لم تكن القيادة وسامًا يعلّقه، بل مسؤولية ينهض بها: سلسلة عمليات نوعية هدفت إلى تأمين نقل السلاح والذخائر من الشمال القسنطيني إلى معاقل الأوراس، أبرزها عملية “أولاد نويّوة” التي كبّدت العدوّ خسائر فادحة وصادرت عتادًا حربيًا حاسمًا. وخلال مسيرته، خاض ما لا يقلّ عن أربعٍ وعشرين معركة، يتقافز فيها بين أدوارٍ ثلاثة: قائدٌ يرسم الخطة، منظّرٌ يضع القواعد، ومقاتلٌ يتقدم عند الملمات. هذه الكثافة الميدانية لم تكن اندفاعًا غرائزيًا؛ كانت ترجمةً لقاعدةٍ تربوية رسّخها في محيطه: “المعركةُ عِمادُ التنظيم، والتنظيمُ روحُ المعركة”.
لمّا عجزت فرنسا عن قتله مباشرة، ارتكبت جريمةً مدروسة ببرودةٍ استعمارية: انتقامٌ جماعي. دمّرت قريته وأحرقت منازلها، وأعدمت من أفراد عائلته من كان يُسعفه من الخلف، وبينهم الشهيدان الصديق لوز وحسين بوهالي، وكانا يمدّانه بالدعم والمساندة. نزح أهل المنطقة إلى الجبال شهورًا، أو احتموا بمدينة عين مليلة، فصار الألم حقلَ اختبارٍ آخر لصلابة المجتمع الذي رعاه. لم يُطفئ الانتقام النار؛ نفخ في جمرها.
في 1958، وعلى بئرٍ في “طاقزة” التابعة لبلدية سِقوس، داهمه قدرٌ كان يخشاه أكثر من مواجهة الجيوش: الخيانة. وشى به خونةٌ وهو يتزوّد بالماء، فغُدر به بعيدًا عن صرير الرصاص وضوضاء المعارك. سقط كما تنبّه مرارًا: “الفرنسيون لن يطالوني أبدًا، لكني أخشى خيانة من أبناء جلدتنا.” كانت العبارة، التي ردّدها تحذيرًا وتربيةً، نبوءةً ختمت سيرةً منسوجة باليقظة. رحل جسدًا؛ أمّا المعنى فبقي: أن الثورة لا تكتمل بقطع رأس العدوّ فحسب، بل أيضًا بترميم الجبهة الداخلية من تصدّعات الهوى والطمع.
هذه السيرة ليست مجرّد سردٍ لبطولة فرد؛ إنّها خيطٌ في نسيج مقاومةٍ أقدم. عين مليلة، في حدودها الجغرافية القديمة، لم تنتظر نوفمبر لتقول “لا”. ففي سنة 1902 سجّلت صحيفة Le Pèlerin الفرنسية حادثةً صريحة: مجموعة من أهل عين مليلة باغتوا الضابط الفرنسي “ماليه” وجنديًا محليًا يُدعى “مقلار” بالعصيّ أثناء عودتهما من جولة تفقدية، فأصابوهما إصاباتٍ بليغة قبل أن تتدخّل القوات الفرنسية بعنف. وسمتها الرواية الرسمية يومها “قطعَ طرق”، لكنّ الذاكرة الشعبية قرأتْها كما هي: إرهاصًا مبكرًا لوعيٍ جمعيّ يرفض القهر. على هذا الجذر القديم نبتت زهور نوفمبر؛ ومن هذا التراب خرج الحاج شعبان لوز.
ما يرفع سيرة الحاج شعبان إلى “سنام الاستثناء” ليس فقط ما فعله، بل “كيف” فعله. لقد جسّد اللقاء النادر بين الشريعة والسلاح، بين المرجعية والقوة. في ساحته، كان الفقيه يضبط اندفاع البطل، وكان القاضي يغسل شوائب الحرب بالعدل، وكان القائد يحوّل الدين من شعارٍ إلى منظومة سلوك: لا اعتداء على المدنيين، لا تسلّط على الضعفاء، لا تضييع لذمّةٍ أو عهد. بهذا المعنى، كان من أوائل القضاة الشرعيين في جيش التحرير الوطني؛ وظيفةٌ تقتضي علمًا راسخًا، وبصيرةً بالواقع، وقدرةً على تكييف الأحكام مع ظرف الاستثناء، دون مسخٍ لمقاصد العدل ولا استسهالٍ لفتاوى العنف.
ولأن الثورة مشروعُ مجتمعٍ قبل أن تكون مجرّد بنادق، اشتغل الحاج شعبان على الحوافّ الخفيّة للانتصار: تماسك القرى المحرّرة، إدارة الشحّ بعدل، زرعُ الثقة بين الأهالي والمجاهدين، وتربيةُ المقاتل على أنّ الانضباط عبادةٌ لا عقوبة. لذلك، كان اسمه يُذكر بنفس الطمأنينة في مجالس القضاء العرفي كما يُذكر في غرف التخطيط العسكري. هذا التوازن هو الذي جعل معركة فم الفج أكثر من نصرٍ تكتيكي: جعلها بيانًا عمليًا بأنّ “الشرعية” إذا ساندت “الشرارة” صار الانفجار تحريرًا لا فوضى.
قد يسأل سائل: ماذا يبقى اليوم بعد رحيلٍ غادر؟ يبقى المنهج. يبقى الدرس الذي ينصح بأنّ التحرير يبدأ من “تحرير المعنى”: أن تكون الثورة منضبطة بمقاصد العدل، وأن يكون السيف مأذونًا من ميزانٍ لا يميل، وأن تُقرأ الخسائر الفردية على محكّ المكاسب الجمعية. تبقى القاعدة التي لقّنها لأصحابه: “إدارة الموارد القليلة بأخلاقٍ كبيرة تصنع فرقًا أكبر من ذخيرةٍ وافرةٍ بلا ضمير.” ويبقى النداء إلى الأجيال: لا يكفي أن نحفظ أسماء الشهداء؛ علينا أن نحفظ معجمهم الأخلاقيّ الذي به انتصروا وهم في الخنادق.
الحاج شعبان لوز ليس فصلًا في كتاب “بطولات الأوراس” وحسب؛ إنّه أحد محرّري فهرس المعاني التي قامت عليها الثورة الجزائرية: علمٌ يضبط السلوك، وعدلٌ يُهذّب القوة، وشجاعةٌ تعرف متى تمضي ومتى تتماسك. في عين مليلة والأوراس يتردّد اسمه كما تتردّد الآيات في صدر قارئٍ مُقبل: حروفٌ تضيء، وتاريخٌ يربّي، ومستقبلٌ يستمدّ من سيرته معيار التفوق: أن تكون جزائريًا معنىً لا بطاقةً، ومجاهدًا مبدأً لا لحظة، وقاضيًا للحق ولو كان الخصم من “أبناء جلدتنا”.
هذه السيرة، بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، تقيم الحُجّة على أن مقام الشهادة ليس خاتمة الحكاية؛ إنّه افتتاحٌ دائمٌ لممكنٍ أعلى. وإن كان الرحيل قد تمّ عند بئرٍ في طاقزة، فإنّ الارتواء الحقيقي ما زال قائمًا: عدلٌ يُحيي، وذاكرةٌ لا تجفّ، ووطنٌ يتعلّم كيف يصون دماءه بحراسةِ المعنى قبل السلاح.