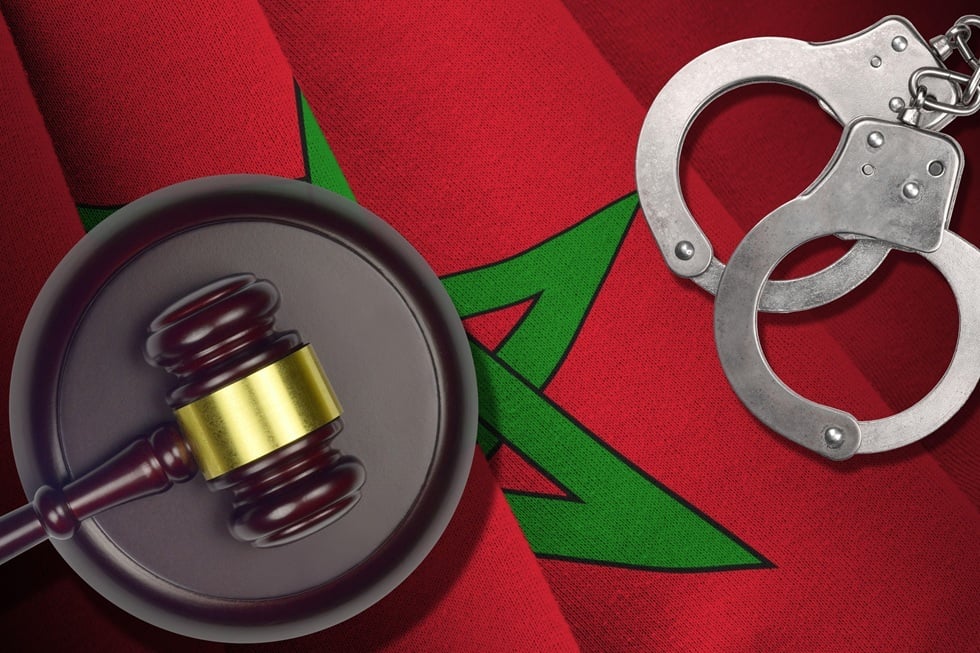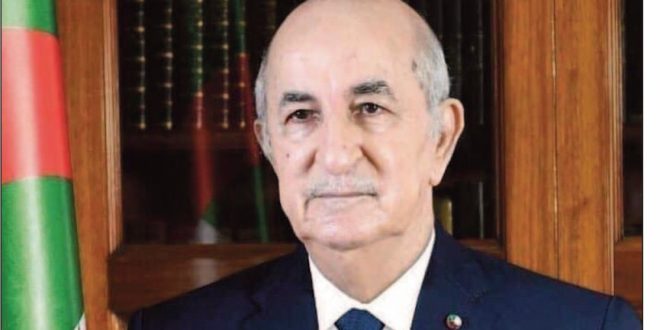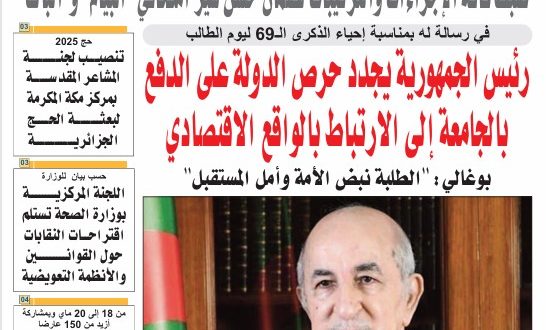ملاحظات حول قانون الأسرة الجزائري
أ.د. الخامسة مذكور/ قبل التطرق لقانون الأسرة الجزائري 02/05 موضوع الدراسة لا بد من الحديث عن قانون الأسرة السابق 11/84 ، الذي تم سنه في ظل نظام الحزب الواحد، وقد تميز هذا الأخير بالعديد من المميزات منها: – أنه أسس على نص المادة 151/1 من دستور 1976 م التي تقضي بأن دين الدولة الإسلام، وأيضا …

أ.د. الخامسة مذكور/
قبل التطرق لقانون الأسرة الجزائري 02/05 موضوع الدراسة لا بد من الحديث عن قانون الأسرة السابق 11/84 ، الذي تم سنه في ظل نظام الحزب الواحد، وقد تميز هذا الأخير بالعديد من المميزات منها:
– أنه أسس على نص المادة 151/1 من دستور 1976 م التي تقضي بأن دين الدولة الإسلام، وأيضا على نص المادة 154 منه ومفادها أن الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع.
– أن معظم نصوصه صيغت من الشريعة الإسلامية، وغلب فيها المذهب المالكي على غيره من المذاهب الأخرى مما يوحي بأن الجزائر تعتمد هذا المذهب.
– أنه اعتمد على العرف الاجتماعي السائد.
لكن ورغم هذه الميزات لم يعد يتماشى مع التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد منها خاصة والمتمثلة في التعددية الحزبية، مما دفع بالعديد من القوى الاجتماعية والسياسية إلى المطالبة بتغيير بعض نصوصه، وتقديم طروحاتهم المبنية على مواكبة موجة إعادة النظر في قوانين الأسرة في الكثير من دول المشرق والمغرب بناء على ما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان خاصة ما تعلق منها بحقوق المرأة والطفل.
ويضاف إلى هذه الأسباب احتدام الصراع بين القوى السياسية في البلاد بين التيار الإسلامي والتيار الفرنكفوني، ورغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة آنذاك في استمرار عهدته بتمرير مشروع قانون الأسرة الجديد ليضمن تأييد التيار الإسلامي له وعدم خسارة الحزب الذي أوصله للسلطة، وقد تضمن هذا القانون العديد من التعديلات في محاولة من المشرع الجزائري أن يتدارك الثغرات التي اتسم بها القانون القديم ، لكن ونظرا لكون هذا القانون هو نتاج الصراع بين التيار الإسلامي والتيار الفرنكفوني وكونه أيضا من إملاءات الاتفاقيات الدولية المدعية حماية حقوق الإنسان، نجد أن أهم ميزة طبعته هي اتسامه بالنزعة الفردية التي تظهر جليا من خلال اختيار المرأة لوليها، وأيضا كونه لا يعكس توجهات غالبية القوى السياسية والاجتماعية، بدليل التعارض الكبير بين مواده ومعالم الشريعة، إذ نجده يقوم في معظم جوانبه على تغريب الأسرة ذات المعالم المسلمة ويخالف هوية المجتمع الجزائري كما سنوضحه في هذا المقام.
ولعل أبرز مآخذ هذا القانون وقبل الشروع في تحليل نصوصه هو القول بأن هذا القانون لم يعتمد على المذهب المالكي بل على كل المذاهب، مما يجعل الأسرة الجزائرية تدخل دوامة الاختلاف الفقهي بعدما كانت مسائل الأحوال الشخصية محسومة بمذهب فقهي واحد يعكس الهوية الوطنية وهو المذهب المالكي وهذا أيضا يعد مساس بالهوية الوطنية.
أما بخصوص ما ورد في نصوص المواد 4،8،49،54،222 منه فنقول أن الأمر أكثر مرارة مما سبق ذكره إذ:
– نجد المادة 4 تنص على: «الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي» ، وبهذا يكون قانون الأسرة الجديد قد غيّر مفهوم الزواج من رباط مقدس إلى شركة وعقد، وفي هذا محاولة لسحب الأسرة المسلمة نحو الغرب الذي يعتبر عقد الزواج عقدا رضائيا يخضع للقانون المدني، في حين أن الدول العربية تخضعه لقانون الأحوال الشخصية والذي مصدره الشريعة الإسلامية، وبذلك يكون المشرع وبهذا التعديل قد أخضع بدوره الزواج إلى القانون المدني لا إلى الشريعة الإسلامية، أي القضاء على الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي أول في الأحوال الشخصية واعتماد قانون نابليون كمصدر لهذا الفرع من القوانين الذي يحدد بوضوح هوية المجتمع الجزائري وهذا أيضا فيه مساس بهويتنا الوطنية .
– بالنسبة للمواد 8 و 8 مكرر و8 مكرر 1 منه؛ والتي جعلت التعدد في الزواج يتوقف على قبول القاضي وقبول الزوجة السابقة حتى ولو توفرت شروط التعدد، وبهذا يكون القاضي ضمنيا قد عين نفسه وصيا على الزوج، وهذا يشكل دستوريا اعتداء على الحياة الخاصة للزوج، وما دام الدستور يعد أعلى درجات التشريع فلا يمكن لقانون الأسرة وهو أقل درجة منه أن يخالفه، إذ أن الدستور والذي يقر بأن الإسلام دين الدولة وأن هذا الدين يمنحه التعدد، والإسلام اشترط العدل ولم يشترط إذن الزوجة السابقة أو الترخيص من القاضي.
-أما المادة 11 منه والتي أثارت جدلا كبيرا في أوساط المجتمع وسخطا كبيرا كونها عكست وبوضوح مآرب اتفاقيه سيداو ونص المادة جاء كالآتي :» تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص تختاره»
فبالنظر إلى المصطلحات الواردة في نص المادة وهي: تعقد، بحضور، أو، أي شخص تختاره نجد أن هذه العبارات في مجملها تضفي غموضا كبيرا على النص، وتطرح بذلك إشكالات قانونية وفقهية في غاية الأهمية منها مسألة حضور الولي هل هي مسألة اختيارية أم الزامية؟ لنقول بأن هذا الاشكال يعد من المسائل الخلافية فقهيا، فهناك من المذاهب من تعتبره مسألة الزامية وهناك من تعتبره غير ذلك، وهذا يفتح ثغرة أمام ضعاف النفوس لإعمال أيسر المذاهب.
واستعماله لعبارة أو، هو للتخيير لا للترتيب وذلك حسب التفسير الحرفي للنص لأن النص باللغة الفرنسية ورد فيه لفظ (ou) التي تفيد التخيير لأنه عندما أراد الترتيب في الفقرة الثانية أورد عبارة (puis)، أيضا استعماله لعبارة «أو أي شخص تختاره» وهي عبارة جديدة تنم عن وضع جديد آل إليه المجتمع الجزائري، فبالرجوع إلى مصالح البلدية نجد عقود زواج كثيرة أبرمت في غياب الولي الشرعي (الأب، الأخ، القريب من المرأة) وحل محلهم أشخاص من الشارع وأصدقاء المرأة وزملاء العمل،،، ولا يحق للأعوان سؤال المرأة عن هوية الوكيل .
– ومن الثغرات التي وردت في هذا القانون الغموض الذي ورد في نص المادة 49 : «لا يثبت الطلاق إلا بحكم…»، إذ يفهم من هذا النص أن الطلاق يقع من القاضي وهذا خطأ فهو يقع بالإرادة المنفردة للزوج، أو بإرادة الطرفين معا، وقد ترتب على هذا النص وضعيات قانونية منها ما جاء في نص المادة 51، التي تقضي بأن من راجع زوجته قبل صدور الحكم لا يحتاج إلى عقد جديد؛ في حين أن من راجعها بعد صدور الحكم يحتاج إلى عقد جديد، لأن صدور الحكم قد يطول والزوج يكون قد طلق زوجته وفاتت مدة العدة المقدرة بـثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق وليس من تاريخ النطق بالحكم.
-ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتكلم عن المادة 54 التي مضمونها: «يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي، إذا لم يتفق الزوجان على مقابل مالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم»، من خلال نص المادة نجدها انها تتضمن العديد من النقائص منها:
– مادة واحدة لمعالجة الخلع، تبعث عل الدهشة والتساؤل فيما إذا كانت تكفي لمعالجة جوانب الموضوع كلها.
– المادة في فقرتها الأولى لا تعطي للقاضي الحق في تقدير مشروعية الخلع من عدمه، إذ قد تلجأ إليه الزوجة بقصد الاضرار بالزوج ، والتعسف في استعمال حقها وهذا ظلم والإسلام لا يرضى بالظلم.
– المادة 54 من القانون السابق 84/11، صيغت بناء على ما اتفق وأجمع عليه جمهور الفقهاء، لكن النص الجديد خرج عن إجماع الفقهاء وأخذ باجتهاد غير مجمع عليه وليس برأي راجح وهو رأي ابن رشد الحفيد في تكييفه للخلع فقال: «أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابل ما بيد الرجل من الطلاق إذا فرك المرأة جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل» .
– إهمال المشرع لأهلية الزوجة لأنها قد تكون قاصرا، فهل تلزم بدفع البدل الذي يعد من التصرفات الضارة ضررا محضا للقاصر؟
-المشرع الجزائري لم يعرف الخلع ولم يحدد آثاره ولا شروط صحته، مما يستدعي الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية بكل مذاهبها .
– ومن المآخذ أيضا المادة 222 التي تحيل إلى الشريعة الإسلامية كل ما ليس فيه نص وقضاتنا تكوينهم الفقهي بسيط، مما يطرح التساؤل حول مبررات ترجيحهم لأقوال الفقهاء وكيفية القيام بذلك.
ختاما نقول وبكل أسف وحسرة أن التعديل الجديد قد ضرب المجمتع الجزائري في هويته وفي دينه وفي مذهبه فلم يعد لنا مذهب محدد نحتكم إليه، ولم تعد الشريعة مصدرا رسميا أول في الأحوال الشخصية، كما لم تعد لنا هوية خاصتنا فقد غربت الأسرة وغرب المجمتع، فنسألك اللهم اللطف والثبات.
والحمد لله رب العالمين.