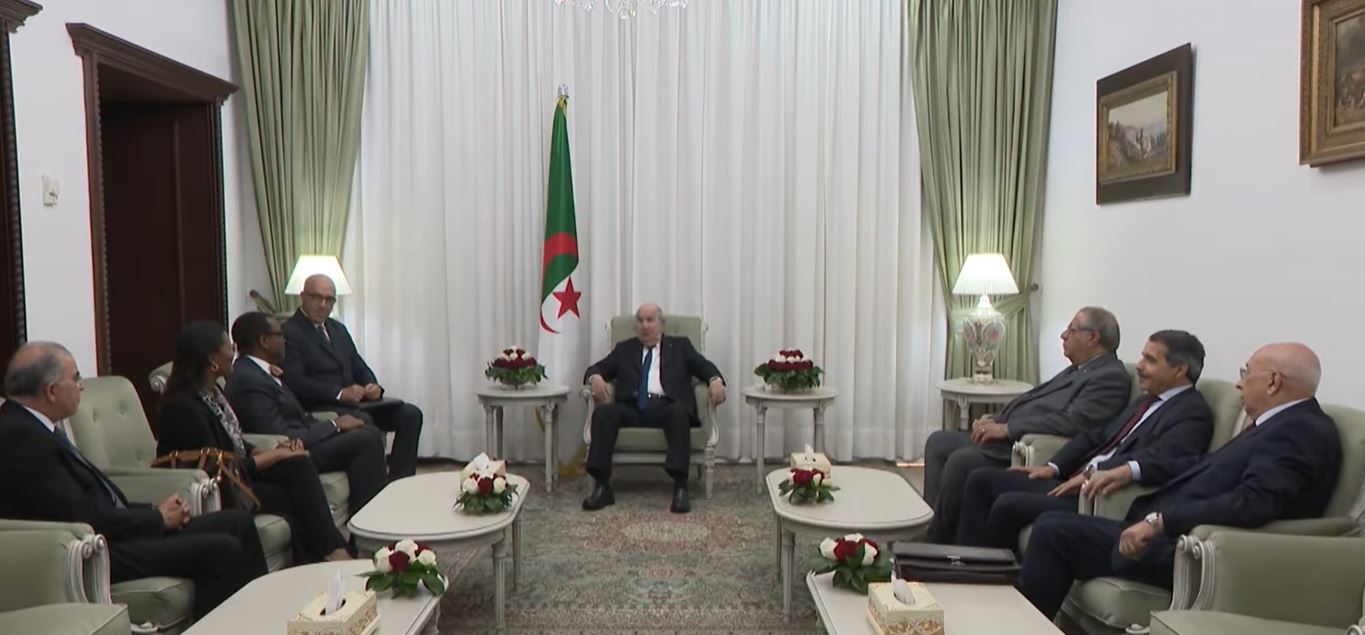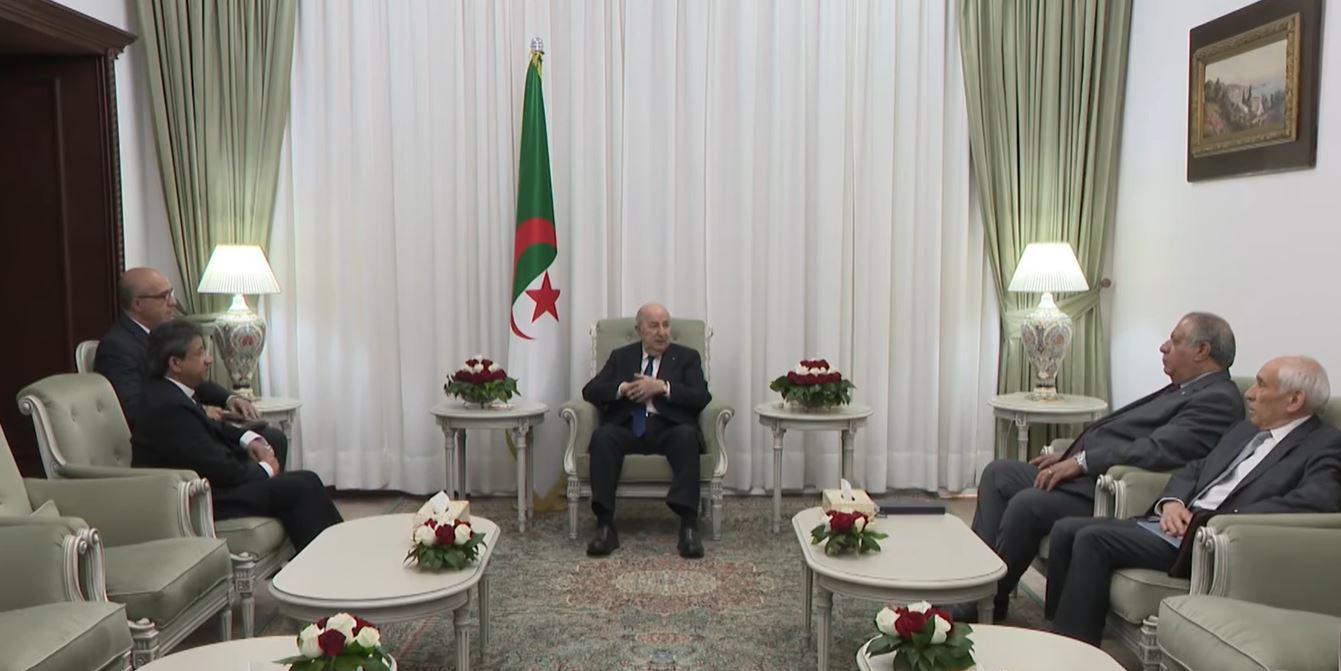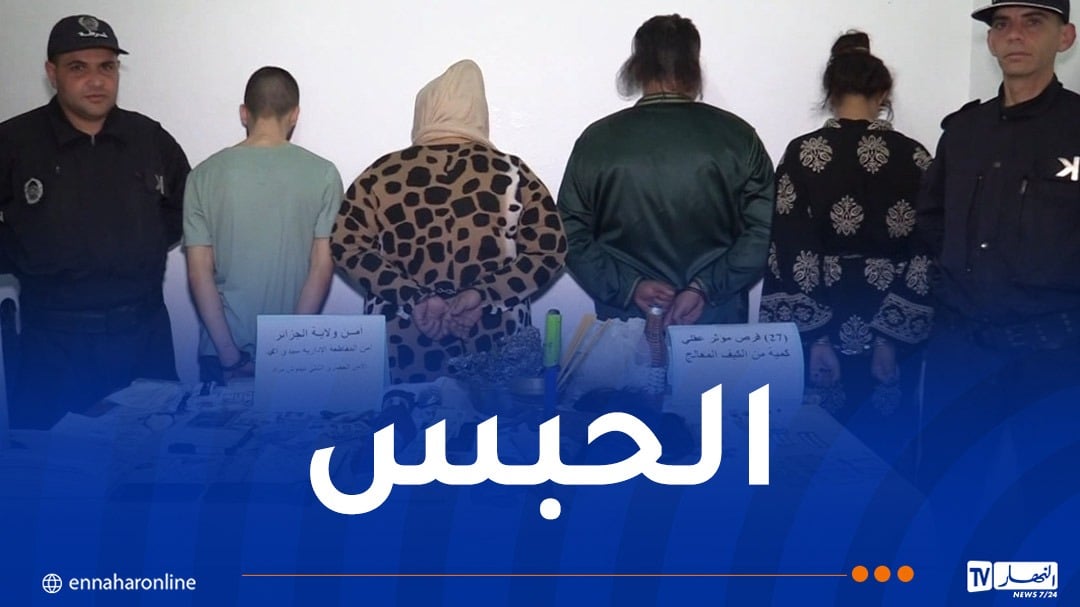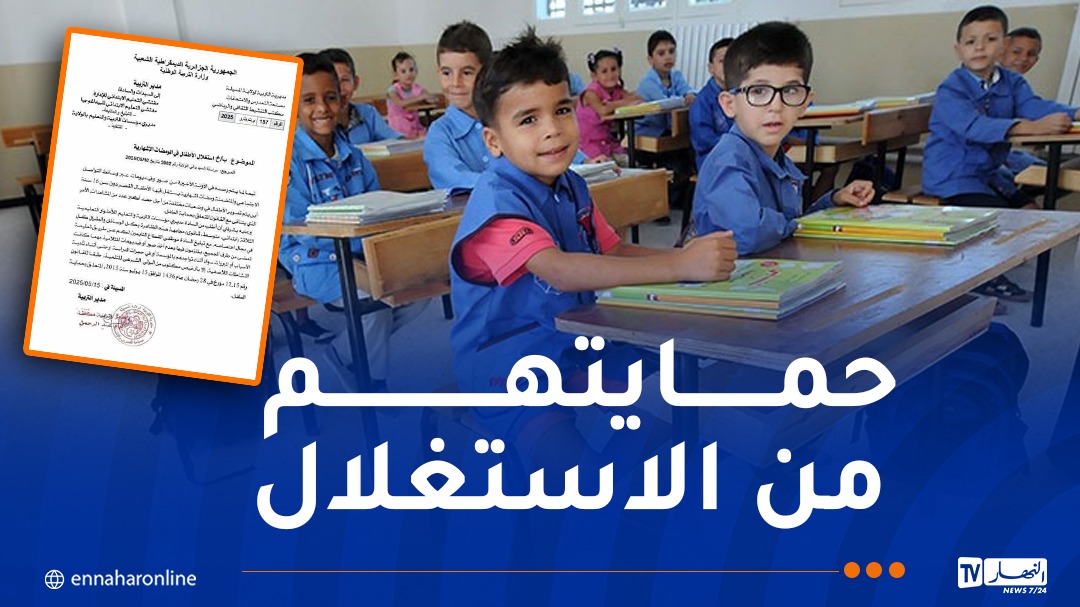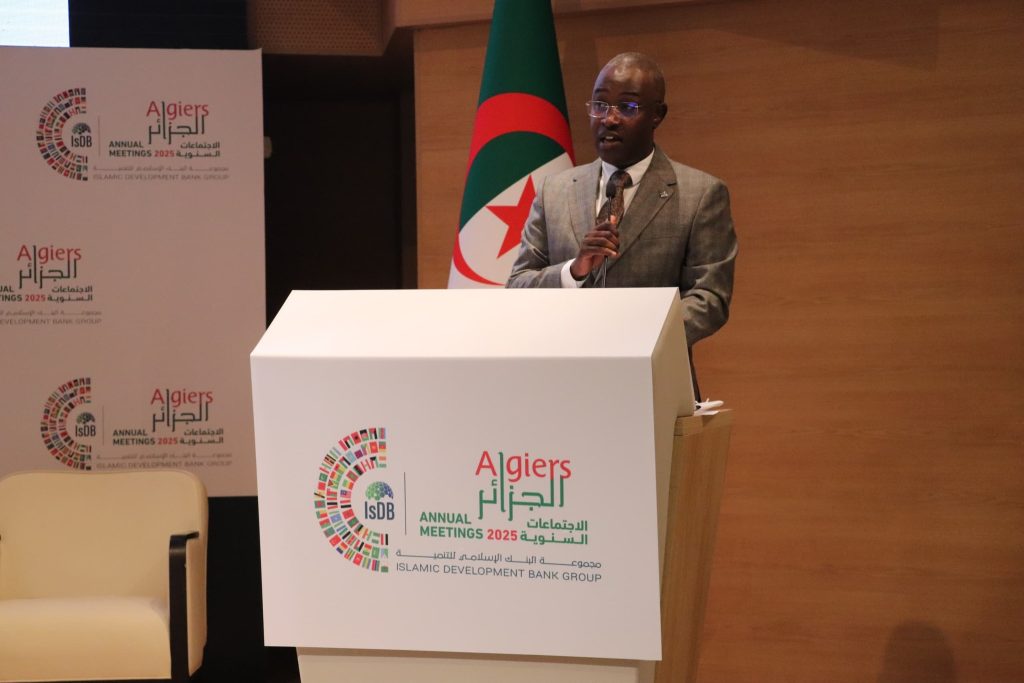إنسان ما بعد الموحدين على ضوء الفكر الخلدوني والنهج الإسمي.
د. محمد عبد النور/ يتحدث علماء البيولوجيا الاجتماعية اليوم: عن وراثة مزدوجة: وراثة ثقافية ووراثة بيولوجية، وقد وظف بن نبي كثيرا مفهوم الوراثة في كتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، وهو كدح خلدوني أصيل من حيث استناد تحليلاته إلى ما يسميه «العوائد» وهي ذات المقصود بالوراثة وابن خلدون يفصل بشكل دقيق في كيفية انتقال العوائد، …

د. محمد عبد النور/
يتحدث علماء البيولوجيا الاجتماعية اليوم: عن وراثة مزدوجة: وراثة ثقافية ووراثة بيولوجية، وقد وظف بن نبي كثيرا مفهوم الوراثة في كتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، وهو كدح خلدوني أصيل من حيث استناد تحليلاته إلى ما يسميه «العوائد» وهي ذات المقصود بالوراثة وابن خلدون يفصل بشكل دقيق في كيفية انتقال العوائد، وهو ما نحته علماء البيولوجيا الاجتماعية اليوم في مصطلح دقيق هو: «الانتقال الثقافي» مع التنبيه إلى أن البيولوجيا الاجتماعية لا تتعلق فقط بالجانب الجسدي المادي إنما أصبحت تتضمن أيضا الجانب الثقافي الرمزي حيث تقابل الجينات، بما هي وحدة المعلومات الجسدية، الميمات بما هي وحدة المعلومات الثقافية.
باستحضار النسق البنبوي في جملة كتاباته يأتي ما سماه في كتاب «ميلاد مجتمع» بالمجتمع الطبيعي ذي الوجود الغفل مقابل المجتمع التاريخي ذي القصود الواعية، فالتماثيل بين المجتمعين الإسلامي والإنجليزي في الميل إلى المحافظة على التقاليد ليس إلا تماثلا ظاهريا، حيث الأول يميل إلى التقاليد بقصد تحقيق التوازن مع «فكرة التقدم» الطاغية على الاجتماع الأوروبي في تلك اللحظة، بينما ميل المسلم إلى التقاليد إنما هو رد فعل غريزي عن شعور بالنقص أمام الآخر و شعور بالعجز عن ابتكار المعاني وابداع الطرق والوسائل التاريخية التي يتطلبها التحدي الظرفي.
استخدم بن نبي هنا المنظور السببي/العلي الصرف، وهو ببعض التجوز تفسير بنيوي حتمي، لفهم طبيعة البشر في المرحلة التاريخية والمنطقة الجغرافية المتعينين، وهو استدخال للتاريخ المديد في الملاحظة التجريبية الآنية، بمنطق إسمي محض، حيث فهم الجزئي المباشر والعيني التجريبي من منظور متجاوز له حسيا هو التاريخ المديد، ومن جهة أخرى هو تركيزه على «الإطار الحضاري» بنفس الكدح الخلدوني في علاجه لإشكالية البداوة والتحضر التي هي العلاج العميق لإشكالية العلاقة بين الوجود الطبيعي الفطري و الوجود الثقافي المكتسب، لكن في إطار زمني مختلف عن الزمن الخلدوني حيث الاختلاف النوعي بين المرحلتين الخلدونية والبنبوية يتمثل في أن ابن خلدون عالج مشكلات الاجتماع الإسلامي بمنطق التداول الحضاري الداخلي من منطلق تعاقب الدويلات الحاكمة عليه في المغرب والمشرق منذ أفول الدولة العربية الأخيرة مشرقا: العباسيين وتحول الخلافة الإسلامية إلى بقية الأعراق المسلمة، بينما كان دأب بن نبي أن يعالج مشكلات الاجتماع الإسلامي بمنطق التداول الحضاري الخارجي من منطلق تراجع الحضارة الإسلامية عامة بالتركيز على ما حدث للمسلمين منذ أفول آخر دويلات البربر مغربا: الموحدون.
بدلا من الخصوصيات التفصيلية للمجتمعات التي دأبت عليها الانتروبولجيا الاجتماعية، وحتى الأدبيات السوسيولوجية التي نشأت في كنف الدولة الوطنية الحديثة، يتكلم بن نبي عن «جوهر اجتماعي» موحَِّد تشترك فيه مجتمعات الإسلام من طنجة إلى جاكرتا، وذلك من خلال ملاحظة تشترك فيها كل مجتمعات الإسلام أو قل هي «خاصة» بالعالم الإسلامي دون غيره، فهي في نظره ليست خصوصية اجتماعية، ذرية بالتعبير الفيزيائي، إنما هي خصوصية حضارية، مجرّية بالتعبير الفلكي، فهي الخصوصية التي لا ينتبه إليها الفكر الاجتماعي الحديث ولا يلقي لها بالا، رغم كون الأدبيات الغربية تستبطنها ضمنيا، وهو أمر غائب في تقاليد سوسيولوجيا العرب والمسلمين، فهو تقسيم يستبطن البعد الديني بشكل عميق بوصفه عاملا ذا تأثير حاسم في صياغة الخصوصيات الاجتماعية التاريخية، وميزة بن نبي أنه قدم ملاحظة تجريبية (ملاحظة اللعب مع الثعابين) استلها بن نبي كملاحظة عابرة للحضارة الواحدة، وهي الملاحظة التي تجعلنا ندرك التفاصل الزمني بين مجتمعات الإسلام والحضارة الحديثة من الناحية النفسية-الاجتماعية التي تعيد صياغة مفهومنا للزمن الاجتماعي-الحضاري وأنه زمن كوني، فهي ليست بالملاحظة التي تكشف عن خصوصيات أدنى من «البعد الحضاري» ولا أكبر منه، فهي ملاحظة منتقاة بشكل ظاهراتي سعى لاستلال جوهر كامن بعيدا عن المرور المغرق في التفاصيل التجريبية وأبعد عن الجمود النمطي على مفهوم الرؤية الموحدة التي تطابق المفاهيم بالوجود الفعلي عنوة، وهو اكتشاف أشبه باكتشاف انشتاين لاختلاف مفهوم الحركة حسب السرعة في نسبة كل جسم متحرك إلى الآخر حسب درجة سرعته أو ثباته، هذا المفهوم الذي حرر الفلسفة من معتقد الزمن الموحد والثابت إلى منظور الزمن المختلف والمتعدد الذي تنتج عنه نتائج على مستوى العلوم الاجتماعية، وهو في الواقع ليس إلا امتدادا للثورة الخلدونية التي أدخلت مفهوم الزمن التاريخي المتغير على المفاهيم الفلسفية التي كان مقصيا منها آلاف السنين، فكما اكتشف ابن خلدون التغاير الزمني بين دويلة إسلامية وأخرى اكتشف بن نبي التغاير الزمني بين حضارة وأخرى، وهذا التمييز هام جدا في العلوم الاجتماعية لتحريرها من التبعية المطلقة للسياق المعرفي والحضاري الغربي من خلال الارتباط المدرسي بالمفاهيم والنظريات الغربية الحديثة، وكأنها مفاهيم نهائية ممكنة الانطباق على اي مجال حضاري.
أكّد بن نبي هنا أن تاريخ الإسلام بعد الفترة الراشدية هو تاريخ تفكك، إذ أن تحول الخلافة الاختيارية إلى ملك وراثي سيؤدي حتما إلى انشطار العلاقة بين الحاكم والمحكوم أولا، ثم ظهور الانقسامات السياسية ذات الأساس الاجتماعي، وهو ما تحقق في عهد الدويلات، أو بلغة بن نبي صويلجانات، ومن ثم فإن النتيجة المنطقية تتمثل في أن استعادة اللحمة بين السياسي والاجتماعي بما هو استعادة الوحدة إلى الأمة جميعا إنما يقوم على الاختيار الطوعي للحاكم لا الملك الوراثي، وأن الانشطار الحاصل اليوم أبعد من كونه قائما على الميراث العصبي إنما أصبح قائما على الاعتماد على شوكة الأجنبي، لكن من منظور الحتميات التاريخية وبإحصاء زمني نجد أن زمن الحكم الراشدي الذي أصبح بمثابة ما يجب أن يكون، لا يعد شيئا أمام مسار الملك الوراثي نحو الملك برعاية أجنبية، وهي النقلة التي حدثت بين العهد الخلدوني والمرحلة البنبوية، بمعنى أنه وحتى باستعادة «الحكم الاختياري الراشد» الذي أصبح بمثابة المرحلة المثالية، فإنها تأتي بأسباب وتنتهي بأسباب، لكن الأهم في كل الأمر هي أن تغدو ذات أثر مفصلي في المقبل من الأحداث خاصة من حيث دورها المؤسس في إعادة الإسلام والمسلمين إلى الريادة الحضارية أساسا، وبالتالي فإن تأثيرها المركزي هو في كونها «حديثا» يعادل أو هو أهم من أن تتحقق فعليا كـ»حدث»، أعني أن تكون في الأذهان والإرادات كتمثل دائم يراود أصحابه حتى يكون يوما واقعا معيشا، ولعل من حقائق التاريخ المديد، أن استعادة الوضع السياسي الأتم المحقق للحمة العامة للأمة والمعيد لها إلى صناعة التاريخ إنما ليس مطلوبا لذاته، وأن استمراره ليس الغاية بقدر ما أن ما ينتج عنه هو الأهم، ذلك أن التفسير المقابل لإشكالية تحول الخلافة إلى «ملك وراثي» إنما ينطوي على أمرين: الأول هو أن الحرب الأهلية إنما كانت التعبير عن الحيوية الحاصلة داخل المجتمع الإسلامي حينها، كما هي السنة في كل الحضارات، التنافس على الريادة، ضمن منطق «الأمة السيدة»، والثانية هي أن الانحراف في طبيعة الحكم سيكون الشر الذي لابد منه، لكون النظام أيا كان مقدّما ومفضّلا على الفوضى التي قد تنشأ في عدم تمكن أي طرف من الأطراف المتنافسة على بسط الهيمنة، ما يتحول إلى مسار استنزاف داخلي مستمر ومتواصل، لذلك كان بسط الهيمنة بقانون الشوكة هو الواقع/المبدأ الأهم في استمرار الاجتماع البشري المستحيل من دون منظومة حكم سياسي يقودها.
النص البنبوي أعلاه، ورغم القول بالحتميات وضروراتها، هو كدح أخلاقي أساسي، بغض النظر عن المنظور الحتمي الواقعي، ذلك أن الانحراف القيمي في مسار التأسيس لطبيعية الحكم، التي ستهيمن لقرون بل وستزداد انحرافا إلى درجة التعامل مع الأجنبي، بدءا بفترة ملوك الطوائف في الأندلس إلى غاية اللحظة، يبقى انحرافا لا يمكن تبريره أخلاقيا، إلا من باب كون مرحلته المؤسسة بأفضل مما أتى بعدها؛ وبين المنظورين الحتمي والأخلاقي يتأرجح النظر الإنساني والحكمة الراجحة في التعامل مع أي مرحلة، فإن نحن استطلعنا جل التاريخ الإسلامي في مشرقة ومغربه وجدناه يتأرجح بين جدليتي: الانصياع والرفض كجدلية، يكون اختيار الموقف فيها «اجتهاديا» عند كبار المجتهدين، بعيدا عن منطق التزلف أو الفوران الغريزي، وهو ليس مقصودنا هنا، إنما نجد رعيلا من العلماء والعاملين، اتخذوا مواقف تتأرجح بين الرفض والمهادنة حسب الموقف وتقديره، وكذلك نستقرئ في كيفية التعامل مع الغازي الأجنبي من المغول إلى غزو الأوروبيين، لكن كل ذلك يبقى المبدأ الأخلاقي قاضيا على المواقف الاجتهادية، لأن الموقف الأخلاقي غالبا ما يكون التزاما مجردا، ولأن مجرد الانخراط في الاجتهاد فسيحصل اعتبار المصلحة العامة والمرسلة وتقديمها على الموقف الثوري، وهو الأساس نفسه الذي عليه تفترق الأمة في كثير من مفاصلها الجغرافية، بناء على الاختلاف في تقدير المواقف، وبناء على الفرقة التاريخية الحاصلة، ولأن استعادة اللحمة التاريخية بناء على الحكم الاختياري إنما سينهي أي حالة افتراق واختلاف، مادامت الوحدة السيادية هي الخيار الوحيد.
قول بن نبي: «إن التركيب الأساسي نفسه قد تحلل فتحللت معه الحياة الاجتماعية، وأخلت مكانها للحياة البدائية» هو التعبير المماثل للقول الخلدوني: «وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة والله وارث الأرض ومن عليها وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث».
نستشف من كلام بن نبي هنا وهو يتحدث عن النهضة التي تعوقها مشكلات قوله الضمني بتفاصل الوعي عن السلوك، وهي الفكرة القطب في كل المسألة الحضارية، أو بقول بسيط أن الرغبة في تحقيق النهضة لا يكفي بمجرد التهيؤ الإرادي ولا الخطاب اللفظي، إذ يوجد ما به يمكن أن تكون به الإرادة الصادقة مجرد أمنيات، والخطاب النزيه مجرد ألفاظ تتكاثر بلا عائد واقعي، ذلك أن الأمر متعلق بعلل آتية من عمق الماضي قاضية على التمني والعزم مهما كان نزيها وصادقا، ذلك أن أسبابا فعلية تأتي من الماضي لتؤثر في الحاضر يعسر تجاوزها من حيث كونها «جماعية» قاهرة للأفراد، ومن حيث هي «لا واعية» تتخلل الوعي فتجرفه إلى تياراتها، ويمعن بن نبي في التشخيص بأن المرض كامن في أعماق الكل حتى عند علاج الموضوع ذاته.
يشير بن نبي هنا إلى أن هناك مدخلين للخروج من هذه الحتمية ومحاولة تجاوزها وهي: 1- التعاليم الإسلامية الحقة (خلقا)، و2- مناهج التعليم الحدثية (علما)، وقد أصبحنا نفقه ما بين أخلاق الحنيفية المحدثة ومنهج الإسمية العلمي من رابطة واتصال تجعل من مناهج العلوم الحديثة وتعاليم الإسلام وجهان لعملة واحدة، بما هي -أي العملة، عملة التحرر من حتميات التاريخ- كملاذ ميتاتاريخي متعال قائم على النقدية الحادة لكل الحاصل التاريخي: خلقيا كان أو علميا، ومنه وحدة الطريقين الخلقية والعلمية وأنهما متصلان جوهرا ومنفصلان مظهرا من حيث أن كينونة الإنسان الوجودية تتحرك وفقا لفقه الإنسان اتصالهما الجوهري من عدمه، فإن هو فقه الاتصال بينهما كان ذلك المدخل للتحرر من الظرفيات القاهرة للإنسان فالأمر حينها سيتجاوز مجرد العلم دون قدرة على العمل، إنما العلم متصل بالعمل.
أخيرا، وليس آخرا أهم خلاصة بنبوية عن السمة الجامعة المانعة لإنسان ما بعد الموحدين وهي كونه «فاقدا السيادة على ذاته» تابع لغيره، وذلك جوهر مقولة القابلية للاستعمار عند بن نبي، حيث المؤشر الظاهري الرئيس على ذلك هو تولي غير ذوي الكفاءة تسيير الشؤون العامة لشعوب الإسلام، بوصفها التجلي الأخير لفقدان الإنسان أسس السيادة على نفسه، ذلك أن أسباب تحقيق السيادة على الذات: خلقية إرادية ونظرية تصورية، يكون المدخل إليها: التعليم الديني أو التعليم المدني الإسميا الطابع، غير الجامدين على أسسهما المدرسية، بحيث تتحرر المقولات الخلقية من نهج التعامل بالمثل ورد الفعل، إلى الفعل المبدأي المطلق من تأثير الذوات التاريخية التي تحمل مخزونها الجمعي الماضوي والنفسي التراكمي، وتتحرر المقولات النظرية من نهج تصور التطابق من المقولات الجمعية الموروثة والصور الفردية الملتقاة لفظا لا حسا، وتلك هي الشروط التأسيسية العميقة للتحرر من التبعية والارتقاء إلى عالم السيادة، عالم الكبار.