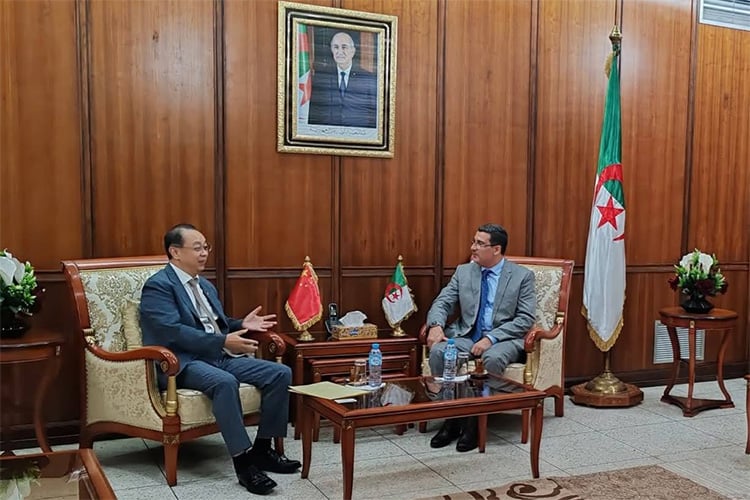المؤسسة الدينية في مواجهة اتفاقية سيداو: الرؤية والأهداف
أ.د رقية بوسنان/ تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، من أبرز الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، ورغم أهمية ما تتضمنه من مبادئ لحماية المرأة من العنف وضمان مشاركتها في الحياة العامة، إلا أنها مثلت تحديا كبيرا للمجتمعات الإسلامية، فبعض موادها، مثل الدعوة …

أ.د رقية بوسنان/
تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، من أبرز الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، ورغم أهمية ما تتضمنه من مبادئ لحماية المرأة من العنف وضمان مشاركتها في الحياة العامة، إلا أنها مثلت تحديا كبيرا للمجتمعات الإسلامية، فبعض موادها، مثل الدعوة إلى المساواة المطلقة في الأدوار الأسرية، وإلغاء التمييز في قضايا الميراث والولاية والزواج، تتعارض مع المرجعية الشرعية الإسلامية، وهنا برز دور المؤسسة الدينية باعتبارها الحارس على الهوية الدينية، والساعي لتأطير النقاش الاجتماعي والسياسي حول الاتفاقية بما يحفظ ثوابت الشريعة.
الرؤية الدينية… استيعاب لا إقصاء
تنطلق رؤية المؤسسة الدينية في تعاملها مع اتفاقية سيداو من جملة من المرتكزات الفكرية والفقهية، التي تستمد جذورها من مرجعية الشريعة الإسلامية ومقاصدها العليا في حفظ الدين والنفس والعرض والنسل، فهي لا تنظر إلى الاتفاقية باعتبارها نصا قانونيا مجردا، بل باعتبارها تعبيرا عن منظومة قيمية قد تتعارض في بعض جوانبها مع ثوابت الأمة الإسلامية، ومن هنا، فإن المؤسسة الدينية تعتمد في مقاربتها على التمييز بين ما يمكن التوافق معه من بنود لا يتناقض مع الشريعة، وبين ما يمثل مساسا بالهوية العقدية أو تفكيكا لبنية الأسرة كما صاغها الإسلام، وبذلك فإن موقفها ليس رفضا مطلقا ولا قبولا غير مشروط، وإنما قراءة نقدية تنطلق من مقاصد الشرع، وتسعى في الوقت نفسه للحفاظ على حضور الأمة في الساحة الدولية دون تفريط في ثوابتها، ومن عناصر هذه الرؤية…
سيادة الشريعة الإسلامية
تنطلق المؤسسة الدينية في رؤيتها لاتفاقية سيداو من مبدأ أصيل يتمثل في سيادة الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجعية العليا المنظمة لشؤون المجتمع والدولة، فالشريعة ليست مجرد منظومة أخلاقية، بل هي مصدر القوانين والأحكام التي تعطي للإنسان حقوقه وتحدد له واجباته في إطار متوازن، ومن هذا المنطلق، تؤكد المؤسسة الدينية أن أي اتفاقية دولية لا يمكن أن تكون ملزمة إذا ما تعارضت مع نصوص قطعية أو مقاصد شرعية كبرى، وقد عبر الشيخ يوسف القرضاوي عن هذا التوجه بقوله: «لا نرفض المواثيق الدولية جملة، ولكننا نقف عند ما يخالف نصا قطعيا من ديننا، فدين الله فوق كل المواثيق» .
هذا الموقف يعكس رؤية فقهية تقوم على قاعدة «لا اجتهاد مع النص»، أي أن ما ثبت بدليل قطعي في القرآن أو السنة لا يمكن تجاوزه تحت أي ضغط دولي أو التزام خارجي، كما أنه يجسد البعد السيادي للشريعة، إذ تعتبر المرجع الأعلى الذي يعلو على القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية، ومن هنا، يصبح تحفظ الدول الإسلامية على بعض مواد سيداو ليس مجرد خيار سياسي، بل هو واجب ديني وأخلاقي لحماية الهوية والخصوصية التشريعية للأمة.
العدالة لا المساواة المطلقة
ترى المؤسسة الدينية أن العدالة بين الجنسين لا تعني المساواة المطلقة في جميع الأدوار والحقوق، وإنما إعطاء كل طرف ما يناسبه وفق طبيعته وفطرته التي خلقه الله عليها، فالاختلاف بين الرجل والمرأة ليس مجالا للتفاضل، بل أساس للتكامل، وقد أشار الإمام الطاهر بن عاشور إلى ذلك في مقاصده قائلا: «العدل أن يعطى كل ذي حق حقه، وأن يراعى ما جبل عليه كل من الرجل والمرأة من خصائص»، وتؤكد المؤسسة الدينية أن مفهوم «المساواة المطلقة» الذي تطرحه سيداو يتجاهل هذه الفوارق الفطرية، مما قد يؤدي إلى ظلم للمرأة نفسها عبر تحميلها أدوارا لا تتناسب مع بنيتها النفسية والجسدية، وهنا يصبح طرح العدالة أعمق وأكثر إنصافا من المساواة الشكلية، لأنه يقوم على مراعاة الفطرة الإنسانية ومقاصد الشريعة في التكامل بين الجنسين.
حماية الأسرة
تعتبر الأسرة في المنظور الإسلامي الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وحماية استقراره القيمي والأخلاقي. ومن ثم، ترى المؤسسة الدينية أن أي محاولة لإعادة تشكيل بنية الأسرة وفق تصورات خارجية، كما في بعض مواد سيداو التي تمثل تهديدا مباشرا للبناء الاجتماعي، وقد حذر الشيخ عبد الله بن بيه من هذا الاتجاه بقوله: «المواد المتعلقة بالزواج والولاية ليست إنصافا للمرأة بل إفقادها للحماية التي وفرها الشرع»، فالأسرة ليست عقدا مدنيا بسيطا كما في التصور الغربي، بل هي مؤسسة تكاملية ذات أبعاد دينية وأخلاقية، والتخلي عن الضوابط الشرعية في مسائل مثل الولاية، والقوامة، والميراث، لا يفتح المجال أمام مساواة حقيقية، بل يؤدي إلى تفكيك الأسرة وإضعاف تماسك المجتمع بأسره، لذلك، فإن المؤسسة الدينية تجعل من حماية الأسرة هدفا استراتيجيا في موقفها من الاتفاقية.
الشرعية الدولية مقابل السيادة الدينية
تسعى المؤسسة الدينية إلى التأكيد على أن احترام الشرعية الدولية لا يعني التخلي عن السيادة الدينية والتشريعية، فالمواثيق الدولية – بما فيها سيداو – يجب أن تقرأ في ضوء الخصوصيات الثقافية والدينيةـ، وقد صرح الدكتور محمد سليم العوا بأن: «الجهل بخلفيات المواثيق الدولية يجعل كثيرا من المسلمين يتبنونها بلا تمحيص، والمؤسسة الدينية مسؤولة عن كشف التناقضات» ، هذا الموقف يتناغم مع تحفظات عدد من الدول الإسلامية، التي أدرجت تحفظات عامة أو خاصة على الاتفاقية لتؤكد أن التزامها الدولي لا يمكن أن يتجاوز التزاماتها الدينية، وهنا يتجسد دور المؤسسة الدينية باعتبارها سلطة مرجعية تضبط حدود التفاعل مع النظام الدولي.
الرؤية البديلة
تسعى المؤسسة الدينية إلى طرح بدائل مستندة إلى المرجعية الإسلامية، بدل الاقتصار على النقد والرفض، فهي تؤكد أن الإسلام لا ينكر حقوق المرأة، بل يضمنها في إطار عادل ومتوازن، وقد أشار الإمام ابن القيم إلى أن: «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها»، وعليه، فإن البديل الإسلامي يتمثل في مفهوم «العدالة النسوية» الذي يقوم على التكامل والتوازن لا على التماثل والمساواة الشكلية، وهذا الطرح يقدم للعالم نموذجا حضاريا مختلفا قادرا على الإسهام في النقاش الدولي حول قضايا المرأة وحقوقها.
وتتعامل المؤسسة الدينية مع اتفاقية «سيداو» من زاوية مقاصدية لا تقتصر على قراءة النصوص الشرعية حرفيا، بل تتجاوزها إلى النظر في الغايات الكبرى للشريعة الإسلامية، مثل حفظ الدين والأسرة والكرامة الإنسانية، فهي ترى أن بعض مواد الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بالميراث والولاية، تمثل تهديدا لمقاصد أساسية كحماية الأسرة وصون الهوية الدينية، بينما تنسجم مواد أخرى – مثل تلك التي تدعو إلى محاربة العنف وضمان حق المرأة في التعليم والعمل – مع مقاصد الشريعة في تكريم الإنسان وتحقيق العدالة، وبذلك يظل موقف المؤسسة الدينية قائما على مبدأ التمييز بين ما يحقق المصلحة وما يهدد الثوابت، في مقاربة نقدية تسعى للتوازن بين الانفتاح على المواثيق الدولية والحفاظ على الخصوصية الشرعية.
الأهداف العملية … درع واق ومواجهة واعية
إن تعامل المؤسسة الدينية في العالم الإسلامي مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لم يكن مجرد موقف فكري أو اجتهاد فقهي نظري، بل هو رؤية شاملة ذات أبعاد عملية، تنطلق من إدراك عميق لمكانة الشريعة الإسلامية بوصفها المرجعية العليا التي تضبط القوانين والسياسات الاجتماعية، فالمؤسسة الدينية ترى أن أي اتفاق دولي لا يمكن أن يطبق بمعزل عن الثوابت العقدية والأحكام القطعية التي تنظم قضايا المرأة والأسرة في الإسلام، ومن ثم فإنها تسعى إلى تحويل رؤيتها من مستوى التنظير إلى مستوى الممارسة، عبر آليات عملية تتجلى في الفتوى، والإرشاد، والمشاركة في صياغة السياسات، والتأثير في الخطاب العام.
وفي هذا السياق، يظهر الدور الحيوي للمؤسسة الدينية باعتبارها حلقة وصل بين المرجعية الشرعية من جهة، والدولة والمجتمع من جهة أخرى، فهي لا تكتفي برفض ما يتعارض مع النصوص القطعية أو مقاصد الشريعة، بل تتبنى استراتيجية مزدوجة تقوم على التصحيح والبديل: التصحيح عبر كشف مواطن التعارض بين بنود الاتفاقية وأحكام الشريعة، والبديل عبر تقديم تصورات ومفاهيم أصيلة مثل مبدأ «العدالة النسوية» القائم على التكامل لا التماثل، وبهذا المعنى، فإن المؤسسة الدينية لا تقف موقفا دفاعيا فحسب، بل تطرح نفسها كفاعل مؤثر في الحوارات الدولية، مدافعة عن الخصوصية الحضارية للأمة، ومبرزة قدرة المرجعية الإسلامية على استيعاب قيم العدل والكرامة الإنسانية في إطارها الخاص.
وعليه، يمكن القول إن الأهداف العملية للمؤسسة الدينية في مواجهة اتفاقية سيداو تتمثل في جملة من المرتكزات الأساسية التي تتوزع بين حماية الثوابت الشرعية، توجيه السياسات العامة، المشاركة في الحوار العالمي، وتقديم البدائل الإسلامية، فضلًا عن تعزيز وعي المجتمع بقضايا المرأة من منظور شرعي رصين، ومن خلال هذه الأهداف المتشابكة، تسعى المؤسسة الدينية إلى رسم معالم خطاب متوازن يجمع بين الثبات على المرجعية والانفتاح على الحوار، بما يحفظ هوية الأمة ويؤكد حضورها في الساحة الدولية، ويمكن التفصيل فيها.
التوعية والتثقيف
تعد التوعية المجتمعية من أبرز المهام التي تنهض بها المؤسسة الدينية في مواجهة اتفاقية سيداو، إذ تدرك أن معركة المرجعيات ليست مقتصرة على أروقة السياسة والقانون، بل تمتد إلى وعي الناس وإدراكهم اليومي للقضايا المتصلة بالمرأة والأسرة، ومن هذا المنطلق، تعمل المؤسسات الدينية على تفكيك مضامين الاتفاقية وشرح ما ينطوي عليه بعض بنودها من تعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، لتجنيب المجتمع الانسياق وراء خطاب أممي قد يفضي إلى طمس الخصوصيات الدينية والثقافية.
وتتجسد هذه المهمة عبر جملة من الوسائل والآليات، منها: تفعيل المنابر الدينية كالخطب والدروس في المساجد، وتنظيم الندوات الفكرية والحلقات النقاشية في الجامعات ومراكز البحوث، فضلا عن توظيف وسائل الإعلام التقليدية والجديدة لنشر خطاب بديل يقوم على التوازن بين الانفتاح على القيم الإنسانية الكونية والحفاظ على المرجعية الشرعية، كما يتوسع دور المؤسسة الدينية ليشمل الفضاء العمومي الرقمي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة مركزية لإعادة تشكيل الوعي الجمعي، ما يفرض عليها حضورا فاعلا لمواجهة الخطابات المهيمنة وتقديم رؤية إسلامية أصيلة ومقنعة.
وبهذا المعنى، فإن التوعية والتثقيف لا تقتصران على التحذير من المخاطر فحسب، بل يشملان أيضا بناء وعي إيجابي يبرز مقاصد الشريعة في حماية الكرامة الإنسانية، وتأكيد عدالة الإسلام في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة ضمن إطار من التكامل والتوازن، وهو ما يعزز ثقة الجمهور بمؤسساته الدينية، ويجعلها مصدرا مرجعيا آمنا في خضم النقاشات العالمية حول قضايا المرأة وحقوق الإنسان.
إصدار الفتاوى والبيانات الشرعية
يعد إصدار الفتاوى والبيانات الشرعية من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسة الدينية في مواجهة اتفاقية سيداو، إذ تسهم هذه البيانات في تحديد الموقف الشرعي من البنود المثيرة للجدل، لاسيما ما يتعلق بالأحوال الشخصية كالميراث والولاية الزوجية ونظام الأسرة، فقد أكدت دور الإفتاء في عدد من الدول العربية أن هذه البنود لا يمكن تطبيقها لأنها تصطدم بالنصوص القطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية، مثل قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، وهو نص قطعي الدلالة والثبوت لا يقبل الاجتهاد أو التغيير، ومن هذا المنطلق، أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية ودار الإفتاء المصرية وغيرها من الهيئات الشرعية بيانات رسمية تؤكد أن الالتزام بمثل هذه المواد يعد مخالفة للشريعة الإسلامية.
إن هذا الموقف الفقهي الرسمي يمنح الحكومات غطاء شرعيا لتسجيل التحفظات عند التصديق على الاتفاقية، ويمنع عنها الحرج الدولي من خلال إظهار أن التحفظ ليس خيارا سياسيا فحسب، بل هو استجابة لمرجعية دينية ملزمة، وفي الوقت ذاته، تعزز هذه الفتاوى ثقة الجمهور بالمؤسسة الدينية، باعتبارها الحارس الأمين على الثوابت العقدية والأحكام الشرعية، وهو ما يرسخ مكانتها كمصدر للشرعية والمرجعية في المجتمع، كما أن إصدار هذه الفتاوى والبيانات يسهم في ضبط النقاش المجتمعي، ويمنع الانزلاق نحو تبني مفاهيم قد تصادم الهوية الدينية والثقافية للأمة.
التأثير في السياسات العامة
لا يقتصر دور المؤسسة الدينية على الإرشاد الدعوي أو الاجتهاد الفقهي، بل يمتد إلى التأثير المباشر في صياغة السياسات العامة للدول الإسلامية، خاصة في ما يتعلق بالالتزامات الدولية ذات الصلة بالقيم الدينية والأسرة، فقد مارست المؤسسات الدينية في عدد من الدول ضغوطا ملموسة على صانعي القرار لتسجيل تحفظات رسمية عند التصديق على اتفاقية سيداو، بما يضمن الانسجام مع المرجعية الشرعية، ويبرز في هذا السياق موقف المملكة العربية السعودية التي أعلنت تحفظا عاما ينص على عدم الالتزام بأي مادة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهو ما اعتبر نموذجا للتكامل بين المؤسسة الدينية وصانع القرار السياسي.
وفي مصر، جاء تأثير المؤسسة الدينية، ممثلة بالأزهر الشريف، في بلورة موقف الدولة التي سجلت تحفظات على المواد المتعلقة بالمساواة في قوانين الأسرة، خصوصا في مسائل الميراث والولاية. أما الجزائر، فقد عبرت عن موقف متأثر بالمرجعية الدينية عبر تحفظاتها على المواد المتعلقة بالزواج والولاية والحقوق الأسرية، وهو ما يعكس استمرار حضور الخطاب الديني في صياغة السياسات الرسمية، هذه الأمثلة تكشف أن المؤسسة الدينية ليست مجرد صوت موازٍ للسياسة، بل هي قوة ناعمة استراتيجية قادرة على توجيه القرارات السيادية للدول، وتوفير الغطاء الشرعي لصانعي القرار، بما يوازن بين مقتضيات الانفتاح الدولي ومتطلبات الحفاظ على الهوية الدينية للأمة.
طرح البدائل الإسلامية
لا يقتصر موقف المؤسسة الدينية في مواجهة اتفاقية سيداو على النقد والرفض، إذ تدرك أن مجرد الاعتراض لا يكفي لبناء خطاب مقنع أو مؤثر، بل تسعى إلى تقديم بدائل مفاهيمية وتشريعية تنطلق من أصولها الشرعية وتستجيب في الوقت ذاته لتحديات العصر، فهي تعرض مفهوم «العدالة النسوية» باعتباره رؤية إسلامية أصيلة، قائمة على مبدأ التكامل بين الرجل والمرأة لا على التماثل المطلق، فالاختلاف بين الجنسين في المنظور الإسلامي ليس مدعاة للتفاضل أو الانتقاص، وإنما أساس للتكامل في الوظائف والأدوار، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى﴾ [آل عمران: 36]، وهو اختلاف تكويني تترتب عليه مسؤوليات متباينة تحفظ التوازن الأسري والاجتماعي، وقد عبر الشيخ الطاهر بن عاشور عن هذا المعنى بقوله: «إلغاء الفوارق الطبيعية بين الجنسين إلغاء للفطرة، والشرع جاء بحماية الفطرة لا نقضها» .
وانطلاقا من هذا التصور، لم تكتف المؤسسة الدينية بالرفض النظري، بل قدمت نماذج عملية للبدائل، من أبرزها «وثيقة الأزهر لحقوق المرأة» الصادرة عام 2019، التي أكدت أن للمرأة الحق في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية والسياسية، مع الحفاظ على الضوابط الشرعية للأسرة والمجتمع، وتعد هذه الوثيقة مثالا واضحا على قدرة المؤسسة الدينية على صياغة مرجعية بديلة تنطلق من الداخل الإسلامي، بدل الاكتفاء بالاعتراض الخارجي، كما تدعو المؤسسة إلى إصلاح قوانين الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة ويحمي حقوق المرأة والطفل، وتطوير مناهج التعليم الشرعي لتعزيز ثقافة المساواة في الكرامة الإنسانية، وبهذا، تنتقل المؤسسة الدينية من موقع الدفاع إلى موقع المبادرة، حيث لا تقدم الشريعة الإسلامية باعتبارها عائقا أمام تطلعات المرأة، بل باعتبارها مصدرا لإطار حضاري متكامل، قادر على صياغة بدائل أكثر توازنا وإنسانية من تلك التي تطرحها المرجعيات الغربية.
المشاركة في الحوار الدولي
لا تقتصر وظيفة المؤسسة الدينية في تعاملها مع اتفاقية سيداو على الرفض أو التحفظ، بل تمتد إلى المشاركة في الحوارات الدولية حول قضايا المرأة وحقوق الإنسان، فهي تدرك أن الانعزال عن هذه النقاشات يفسح المجال لهيمنة مرجعيات فكرية مغايرة، ولذلك تسعى إلى الحضور الفاعل لتوضيح الخصوصية الإسلامية وإبراز قيمها الحضارية، ولا يعني هذا الانخراط الذوبان في المرجعيات الأخرى أو التنازل عن الثوابت، بل هو محاولة لإعادة تعريف المفاهيم الإنسانية الكبرى من منظور مقاصدي يوازن بين الكرامة والعدل وحماية الأسرة، وقد عبر الدكتور طه جابر العلواني عن هذا التوجه حين دعا إلى تجاوز منطق الصراع بين المرجعيات نحو بناء جسور للتفاهم، مؤكدا أن: «تحويل الحوار من حالة صراع بين المرجعيات إلى حالة تعارف حضاري يتيح لكل ثقافة التعبير عن رؤيتها للإنسان».
وشارك الأزهر الشريف عمليا في عدة مؤتمرات دولية أبرزها «مؤتمر حوار الأديان في الأمم المتحدة» عام 2008، حيث أكد ممثلوه على مركزية الأسرة في التشريع الإسلامي كمرتكز للعدالة الاجتماعية، كما أطلقت رابطة العالم الإسلامي عبر ندواتها في جنيف (2019) مبادرات لتعزيز حقوق المرأة من منظور إسلامي، مبرزة التوازن بين المساواة والخصوصية الثقافية،أما منظمة التعاون الإسلامي، فقد لعبت دورا محوريا في المحافل الدولية عبر التأكيد على ضرورة احترام المرجعية الدينية للدول الأعضاء في أي اتفاقيات تخص قضايا الأسرة والمرأة، هذه الأمثلة تعكس إدراك المؤسسة الدينية لأهمية الخطاب التواصلي، وتحويل الحوار الدولي من أداة ضغط إلى فضاء للتعارف الحضاري والتعاون المثمر.
بلورة المواقف العملية وتحفظات الدول
لقد ساهمت المؤسسة الدينية في بلورة مواقف الدول الإسلامية إزاء اتفاقية سيداو، حيث انعكس حضورها الفكري والفقهي في صياغة التحفظات الرسمية، فقد أعلنت مصر تحفظها على المواد التي تدعو إلى المساواة المطلقة في قوانين الأسرة والميراث، باعتبارها من الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية، بينما سجلت الجزائر تحفظات تتعلق بالزواج والولاية، انسجاما مع رؤيتها لخصوصية الأسرة المسلمة، هذه المواقف لا تعكس فقط حساسية سياسية، بل تجسد تأثير المرجعية الدينية في توجيه القرار الرسمي، ومن هنا يظل النقاش قائما حول جدوى الإبقاء على هذه التحفظات أو مراجعتها أو رفعها، وهو نقاش تتكفل به المؤسسة الدينية من زاوية شرعية مقاصدية، لضمان عدم المساس بالثوابت مع الانفتاح على القيم الإنسانية المشتركة بما يعزز مكانة المرأة في التعليم والعمل ومكافحة العنف، ويرفض ما يخالف أحكام الشريعة في قضايا الأسرة والمواريث، ومن ثم فإن أهداف المؤسسة تتمثل في حماية الهوية الإسلامية، والحفاظ على توازن الأسرة، مع الانفتاح على حوار حضاري يتيح مشاركة العالم الإسلامي في صياغة مفاهيم إنسانية عادلة للمرأة.
في الختام يتبين من خلال تتبع مواقف المؤسسة الدينية تجاه اتفاقية سيداو أن حضورها لا يقتصر على المرافعة الفقهية أو التحفظ القانوني، بل يمتد ليشكل رؤية متكاملة تستند إلى المرجعية الإسلامية في بعدها العقدي والمقاصدي، وتترجم إلى أدوار عملية تشمل التوعية، وتوجيه السياسات العامة، والمشاركة في الحوارات الدولية، وطرح البدائل التشريعية والمفاهيمية، فالمؤسسة الدينية تنطلق من قناعة راسخة بأن الشريعة الإسلامية ليست مجرد منظومة نصوص جامدة، وإنما إطار حضاري قادر على استيعاب المستجدات ومقارعة الطروحات الأممية بما يحفظ للمرأة كرامتها ويصون للأسرة توازنها.
وفي هذا الإطار، يصبح دور المؤسسة الدينية جوهريا في تعزيز السيادة الثقافية والفكرية للأمة الإسلامية، من خلال إعادة صياغة الخطاب الديني بما يجمع بين الثبات على الأصول والقدرة على الحوار مع الآخر، وبين النقد البناء والطرح البديل، وهكذا يمكن القول إن المواجهة مع اتفاقية سيداو لا تفهم في بعدها السلبي بوصفها رفضا مطلقا، بل تترجم كمسعى حضاري لإثبات الخصوصية الإسلامية في قضايا المرأة والحقوق الإنسانية، وتأكيد أن الانفتاح على العالم لا يعني الذوبان فيه.
إن الرهان المستقبلي أمام المؤسسة الدينية يتمثل في تعميق حضورها في فضاء النقاشات العالمية، وتطوير أدواتها الخطابية والتوعوية بما يواكب تحولات العصر، دون التفريط في الثوابت الشرعية، وبهذا المنهج تغدو مواجهة اتفاقية سيداو جزءا من معركة أوسع لحماية المرجعية الدينية وصيانة الهوية الحضارية للأمة، مع الانفتاح الإيجابي على قيم العدالة والكرامة الإنسانية المشتركة.