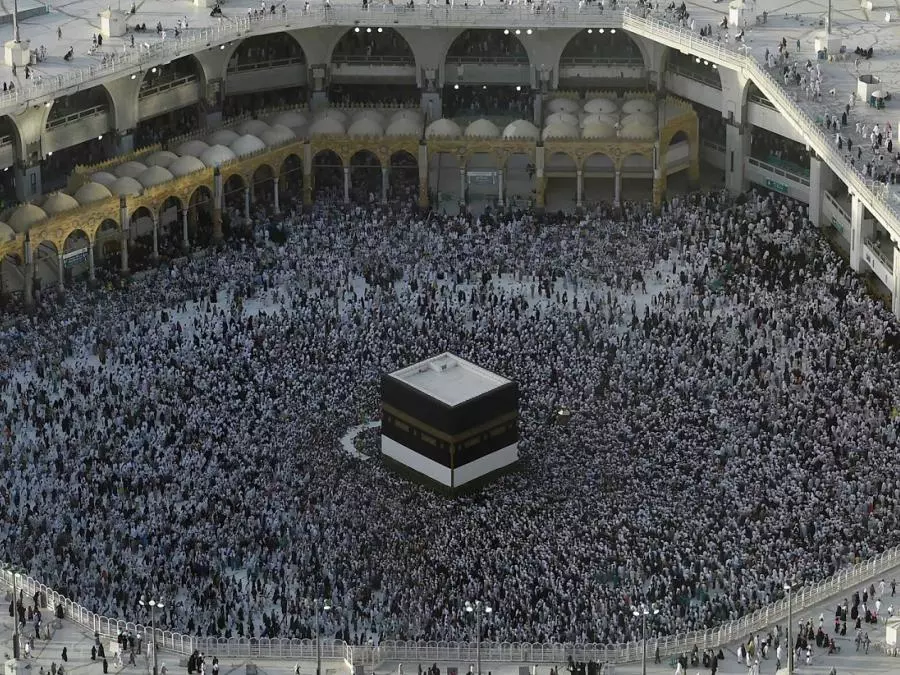من ميزان العدالة إلى ساحة النزاعات: الجرح والتعديل بين خدمة العلم وتصفية الحسابات
د. بن زموري محمد/ يُعدّ علم الجرح والتعديل من أعظم العلوم التي ابتكرتها الأمة الإسلامية في مسيرتها لحفظ السنة النبوية وضبط النقل عن رسول الله ﷺ. نشأ هذا العلم بدافع الدفاع عن الوحي وتطهيره من الكذب والتحريف، فكان بمثابة ميزان دقيق يزن به العلماء أحوال الرواة من حيث العدالة والضبط، ويقررون على ضوء ذلك قبول …

د. بن زموري محمد/
يُعدّ علم الجرح والتعديل من أعظم العلوم التي ابتكرتها الأمة الإسلامية في مسيرتها لحفظ السنة النبوية وضبط النقل عن رسول الله ﷺ. نشأ هذا العلم بدافع الدفاع عن الوحي وتطهيره من الكذب والتحريف، فكان بمثابة ميزان دقيق يزن به العلماء أحوال الرواة من حيث العدالة والضبط، ويقررون على ضوء ذلك قبول الرواية أو ردها.
هذا العمل الجليل أسس لمنهج نقدي صارم، جعل التراث الحديثي الإسلامي نموذجًا فريدًا في تاريخ التوثيق البشري، حتى عند غير المسلمين.
لقد وضع الأئمة الأوائل قواعد واضحة لهذا العلم، فاشترطوا أن يكون الجرح مفسرًا بأسباب محددة، وأن يصدر عن عالم متمكن خبير بأحوال الرجال، وأن يخلو من الهوى والتعصب، وأن يُراعى فيه العدل مع المخالف كما يُراعى مع الموافق.
وكان العلماء الكبار يتجنبون التجريح في أقرانهم إذا علموا أن الخلاف بينهم ليس في ثبوت الرواية بل في مسائل اجتهادية أو فقهية أو منهجية، مستحضرين قاعدة الإمام الذهبي الشهيرة: “كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُقبل، فلا يُلتفت إلى الطعن بين المتعاصرين، لأن الغالب عليه الحسد أو المنافسة أو التعصب للمذهب”.
لكن مسار هذا العلم لم يسلم على مر العصور من الانحرافات عن مقصده الأصلي، إذ انتقل في بعض المراحل من دائرة خدمة النص النبوي إلى ميدان النزاعات الفكرية والمذهبية، بل وأحيانًا الخلافات الشخصية. وبدل أن يظل سلاحًا علميًا منضبطًا بالضوابط الشرعية، استُخدم أحيانًا كسلاح لتصفية الحسابات بين العلماء أو بين تيارات دعوية مختلفة، فأصبح الحكم على الأشخاص بأوصاف مثل “مبتدع” أو “صاحب هوى” يطلق أحيانًا على من يخالف في مسائل اجتهادية أو خيارات فقهية، لا على من ثبت انحرافه في الرواية أو العقيدة.
هذا التحول أفرز آثارًا سلبية عديدة، منها تشويه صورة العلماء أمام العامة، وإضعاف الثقة فيهم، وزرع الشقاق بين طلاب العلم، فضلًا عن هدر طاقات كان الأولى أن تُصرف في البناء والإصلاح وخدمة الدين. كما أن هذا الانزلاق حوّل لغة النقد العلمي إلى لغة تصنيف وتشنيع، مما أضعف أثر النصيحة، وحجب نور الحق وسط ضجيج الاتهامات.
لقد كان السلف الكبار نموذجًا فريدًا في الجمع بين الخلاف العلمي وحسن الخلق، فالإمام مالك كان يقول: “ما منا إلا رادّ ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر”، مشيرًا إلى النبي ﷺ، والإمام الشافعي كان يثني على أبي حنيفة بقوله: “الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة”، والإمام أحمد بن حنبل كان يدعو لمخالفيه بظهر الغيب، رغم الخلافات الكبيرة في بعض المسائل. هذا السلوك الراقي يؤكد أن الخلاف إذا أحاطه الأدب والإنصاف، صار رحمة، وإذا جرده الهوى والتحزب، صار فتنة.
وإذا أردنا اليوم أن نعيد لهذا العلم مكانته الصحيحة، وجب أن نلتزم بضوابطه الأصيلة، وأن نحصّنه من التوظيف الخاطئ في الخلافات الدعوية أو الفكرية أو السياسية. وهذا يتطلب عدة خطوات، أهمها:
إعادة حصر مجال الجرح والتعديل في سياق الرواية الحديثية، نشر ثقافة النقد العلمي المحترم، تعليم طلاب العلم التفريق بين النصيحة المخلصة والتجريح الشخصي، وتأكيد أن حماية مكانة العلماء لا تتنافى مع نقد آرائهم نقدًا موضوعيًا.
إن الأمة التي تحترم علماءها وتؤدب طلابها على الخلاف المنضبط، قادرة على استثمار اختلاف وجهات النظر في إثراء الفكر وتوسيع دائرة الفقه، بدل أن يكون ذلك سببًا للتنازع والفرقة.
وإذا كان علم الجرح والتعديل في أصله ميزانًا للعدالة في نقل الحديث، فإنه في زماننا يحتاج إلى من يعيده ميزانًا للإنصاف في ساحة الحوار العلمي، لا أداة للخصومة وتصفية الحسابات.