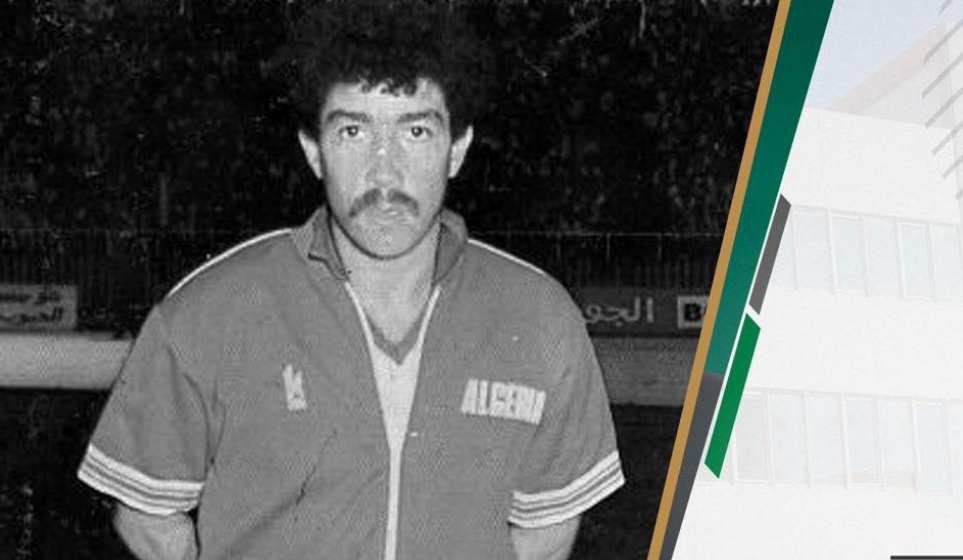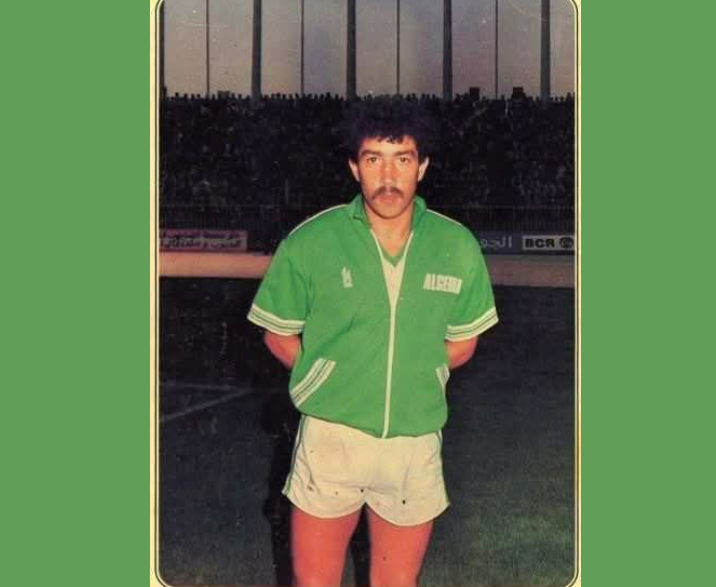الأزمة الفكرية والثقافية الإسلامية في النقد البن-نبّي لمشكلات الاجتماع الثقافي الإسلامي
د. محمد عبد النور/ في مدخل كتاب وجهة العالم الإسلامي أشاد بن نبي كثيرا بكتاب «الاتجاهات الحديثة في الفكر الإسلامي» للمستشرق هاملتون جب الحديث الظهور حينئذ، لما وجده فيه من شبه بكتابه هو؛ إلا أنه أخذ عليه مأخذان أساسيان هما: 1- دعوى اختصاص العقل المسلم بـ»التفكير الذري» دون غيره. 2- دعوى استمداد المسلمين لـ»النزعة الإنسانية» …

د. محمد عبد النور/
في مدخل كتاب وجهة العالم الإسلامي أشاد بن نبي كثيرا بكتاب «الاتجاهات الحديثة في الفكر الإسلامي» للمستشرق هاملتون جب الحديث الظهور حينئذ، لما وجده فيه من شبه بكتابه هو؛ إلا أنه أخذ عليه مأخذان أساسيان هما:
1- دعوى اختصاص العقل المسلم بـ»التفكير الذري» دون غيره.
2- دعوى استمداد المسلمين لـ»النزعة الإنسانية» من الغرب.
كما عرّج إلى نقد الأزمتين العضال في الاجتماع الثقافي الإسلامي وهما:
1- معضلة الاعتباطية الفكرية والغموض وسواد النزعة المدرسية الشكلية.
2- معضلة افتقاد الفكر الإسلامي للرؤية العقلية واستسلامه للرومانسية.
ففي قوله بأن مشكلة «التفكير الذري»(*) خاصة بالفكر الإسلامي، بين بن نبي أن سمة الذرية هي حالة أو علّة عقلية عامة يمكن أن تصيب عقل أية أمة في لحظة معينة من تطورها التاريخي، إما عند الأفول أو قبيل الصعود، حيث وضع بن نبي معلمين في تجاوز الفكر الذري هما ديكارت وابن خلدون، حيث كان الأول بشير انطلاق نحو اليقين العقلي في الفكر الغربي، بينما الثاني نذير أفول النظر السببي في الوجود في العالم الإسلامي.
فديكارت حرر الأوروبيين من التشريع الاعتباطي الذي لا سند عقلي له، بينما ابن خلدون أنذر بأفول «الشعور بالنظام» في الوجود عند المسلمين بعد أن كانوا روادا له، وهو ما ظهر خاصة في التشريع الذي قام على «أسس عقلية» سُميت في التاريخ العلمي بأصول الفقه، ما جعل من الحضارة الإسلامية الأولى في التاريخ البشري التي يقوم النظام التشريعي فيها على «نسق معرفي» متكامل لم يكن موجودا من قبل، وهو ما وجد فيه بن نبي تراثا خطيرا خلفه المسلمون للحضارة الحديثة، ومفاد خطورته أمران:
1- هو تجاوز المسلمين للذرية في مسألة التشريع ذلك أنها تستند إلى «قواعد منطقية» يمكن استخلاصها من التشريع الإلهي، فهي نقلة تأسيسية في الخروج من الذرية في المسألة الاجتماعية، وهي أهم من الخروج منها في مسألة العلوم النظرية، ما يعني إمكان تأسيس المجتمع على أسس نسقية، فإذا كان اليونان قد اكتشفوا النظامين: العقلي (لوغوس) والطبيعي (كوسموس)، فإنهم كانوا أبعد عن استكشاف النظام في التاريخ والمجتمع واعتبروا أنهما لا يقومان على نظام، وهو ما قام ابن خلدون باستكشافه الواعي في علم العمران، رغم أنه كان حاضرا في اللاوعي العام بفضل النصوص والتوجيهات الدينية في الإسلام.
2- أن نسبة التأسيس النسقي للمجتمع لم يكن إلى شخص بعينه بقدر ما هو إلى «منظومة معرفية» استمدت من النصوص والتوجيهات الصادرة عن مصدر غيبي، فمحاولة ديكارت مثلا في تأسيسه للمعرفة اليقينية أقام نسقه على مبدأ «التخلص من خداع الشيطان»، فهو مبدأ أخلاقي محض، لم يكن من مبدعات ديكارت بقدر ما كان عقلنته للمعطى الديني في إطار عقلي رياضي الطابع.. وبالتالي فالمنظومة المعرفية في الإسلام بنيت على الاستمداد المبدئي من «الخطاب الإلهي» الذي يعد فيه الشيطان لحظة من لحظاته، بينما ديكارت أقام فكره على مركزية محاربة الشيطان لا ضمن منظومة متعالية التأسيس لكن ضمن منظومة جعلت الإنسان والطبيعة والرياضيات الأسس المخلصة من الخطأ والقصور في المعرفة.
ولست أيضا مع العالم الإنجليزي، فيما ذهب إليه حين تحدث عن ( الاتجاه الإنساني) في الحركة الإسلامية الحديثة، فعزاه إلى تأثير الثقافة الأوربية، فإن من الواجب أولاً أن تحدد مصطلحاتنا فإذا كنا نتحدث عن نزعة إنسانية تقليدية أو دبلوماسية، فإنا نعترف مختارين بأن الثرثرة الإنسانية ذات جرس جميل، وبأن المتاع اللغوي لدى بعض المسلمين المحدثين قد أثرى ببعض الجمل المنقمة، وببعض الأشعرة الخلابة. بيد أنه ربما وجب علينا أن نبحث الوقائع وأن نذر الألفاظ، وذلك بأن نتناول النزعة الإنسانية في معادنها الأصيلة من التسامح والإيثار واحترام شخص الإنسان.
ولا مجال في مثل هذا الكتاب لعقد مثل هذه الموازنة، إذ ينبغي أن نبدأ فيما يخص الإنسانية في الإسلام ، بذكر ( القيمة الدينية) التي قررها القرآن للفرد، كما أكدنا ذلك في دراستنا عن الظاهرة القرآنية)، في الفصل الذي درسنا فيه (علاقة القرآن بالكتاب المقدس). وربما كان من الواجب أن نورد أيضا ما أوصى به أبو بكر الصديق رضي الله عليه جيش المسلمين من أن لا يقتلوا الأعزل، ولا الراهب في صومعته، ولا يقتلوا الأنعام، ولا يحرقوا الزرع ). ثم يرد بعد ذلك الموقف الجليل الذي وقفه عمر عنه عندما استولى المسلمون على بيت المقدس، فقد أبى أن يؤدي الصلاة داخل كنيسة القيامة، واكتفى بأن يسجد عند بابها الخارجي في خشوع، مؤمنا بذلك النصارى من جارة الجند المسلمين، كما لا تستطيع أن تضرب صفحا عن سعة الصدر التي امتازت بها مدارس الفكر في العالم الإسلامي في عصرها الذهبي، حين تتلمذ عليها الفكر الإنساني دونما قيد أو شرط، كان العلم أمرا مباحا للراهب جربرت»، والكاهن ميمون»، على حد سواء،
أما في مسألة النزعة الإنسانية فيشير بن نبي إلى ما تميزت الرؤية الدينية في الإسلام للفرد محيلا إلى كتاب «الظاهرة القرآنية»، إذ وبالعودة إليه نجد أن بن نبي خطط برؤية عقلية دقيقة كيف تفاصلت أخلاق الإسلام عن نظيرتيها في اليهودية والمسيحية في فصل بعنوان أخلاق (208/207) كما يلي:
يرى بن نبي أن الأخلاق التي صاغتها المدنية الحديثة تقوم على المنفعة الفردية العاجلة، والتي أصبحت الركن الأساس للمجتمع المدني، بينما تتميز الأخلاق الدينية في الإسلام بالتنبيه إلى ضرورة رعاية منافع الآخرين زيادة على رعاية المنافع الشخصية، ثم على ذلك هي أخلاق توجيه إلى نشدان «ثواب الله الأخروي» معيارا قاضيا بالسعي إلى أية مصلحة: فردية كانت أم جماعية. إذ هنا تتجلى النزعة الإنسانية العميقة في الديانة الإسلامية بأن جعلت «منافع الآخرين» في صلب رؤيتها الأخلاقية، وهو ما ما غاب في الأخلاق التوراتية والإنجيلية التي اقتصرت على التوجيه إلى مبدأ «الكف عن الأذى وفعل الشر»، بينما أضاف الإسلام إليها مبدأ «مقاومة الأذي والشر» الآتي من الآخرين، كما تنص الآية 110 من الأنعام.
كما ركّز الإسلام على مبدأ «القيمة الفردية» عندما فصله فصلا واضحا عن ارتهانه بالجماعة في تحمل المسؤولية الأخروية، كما في الآية 11 من المدثر و الآية 80 من مريم، وهو بالطبع سيكون له نتائج واضحة على السلوك الدنيوي للفرد بأن يحتفظ دائما ببعض ملامح الفردية فيه، وأن لا ينغمر نهائيا في الجماعة، بل إن القرآن يؤكد على غلبة الانحراف على السلوك الجمعي، الآية 116 من الأنعام، وذلك بعكس ما ساد في اليهودية التي علقت مسؤولية أفعال الأفراد على الجماعة، بعكس المسيحية التي أهملت الجانب الجماعي تماما في الأخلاق وأحالته بشكل كلي إلى الآخرة، وهو بالتأكيد سيؤثر على الأدبيات الفلسفية الغربية في منظورها للفرد والجماعة، بينما النموذج الأخلاقي في الإسلام ينص على حقيقة المسؤولية الجماعية دنيويا والفردية أخرويا، وهو ما يؤسس لرؤية عقلية متماسكة بخصوص العلاقة فرد-جماعة. وهي بالتأكيد ذات أساس إنساني دقيق.
وعليه أمكن استخلاص البعد الإنساني في الأخلاق الإسلامية من جانبين:
1- ما تعلق بتخليص الفرد من أنانيته في تحقيق المنافع ومدافعة الأذى عن الآخرين، بوصفه من أجل الأعمال التي يثاب عليها المرء أخرويا.
2- ما تعلق بتحميل الفرد مسؤولية أعماله أخرويا ما يبقيه دائم التيقظ والانتباه من اندراجه السلبي في جماعته دنيويا.
ولعل المبدآن هما قطبي رحى النزعة الإنسانية التي سبق إليها الإسلام وتصور جب أنّ الفكر الإسلامي الحديث استقاها من الفكر الغربي، فالتزام المبدأين يعني أن يبقى الضمير في تأرجح دائم بين الشأنين الفردي والجمعي: أ- خدمة الجماعة والإحسان إلى ما يحثه على العناية بالآخرين، ب- فك الارتباط بالآخرين ما يحثه على المراقبة الدائمة لتصرفات الجماعة. إذ بهما يتحقق «الخير المطلق»، ويجعل من «العمل الصالح» حاضرا بشكل إيجابي في الأول: الإيثار والإحسان، وبشكل سلبي في الثاني: النقد والنهي عن المنكر.
وهو الكدح الأخلاقي الذي ميز الفترة الأولى من الإسلام، وبقي محفوظا في النص ليكون المبدأ المرجعي لكل مسلم في كل مرحلة، بينما لا نجد النزعة الإنسانية في السياق الأخلاقي الغربي إلا نزعة جاذبة بلا إشعاع على الآخرين لفقدها مبدأ الإيثار، فهي أخلاقا مفصومة فتكون أخلاقا إنسانية في الداخل وأخلاقا استعمارية في الخارج، بينما اتسم التاريخ الإسلام بتوجيهات أخلاقية ملزمة لقادته نحو عموم الناس، منها توجيه النبي لجيوشه بالاحجام عن الغدر والغلو والتمثيل وقتل الأطفال وأذى رجال الدين، وحفظ عمر لحرمة كنيسة القيامة عند فتح القدس، وانتهاء إلى التسامح الذي عرفته مدارس الفكر الإسلامي التي تتلمذ عليها جربرت وابن ميمون، فيقول بن نبي: «فكيف يتأتى للعالم الإسلامي أن يبحث عن إلهام فلسفته الإنسانية فيما وراء تقاليده العريقة» ص19
أخيرا يعرّج بن نبي إلى مشكلتين تعاني منهما الثقافة الإسلامية وهما:
1-النزعة الشكلية في الثقافة
2-النزعة الرومانسية في الخطاب
يسمى بن الأولى بـ»الحرفية في الثقافة» والتي تتجسد في الحشو بما هو تلفيق أسلوبي بلا رابط منطقي، وهو ناتج عن عدم الدقة والاعتباطية التي تهيمن على المشتغلين في الميادين المتصلة بالثقافة، خاصة منهم أصحاب العلوم الانسانية والاجتماعية، الذين تغلب عليهم النزعة الذاتية، فتصوروا علومهم مجرد إطناب لغوي أقرب إلى الشاعرية منه إلى الموضوعية، فغاب الاجتهاد الحي في الإنسانيات والاجتماعيات، وحل محله النقل والترديد المدرسي لمقولات الأغيار، بحيث يحصل استعارتها بشكل فج دون تفهمها الصحيح وإعمال النقد عليها.
إذ وبناء على الاعتباطية التي تحكم المجال الثقافي بالمعنى الانتروبولوجي الفعلي، سيكون المجتمع بذات الطريقة الاعتباطية الخالية من أي وازع خلقي أو حس فني أو منطق عملي ولا تكوين تقني، أي فقدان تام للبوصلة الثقافية، ورغم كل التطور المادي والتقني الذي داخل حياة المجتمع المسلم إلا أن إنسانه ما يزال بعيدا عن السياق التاريخي والثقافي الذي نتجت منه، لا يتفهمه فضلا عن يدرك روحه ليستلهم منه.
ذلك ما أنتج نخبا مدرسية لا تقدر على مجاوزة أشكال العلم والتعلم تقود شعوبا أمية لا قدرة لها على تحقيق الرقابة عليها ولا تحوز ملكة الحكم وأهليته، وهذا ما يفضي إلى حالة من الفوضى المطلقة التي رأس حربتها «أمية مركبة» لأنصاف المتعلمين، يملكون كل أشكال العلم ووسائله الظاهرية ويفتقدون لجوهره الحي بما هو حيازة لأدوات الاجتهاد الذهنية.
أما الرومانسية فيقصد بها بن نبي الميل إلى الفخر والمديح الذي يبعد الفكر عن النظر العقلي الناقد. وهو ناتج أساسا عن الشكلية الثقافية.
ويختم بن نبي تقديمه لكتاب وجهة العالم الإسلامي بالإشارة إلى الأمراض شبه الصبيانية التي يعاني منها العالم الإسلامي، والتي تضمنها كتاب جب وأن يطلع عليه المسلمون «وأن يقدروا فيه نزاهته التي سمت على كل مركب عقيدي أو سياسي»، رغم المآخذ النقدية التي قدمها بن نبي والتي أجليناها في
هذا النص. د. محمد عبد النور 17/05/2025
—————-
(*)- التفكير الذري: غير القادر على تجاوز الجزئيات إلى بناء مناظير كلية، واكتشاف القوانين العامة، حيث يقف التفكير الذري أمام كل ظاهرة عاجزا عن إحالتها إلى أسسها الطبيعية التي تمكن من التعامل معها بطريقة عقلانية تعالج الأسباب العميقة بالمدد والطرق التي تتطلبها كل معضلة فلا تبقى تائهة في الانفعال اللحظي من الأحداث أو التعامل الغرائبي معها.