الدّكتور محمد صالح ناصر.. نجمٌ ساطعٌ يَغيب
أ. نوار لمباركيّة/ لمن لا يعرف الدكتور محمد صالح ناصر، هو شامة لائحة من شامات الحسن، وعلامة لامعة من علامات الإحسان. عقد العزم على تسلق قمّة المجد في ساحة الأدب العربي حتى غدا علما من أعلامه البارزة والشامخة الذين يشار لهم بالبنان. وهو درّة فريدة من الدّرر التي لا يجود بها الزمان إلا نادرا، وهو …

أ. نوار لمباركيّة/
لمن لا يعرف الدكتور محمد صالح ناصر، هو شامة لائحة من شامات الحسن، وعلامة لامعة من علامات الإحسان. عقد العزم على تسلق قمّة المجد في ساحة الأدب العربي حتى غدا علما من أعلامه البارزة والشامخة الذين يشار لهم بالبنان. وهو درّة فريدة من الدّرر التي لا يجود بها الزمان إلا نادرا، وهو مضرب المثل في المواظبة والمثابرة والصبر والمصابرة.
في يوم العشرين من شهر أوت المنصرم، قرع نعيه الأسماع معلنا أن الموت الزّؤام قد أنهى دقائق عمره في هذه الحياة. وكان الخبر بمثابة طرق قويّ أصمّ الأذان، وأوقف كل من يعرفه صامتا وحائرا، وأفقده توازنه، وأقعده في دوّامة تفكير محيّر عميق يتجاذبه الذهول والدهشة لعدة لحظات؛ لأن الصدمة كانت شديدة الوقع وبالغة التأثير.
تمنى صديقه الحميم وأخوه الذي لم تلده أمه الأستاذ محمد الهادي الحسني لو يستطيع تخليده في كتاب. وأرى أنه من تمام الوفاء له أن يمجّد ذكره في عدة أسفار زاخرة نفيسة، لا تغفل أي شاردة أو واردة تخصّه، وتأتي على تفاصيل حياته كاملة، وتملأ صفحاتها بالقراءات في كل أطوارها، وتتعرّض إلى ما خلّفه من أعمال وكتابات أدبية نثرية وشعرية وتاريخية وفكرية ونقدية ثمينة ستبقى شاهدة أبد الدهر على نبوغه وأصالة فكره، ولا تسقط ما تركه من آثار طيبة وبصمات إنسانية نقية في سيرته الاجتماعية في كل المواقع التي مرّ بها.
سطّرت رشفات الحبر التي يسقى بها قلم الدكتور محمد صالح ناصر سطورا ومصنّفات متميزة من حيث اصطفاء المواضيع وانتقاء الألفاظ وجودة البناء ومتانة التشكيل وصرامة الدقة في النحو والصرف وصدق التعابير في الوصف والتحليل والتفسير وبراعة الإنشاء وجمال الأسلوب وغزارة المعاني وتماسكها. وجعلت منه أديبا مصقعا بليغ الفصاحة واضح البيان وشاعرا متدفق الموهبة ويانع المَلكة. وكانت مؤلفاته حبات لؤلؤية تلمع إشراقا ووضاءة تضاف إلى قلادة لغتنا العربية المجيدة التي لانت له وسلّمته قيادتها، فطوّعها في راحة، وأمسك بأهداب شائعها وغريبها حتى امتلك نواصيها، ومن ثَمَّ انبرى يثري كنوزها بإضافات سمتها الجودة والإتقان، ويغني مآثرها بزيادات رائعة أجاد فيها وأفاد. واستطاع أن يكون من أهل العلم وخاصته الذين يفسح لهم مكان شاسع مستحق في كل مجلس وناد، وأن يبوأ المنابر الأثيرة.
حرص الفقيد على أخلقة لغته في كل كتاباته، وتنميقها بالصفاء والعفة، وتخليصها من شوائب الرداءة والوضاعة. وحتى في ردوده وانتقاداته التي قرأناها في الصحف والمجلاّت، لم يكن يسمح لنفسه بالانحراف عن الجادة والابتعاد عن سلامة الذّوق والوقوع في درك الشطط ومنحدر السفالة. وهو يرى أن الكتابة درس أخلاقي راق قبل أن تكون تدبيجا للسطور وتسويدا للورق. وكان يميل إلى الملاينة والملاطفة حتى لما يُستفّز وتثار أعصابه، مما يعني أنه كان يخضع قلمه إلى قواعد التربية الأصيلة، ويغمسه في محبرة الأخلاق اولا، ثمّ يرويه بسائل المداد ملتزما بشعار معهده الأول، معهد الحياة، الذي كان ينص في شطره الأول على تقديم الدّين والأخلاق عن الثقافة. ولا يجنح إلى الحدّة والشّدة والغضب والتهجم. وأن ضبط النفس بالنسبة إليه هو من لوازم معاملاته الذي لم يجوّز لنفسه التخلي عنها أو هجرانها أوالتجرّد منها مهما كان الموقف عصيبا وصعبا.
يمتلك الدكتور محمد صالح ناصر صدقا أدائيا وإتزانا فكريا لما يشدّ القلم بين أصابعه، ويكتب عن وعي وصدق ومسؤولية رسالية، ولا يخط إلاّ ما يمليه عليه نور فكره ونبض قلبه ومختارات جوارحه. ومن يقرأ له يحس بالاتساع والشمول في كل كلمة يرسمها، ويعترف له أنه رجل علم وقلم، وأنه أمير من أمراء البيان اكتملت عنده الموهبة الفطرية بما زاد عليها من اجتهادات معرفية مختارة ظفر بها بعد مسار طويل من المطالعة والبحث والإنتاج الأدبي الرّصين والعطاء الفكري الناضج المكين.
يجمع عارفوه أنه كان نموذجا حيّا للخلق الكريم، والروح العالية، والبذل الكامل والاستثمار المتواصل في الخير بالفكرة والأداء من دون انتظار مقابل أو ترقب تلقي شكر جزيل. وكان بابتسامته المريحة التي تعكس بشاشته، وصوته الدافئ الممزوج برنّة رقيقة تسيل عذوبة، وحضوره اللطيف في المجالس والمناسبات العامة وأمام طلبته في مدرّجات الجامعة، يقدّم دروسا بليغة في هدوء، ويعلّم النّاس أن جوهر القوة والعظمة في التسامح والملاطفة، وأن بذور الاحترام لا تتفتق إلاّ إذا زرعت في لين ورفق في القلوب، وأن العلم يفقد معناه الصافي حتى وإن نطق به لسان عبقري إذا لم يتوّج صاحبه بالأخلاق.
لم أقف على تلميذ بار حمل واحتفظ وصان أمانة ودّ شيوخه وأساتذته، وقابل جميلهم في تأديبه ورعاية موهبته مثل الدكتور محمد صالح ناصر. فقد ظل وفيّا إلى كل واحد منهم وفاء لا يبلى، ومحبّا له حبا لا يفنى منذ أن كان تلميذا صغيرا متميزا بالاجتهاد والنجابة في معهد «الحياة» ببلدته «القرارة» الذي جلس في حلقات أقسامه يكرع أوليات العلم، ويتشرب الأدب وقواعد الأخلاق، وينهل في نهم من معين كل واحد منهم، ووصولا إلى طوره التعليمي الجامعي العالي. وجمع انطباعاته وذكرياته معهم في مؤلف فخم فريد دعاه: «مشايخي كما عرفتهم»، وكتب فيه عن الشيخ إبراهيم أطفيّش والشيخ أبي اليقظان إبراهيم والشيخ رائد الإصلاح في الجنوب الجزائري إبراهيم بن عمر بيّوض والشيخ الأديب والمؤرّخ محمد علي دبّوز والدكتور شكري فيصل والشيخ إبراهيم الحاج أيوب القرادي المتوفى في المدينة المنوّرة والشيخ عدّون بن بالحاج شريفي والشيخ حمّو بن عمر فخّار. ومن باب الإضافة والزيادة، شملت الطبعة الثانية من الكتاب صفحات عن الشيخ ناصر بن محمد المرموري، رحمهم الله جميعا. واحتوى الكتاب جانبا تاريخيا عن كل واحد من هؤلاء المحظوظين وجانبا انطباعيا يعكس ملامح سامية عن البنوّة الروحية الطاهرة في أسمى تجلياتها.
يحتار من يرغب في الإقدام على محاولة الاقتباس من محتوى الكتاب للاستشهاد؛ لأن كاتبه يقف على نفس المسافة من مشايخه وأساتذته. وأمام هذه الحيرة، لم أر مخرجا سوى الأخذ مما كتبه الدكتور شكري فيصل (1918 ـ1985م) في تقريره عن طالبه محمد صالح ناصر عشية مناقشته رسالته الجامعية لنيل شهادة الدّكتوراه «الحلقة الثالثة» بجامعة الجزائر المركزية، إذ قال عنه في فقرة ندية شهية تشبه الرّوضة الغناء بعد أن أثنى عنه ثناء يتضوّع شذى ويفوح أريجا، قال: (إن هذه الصفات الطّيّبات منحت الطالب محمد ناصر سلوكا علميا نقيّا محبّبا، هو أول عُدّة الذين يريدون أن ينهضوا لهذه الرحلة العلمية الواسعة. لقد أنبتت عنده روح الدارس وخلقية الباحث وسلوك العالم، فإذا هو يأخذ طريقه إلى ذلك في تواضع بعيدا عن كلّ ادّعاء، وفي جهد بعيدا عن كل تململ، وفي مثابرة لا تكاد تعرف الكلل، وفي إيمان بأن الدّرجات العلمية ليست رغبة من غير عمل، ولا عملا من غير نصَب. وأن ثمرة البحث العلمي ليست ثمرة جاهزة، وإنما نتيجة معاناة طويلة وآلام قاسية).
عندما ينصرف القارئ المتابع المهتم إلى أعمال الدكتور محمد ناصر الأكاديمية، يلمس قيمة نصوصه التي تشبه مياه الأنهار الجارية، فهي في تجدد دائم، لا تعرف الهمود والركود والتّكرار، ولا يعمّر فيها الأسن والعفن المفسدان. وكلما زاد جريانها تدفق صفاؤها بدرجة أقوى. وحين تطول رحلة قارئها معها، تبرق أمامه كنوز عامرة توسع أمامه آفاق فهم مكنوز كانت متخفية من وراء تلال الكلمات التي نسج بها نصوصه.
في سنواته العشرين الأخيرة وزيادة قليلة من عمره الثري والمبارك الذي أفناه في محراب العلم كالناسك المتعبّد، كشف الدكتور محمد صالح ناصر عن صبر نادر أمام بلية المرض المستعصي الذي ألمّ به فجأة. وإن لم يقعده أو يَنَلْ من عزمه، إلاّ أنه أتعبه بعد أن فرض عليه نظاما قاسيا في المأكل والمشرب، وأخضعه إلى عادات لم يألفها في الإقامة والمكوث، وحدّت من ظعنه وترحاله، وسرقت منه ساعات طويلة ثمينة كان يستسلم فيها إلى آلات الغسيل الكُلوي متكبّدا مشاقه، ويصرفها بعيدا عن القلم والورقة. ومع ذلك، استطاع أن يقاوم محنته بجلد، وأن يتكيف بفضل قوة إيمانه في مرونة مع وضعه الجديد الذي لم يضجر من ضيقه ولم يجزع من ثقله، ولاذ بالاحتساب وسعة الصّدر وحسن التحمل. ورغم معاناة الدّاء، إلا أنه استطاع أن يضيف إلى مشروعه الكتابي عدّة عناوين دعّم بها إضبارة مؤلفاته التي أغنى وزيّن بها المكتبة العربية.
أذكر أنني زرت في شهر جويلية من سنة 2004م الفقيد في بستانه بمنطقة الجنانات الواقعة في ضاحية من محيط بلدة القرارة الآمنة، وقضيت معه ما يقارب ساعتين أمضيناها في أحاديث متفرقة شيقة. ولما جلسنا تحت ظل شجرة كثيفة الظلال، وضع أمامي لبنا باردا وتمرا محليّا لذيذا، فأكلت وشربت، وحبس هو نفسه عنهما. وبعد أن روى لي قصة إصابته بالمرض مفصلة، صارحني بقوله: ما كان المرض يؤلمني، ويفتّ من عضدي لو لم يحرمني من التمر واللّبن اللذين اشتهيهما كثيرا.
وأنا أدنو لوضع نقطة النهاية لسطوري الهزيلة العجفاء، أحسست أن كلماتي لم توّف الراحل الكبير حقّه كاملا. ولولا يقيني من حلمه وتسامحه وتواضعه ورضاه بالقليل وقلة كفه عن جمع الأعذار لإخوانه وخلصائه، ما كنت أجرؤ على نشرها.
رحم الله فقيد الوطن وفقيد الثقافة العربية الإسلامية الدكتور محمد صالح ناصر العزيز والكريم. وطيّب حبيبات تربة المكان الذي يحتضنه بالمسك والعنبر.








































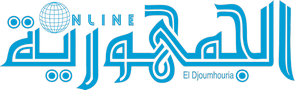























![مذكرات الدكتور عبد القادر فضيل (1932-……) [الجزء الثاني]](https://cdn.elbassair.dz/wp-content/uploads/2025/09/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.jpg)


