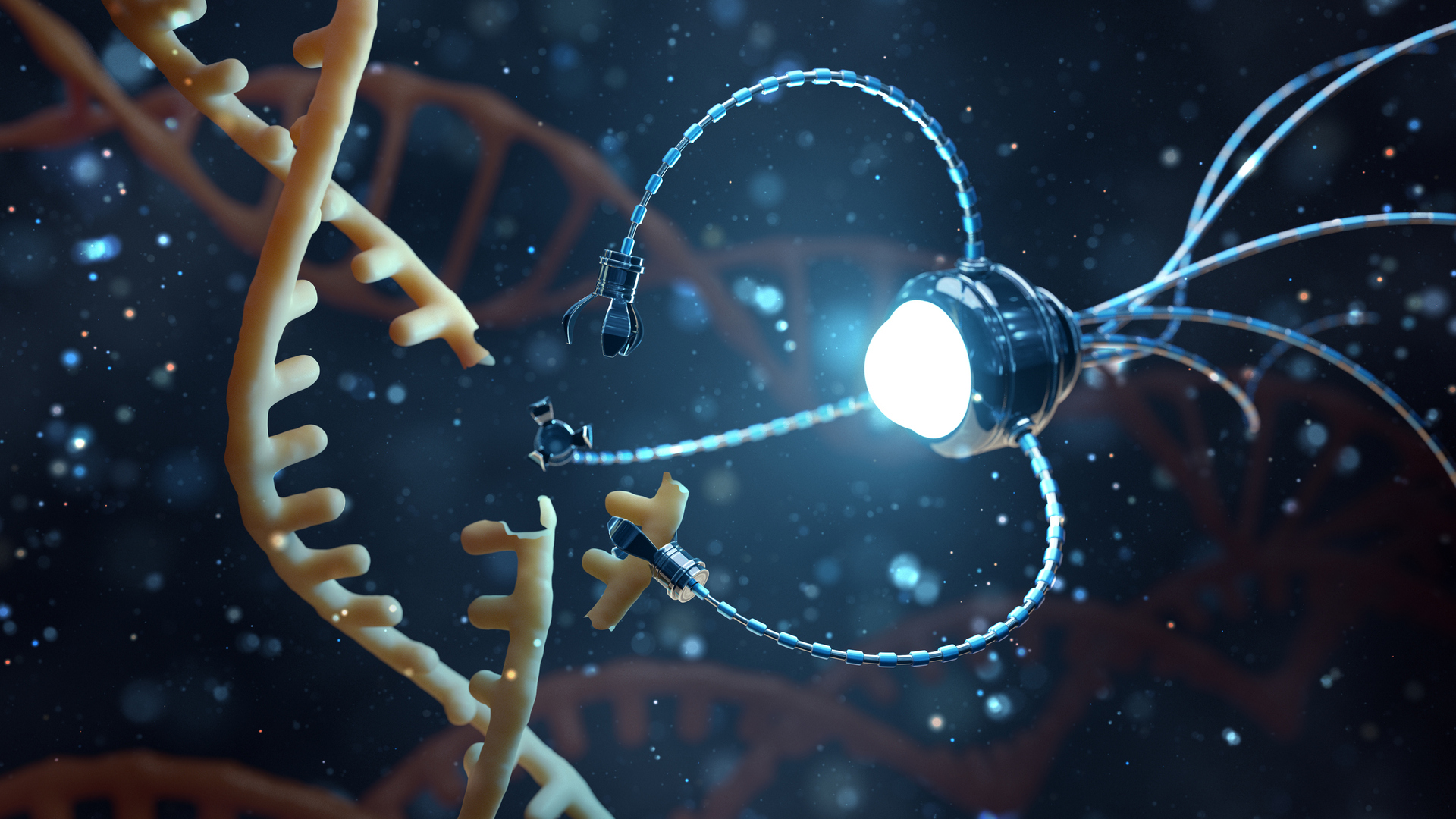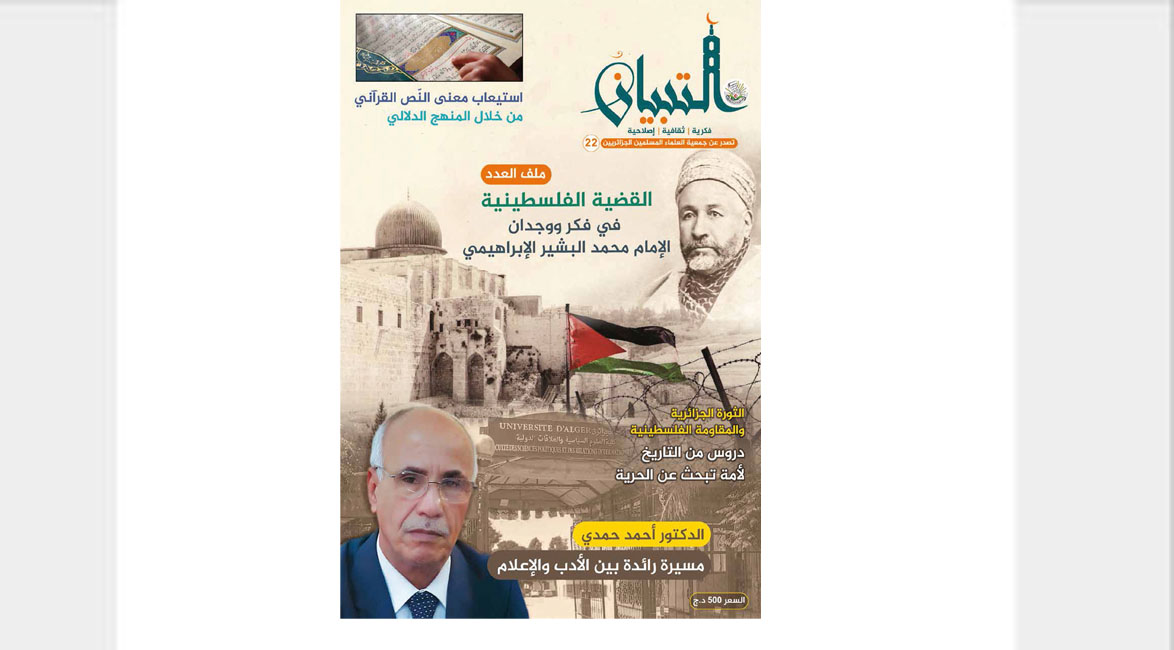شُبُهاتُ المُعترِضِ على الملثَّم: منازلة بين التأصيل والتأثيم (1)
الشيخ خالد أوصيف */ كنتُ قد رددتُ على هذه الشُّبُهاتِ في مجالسَ خاصّةٍ، وكنتُ أَرى عدمَ التوسّعِ في نشرِ الردّ، دفعًا للتشاغلِ بما هو أنفعُ للأمّةِ في هذا الظرفِ العصيب، وقطعًا لأسبابِ الجدلِ والتنازُع. غيرَ أنَّ عددًا من الإخوةِ الصادقين ألحُّوا عليّ في نشرِ البيانِ وتعميمِ الردّ، لما رأوا من أثر تلك الشُّبُهاتِ في التشويشِ …

الشيخ خالد أوصيف */
كنتُ قد رددتُ على هذه الشُّبُهاتِ في مجالسَ خاصّةٍ، وكنتُ أَرى عدمَ التوسّعِ في نشرِ الردّ، دفعًا للتشاغلِ بما هو أنفعُ للأمّةِ في هذا الظرفِ العصيب، وقطعًا لأسبابِ الجدلِ والتنازُع. غيرَ أنَّ عددًا من الإخوةِ الصادقين ألحُّوا عليّ في نشرِ البيانِ وتعميمِ الردّ، لما رأوا من أثر تلك الشُّبُهاتِ في التشويشِ على المجاهدين، وتثبيطِ هممهم، وصرفِ الناسِ عن مناصرتهم.
فاستجبتُ لذلك التزامًا بواجبِ البيانِ عند الحاجة، ودفعًا للشبهةِ عن الدين، وتثبيتًا للموقفِ الشرعيِّ في نُصرةِ إخواننا في غزّة.
وإنني وإن كنتُ لا أنشطُ للردودِ في مسيرتي العلميّة التي ارتضيتها لنفسي -إذ لطالما آثرتُ الانشغالَ بالتأصيلِ والتعليمِ – إلا أنّني نشطتُ في هذا الموضعِ -منذ عامين- للذب عن أعراضِ المجاهدين، قيامًا بحقّهم العظيمِ علينا، ورجاءَ أن يُصيبَني من وعدِ اللهِ لهم شيءٌ، وإن لم أكن في صفّهم؛ فإنّ النصرةَ بالقلمِ والبيانِ بابٌ من أبوابِ الجهاد.
وقد حذفتُ اسم المعترض – مع أنه معروف مشهور – ليكون الردّ عامًا في بيانه وزمانه، فيُبنى على المعاني لا على الأشخاص، وعلى التأصيلِ لا على التشخيص،ثم قابلتُه في الخطاب بـ”الملثَّم” من باب المقابلة العادلة: فـ”الملثّم” وصفٌ للتفخيم والتعظيم، إذ هو ستار الجهاد والشهادة، وأما المعترض، فحَجب اسمه لا يقتصر على قصد التعميم فحسب بل يحمل معنى آخر، وهو تجنُّبُ ذكره مع من يعلوه قدرًا وشرفا؛ فشتّان بين مَن سترته البنادق، ومَن لَفَّهُ التجاوُز.
الشبهة الأولى: دعوى عدم استئذان العلماء
تُعد هذه الشبهة من أكثر الشُّبَهِ تكرارًا في الطعن في مشروعية المقاومة، حيث يزعم أصحابها أنّ ما تقوم به المقاومة من ردٍّ للعدوان ومواجهةٍ للمحتلّ هو عملٌ غيرُ منضبطٍ شرعًا، لكونه لم يصدر عن إذن صريح أو فتوى معلنة من العلماء، وكأنّ الجهاد لا ينعقد إلا بإشارةٍ من جهةٍ علميةٍ مخصوصة.
وهذا التصوّر، فضلًا عن كونه بدعةً محدثةً في شروط الجهاد لمخالفته الإجماع كما سيأتي ، ينطوي على خللٍ في فهم طبيعة النوازل، وقصورٍ في تحقيق مناط الحكم، وجهلٍ بتصنيف الجهاد وأحكامه التفصيلية، وغفلةٍ عن السياق الواقعي والتأريخي الذي تنبعث فيه حركة المقاومة ، وفيه تحاملٌ ظاهرٌ، وانتقاءٌ غيرُ منصفٍ في تنزيل الشروط، إذ يُقصَرُ تطبيقُها على غزّة دون سائرِ ساحات الجهاد المعاصرة، وكأنّها – دون غيرها – خارجةٌ عن الإجماع، أو مجرّدةٌ من الاعتبارات الشرعية الراسخة.
والجواب عن هذه الشبهة يتبين في أحد عشر وجهًا تأصيليا جامعا، تُظهر فساد هذا التصوّر من جهة أصولية وفقهية وواقعية، نذكرها فيما يأتي:
1/ منشأ الخطأ القصور في تحقيق المناط المتعلق بواقع غزة:
واقعُ غزةَ اليومَ لا يندرجُ إلا تحتَ جهادِ الدّفعِ؛ فهو جهادٌ تُفرضُه الضّرورةُ، ويُحتّمه العدوانُ المتصلُ، والاحتلالُ القائمُ، واستباحةُ الأرضِ والنفسِ والحرمةِ والدماءِ، فضلًا عن التهجيرِ والحصارِ والتقتيلِ والعدوانِ المركّبِ من البرِّ والبحرِ والجوّ.
وهو في توصيفه الشرعي جهادُ مَن كان في داره، فهجم عليه العدوُّ فيها، فقاتله دفعًا للعدوان؛ لا توسّعًا ولا طلبًا، وهذا عينُ ما عليه أهلُ فلسطين، فإنهم في أرضهم، والعدوُّ هو الذي اقتحمَها وأعمل فيها البطشَ والتقتيلَ.
فهذا الواقع، باعتباره من أعظم صور العدوان، لا يصحُّ توصيفُه شرعًا إلا بكونه ، عدوانا صائلا يُواجَهُ بحسبِ القدرةِ، لا ينتظرُ فيه إذن من أحد، ولا يُفتَرَضُ فيه التوقّفُ حتى تصدرَ فتوى، بل هو فرضُ عينٍ على من نزل به، وفرضُ كفايةٍ على من وراءه، فإن لم يندفع العدوُّ بقتالهم، صار فرضَ عينٍ على من يليهم من بلدان المسلمين، ثم على من بعدهم، حتى يتحقّق انكفاء العدوان، إذ الواجب الشرعي لا يسقط مع العجز في موضع، بل ينتقل إلى القادر بعده.
وخلاصة وصف جهاد الدفع أنه لا يشترط له إذن عام من إمام أو عالم ولا إذن خاص من السيد لعبده ومن الوالد لولده ومن الغريم لغريمه؛ وذلك لأنَّه جِهادُ ضَرورةٍ، لا جِهادُ اختيار، قاعدتُه: أنَّ المسلمَ مَطلوبٌ لا طالِب، والخروجُ لدفعِ الصائلِ يكونُ بحسَبِ الإمكان، وهذا إذا خرج العدوُّ من بلاده إلى ديارِ المسلمين، وكذلك إذا بلغَها ولم يدخُلْها بعد، ولذا قاتلَ رسولُ اللهِ ﷺ في حالتين: في أُحدٍ: حين خرج العدوُّ من بَلَدِه إلى ديارِ المسلمينَ وفي الخندقِ: حين بلغَهم العدوُّ وهاجَمَ المدينةَ.
وممن نصّ على هذا التأصيل ابن القيم حيث قال : “قتالُ الدَّفْعِ أوسعُ من قتالِ الطَّلَبِ وأعمُّ وُجوبًا، ولهذا يَتعيَّنُ على كلِّ أحدٍ، فيُجاهِدُ فيه العَبدُ بإذْنِ سَيِّدِه وبدونِه، والوَلَدُ بغيرِ إذْنِ والده، والغَريمُ بغيرِ إذنِ غَريمِه. وهذا كجِهادِ المسلمينَ يومَ أُحدٍ والخندقِ ، ولا يُشترطُ في هذا النَّوعِ من الجهادِ أن يكونَ العدوُّ ضِعفَيِ المسلمينَ فما دون، فإنهم كانوا يومَ أُحدٍ والخندقِ أضعافَ المسلمينَ، ومع ذلك كان الجهادُ واجبًا، لأنَّه جهادُ ضرورةٍ ودَفْعٍ، لا جهادُ اختيارٍ.” الفروسية، ص 188
وهذا القول هو محل إجماع ليس فيه خلاف وقد نُقل الإجماعُ على وجوب هذا النوع من الجهاد دون استئذان في مواضع متعددة، منها أحكام القرآن للجصاص (3/146)، المحلّى لابن حزم (5/341)، غياث الأمم لإمام الحرمين (ص 258)، الإقناع في مسائل الإجماع (3/1015)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/151)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/538)، الإنصاف للمرداوي (4/117)
ومستندُ الإجماعِ في هذا البابِ قولُه تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ﴾ [النساء: 75]، وقولُه تعالى: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: 39] وقد دلَّت هاتان الآيتانِ على أنَّ قِتالَ مَن قاتَلَ المسلمينَ، وحِمايةَ المستضعفينَ، ونُصرةَ المظلومينَ، واجبٌ شرعيٌّ حتى ينكفِئَ المعتدونَ ويُنتصَرَ للمظلومينَ، ويدخل في معناه ، حديث النبي ﷺ: «من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد» رواه الترمذي وغيره، ووجه الدلالة: أن دفع الاعتداء عن النفس والمال والأهل مشروع، بل من مات دونه فهو شهيد، مما يدل على وجوب الدفع.
وحين يُقرّر العلماء أن جهاد الدفع لا يُشترط له إذن الإمام، ويصفونه بأنه “جهاد ضرورة”، فإنهم يُسقِطون بذلك كل إذنٍ مكمِّل، سواء من إمام أو غيره، لأن أصل هذا الجهاد لا يقوم على الإذن، بل على فورية الدفع بحسب القدرة، إذ لم يكن العلماء ولا الفتوى شرطًا في أصل التكليف به.
ومن نصّ على سقوط إذن الإمام، وصرّح بعدم اشتراط إذن السيد لعبده، أو الوالد لولده، أو الغريم لغريمه، فإن قوله يَستلزم – بطريق أولى – سقوط اشتراط فتوى عالم؛ لأنها ليست من مُكمِّلات هذا الواجب، بل هو فرضٌ يُباشره المكلَّف المعتدى عليه بحسب وُسعه، دون انتظار إذنٍ أو فتوى من أحد.
2/ تحقق موجبات الجهاد بالإجماع:
قد قرر أهل العلم أن جهاد الدفع لا يتوقف على إذن أحد، وإنما يُبنى على تحقق موجباته الشرعية، وهي موجبات الانعقاد والوجوب التي لا يُشترط معها إذن إمامٍ ولا فتوى عالم؛ إذ قد أجمع العلماء على أن الجهاد يصير فرضَ عينٍ في حالتين لا خلاف فيهما:
-إذا التقى الصفان والتحم الجيشان: وحَرُمَوا فيه الانصرافُ والفِرارُ، إلا في الصور المستثناة شرعًا، كالتّحيّز أو التّحرّف لقتال، قال ابنُ هُبيرة: “واتَّفقوا على أنَّه إذا التقى الزَّحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثَّبات وحَرُم عليهم الانصراف والفرار، إذ قد تعيَّنَ عليهم، إلَّا أن يكون متحرِّفًا لقتالٍ أو متحيِّزًا إلى فِئة، أو يكون الواحدُ مع ثلاثة، أو المائةُ مع ثلاثمائة، فإنَّه أُبيحَ لهم الفرار، ولهم الثَّبات، لا سيما مع غلبةِ ظنِّهم بالظُّهور” (اختلاف الأئمَّة 2/300).
ونقل الإجماعَ أيضًا ابنُ رُشدٍ في بدايةِ المجتهد 2/150، والمرداويُّ في الإنصاف 10/14.
وقد دلَّ على هذا الوجوبِ قولُ اللهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ ﴾ [الأنفال: 15]، ففيه نهيٌ صريحٌ عن التولِّي عندَ اللقاء، وهو يدلُّ على تحريمِ الفرار، ووجوبِ الثَّباتِ في موطنِ المواجهة، وقال أيضا : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ﴾ [الأنفال: 45]، فهذا أمرٌ إلهيٌّ بالثَّباتِ عندَ اللقاء، والأمرُ يقتضي الوجوبَ ما لم يصرِفْهُ صارفٌ.
وقد شدَّد الشَّرعُ في شأنِ الفِرارِ من الزَّحف، وجعلهُ من السَّبعِ المُوبقات، فعن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه، عن النبيِّ ﷺ قال: «اجتَنِبوا السَّبعَ المُوبقات». قالوا: يا رسولَ الله، وما هُنَّ؟ قال: «الشِّركُ بالله، والسِّحرُ، وقتلُ النَّفسِ التي حرَّم اللهُ إلَّا بالحقِّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، والتولِّي يومَ الزَّحفِ، وقذفُ المُحصَناتِ المؤمنات» رواه البخاريُّ ومسلم، وانظر: تفسير ابن كثير 4/23.
-إذا استنفر الإمام أهل البلد: فيصير الجهادُ فرضَ عينٍ، يأثَمُ من تركه، قال المرداوي: ومَن حضَرَ الصَّفَّ مِن أهْلِ فَرْضِ الجِهَادِ، أو حضَرَ العَدُوُّ بَلَدَه، تَعَيَّنَ عليه، بلا نِزاعٍ ، وكذا لو اسْتَنْفَرَه مَن له اسْتِنْفارُه، بلا نِزاعٍ. الإنصاف 10/14 وانظر المغني 13/8
ومستندُ الإجماعِ قولُه تعالى: ﴿ ييَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ ﴾ [التوبة: 38]، اقتضى ظاهرُ الآيةِ وجوبَ النَّفيرِ على من يُستنفَر، انظر: أحكامُ القرآنِ للجصّاص، ت: قمحاوي 4/309، وقال القرطبي: (والاستنفارُ يَبعُدُ أن يكونَ موجبًا شيئًا لم يَجِبْ من قبل، إلا أنَّ الإمامَ إذا عيَّن قومًا وندَبَهم إلى الجهاد، لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين، ويصيرُ بتعيينِه فرضًا على من عيَّنه، لا لمكانِ الجهاد، ولكن لطاعةِ الإمام، والله أعلم) أحكام القرآن 8/142
وفي صحيحِ البخاري قوله ﷺ: «لا هجرةَ بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونيَّةٌ، وإذا استُنفِرتُم فانفِروا» ووجه الدلالة منه واضح.
قلت : وكلا الموطنين المذكورين متحقّقان في واقع غزة اليوم، فقد التحم الصف، ووقع العدوان، وثبت الاستنفار، فهو فرض عين، لا يُشترط فيه إذن أحد، بل هو إجماع قديم متحقق في أتم صوره.
فالفتوى في هذا الموطن ليست منشئةً لحكمٍ جديد، وإنما هي مؤكِّدةٌ لحكمٍ انعقد بيقينٍ من قبل.
يتبع