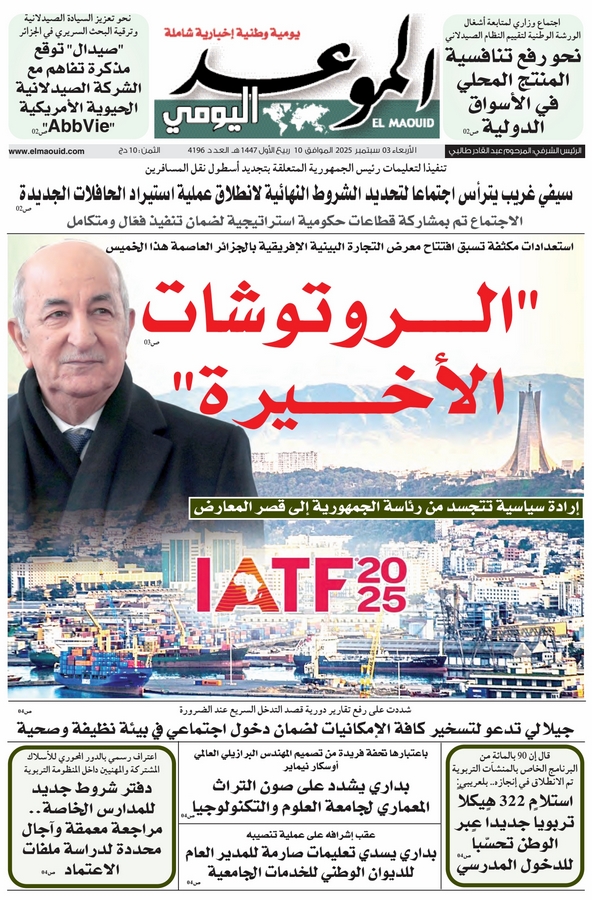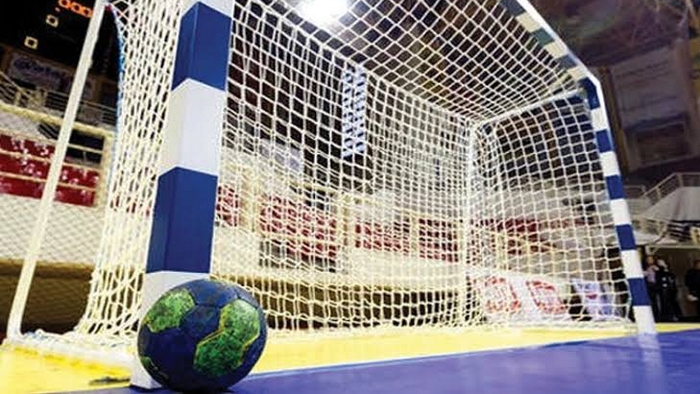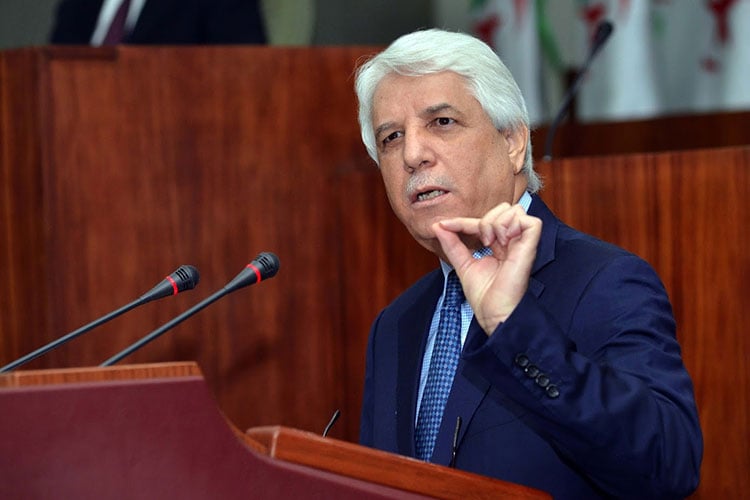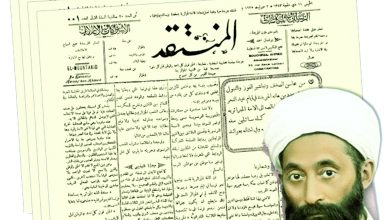ملاحظات متابع لقطاع الأوقاف بالجزائر (1)
د. مـوسى عبد اللاوي */ النظام القانوني الجديد رقم: 25-06 مؤرخ في 23 محرم عام 1447 الموافق 19 يوليو عام 2025، الخاص بتنظيم الأوقاف المنشور في الجريدة الرسمية العدد:47 عام 2025، في: 122 مادة و13فصلا. قانون يعد خطوة مهمة في تاريخ المنظومة التشريعية والقانونية الجزائرية وقيمة مضافة لها، وعلامة فارقة في تاريخ تسيير واستثمار وتطوير …

د. مـوسى عبد اللاوي */
النظام القانوني الجديد رقم: 25-06 مؤرخ في 23 محرم عام 1447 الموافق 19 يوليو عام 2025، الخاص بتنظيم الأوقاف المنشور في الجريدة الرسمية العدد:47 عام 2025، في: 122 مادة و13فصلا.
قانون يعد خطوة مهمة في تاريخ المنظومة التشريعية والقانونية الجزائرية وقيمة مضافة لها، وعلامة فارقة في تاريخ تسيير واستثمار وتطوير نظام الأوقاف في بلدنا، يحقق المقاصد الشرعية للوقف ويجعل منه رافدا تنمويا فعالا في خدمة المجتمع مراعيا تطورات العصر ومتطلباته.
ولذا وجب تثمين كل الجهود التي كانت وراء هذا المشروع الذي تطلع له كل جزائري مسلم تواق لتمثل روح الشريعة السمحاء ومحب لفعل الخير ولاسيما المستدام منه.
ولعل ما يعزز الإقبال على العمل في القطاع الخيري (والمستدام منه على الخصوص)، وهي الأوقاف هو اعتباره قربة إلى الله تعالى تدل على التزام المسلم باحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقا لقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم «الخلق كلهم عيال الله واحبهم إليه انفعهم لعياله»
وفي ظل انتشار الأوقاف وتنوعها أصولا وريوعا في بلدنا الجزائر كان ادراج هذا الملف ضمن خطط تطوير المنظومة الوقفية، وإعطائه المكانة اللائقة به كرافد من روافد اصلا ح الاقتصاد الجزائري.
ولا تتأتى استفادة هذا الأخير وضمان استقراره وتطوره في ظل المعطيات المحلية والدولية الحالية مما يتيحه القطاع الثالث وخاصة الأوقاف في مختلف مجالاته إلا باستجابة وفعالية النظام الوقفي لمعطيات الواقع وتحدياته تشريعا وتطبيقا أو تنظيرا وممارسة.
ولهذا جاء هذا القانون: 25-06 مؤرخ في 23 محرم عام 1447 الموافق 19 يوليو 2025 الذي ناضل من أجله رجال قال فيهم الله تعالى: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً» الأحزاب: 23،
لقد انتشرت الأوقاف في الجزائر منذ دخول الإسلام ارضها فكان أول وقف فيها هو مسجد سيدي غانم الأثري في مدينة ميلة، بُني هذا المسجد في عهد القائد أبي المهاجر دينار حوالي عام 59-60 هجرية، مع دار الإمارة، ويُعد هذا المسجد ثاني أقدم مسجد في أفريقيا بعد جامع القيروان في تونس، ولم يتوقف الجزائريون عن تحبيس ما عز من أموالهم طمعا في رضا الله عزوجل ونشر الخير في الأرض.
إن الأوقاف أو الاحباس– او الحبوس- كما تعرف لدى سكان المغرب الكبير عامة هي أحد مظاهر الحضارة الإسلامية التي تميز بها تاريخ منطقة المغرب الكبير منذ أن أصبحت جزء من دار الإسلام، حيث أصبحت الأوقاف واقعا اجتماعيا يستند إلى أحكام الشرع في نظامه ومعاملته.
وإدراج هذا الملف ضمن ملفات تطوير المنظومة الوقفية، وإعطائه المكانة اللائقة به لإصلاح الاقتصاد الجزائري، يأتي في إطار الإجراءات المتخذة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني في ظل المعطيات المحلية والدولية الحالية، فتطوير الجانب الاقتصادي مرتبط بمدى استجابة وفعالية النظام الوقفي، ولهذا يمكن للاقتصاد الجزائري الاستفادة مما يتيحه القطاع الثالث وخاصة الأوقاف في مختلف المجالات، خاصة وأن بلدنا يجتاز مرحلة صعبة يحتاج فيها لكل ما يدعم ويعزز نمو وتطوير واستقرار الاقتصاد الوطني.
تاريخ الأوقاف في الجزائر
عرفت الجزائر الوقف على امتداد تاريخها الحضاري العريق فشهدت في وقت مبكر اشكالا من التبرعات لاغراض دينيه او اجتماعيه لم تكن واضحة المعالم والاهداف وهذا قبل الفتح الإسلامي، وازدهرت واتضح شكلها ونوعها وحددت اهدافها بدخول الاسلام ارض الجزائر
وقد عرف المجتمع الجزائري الوقف وطوره كما ونوعا وسعى لتنميته وازدهاره وساهم بذلك في حياة المواطن التنموية والاقتصادية وبناء شبكة التكافل الاجتماعي القوية ذات الأصول القانونية والبعد الايماني تسييرا وإنماء واستثمارا وجمعا وتوزيعا على المستحقين.
ولقد تميزت فترة الحكم العثماني للجزائر كنموذج بكثرة الاوقاف ذات الطبيعة الاستثمارية والمردود الاقتصادي وانتشرت في مختلف أنحاء البلاد، فوقفت الدور والفنادق والأراضي الزراعية والبساتين والسواقي والمطاحن والافران والدكاكين، توجه عوائدها لتغطية المنح الدراسية وسد حاجة طلبة العلم، والتكفل بالمساجد والزوايا والمدارس تأسيسا وتجهيزا وتسييرا وصيانة، إضافة الى انشاء بعض المرافق العامة وصيانتها كالطرق والآبار والعيون والجسور والحصون وغيرها.
كما ساهمت بصفة مباشرة في التخفيف من حاجات المعوزين عن طريق الصدقات والتبرعات والاعانات المختلفة.
كل هذا تحت مسمى الوقف العام المتمثل في الاوقاف الخيرية ذات الصفة الدينية والشخصية القانونية والوضع الإداري الخاص.
كما كانت موارد الأوقاف خير مساعد على صيانة بعض المرافق العامة مثل الطرق والآبار والعيون والسواقي والجسور والحصون، وقد ساهمت الأوقاف في تخفيف شقاء المعوزين لما كانت تقدمه لهم من صدقات وإعانات مختلفة من عائداتها.
وقد كان الوقف الخيري (الوقف العام) يتوزع على مؤسسات خيرية لها صفة دينية وشخصية قانونية ووضع إداري خاص، حيث اشتهرت منها المؤسسات التالية:
-1/ (سبل الخيرات): الحنفية التي أسسها شعبان خوجة سنة 999 هـ /1590م و كانت تشرف على ثـمانية مساجد لاسيما (الجامع الجديد) و مشاريع خيرية عامة كإصلاح الطرقات و إجراء القنوات للري و إعانة المنكوبين و ذوي العاهات و تشيد المعاهد العلمية و شراء الكتب و لوازم طلبة العلم، وتقدر ثروتها بثلاثة أرباع (¾) الأوقاف العامة.
-2/ أوقاف الحرمين الشريفين: يذهب البعض إلى أنها أقدم من المؤسسة السابقة، إذ تعود إلى ما قبل العهد العثماني و تؤول أموالها إلى فقراء مكة والمدينة، وللدلالة على أهميتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في آخر العهد العثماني، هذه إحصائية بأحباسها: 840 منزلا و757 دكانا و33 مخزنا و72 غرفة و3 حمامات و11 كوشة و4 مقاهٍ وفندق و57 بستانا و62 ضيعة و6 ارحية و201 ايجار.
ويذكر ديفوكس أن مجموع الأوقاف التابعة للحرمين الشرفين يناهز 1557 وقفا، والملاحظ أنها لم تسلم من نهب الاحتلال الفرنسي.
-3/ أوقاف النازحين من الأندلس: تأسست الجمعية الأندلسية للأوقاف سنة 1033هـ / 1622 م بتشجيع من السلطة التي كانت تتعاطف مع المهاجرين من الأندلس الذين استقروا في المدن الساحلية وساهموا في الحروب البحرية ضد الاسبان، وكان بعضهم يمارس التجارة والتعليم والصنائع المختلفة والزراعة، ولقد تكاثرت المشاريع الخيرية لأوقاف الأندلس حتى بلغت بالفرنك الذهبي 072 408 فرنكا في عام 1837م.
– 4/ أوقاف الزوايا والأولياء والأشراف والمرابطين: كانت كثيرة في مختلف المدن وخاصة مدينة الجزائر، وتكونت الزوايا غالبا حول ضريح ولي صالح، فكانت تقدم لها الهدايا والهبات وتحبس عليها الأملاك، فتكونت بذلك لكل منها ملكية.
مصير الأوقاف خلال فترة الاستعمار الفرنسي
بعد القضاء على السيادة الوطنية – كان القضاء على الاوقاف، فقد جاء في البند الخامس من معاهدة 05 جويلية 1830 (وثيقة الاستسلام) التي حررها قائد الحملة الفرنسية
«دوبرمون» ووقعها الداي الحسين، ما نصه: حرية المعتقد بالدين الإسلامي واحترام كل شيء يرمز إليه والمحافظة على أموال الأوقاف وعدم التعرض إليها بسوء، من طرف فرنسا.
وبعد شهرين من تاريخ إبرام الاتفاقية، أصدر دوبرمون يوم 08 سبتمبر 1830 م مرسوما يقضي بمصادرة الأوقاف الإسلامية والاستيلاء عليها، وبإصداره أول قانون في سبتمبر 1830 الذي خول للأوربيين امتلاك الأوقاف والذي اعتبر بداية لتصفية الأوقاف، حيث استمرت هذه المرحلة خمس سنوات انتهت بسيطرة الإدارة الفرنسية على الأملاك الوقفية.
و اصدر في اليوم الموالي قرارا آخر يمنح فيه لنفسه حق وصلاحية التسيير و التصرف في الأملاك الدينية بالتأجير، و توزيع الريوع على المستحقين و غيرهم مرتكزا في هذا على قوله بحق الحكومة الفرنسية في إدارة الأوقاف بحلولها محل الحكومة الجزائرية ، في تسيير شؤون البلاد، ومن المعلوم أن هذه العملية تمت لحساب الحكومة الفرنسية التي نهبت أموال الاحباس و صرفتها في غير موضعها، إذ سجل أن الكاردينال الفرنسي المسيحي بالجزائر كان منابه منها ثلاثون ألفـا من الفرنكات سنويــا، فصودرت بذلـك أمــلاك وقفية و منع أصحــابها الشــرعيين ( الجهات الموقوفة عليها) من حقهم.
وبعد ثلاثة أشهر أصدر كلوزيل قرارا مؤرخا في 07 ديسمبر 1830 يخول للأوربيين امتلاك الأوقاف، وبحكم هذا القرار ألحقت الأوقاف جميعها بأملاك الدولة الفرنسية، ومنحت التسيير لمصلحة أملاك الدولة وقضى القرار ببقاء وكلائها وحملهم جمع وتسليم مداخيلها إلى السيد (جيريدان) الذي عين لإدارة الأملاك الوقفية على مستوى مصلحة أملاك الدولة.
ثم جاء في قرار لوزير الحرب الفرنسي مؤرخ في 23 مارس 1843 بضم مداخيل ومصاريف المؤسسات الدينية إلى ميزانية الدولة الفرنسية.
وعليه توالت المراسيم، والقرارات، والمناشير واللوائح، وكان هدفها الوحيد هو الاستيلاء على الأوقاف ونذكر منها المرسوم المؤرخ في 04 جوان 1843، الذي قضى بمصادرة جميع الأملاك المحبسة على المسجد العظيم، كما ان القرار الصادر في 23 مارس 1843 ألغي العمل بقرار 07 ديسمبر 1830، فغالط الحكام الفرنسيون الأهالي.
وتمكن بذلك من حصر الأوقاف ليصدر في 06 أكتوبر 1843 قرارا يضم وبصفة نهائية كل الأملاك الوقفية التابعة للمساجد والزوايا والمرابطين والمؤسسات الدينية والأضرحة والمقابر التابعة لها، لأملاك المستعمر (Domaine colonial). ومما يدعو الى الدهشة ان كارل ماركس عند زيارته للجزائر عام 1882 كتب في مذكرته ان « المؤسسة الوقفية في الجزائر تملك ثلاثة ملايين هكتار من الاراضي الزراعية».
الأوقاف بعد الاستقلال
مرت الاوقاف بعد الاستقلال بعدة مراحل:
1/المرحلة الأولى (1962-1991):
بعد الاستقلال، كان هناك فراغ قانوني فيما يتعلق بالأوقاف، حيث تم تمديد العمل بالقوانين الفرنسية مع استثناء ما يمس السيادة الوطنية، ولم يتم الاهتمام بشكل كافٍ بالأوقاف المتبقية أو المفقودة.
وجدت الجزائر نفسها بعد الاستقلال أمام فراغ قانوني في مجال الأملاك الوقفية ، مما جعل هذه الأخيرة عرضة لكل أنواع التجاوزات و الاستيلاء بدون وجه شرعي من الأفراد و الجماعات و ذلك بالرغم من وضوح الحكم الشرعي الذي يقضي صراحة بأن أملاك الوقف أو الحبوس، ليست من الأملاك القابلة للتصرف فيها و لا هي من أملاك الدولة بالمفهوم القانوني المعاصر، و إنما هي ملك لكل المسلمين، و على الدولة شرعا واجب الإشراف عليها و حسن تسييرها و تنميتها و الحفاظ عليها و ضمان صرف ريوعها وفقا لإرادة الواقفين بما يتماشى و مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء .
إن التفسير القانوني لهذه الوضعية، يمكن أن يجد مصدره في الآثار المترتبة من جراء صدور وتطبيق المرسوم رقم: 62/157 المؤرخ في: 31/12/1962 م المتضمن تمديد سريان القوانين الفرنسية في الجزائر ما عدا تلك التي تمس السيادة الوطنية.
وبناء على ما تقدم، أدمجت كل الأملاك والأراضي ضمن الأملاك الشاغرة وأملاك الدولة وكذا الاحتياطات العقارية.
إن هذه الحالة أفرزت أثارا سلبية على الأملاك الوقفية بالرغم من صدور المرسوم رقم :283/64 المؤرخ في 17/09/1964 م المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة، وهو نص لم يلق تطبيقا من طرف الإدارة الجزائرية، ولقد وضع في ظروف خاصة، لم يحدد فيه الأحكام القانونية التي تلزم الإدارة حماية الأوقاف من الضياع والاندثار.
ونسجل في هذا المنظور صدور الأمر رقم 71/73 المتضمن قانون الثورة الزراعية فبالرغم من تأكيد المادة: 34 منه على استثناء الأوقاف من عملية التأميم، فان الإدارة أممت بعض الأراضي الوقفية.
واستمرت هذه الوضعية السلبية للأوقاف، وازدادت تدهورا بعد صدور القانون رقم: 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 م المتضمن التنازل عن أملاك الدولة بحيث لم يستثنِ هذا الأخير الأملاك الوقفية من عملية التنازل.
كما أن صدور قانون الأسرة رقم: 84/11 الصادر في: 9رمضان عام 1404الموافق ل9 يونيو1984الذي خصص الفصل الثالث منه لتحديد مفهوم الوقف لم يكن كافيا لضمان الحماية القانونية والعملية للأوقاف.
وعليه جاء دستور 23/02/1989 م الذي اقر الحماية على الأملاك الوقفية في أحكام المادة :49 منه، بواسطة قانون مستقل عن باقي أصناف الملكية الأخرى.
ولقد بدأ يتجسد الوجود القانوني للأوقاف بصدور قانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري الذي صنف صراحة الأوقاف ضمن الأصناف القانونية العامة المعترف بها في الجزائر وذلك، بنص المادة: 23، كما أبرز هذا القانون حرصه على أهمية الأوقاف بتخصيص المادتين: 31 و32 منه لتأكيد استقلالية التسيير الإداري والمالي للأوقاف وخضوعها لقانون خاص.
يتبع
* أستاذ جامعي وإطار سابق بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف