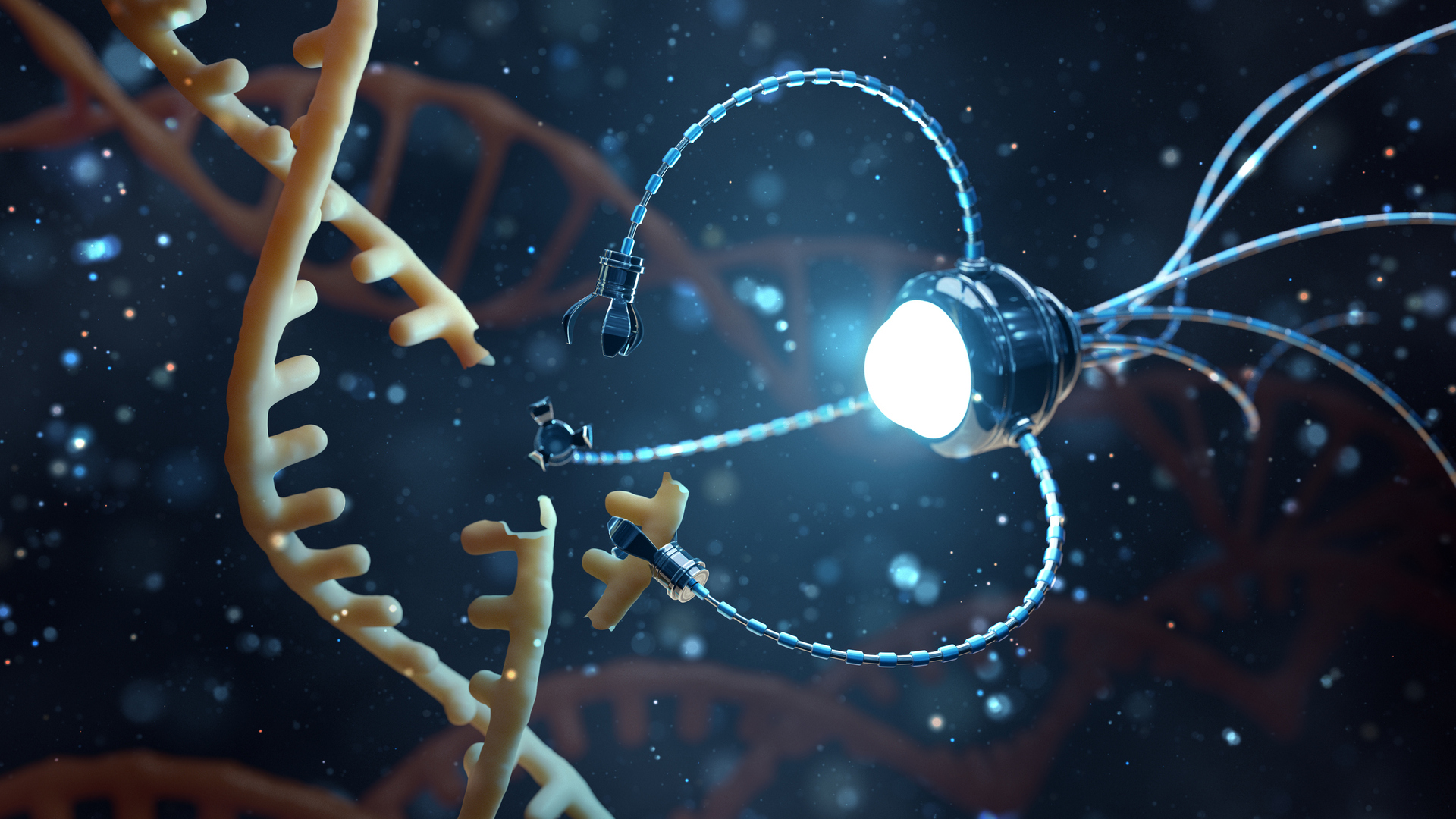التحضّر الزائف والجريمة الحضارية: قراءة في تصريح السفير الفرنسي عن احتلال الجزائر (الجزء الثاني)
د. بدران بن الحسن */ ثانيًا: ما فعله الاحتلال الفرنسي في الجزائر هو جريمة حضارية، لا «رسالة تحضر» على مدى عقود، ظلت فرنسا تروّج لاحتلالها للجزائر على أنه «رسالة تحضّر»، تهدف إلى نقل قيم الحداثة الغربية إلى مجتمعات وصفتها بالدونية والتخلف، وزعمت أنها جاءت لإنقاذها من الانحطاط. غير أن هذا الخطاب الاحتلالي الكلاسيكي يتهاوى تمامًا …

د. بدران بن الحسن */
ثانيًا: ما فعله الاحتلال الفرنسي في الجزائر هو جريمة حضارية، لا «رسالة تحضر»
على مدى عقود، ظلت فرنسا تروّج لاحتلالها للجزائر على أنه «رسالة تحضّر»، تهدف إلى نقل قيم الحداثة الغربية إلى مجتمعات وصفتها بالدونية والتخلف، وزعمت أنها جاءت لإنقاذها من الانحطاط. غير أن هذا الخطاب الاحتلالي الكلاسيكي يتهاوى تمامًا أمام الوقائع التاريخية الموثقة، كما يسقط أمام تصريح جيرار أرو، الذي يقرّ بأن ما جرى في الجزائر لم يكن تنمية ولا تحديثًا، بل عملية تفكيك متعمدة لبنية مجتمع قائم، واستبداله بهيكل احتلالي يخدم مصالح المحتل وحده.
ففكرة «رسالة التحضّر» لم تكن سوى قناع أيديولوجي يُخفي مشروع الهيمنة والنهب، وقد استُخدمت لتبرير السيطرة على أراضي الغير، ونهب ثرواتها، وإخضاع شعوبها. هذا التصور انطلق من نظرة عنصرية تفترض أن الشعوب المستعمَرة بلا تاريخ ولا عقل، وأنها تحتاج لوصاية «الرجل الأبيض» كي تنهض وتتعلم. في الحالة الجزائرية، تجاهل هذا الخطاب الاستعلائي وجود حضارة إسلامية متجذرة، ونظام تربوي ديني، وهوية لغوية وثقافية متماسكة كانت قائمة قبل الاحتلال بقرون.
ما جرى في الجزائر كان جريمة حضارية ممنهجة، بدأت بمحاولة محو الثقافة واللغة، حيث عمل الاحتلال الفرنسي على طمس اللغة العربية ومنع استخدامها في التعليم والإدارة، واعتبارها لغة «أجنبية» في وطنها. كما جفف منابع التعليم الديني، وأغلق الزوايا والمدارس، أو حوّلها إلى أدوات فرنسة وتهميش. فُرضت اللغة الفرنسية بالقوة، لتكون أداة الهيمنة الثقافية وتذويب الشخصية الوطنية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعرّضت المدن والمؤسسات والمدارس والمساجد والمقابر والمكتبات الإسلامية للتدمير أو التحويل إلى ثكنات وكنائس، فيما حوربت رموز الهوية الوطنية، وسُخرت الخطابات الاستعمارية لتشويه المرجعيات التاريخية والدينية للجزائريين.
في موازاة هذا، سعى الاحتلال إلى تفكيك المجتمع من الداخل، بتدمير الهياكل القبلية التقليدية، وإلغاء القضاء الإسلامي، وفرض قوانين فرنسية لا تعترف بالثقافة الجزائرية. وجرى نهب الأراضي الزراعية، وطُرد أصحابها الأصليون منها لصالح المستوطنين الأوروبيين، ما حول ملايين الجزائريين إلى فلاحين معدمين محرومين من أبسط الحقوق في أرضهم. ومورست أشكال متعددة من التمييز العنصري، حيث صُنِّف الجزائريون كمواطنين من الدرجة الثانية، في انتهاك سافر لهويتهم الدينية والثقافية. كما فُرض نظام تعليمي عنصري يقصي الجزائريين من التعليم العالي، أو يضع أمامهم شروطًا مجحفة ومهينة، تجعل من ارتقائهم الاجتماعي والعلمي أمرًا شبه مستحيل.
لم تكن نتيجة هذا المشروع تَقدُّمًا أو ازدهارًا، بل كارثة وطنية كاملة. فقد خرجت الجزائر من أكثر من 130 عامًا من الاستعمار بهوية مجروحة، وذاكرة ممزقة، ونسب أمية فاقت 85%، واقتصاد مدمَّر، وبنية تحتية وطنية شبه معدومة. لم يكن في المشروع الاحتلالي الفرنسي أي توجه إنساني نحو بناء الإنسان الجزائري أو خدمته، بل خُصّصت كل المشاريع لخدمة المستوطنين وجيش الاحتلال، فيما حُرم الشعب الجزائري من أبسط الحقوق.
وبالنظر إلى التجربة من منظور تاريخي مقارن، فإن ما قامت به فرنسا في الجزائر لا يختلف في جوهره عن ممارسات الاستعمار الاستيطاني في فلسطين أو أستراليا، حيث نُفذت عمليات تطهير ثقافي وإحلال سكاني وتزييف للهوية. والحال أن ما وقع في الجزائر يُصنَّف اليوم ضمن جرائم الإبادة الثقافية، والاعتداءات المنهجية على الحقوق الجماعية للشعوب المستعمَرة.
يتضح إذًا أن ما حدث في الجزائر لم يكن «رسالة تحضُّر»، بل مخططًا احتلاليا مدروسًا اقتلع هوية الأمة من جذورها، ومارس التذويب والتفكيك، وأحلّ ثقافة المحتل على أنقاض حضارة حية. وتصريح السفير الفرنسي لا يترك مجالًا للالتباس: إنه شهادة دامغة على جريمة حضارية نفّذتها دولة تدّعي التنوير، لكنها مارست الاستئصال والتدمير والتهميش. وما هو مطلوب اليوم ليس التستر على هذه الحقيقة أو تجميلها بشعارات زائفة، بل الاعتراف العلني بها، ومساءلة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الرمزي والمادي لشعب دُمّر مجتمعه قسرًا باسم الحضارة.
ثالثًا: تقييم موقف السفير الفرنسي Gérard Araud ودلالاته المتعددة
يُعد تصريح جيرار أرو، السفير الفرنسي السابق لدى الكيان الصهيوني، لحظة بالغة الدلالة ليس فقط من حيث صراحته النادرة، بل بالنظر إلى السياق الذي قيل فيه والموقع الرمزي الذي يشغله صاحبه، إذ لا يمثل مجرد شخصية دبلوماسية عابرة، بل رجل دولة مثّل فرنسا في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم. وبالتالي، لا يمكن قراءة تصريحه على أنه رأي شخصي معزول، بل هو انعكاس لتراكمات في الوعي السياسي والثقافي الفرنسي بشأن الإرث الاستعماري، وربما مؤشر على تصدعات داخلية بدأت تتشكل في سردية الدولة الفرنسية حول ماضيها في الجزائر. بالرغم من انه يرفض اعتذار فرنسا للجزائر، لكنه حين يقرّ بأن فرنسا قامت بتفكيك البُنى القائمة في الجزائر، ودمرت كل شيء، وأعادت بناء مجتمع استعماري جديد من الأساس، فإن ذلك يفتح مجالًا واسعًا للقراءة والتحليل على مستويات متعددة.
من الناحية الفكرية، يمثّل هذا التصريح خرقًا للخطاب الرسمي الفرنسي الذي طالما سوّق الاستعمار على أنه مهمة حضارية. إنه ينسف ضمنيًا المزاعم بأن الجزائر كانت بلا دولة ولا مجتمع، ويعيد الاعتبار لوجودها التاريخي والسياسي والثقافي قبل الاحتلال. وقد يُقرأ هذا الموقف بوصفه تعبيرًا عن تيار فكري جديد يتبلور داخل بعض النخب الفرنسية، يعيد النظر في الإرث الاستعماري بعيون نقدية وإن كان مليئا بالاستعلاء والعنصرية ورفض الاعتذار.
ثقافيًا، يكشف التصريح زيف الصورة التي حاولت فرنسا عبر قرون تصديرها عن نفسها كحاملة لمشعل التنوير، ويعري الوجه الحقيقي للاحتلال الفرنسي في الجزائر بوصفه مشروعًا لهدم الثقافات ومحو الهويات وليس نقل المعارف أو القيم. إن سقوط هذا القناع من فم دبلوماسي رفيع يُحرج النخب الثقافية التي تبنت سردية «التمدين»، ويفتح الباب أمام مراجعة جذرية للسياسات الثقافية الفرنسية، خاصة تلك المتعلقة بالفرنسة ومحو اللغة العربية وتهميش البنية الرمزية والدينية للمجتمع الجزائري.
أما على الصعيد السياسي، فرغم أن التصريح يحمل وزنًا رمزيًا لا يُستهان به، إلا أنه يظل منقوصًا من حيث أثره العملي، كونه لم يصدر عن جهة رسمية عليا في الدولة الفرنسية، بل عن دبلوماسي سابق، مما يحدّ من فاعليته القانونية والسياسية، كما أنه تصريح مقرون برفض الاعتذار. ومع ذلك، يمكن اعتباره ورقة ضغط أخلاقية يمكن للجزائر أن توظفها بذكاء في مطالبة فرنسا بالاعتراف الكامل بجرائمها الاستعمارية، وفتح ملف التعويض الرمزي والسيادي عن قرن ونيف من الهيمنة والتدمير الممنهج.
في البعد الحضاري، يعكس التصريح اعترافًا صريحًا بأن ما قامت به فرنسا في الجزائر لم يكن بناءً حضاريًا بل هدمًا لبنية حضارية قائمة. فالحضارة لا تُفرض بالقوة، ولا تنمو على أنقاض شعوب أُبيدت ذاكرتُها. إن ما فعلته فرنسا لم يكن سوى إعادة تشكيل قسري لمجتمع كامل، وسلبه عناصر هويته، وتذويبه في قالب استعماري يخدم مصالح الغزاة. من هذا المنظور، تدخل فرنسا في سجل القوى التي مارست الإبادة المادية والرمزية والمعنوية، لا القوى التي ساهمت في إغناء الحضارة الإنسانية.
أما على المستوى الإنساني، فإن هذا التصريح يُسلط الضوء على حجم المعاناة التي كابدها ملايين الجزائريين الذين خسروا حياتهم، أو هويتهم، أو ذاكرتهم الجماعية بسبب السياسات الاستعمارية القاسية. لكنه، رغم صدقه التحليلي، يفتقر إلى البُعد الأخلاقي، إذ لا يُبدي أي شعور بالندم أو الاعتذار، بل يُقدَّم بلغة باردة تخلو من التعاطف. وهذا ما يثير تساؤلات عن مدى استعداد النخب الفرنسية للانتقال من توصيف الماضي إلى تحمل المسؤولية عنه، ومن الاعتراف الصامت إلى الفعل السياسي المترتب عليه.
يتّضح إذن أن موقف السفير الفرنسي يحمل في طياته اعترافًا مهمًا، لكنه اعتراف ناقص، يثير من الأسئلة أكثر مما يقدّم من الأجوبة. إنه يُفكّك السردية الاستعمارية التي لطالما ظهرت فرنسا من خلالها بمظهر المنقذ والمخلّص، ويضع يدًا صريحة على حقيقة المشروع الاستيطاني الذي أراد طمس الجزائر وهويتها. وما ينبغي للنخبة الجزائرية اليوم هو أن تتعامل مع هذا التصريح لا كوثيقة شرف، بل كفرصة لإعادة بناء الرواية الوطنية، وتصحيح الذاكرة، ومواصلة الضغط من أجل اعتراف رسمي واضح، ومساءلة تاريخية جادّة، وتعويض سياسي يليق بحجم الجريمة. إنها لحظة نادرة من الانكشاف، تتطلب يقظة وطنية واستراتيجية دقيقة، لتحويل هذا «الاعتراف غير المتوقع» إلى أداة تحرّر رمزي وتاريخي.
الخاتمة
إن تصريح السفير الفرنسي السابق جيرار أرو لا يُمثل مجرد رأي فردي عابر، بل يُعدّ اعترافًا صريحًا بخطورة المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر، ويفتح نافذة نادرة على ما كان يُحجب لعقود خلف خطاب «التحضر» و»تمدين الشعوب». فقد دلّت كلماته على أن الجزائر لم تكن أرضًا بلا ماضٍ، بل كانت تملك بنى اجتماعية، وثقافية، ودينية راسخة، ما يجعل من عملية «التفكيك الكامل» التي تحدّث عنها جريمة موصوفة بحق دولة ومجتمع وهوية.
لقد انكشف في ضوء هذا التصريح أن ما قامت به فرنسا لم يكن بناءً ولا تطويرًا، بل إعادة تشكيل قسري للمجتمع الجزائري وفق منطق استيطاني إحلالي، يُشبه في أدواته ونتائجه ما فعله الاحتلال الصهيوني لاحقًا في فلسطين. وهذا يُسقط كليًا خطاب «رسالة التحضر»، ويضع المشروع الفرنسي في خانة الجرائم الحضارية الكبرى التي لا يمكن تجاوزها دون مساءلة تاريخية وأخلاقية.
أما موقف السفير، فرغم أهميته الرمزية، يظل مثقلاً بالمفارقة: اعتراف دون اعتذار، تحليل دون ضمير، تشخيص دون مسؤولية. وهو ما يكشف عن عمق المأزق الفرنسي في التعامل مع ذاكرة استعمارية دامية، لم تُحلّ بعد، لا سياسيًا ولا ثقافيًا.
إن مسؤولية الجزائريين، نخبًا وشعبًا، أمام مثل هذا التصريح، لا تكمُن في الاكتفاء بالتنديد، بل في تحويل لحظة الاعتراف إلى منصة للمطالبة الفعلية بحقوقهم التاريخية؛ من الاعتراف الرسمي الكامل بجرائم الاحتلال، إلى التعويض الرمزي والمادي، وصولًا إلى إعادة الاعتبار للهوية الجزائرية التي حاولت فرنسا طمسها.
هكذا، لا يكون التصريح مجرد وثيقة تُحفظ، بل أداة في معركة الذاكرة والسيادة والكرامة الوطنية، في زمن لا يزال فيه الصراع بين المستعمِر والمستعمَر مستمرًا على جبهة التاريخ والمعنى.
*مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية/ جامعة قطر