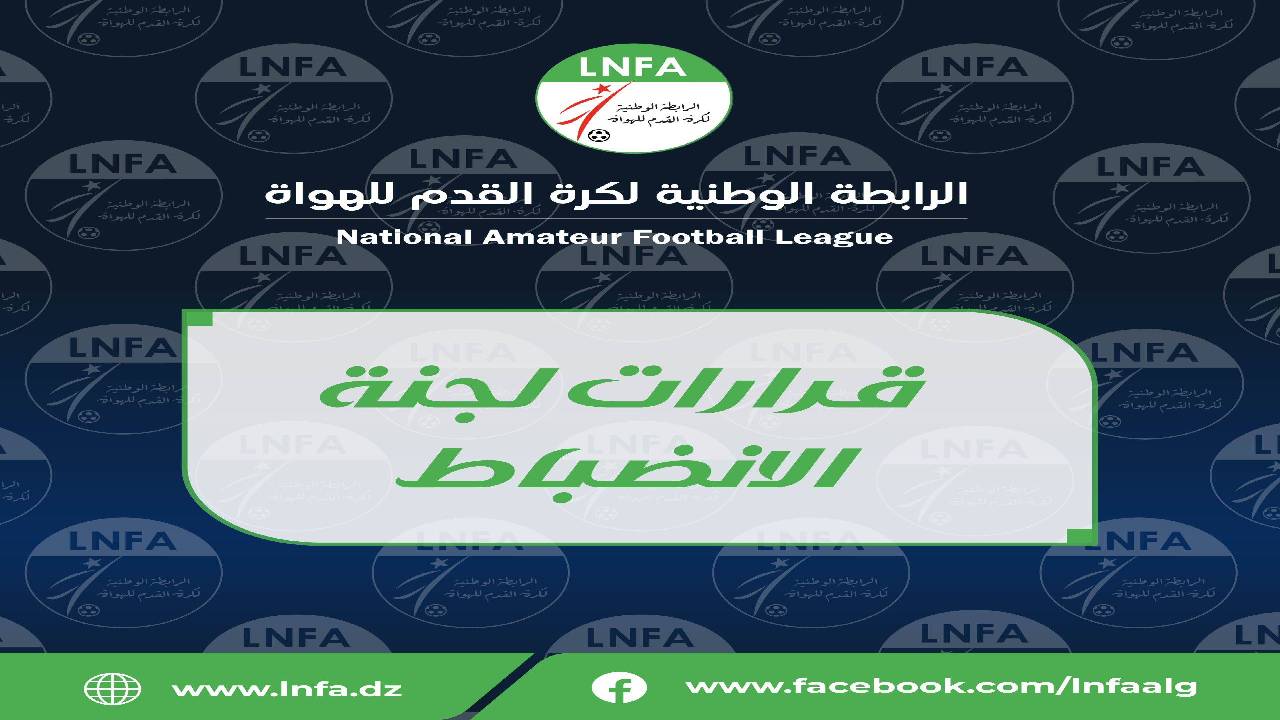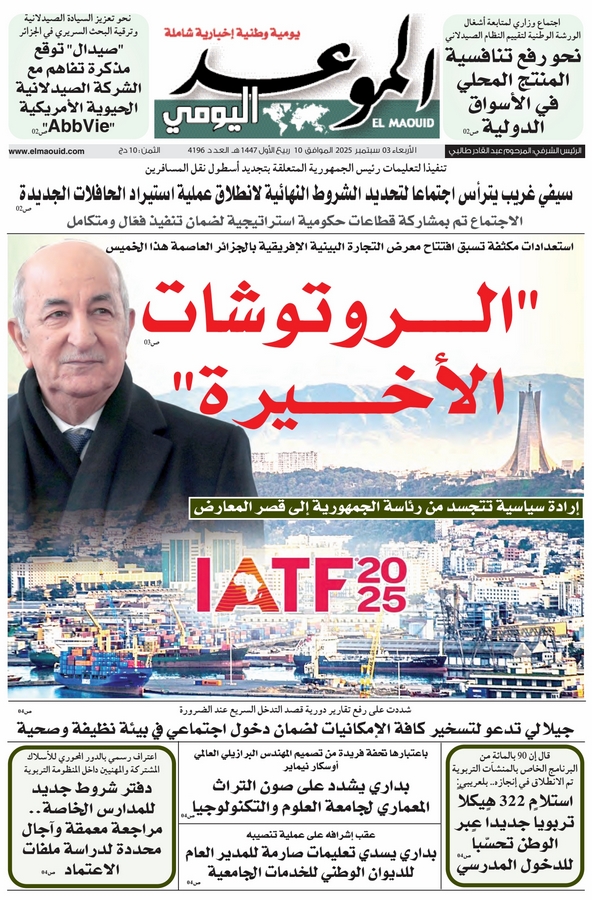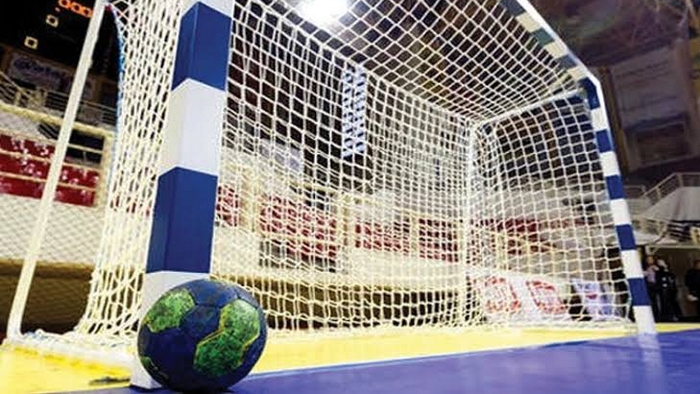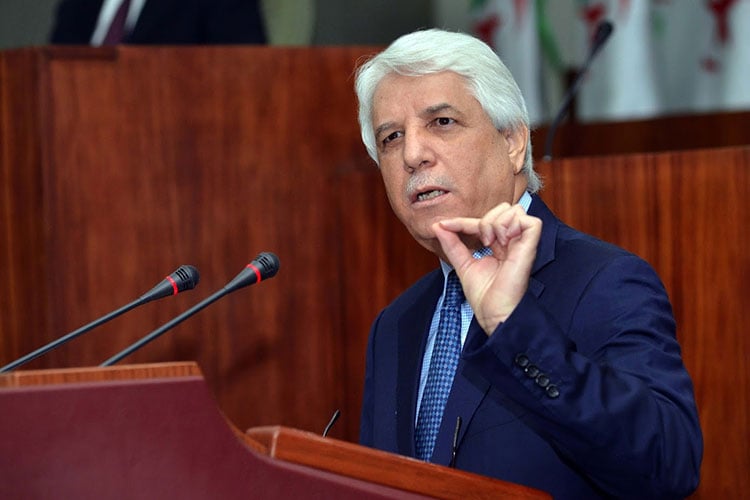انعكاسات اتفاقية سيداو على القيم الأسرية
د. بدران بن الحسن */ مقدمة تُعَدّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة منذ إقرارها عام 1979، وفي نسخها التي تم تطويرها في المؤتمرات اللاحقة، وقد انضمت إليها معظم دول العالم تحت شعار حماية المرأة وتعزيز مساواتها. غير أن هذه الاتفاقية، التي كثيرًا ما …

د. بدران بن الحسن */
مقدمة
تُعَدّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة منذ إقرارها عام 1979، وفي نسخها التي تم تطويرها في المؤتمرات اللاحقة، وقد انضمت إليها معظم دول العالم تحت شعار حماية المرأة وتعزيز مساواتها. غير أن هذه الاتفاقية، التي كثيرًا ما تُوصَف بأنها دستور عالمي لحقوق المرأة، لم تخلُ من إشكالات عميقة تثير تحفظات واسعة، وخاصة في السياق الاسلامي.
إذ الأمر لا يقتصر على مسألة قانونية أو حقوقية مجردة، بل يتعلق بجوهر المنظومة القيمية التي تحكم علاقة المرأة بالرجل داخل الأسرة والمجتمع. إذ بينما تنطلق الاتفاقية من رؤية ليبرالية غربية تفصل الإنسان عن أي مرجعية دينية أو ثقافية عليا، تقوم الشريعة الإسلامية على اعتبار الدين مصدرًا ملزمًا لتنظيم الحياة، بما في ذلك قضايا الأسرة والمرأة. وهنا يظهر التناقض الصارخ: كيف يمكن التوفيق بين مواد تُلزم بالمساواة المطلقة في كل المجالات، وبين نصوص شرعية قطعية تنظم العلاقة بين الجنسين على أساس التكامل والتوازن، لا على أساس التماثل المطلق؟
إضافة إلى ذلك، تُشكّل سيداو تحديًا مباشرًا للثقافة الوطنية في الدول العربية والإسلامية، حيث تقوم الهوية الجماعية على منظومة قيمية تمثل الأسرة فيها نواة المجتمع وحصنًا للهوية والدين. ولذلك فإن فرض بنود تُعيد تعريف الأدوار الأسرية أو تلغي الولاية والقوامة أو تشكك في ثنائية الذكر/الأنثى، يمثل تهديدًا مباشرًا لهذه القيم المركزية. لذلك جاءت التحفظات الرسمية للدول الإسلامية على مواد بعينها، وعلى رأسها المواد (2، 5، 15، 16)، باعتبارها مواد تتجاوز الحد الأدنى من الخلاف لتدخل في صدام مع الثوابت الشرعية نفسها.
من هنا، تنبع الإشكالية المركزية في هذا المقال: إلى أي مدى تمثل مخرجات سيداو تهديدًا للقيم الأسرية والخصوصيات الدينية والثقافية؟ وكيف يمكن بناء موقف نقدي متوازن يحقق العدالة للمرأة دون المساس بالثوابت الشرعية والبناء الاجتماعي؟
المساواة المطلقة في الأسرة (المادة 2 والمادة 16):
المادتان (2) و(16) من اتفاقية سيداو تُعَدّان من أخطر المواد التي تمسّ بنية الأسرة ومسارها التشريعي. فالمادة (2) تلزم الدول الأطراف بإلغاء أو تعديل جميع القوانين والأعراف التي تُعدّ تمييزًا ضد المرأة، فيما تذهب المادة (16) إلى المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في كل ما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، بدءًا من اختيار الزوج وعقد الزواج، مرورًا بالحقوق والمسؤوليات أثناء الحياة الزوجية، وصولًا إلى الطلاق وحضانة الأطفال، بل وحتى الميراث. ورغم ما يبدو على هذه المواد من ظاهر العدالة، فإن صياغتها المطلقة تتجاهل الخصوصيات الدينية والثقافية التي تنظم العلاقات الأسرية في المجتمعات الإسلامية، حيث تقوم الشريعة على مبدأ العدل والتكامل والتوازن لا على مبدأ التماثل التام.
ويظهر التعارض جليًا مع أحكام قطعية؛ فالميراث مثلًا قد نص القرآن على أنصبته في آيات مفصّلة، وجاءت حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل، وأخرى مثله أو أكثر منه، وهو نظام يقوم على العدالة بحسب الأعباء والمسؤوليات، لا على المساواة العددية الجامدة. أما الولاية في الزواج، فهي شرط شرعي لحماية المرأة وصيانة حقها وضمان موافقتها الحرة، بينما تنص سيداو على إلغائها تمامًا. وفيما يتعلق بالقوامة، فإن النص القرآني الصريح يجعل الرجل مسؤولًا عن الأسرة بالإنفاق والرعاية، وهي مسؤولية تكليف لا تشريف، لكن الاتفاقية تراها تمييزًا يجب إلغاؤه. أما التعدد، وهو إباحة مشروطة بالعدل والقدرة، فقد يُعتبر وفق بعض تفسيرات سيداو تمييزًا ينبغي محوه.
إن تطبيق هذه البنود بصيغتها المطلقة يهدد البناء الأسري برمته، إذ يؤدي إلى زعزعة مبدأ التوازن بين الزوجين ويحوّل مؤسسة الزواج من رابطة قائمة على التكامل إلى مجرد عقد مدني هشّ قابل للتفكك عند أول خلاف. ولا يتوقف الخطر عند الجانب التشريعي، بل يمتد إلى الأثر الاجتماعي والثقافي؛ فالمساواة المطلقة تُنتج صراعًا داخل الأسرة بدل الانسجام، وتفتح الباب لارتفاع نسب الطلاق، وتؤدي إلى تفشي الفردانية المفرطة التي تحوّل العلاقة الزوجية إلى منافسة على الحقوق بدل التعاون في أداء الواجبات، كما تضعف الهوية الثقافية الوطنية عبر فرض نموذج أسري غريب عن سياقنا الثقافي الاسلامي.
إن الخطورة في هاتين المادتين تكمن في أنهما لا تقتصران على معالجة مظالم حقيقية قد تتعرض لها المرأة في بعض السياقات، بل تذهبان إلى إعادة هندسة الأسرة وإلغاء المرجعيات الدينية والثقافية التي تنظّمها. فبدلًا من المطالبة بالعدل المبني على التكامل، تفرض سيداو نموذجًا يقوم على المساواة المطلقة، وهو نموذج لا يحقق استقرارًا أسريًا ولا يحفظ خصوصيات المجتمعات، بل يُعيد صياغة علاقة الرجل والمرأة على أسس مغايرة تمامًا لما استقر في الشرائع والثقافات، بما يفتح الباب لاضطرابات قيمية واجتماعية عميقة.
إلغاء القوالب النمطية (المادة 5):
تمثل المادة (5) من اتفاقية سيداو إحدى أكثر المواد إثارة للجدل، إذ تنص على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير الكفيلة بتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف القضاء على ما تسميه «القوالب النمطية» المرتبطة بالأدوار التقليدية داخل الأسرة والمجتمع. وفي ظاهرها، قد تبدو هذه المادة دعوة إلى العدالة والمساواة، لكن عند التعمق في مدلولاتها، يظهر أنها تنطوي على مشروع ثقافي وفكري يرمي إلى إعادة صياغة علاقة الرجل بالمرأة، ليس فقط في المجال العام، وإنما أيضًا داخل الأسرة ذاتها.
والإشكالية الكبرى في هذه المادة أنها تنطلق من افتراض مسبق بأن الأدوار التقليدية، كقوامة الرجل أو أمومة المرأة أو مسؤولية الأبوة، ليست إلا «قوالب» مفروضة ينبغي التحرر منها، في حين أن الواقع الديني والأنثروبولوجي والتاريخي يثبت أن هذه الأدوار ليست اصطناعية، بل هي نتاج طبيعي وشرعي وتاريخي لتكامل الجنسين. فالأمومة ليست مجرد «قالب» ثقافي بل هي حقيقة فطرية وبيولوجية ونفسية تشكّل جوهر دور المرأة في استمرارية الحياة ورعاية الأجيال، وكذلك الأبوة ليست مجرد نمط اجتماعي، بل هي مسؤولية طبيعية للرجل في الإنفاق والحماية والرعاية. وإلغاء هذه الأدوار بحجة التحرر من «الأنماط» يؤدي بالضرورة إلى نزع القيمة والمعنى عن الأسرة وتحويلها إلى إطار هشّ بلا وظيفة متمايزة.
ومن الناحية الشرعية، تتعارض هذه المادة مع التصور المستمد من القرآن للأسرة، الذي يؤكد أن الزوجين «لباس» لبعضهما، وأن العلاقة بينهما قائمة على السكينة والمودة والرحمة. هذا التصور يقوم على توزيع للأدوار يحقق التكامل لا التماثل؛ فالمرأة في الشريعة مكرّمة في أمومتها ورعايتها، والرجل مكلّف بالقوامة والإنفاق. وعندما تُطرح هذه الأدوار بوصفها «أنماطًا سلبية» يجب القضاء عليها، فإن ذلك يعني عمليًا تفكيك المرجعية القرآنية لصالح مرجعية ثقافية غربية حديثة، لا تنسجم مع السياقات الشرعية والثقافية الإسلامية.
أما على المستوى الاجتماعي، فإن الدعوة إلى إزالة الأدوار التقليدية تترجم إلى تغييرات في التربية والتعليم والإعلام. فهي تدفع نحو إعادة صياغة المناهج الدراسية بحيث تُمحى أي إشارات إلى الأدوار المميزة للذكر والأنثى، وتُستبدل برؤية قائمة على المساواة المطلقة بينهما في كل شيء. هذا التحول قد يبدو جذابًا تحت شعارات الحرية، لكنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة؛ إذ يُنشئ أجيالًا بلا وعي بدور الأبوة أو الأمومة، ويُضعف من قيمة الأسرة كمؤسسة قائمة على التعاون والتكامل، ويحوّلها إلى مجرد اجتماع أفراد تجمعهم مصالح وقتية.
كما أن محو «القوالب النمطية» قد يُستغل لتمرير مفاهيم أوسع مرتبطة بمفهوم «النوع الاجتماعي» (Gender)، حيث يتم التشكيك في الثنائية الطبيعية بين الذكر والأنثى لصالح هويات جندرية متعددة. وهذا يفتح الباب أمام تحولات ثقافية خطيرة تمس هوية المجتمعات وتوازنها القيمي، بل وتُهدد بانفصال الإنسان عن فطرته.
لذلك فالمادة (5) لا تقتصر على محاربة مظاهر التمييز الظالمة – وهو مطلب مشروع – بل تتجاوز ذلك إلى مشروع لإعادة هندسة الأسرة والمجتمع على أساس فرداني يُضعف قيمة الأمومة والأبوة ويُقصي البعد الديني والفطري. وإن الاستجابة لهذه المادة بمعناها الأممي المطلق قد تؤدي إلى تحويل الأسرة من مؤسسة متكاملة تحفظ النوع الإنساني وتبني الأجيال، إلى مجرد إطار هشّ لتعايش أفراد متساوين بلا روابط مميزة ولا وظائف متكاملة.
حرية الإنجاب وتنظيم الأسرة (المادة 12 والمادة 16/هـ):
تطرح المادتان (12) و(16/هـ) من اتفاقية سيداو إشكالية شديدة الحساسية تتعلق بحرية المرأة في الإنجاب وتنظيم الأسرة. فالمادة (12) تنص على حق المرأة في الحصول على جميع الخدمات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك تنظيم الأسرة، بينما تنص المادة (16/هـ) على أن للمرأة الحق في أن تقرر بحرية ومسؤولية عدد الأطفال والفترات الفاصلة بينهم، والحصول على المعلومات والوسائل الكفيلة بممارسة هذا الحق.
للوهلة الأولى، قد تبدو هذه البنود خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز صحة المرأة وتمكينها من اتخاذ قرارات واعية بشأن حياتها الإنجابية، خصوصًا في مجتمعات عانت النساء فيها من التهميش أو من ضغوط اجتماعية تُقيّد حريتهن في هذا المجال. غير أن الإشكال الحقيقي يظهر عند تحليل هذه المواد في ضوء خلفيتها الفكرية والتطبيقات العملية التي صاحبتها في العديد من الدول.
إذ لا يمكن تجاهل أن مفهوم «الحرية الإنجابية» في الخطاب الغربي يرتبط غالبًا بسياسات سكانية دولية لها أهداف اقتصادية وديموغرافية. فالعديد من الهيئات الدولية والمنظمات المانحة ربطت تقديم المساعدات للدول النامية بتنفيذ برامج تنظيم أسرة واسعة النطاق، بل وفي بعض الحالات على نحو إجباري أو شبه إجباري، تحت شعار «الصحة الإنجابية». وهذا ما حدث في دول عدة في آسيا وأفريقيا حيث مورست سياسات صارمة لتقليل معدلات المواليد، ما أدى إلى تفكك النسيج الأسري وخلخلة البنية السكانية.
ومن المنظور الشرعي، يطرح هذا الأمر إشكاليتين جوهريتين:
الأولى، أن الشريعة الإسلامية وإن أقرت جواز تنظيم النسل في بعض الحالات الخاصة وبشروط (كالعجز عن الإنفاق أو وجود ضرر صحي معتبر)، فإنها لم تجعله مبدأ عامًا يُفرض على الأسر. بل الأصل في التصور الإسلامي هو الترغيب في التكاثر والذرية الصالحة باعتبارها مقصدًا من مقاصد الزواج ووسيلة لحفظ النوع الإنساني وإعمار الأرض. وبالتالي، فإن تحويل «تنظيم الأسرة» إلى حق مطلق أو إلى سياسة عامة تتعارض مع هذا التوجه القرآني والنبوي.
الثانية، أن الحديث عن «القرار المستقل» للمرأة بشأن الإنجاب بمعزل عن الزوج يعكس رؤية فردانية صِرف لا تتماشى مع طبيعة العلاقة الزوجية في الإسلام، والتي تقوم على الشورى والتوافق في اتخاذ القرارات المصيرية، ومن أهمها الإنجاب وتربية الأبناء. فإعطاء الحق المطلق للمرأة – أو للرجل – في تقرير عدد الأطفال دون اعتبار لشريك الحياة يُفرغ الأسرة من بعدها التشاركي ويحوّلها إلى علاقة تعاقدية هشة.
كما أن التركيز الأممي على هذه المواد غالبًا ما يتجاهل الضبط القيمي الذي يضعه الدين والثقافة المحلية لمسألة الإنجاب. فحرية الإنجاب في السياق الغربي قد تُستخدم لتبرير الإجهاض الاختياري، أو لإنكار القيمة الدينية للأبوة والأمومة، أو لفتح الباب أمام أشكال أسرية غير شرعية (كالعلاقات خارج إطار الزواج) تُطالب بحقوقها الإنجابية. وهذه كلها ممارسات تتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية ومع الثقافة الأسرية العربية والإسلامية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن تكريس حرية الإنجاب بهذا المعنى قد يؤدي إلى خلل في التوازن الديموغرافي، خصوصًا في المجتمعات العربية والإسلامية التي تواجه أصلًا تحديات مرتبطة بالشيخوخة السكانية أو بانخفاض معدلات المواليد في العقود الأخيرة. فإذا فُسّرت هذه المواد على نحو يُشجع على تأجيل الإنجاب أو تقليص عدد الأطفال استجابة لضغوط اقتصادية أو ثقافية، فإن ذلك يهدد استقرار المجتمع ويؤدي إلى نتائج استراتيجية خطيرة على المدى الطويل.
فالمادتان (12) و(16/هـ) وإن كانتا ترفعان شعار الحرية الصحية للمرأة، فإن تطبيقهما وفقًا للفلسفة الأممية قد يُستخدم أداةً لتفكيك المرجعيات الشرعية والقيمية للأسرة، ولإعادة تشكيل الخريطة السكانية والثقافية للمجتمعات الإسلامية. لذا فإن التعامل معهما يحتاج إلى قراءة نقدية واعية، توازن بين حق المرأة في الرعاية الصحية والقرار المسؤول، وبين ثوابت الشريعة ومصالح الأمة في الحفاظ على الأسرة والنسل.
الأهلية القانونية وحرية التنقل (المادة 15):
تُعنى المادة (15) من اتفاقية سيداو بالمساواة التامة للمرأة أمام القانون، بما يشمل الحق في الأهلية القانونية الكاملة وحرية التنقل والإقامة، وإلغاء أي قيود كانت مفروضة عليها سابقًا بموجب القوانين المحلية أو الأعراف التقليدية. وعلى المستوى النظري، تبدو هذه المادة تجسيدًا لمبدأ العدالة والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، إذ تضمن للمرأة حقوقًا قانونية متكافئة، وتحررها من أي قيود قد تعيق استقلالها الشخصي أو مشاركتها في الحياة العامة.
غير أن التطبيق العملي لهذه المادة في السياق الإسلامي والعربي يثير تحديات حقيقية، إذ توجد قيود شرعية وقانونية تهدف إلى حماية الأسرة وضمان انسجامها واستقرارها. فحق الزوج في تحديد بيت الزوجية، واشتراط المحرم في بعض حالات السفر، ليس مجرد تحكم أو تمييز، بل تنظيم قائم على مبادئ المسؤولية والرعاية وحماية الأسرة من التفكك أو التعرض لمخاطر اجتماعية وثقافية. وإلغاء هذه الضوابط وفق فهم المادة 15 يؤدي إلى تحويل العلاقة الزوجية من رابطة متكاملة قائمة على التفاهم والالتزام المتبادل، إلى علاقة شكلية تُفقد الأسرة قيمتها التنظيمية ويصبح كل طرف فيه مستقلاً بمعزل عن الآخر، مما يضعف أسس التعاون والتكامل التي تقوم عليها الحياة الأسرية في الإسلام.
كما أن منح المرأة حرية مطلقة في التنقل والإقامة، دون إشراف أو توافق مع الزوج أو الأسرة، قد يُنتج آثارًا اجتماعية عميقة على الاستقرار الأسري والمجتمعي. فغياب الرقابة المتوازنة أو الاتفاق التشاركي في اتخاذ القرارات المصيرية، مثل مكان السكن أو السفر لفترات طويلة، قد يؤدي إلى حالات صراع ونزاعات بين الزوجين، ويزيد من احتمالات التفكك الأسري، وهو ما يتعارض مع المقاصد الشرعية العليا التي تهدف إلى حفظ الأسرة وصيانتها.
إضافة إلى ذلك، هناك بعد ثقافي وديموغرافي ينبغي أخذه في الاعتبار، إذ أن المساواة المطلقة في التنقل قد تتناقض مع الأعراف الاجتماعية التي تنظم العلاقة بين الجنسين، وتفرض نوعًا من المسؤولية المشتركة بين الزوجين. وأي تطبيق حرفي للمادة 15 دون مراعاة هذه الأبعاد قد يُضعف الهوية الثقافية والمجتمعية، ويحوّل الأسرة إلى كيان هشّ، بلا وظائف واضحة أو أدوار متكاملة، كما يخفف من احترام النظام الأسري المتعارف عليه، الذي يحمي المصلحة العامة ويحقق التكامل بين أفراده.
أثر هذه المواد على البناء الأسري والقيم الاجتماعية
يمكن القول إن المواد الأكثر حساسية في اتفاقية سيداو، وخصوصًا المواد (2، 5، 15، 16)، تمثل تهديدًا مباشرًا للبناء الأسري في المجتمعات الإسلامية، ليس لأنها تعالج قضايا حقوقية بحد ذاتها، بل لأنها تقوم على فلسفة إعادة تعريف الأسرة والمجتمع من أساسه. فهذه المواد تسعى إلى تحويل الأسرة من مؤسسة قائمة على التكامل والانسجام بين الزوجين إلى مجرد علاقة تعاقدية، يُنظر إليها بوصفها رابطة شكلية يمكن تفكيكها متى شاء أي طرف، دون الالتفات إلى القيم الدينية والاجتماعية التي تُنظم حياة الأسرة وتحافظ على استقرارها.
إضافة إلى ذلك، فإن إدماج مفهوم «النوع الاجتماعي» (Gender) في المناهج الدراسية والسياسات الثقافية والتعليمية يحمل مخاطر طويلة الأمد على الهوية الاجتماعية. فمحاولة تجاوز الفروق الطبيعية بين الذكر والأنثى وتطبيق مفهوم المساواة المطلقة قد يُضعف من وظيفة الأبوة والأمومة، ويجعل الأدوار التربوية والتعليمية التي تقوم عليها الأسرة أقل وضوحًا، ما ينعكس على تنشئة الأجيال الجديدة. فغياب التمييز الوظيفي بين الأدوار يؤدي إلى فقدان القدوة والتوجيه الطبيعي للأطفال، ويقلل من قدرة الأسرة على نقل القيم والأحكام الشرعية والأعراف الثقافية التي تشكل هوية المجتمع.
ومن زاوية أخرى، فإن التركيز على الحقوق الفردية المطلقة للمرأة، مثل حرية التنقل، والأهلية القانونية، وحرية اتخاذ القرار بشأن الإنجاب، إذا أُخذ بمعزل عن الشريك الأسري أو الضوابط الدينية، يؤدي إلى صراع بين الواجبات الأسرية والفردية. وهذا الصراع لا يقتصر على العلاقات بين الزوجين فحسب، بل يمتد إلى الأبناء ويؤثر في استقرار البيت والمجتمع، ويضعف الروابط الاجتماعية التي تشكل أساس الانسجام المجتمعي في الثقافة الإسلامية.
إن التطبيق المطلق لهذه المواد، دون مراعاة للثوابت الشرعية والقيم الثقافية، يهدد البناء الأسري ويفكك شبكة القيم والعلاقات الاجتماعية التي تقوم عليها المجتمعات الإسلامية. وهو ما يجعل الموقف النقدي من سيداو ضرورة استراتيجية، ليس رفضا لمبدأ إنصاف المرأة، بل للحفاظ على التوازن بين الحقوق الفردية والوظائف الأسرية والاجتماعية بما يضمن تماسك الأسرة والمجتمع.
لذلك، يتطلب الموقف النقدي المتوازن اتخاذ ثلاث خطوات أساسية:
أولًا، قبول البنود التي تنسجم مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، مثل حماية المرأة من العنف، وضمان حقها في التعليم والعمل، وتمكينها من المشاركة الاجتماعية والسياسية، بما لا يتعارض مع الثوابت الدينية والثقافية. هذا القبول لا يعني الانسياق وراء كل نصوص الاتفاقية، بل التمييز بين ما هو مشروع ومفيد للمرأة وللمجتمع، وبين ما قد يؤدي إلى اختلال الأسس الأسرية والقيمية.
ثانيًا، رفض البنود المتعارضة مع الشريعة والخصوصيات الثقافية، والتي تمس البناء الأسري أو تهدد الهوية الاجتماعية، مثل المواد التي تسعى إلى المساواة المطلقة في الميراث، والقوامة، والولاية في الزواج، والأنماط الأسرية المتعارف عليها، وحرية الإنجاب والتنقل بلا ضوابط. هذا الرفض لا يعني رفضًا للمرأة أو حقوقها، بل موقفًا واعيًا يحمي المرأة والأسرة في ظل الشرع والثقافة الإسلامية، ويحقق التوازن بين الحقوق الفردية والوظائف الأسرية والمجتمعية، ويصون استقرار الأسرة بوصفها نواة المجتمع.
ثالثًا، تطوير بدائل محلية، إسلامية وعربية، قادرة على تمكين المرأة وحماية حقوقها دون المساس بالبناء الأسري والقيم الاجتماعية. وتشمل هذه البدائل صياغة تشريعات وطنية تراعي المرجعية الشرعية، وتوازن بين حقوق المرأة وواجباتها، مع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف إلى تطوير قدراتها دون تعطيل وظائف الأسرة. كما يمكن تبني آليات تمكين اقتصادي واجتماعي للمرأة تتناسب مع السياق المحلي، بما يعزز استقلالها ويكفل استقرار المجتمع وتماسكه في الوقت نفسه.