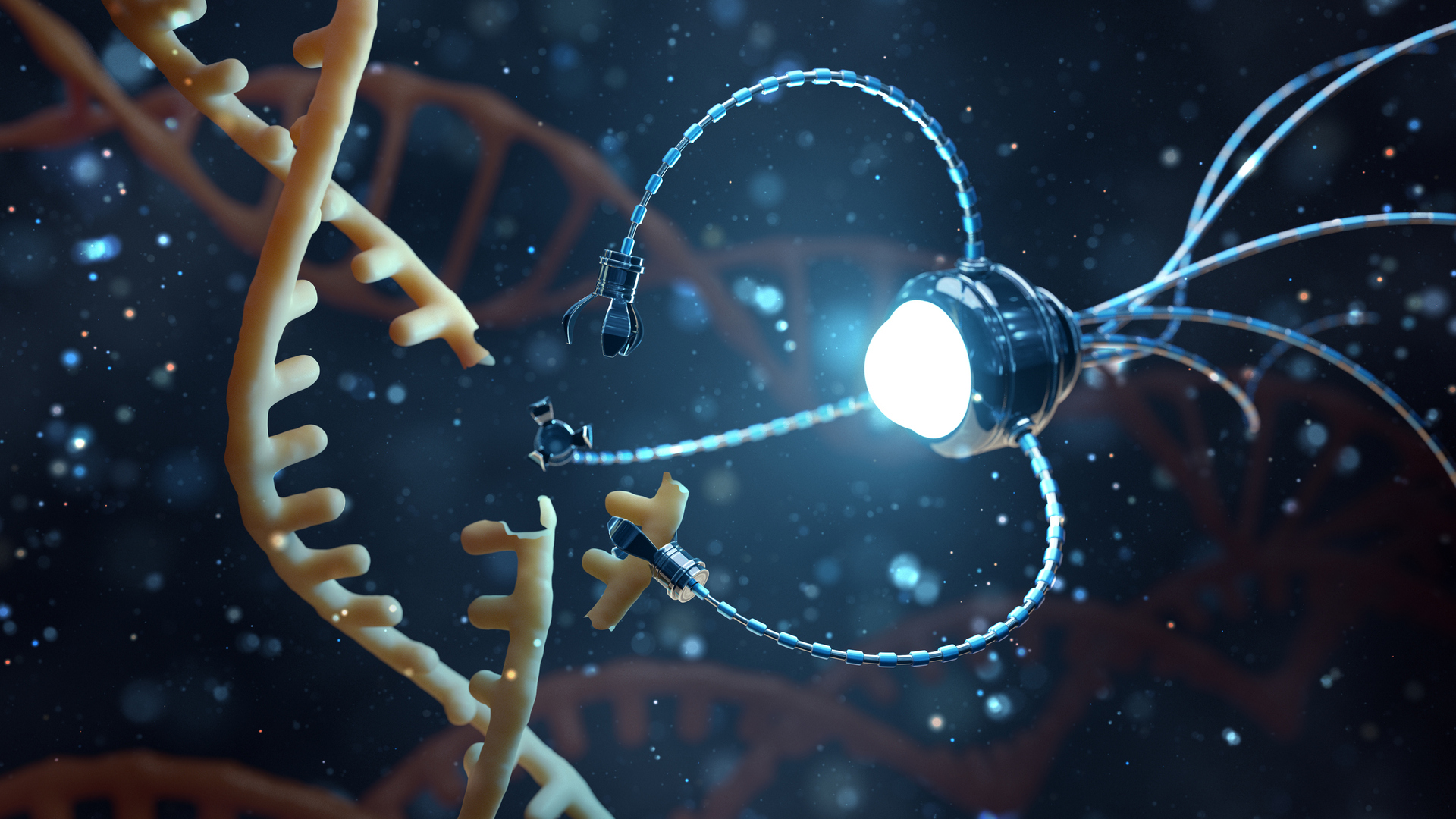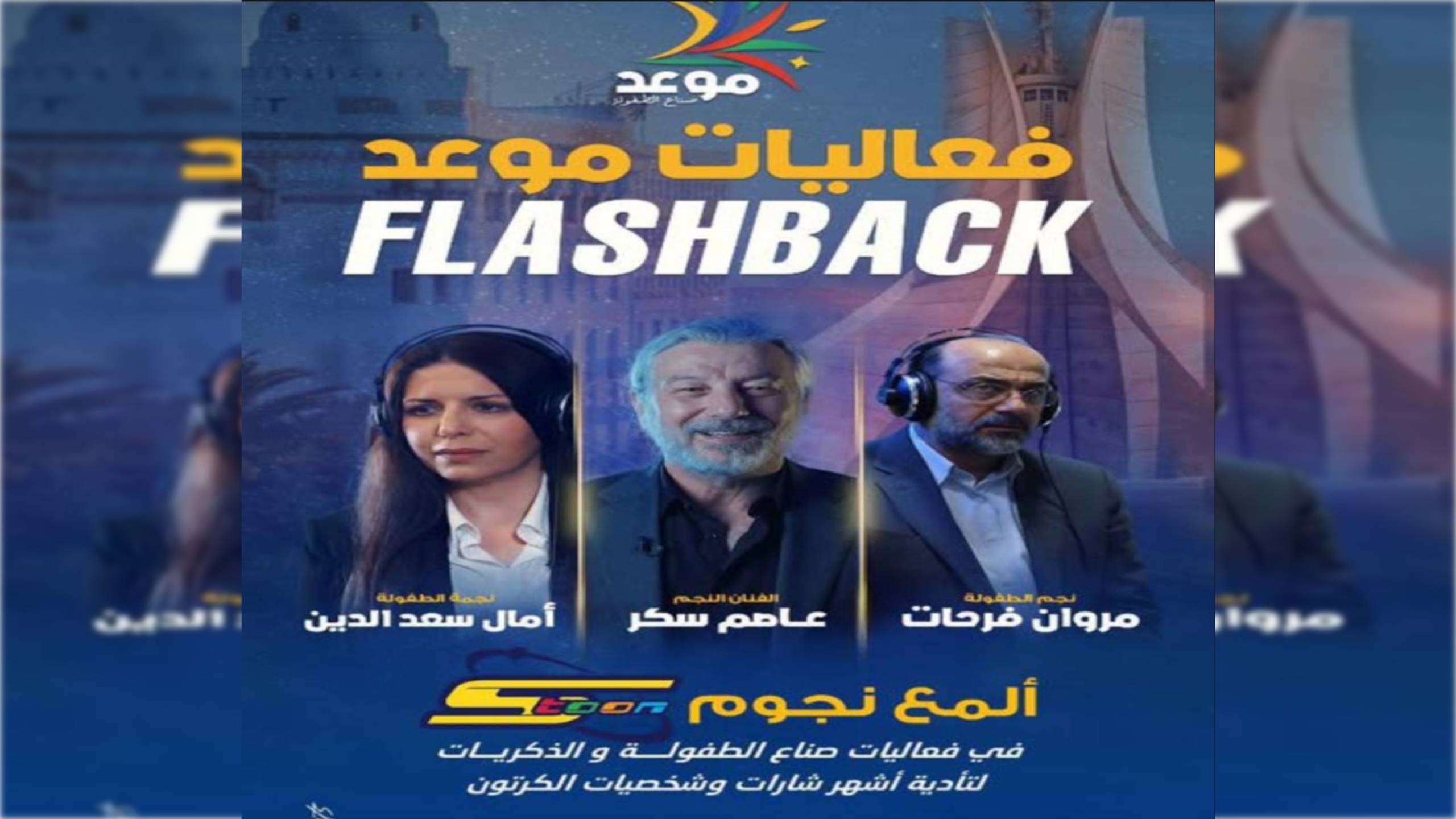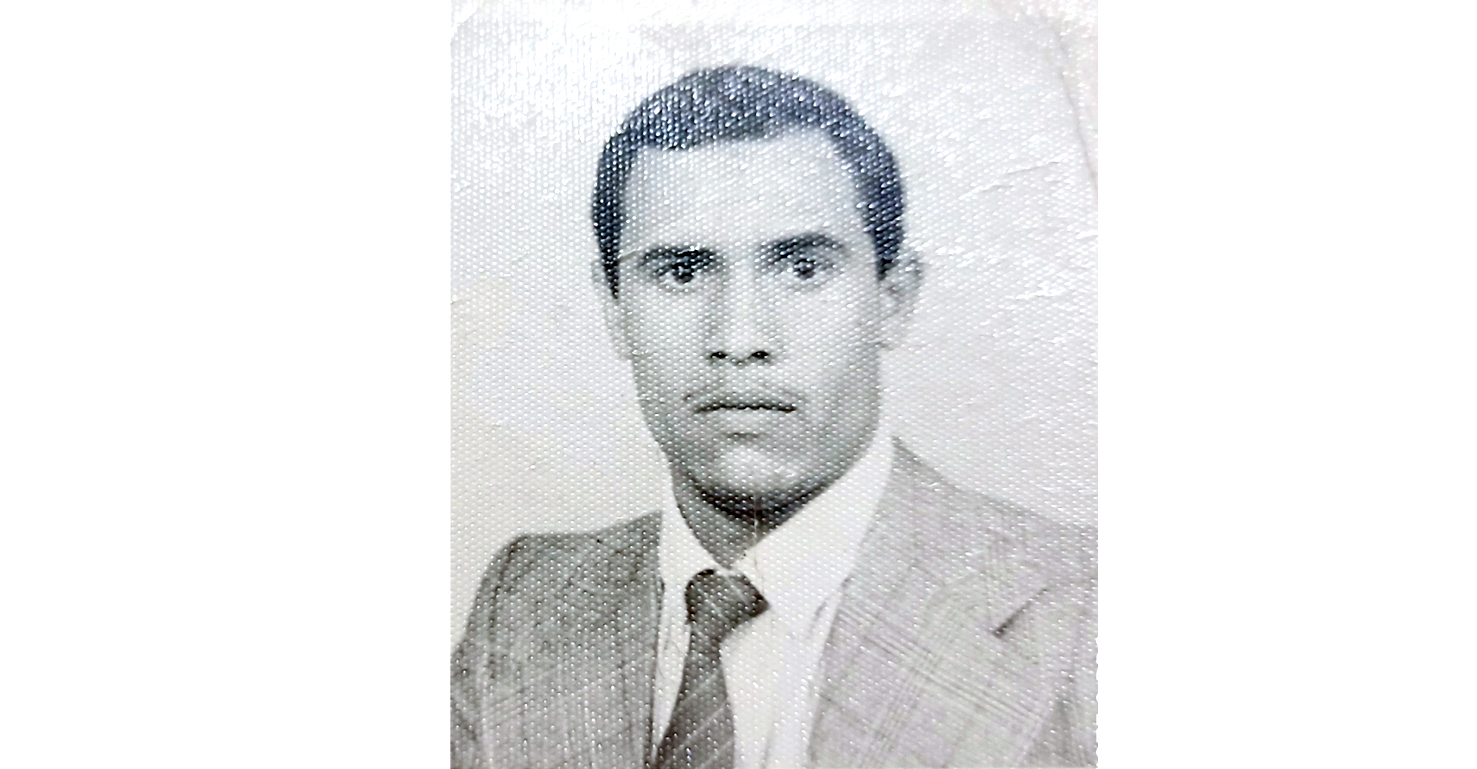فن تدمير الكفاءات
د. بن زموري محمد/ في كل أمة، تُعدّ الكفاءات البشرية أعظم رصيد وأسمى أمل في التقدم الحقيقي. فالعقول التي تنبض بالفكرة، والأيدي التي تتقن العمل، والقلوب التي تنبض بالإخلاص، هي التي ترسم للأوطان طريقًا نحو العزة والاستقلال والكرامة. لكن المفارقة المحزنة أن بعض المجتمعات، بدلاً من أن تحتضن هذه الطاقات وتُكرمها، تمارس في حقها نوعًا …

د. بن زموري محمد/
في كل أمة، تُعدّ الكفاءات البشرية أعظم رصيد وأسمى أمل في التقدم الحقيقي. فالعقول التي تنبض بالفكرة، والأيدي التي تتقن العمل، والقلوب التي تنبض بالإخلاص، هي التي ترسم للأوطان طريقًا نحو العزة والاستقلال والكرامة. لكن المفارقة المحزنة أن بعض المجتمعات، بدلاً من أن تحتضن هذه الطاقات وتُكرمها، تمارس في حقها نوعًا فريدًا من الظلم؛ ظُلم لا يُمارس بالسوط أو القيد، بل بالسخرية والتهميش والتضييق والتجاهل. إنه ما يصح أن نسميه «فن تدمير الكفاءات»؛ فنٌ لا يُدَرّس في الجامعات، ولا يُذكر في اللوائح الإدارية، لكنه يُتقن في الممارسة اليومية داخل المؤسسات، والإدارات، والمجتمعات التي تتآلف مع الرداءة وتضيق بالتميز.
إن الكفاءة في بيئة معادية لا تُكافأ، بل يشكك فيها، لا يُحتفى بها، بل يُطعن في دوافعها. يبدأ هذا الفن الخبيث من لحظة يُنظَر فيها إلى الإنسان الكفء على أنه غريب وسط جماعة لا تهتم إلا بالشكل دون المضمون، أو تتعامل مع النجاح على أنه تهديد شخصي لا إنجاز جماعي. يُقصى المجتهد لأنه لا يُجيد المجاملة، ويُهمّش المبدع لأنه يخرج عن النمط، ويُطارد صاحب المبادرات لأنه يزعج الراكدين بفاعليته. يُربَك المشهد حين يُختزل التميز في العلاقات، ويُختزل التقدم في رضا من هم في القمة، لا في أثر من يعمل في الميدان.
وتتعدد مظاهر تدمير الكفاءات، فتراها في صور شتى: مدير يعاقب من يتفوق عليه في الحنكة لأنه يشعر بالتهديد، ومؤسسة تُقصي فكرة عظيمة فقط لأنها جاءت من موظف «صغير»، وإدارة تضع العراقيل أمام صاحب المبادرة حتى يملّ ويتراجع، وإعلام يُسلّط الضوء على من لا يستحق، ويغض الطرف عن المخلصين. إن أشدّ ما يحبط الكفاءة ليس النقد، بل التجاهل، وليس الاختلاف، بل العزل. وهذا ما يحدث حين تتحول المؤسسات إلى بيئات خانقة، تُدار بشعار خفي: «لا تكن أفضل مني، حتى تبقى».
ولا تتوقف هذه المظاهر عند حدود التهميش، بل تتعمق أكثر حين يصبح صاحب الكفاءة هدفًا للنيل والسخرية، ويُتهم بالكبرياء لمجرد ثقته بنفسه، ويُوصف بالغرور لأنه يحرص على الدقة والإتقان. وتبلغ المأساة ذروتها حين يُسند الأمر إلى غير أهله، ويُكافأ الموالون على حساب الأكفاء، ويتبوأ مواقع القرار من لا يملك رؤية ولا رسالة، بل يملك فقط مفاتيح العلاقات أو أدوات التملق. وقد أشار الحديث النبوي الشريف إلى خطورة هذا الوضع حين قال النبي ﷺ: «إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»، أي انتظر لحظة الانهيار، ليس بالضرورة في صورة كارثة صاخبة، بل في صورة تدهور مستمر يُفقد المجتمع بوصلة النهوض.
لكن هذه المظاهر ليست وليدة الصدفة، بل تغذيها أسباب عميقة، أولها غياب ثقافة الاعتراف بالفضل. فمجتمعاتنا – في كثير من الأحيان – لا تعرف كيف تُكافئ المبدعين، ولا تمتلك آليات شكر فاعلة، بل تستنفر ضد من ينجح خارج النسق المعتاد. كما أن الخوف من التغيير يخلق حاجزًا نفسيًا يجعل القادة يفضلون التوسط والجمود على المخاطرة والتجديد. وهناك أيضًا هشاشة المنظومة الإدارية، التي تُقيم الأداء على أسس شكلية لا موضوعية، وتفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
ويُضاف إلى ذلك تربية مجتمعية لا تُربي على الجرأة، بل على الطاعة، لا على الإبداع، بل على التكرار. فالشاب المتفوق يُقال له منذ الصغر: «اخفض رأسك تعِش»، و»لا تكن نجمًا حتى لا تحترق»، وتُزرع فيه مفاهيم سلبية عن الطموح، كأنه نوع من الأنانية، أو شكل من الغرور، أو سعي مريب وراء المناصب. وبهذا تنمو في الوعي الجمعي مقاومة غير معلنة ضد كل من يريد أن يتميز.
أما النتائج، فهي أكثر ما يجب أن يُقلق الضمير الوطني. أولها هجرة العقول؛ فحين لا يجد الطبيب أو المهندس أو الباحث بيئة تقدر جهده، يبحث عنها خارج الحدود. وقد صرّح الدكتور أحمد زويل، بعد أن نال جائزة نوبل، أنه «حاول أن يخدم بلده، لكن البيروقراطية قتلت المشروع قبل أن يولد»، مضيفًا أنه شعر في بعض اللحظات أن الغرب قدّره أكثر من وطنه. هذا الشعور – حين يتكرر – يصنع جرحًا غائرًا في الوعي الوطني، لا يلتئم بسهولة. ثم هناك النتائج المؤسسية؛ إذ تفقد الإدارات حيويتها، ويتسرب الجمود إلى كل المستويات، ويستقر الأداء الرديء على أنه «أفضل ما يمكن»، لأن من يمكن أن يغيّره قد تم دفعه إلى الهامش أو إلى الخارج. وينشأ جيل جديد يرى أن النجاح لا يُبنى على الكفاءة، بل على العلاقات، فيفقد دافعيته نحو التفوق، ويغلب عليه الإحباط أو اللامبالاة.
أما الأخطر من ذلك كله فهو الخسارة المعنوية؛ فحين يشعر الكفء أنه غير مرحب به، يتوقف عن الإبداع، وإن بقي في مكانه. يُؤدي مهامه بقدر الحد الأدنى، ويموت فيه الشغف، وتذبل فيه الروح. وهذا النوع من الموت البطيء لا يُرى، لكنه ينعكس على كل شيء: على جودة التعليم، وعلى فعالية الإدارة، وعلى نزاهة الاقتصاد، وعلى استقرار المجتمع.
ولذلك، فإن العلاج لا يكمن فقط في تحسين الرواتب أو تغيير القوانين، بل في بناء ثقافة جديدة ترى الكفاءة قيمة لا تهديدًا، وتعتبر الطموح طاقة لا جرمًا. لا بد أن تعود للمجتمع ثقته في نفسه وفي مبدعيه. أن نربي أبناءنا على أن الاجتهاد لا يضيع، وأن التفوق ليس جريمة، وأن من يعمل يجب أن يُقدَّر، ومن يُخلِص يجب أن يُكافَأ. يجب أن نُراجع آليات التوظيف والترقية، وأن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بلا مجاملة ولا محاباة. يجب أن نفتح المجال للرأي الآخر، وللشباب، وللنساء، وللمبادرات الفردية، وأن نكسر الأصنام الإدارية التي تقدس الشكل وتقتل الجوهر.
فالأمم لا تنهض بالعشوائية، ولا بالصدف، ولا بالولاء الأجوف، بل تبنى حين تُحتضن كفاءاتها وتُفجَّر طاقاتها. وما لم نكسر هذا الفن الهدّام، فن تدمير الكفاءات، فسيظل النهوض مؤجلًا، وسيبقى المستقبل رهينة التردد والخوف والركود. وإن التاريخ لا يرحم من ضيّع أبناءه، ولا يُعذر من كسر أجنحة طيوره وهو في أمسّ الحاجة إلى التحليق.